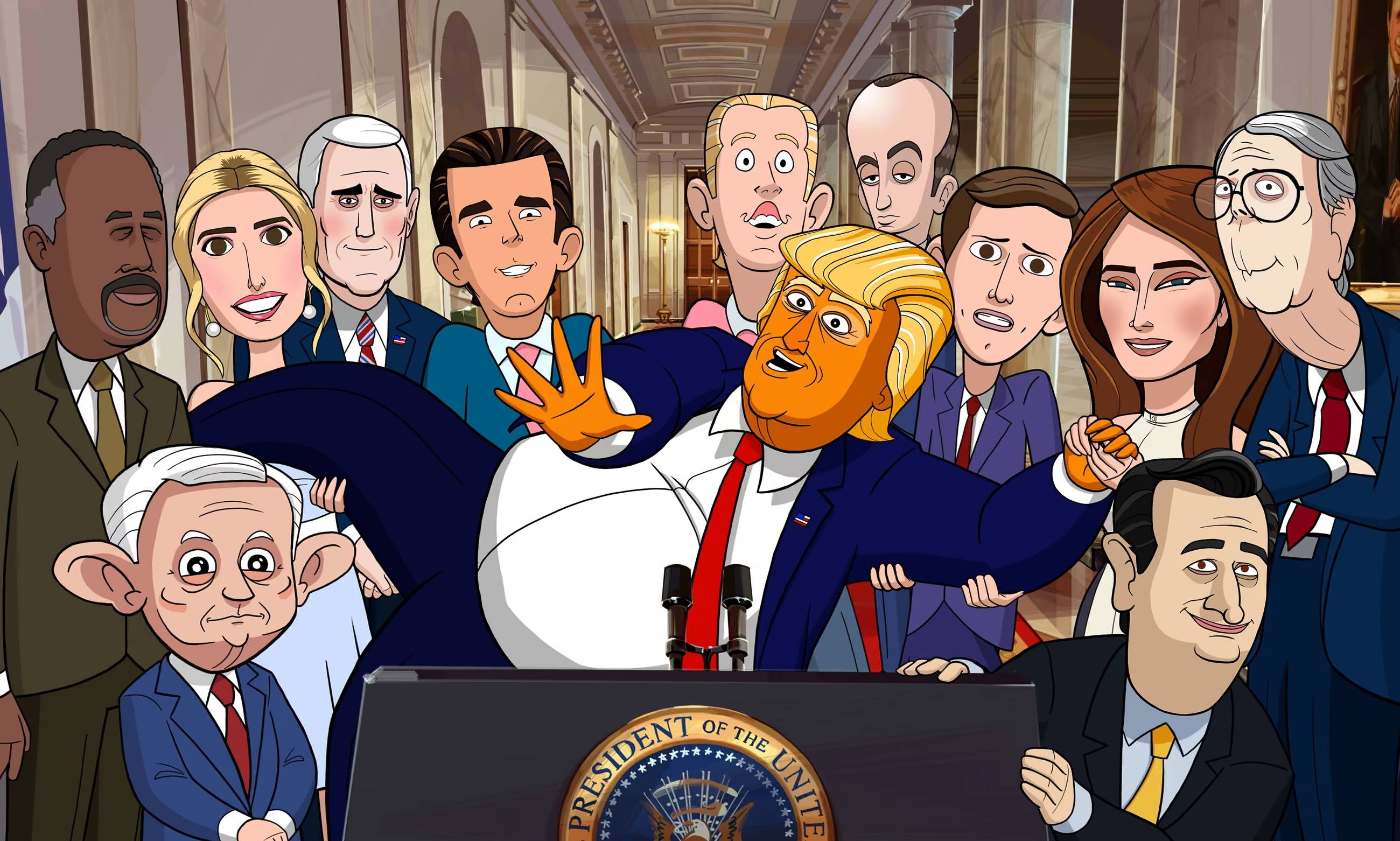عن الأحلام والذكريات والحب المفتقد والرغبات المؤجَّلة المقموعة، تدور مناخات رواية «أحلم وأنا بجوارك» للكاتبة زينب عفيفي، مراوحة بين طرف من أدب السيرة الذاتية، وطرف آخر من أدب البوح أو الاعتراف. وبين الطرفين تبحث (الذات الساردة) البطلة الكاتبة عن عالم بديل، ووجود موازٍ يحقق لها نوعاً من التوازن النفسي، ويخفف من مأزق حياتها في ظل هذه الحيوات المفتقدة الحارقة، لكن لا المأزق الإنساني بمكابداته المأساوية وحده يصنع الدراما فنياً، ولا السيرة الذاتية وحدها تمنح الأنا نشوة الاعتراف، لتمتلئ بكينونتها، بعيداً عن محاولة التصالح مع ماضٍ قاسٍ عاشته أم وابنتها ينتميان إلى الطبقة البرجوازية، ولا يزال يلقي بظلاله على حاضر مترع بالأسى والشجن، كأن ذلك الماضي أصبح وصيّاً عليه، وعلى معنى الحياة.
تتجسد عقدة ذلك الماضي، في صورة البطلة التي شارفت على سن الأربعين، ولم تزل فتاة عذراء، وأيضاً في صورة الأم التي فقدت بصرها وهي في أوج شبابها، ولا تجد عزاء لحياتها الزوجية النمطية الخشنة سوى بالرجوع إلى الماضي بكل ذكرياته ومفارقاته المؤلمة، محاولة استعادة صورة حبها الأول وحبيبها الذي تخلى عنها فجأة، في ظروف ملتبسة وشائكة، ورغم ذلك لا تزال تحتفظ بصوره ورسائله كأنه ومضة الروح الحانية الوحيدة الباقية في جراب الزمن.
يفاقم موت الأب المفاجئ في حادث سير، مأزق الأسرة إنسانياً، مخلّفاً انكساراً في الروح ومشاعر باليُتم، وتتحول حواسُّ مثل الشم، والملمس، والسمع، والرهافة إلى لغة خاصة، غير منطوقة، بديلة بين الأم الكفيفة وابنتها التي تشبهها، بل تكاد تكون صورة طبق الأصل منها. بينما يعزز حبهما المشترك للأدب والقراءة والموسيقى من قدرتهما على الصمود في هذا الوضع المأساوي، ومجابهة وجود ناقص ومشوه، لا يملكان حياله سوى الاختباء من الحياة، ولو في عباءة الماضي والذكريات، كوسيلة للخلاص من شبح اليأس الذي أصبح يعشش في الحاضر ويحاصره، كأنه النقطة الوحيدة التي تشكل عمق الصورة وتلون ظلالها.
هكذا، تتعمد «مي» الفتاة الأربعينية بطلة الرواية التي لم تذق طعم الحب، ولم تلفح نسماته جسدها الغض، تتعمد الهروب من واقعها الأنثوي، ونسيان الحب، لكنه مع ذلك، يظل يطاردها بإيقاعاته الناعمة والصاخبة في روايات الحب الكلاسيكية الكبرى التي أدمنت قراءتها، حتى أصبحت تمثل وجوداً موازياً، تجد فيه تعويضاً عن عدم مصادفة الحب وتحققه في الواقع المادي... وهو ما تصوره الكاتبة على هذا النحو في مستهلّ الرواية (ص 12) قائلةً: «بدأت تتسع دائرة وجود أبطال الروايات في حياتي، صاروا يأتون كل ليلة ليؤنسوا وحدتي في هذا الفراغ الذي تركه أبي بعد رحيله، هم من يستمعون إلى هلاوسي الليلية دون استدعاء، هم من يكتمون أسراري في حالاتي المتناقضة من الحزن والفرح، والضحك والصراخ، والاحتياج والشعور الزائف بالقوة والاحتمال، ونوبات النشوة والرغبات المكبوتة... رأيت فيهم ما رآه بول أوستر في القراءة من أنها الملاذ والعزاء والسلوى والحافز على الاختيار والسكون الجميل الذي يحيط بنا ونحن نُصغي لأصداء كلمات المؤلف وهي تتردد في رؤوسنا».
بيد أن هذا الاختيار المنشود لا يتحقق، بل تتحول القراءة من فعل إيجابي يعين الذات على المعرفة والتزود بالأفكار والرؤى، إلى فعل سلبي، عابر ومؤقت، يؤدي وظيفة محددة وهي هدهدة مشاعر البطلة وأحلامها في الحب والحياة. كأن القراءة أصبحت شكلاً من أشكال رثاء الذات. وعلى العكس، فأن تقرأ وتحب القراءة يعني أنه أصبح لديك طريق للذهاب والإياب، من وإلى الذات، والعالم أيضاً. إنها ترحال، لتعرف محطات أكثر للوصول والسفر.
فهكذا، بين العيش في قصص الحب وأزمنته المنقضية روائياً، وعزف الأم لحنها الشجيّ الحزين كل ليلة، يتحدد عالم ممعن في الواقعية، سقفه جامد وبارد، لا يعرف الخيال، يكرس للعزلة ويصبح منتجاً لها، بشكل لا إنساني، وتختلط فيه الأشياء، بلا منطق أو معنى، مخلّفة هوّة في الروح والجسد يصعب ردمها... تُقارِب الذات الساردة هذا العالم في (ص 13) قائلة على لسان البطلة الابنة: «عزف أمي يولّد بداخلي حنيناً لأشياء أحسها ولا أتلمسها إلا مع أبطال الروايات وأنا معهم داخل غرفتي المغلقة لفترات طويلة، قد تصل ليوم أو يومين، دون أن أغادر مكاني إلا في أوقات تناول الطعام في صحبة أمي، أو تلبية مطلب تحتاجه، ونادراً ما تستعين بي، فهي كثيراً تفضل الاعتماد على نفسها حتى لا تُشعرني بعجزها».
هذه الحالة التي تتحول فيها معايشة الكتابة والاستغراق فيها إلى وسيلة للخلاص من الحب، يمثلها على النقيض، «سليم علوان» الكاتب الروائي الشهير، الذي سعى عمداً إلى قتل الحب الذي جمعه بأمّ البطلة، في أثناء دارستيهما الجامعية، حتى يخلص إلى الكتابة بحرّية، عن الحب نفسه.
تجمع المصادفة البطلة الابنة بـ«سليم علوان»، فتقدمة للجمهور في ندوة أدبية بإحدى المكتبات، تقرأ خلالها بعضاً من كتاباته، كما يتحدث عن روايته الجديدة: «أحبك إلى الأبد» التي كتبها عن قصة حبه الأول للأم... تنكشف حقيقة «سليم علوان» أمام البطلة، وتروي لها الأم حكايته معها، بل كيف قمع فيها أيضاً طموحها في أن تصبح كاتبة.
يتسع فضاء هذه المكاشفة حين تعطيها ملفاً، تحتفظ فيه بالصور والرسائل المتبادلة بينهما... يتقرب «سليم علوان» بشخصيته الجذابة الآسرة من البطلة المفتونة به، ويصارحها بحبه لها، ويطلب منها الزواج رغم فارق السن الشاسع بينهما... لكنها تقف حائرةً ما بين الرغبة في الحب والانتقام منه، لا تملك الإرادة الحرة لحسم فراغ لا نهائي انفجر فجأة في عمق الصورة، وكاد ينزع عنها الإطار، ويقلبها رأساً على عقب... وهو ما تصوره على هذا النحو في لحظة من البوح والنجوى الداخلية الشفيفة، قائلة في (ص 154): «أنا لست ملاكاً ولا شيطاناً، أنا فتاة عذراء لم يمسسها رجل من قبل، تريد أن تعيش وتمارس الحب، تتذوق طعمه...»، «أنا محرومة من الخيال والواقع، جسدي المحروم وروحي الهائمة تطوف حول أبطال الروايات الوهميين كل ليلة، ثم تعود إلى الفراش مهزومة».
بدافع من الواجب العائلي تغلق البطلة صفحة وقوعها في حب الروائي العاشق، مستثمرة رذاذها الموجع في استعادة نقطة التوازن لحياتها وحياة الأم معاً، وعودة الدفء المفقود إلى البيت، حيث تُقنع الأم بكتابة حكاية حبها مع «سليم علوان» في صورة معارضة قصصية، ونشرها في كتاب، لتحقق بذلك حلمها القديم أن تصبح كاتبة، ويصبح التسامي عن الانتقام واجباً إنسانياً، للدفاع عن الكرامة الإنسانية المجروحة.
لقد وضعت زينب عفيفي يدها بقوة في هذا الكتاب على بذرة روائية خصبة، لكنها لم تستطع أن تنضجها، وتبني عليها مفارقات عالم بطلتها الإنساني الخاص المليء بشقوق الأسى والحرمان. فأصبحنا أمام نص يلعب على سطح الصورة، وبضمير أحادي رخو، تنتجه طبيعة السيرة الذاتية وأنا المتكلم، وفي فضاء مغرق في الرومانسية يقيس كل شيء بمدى التصاقه بها، والعيش في ظلالها.
وفوق سطح هذه الصورة اكتفت الذات الساردة أيضاً بلجوء بطلتها إلى عالم الروايات، حتى أصبح الوجود الموازي الأسير لديها، فلم تتوغل داخله وتُخرجه إلى فضاء صورتها هي، بما تمثله من مساقط شحيحة للنور، يتجاور فيها البياض والسواد، كأنهما يبحثان عن لون آخر مغاير في الصورة... هنا كان يمكن لتقنية التقمص أن تلعب هذا الدور بامتياز، لو فكرت الذات الساردة أن تتخذ منها سلاحاً لتوسيع وتكثيف مناورة الحكي، وكسر هيمنة الضمير الواحد، وذلك بتقمص دور إحدى بطلات هذه الروايات، ومعايشته إلى حد التوحد والذوبان في فضائه وأَقْنِعَته المستدعاة المتوهَّمة، كأنه حقيقة حية معيشة بالفعل على مسرح النص... وكان يمكن أيضاً أن تتقدم لعبة نص الأم المعارض لنص حبيبها الكاتب الشهير الغادر، بدلاً من التأرجح فوق حواف نهاية الرواية، وأن يتم إنجاز هذا النص بالفعل، ويشكل معارضة قصصية حقيقية، داخل الرواية تتضافر فيها قوة الإبداع والعاطفة، الأمر الذي كان سيجعل –برأيي- دوائر الصراع مشدودة إلى أفق درامية خصبة ومضيئة، مسكونة بعلاقة سردية ذات طبيعة خاصة، بين أصل وظل أصبح أحدهما ضحية للآخر.
قصص الحب وأزمنته المنقضية... روائياً
زينب عفيفي تحوّلها إلى عقدة في «أحلم وأنا بجوارك»


قصص الحب وأزمنته المنقضية... روائياً

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة