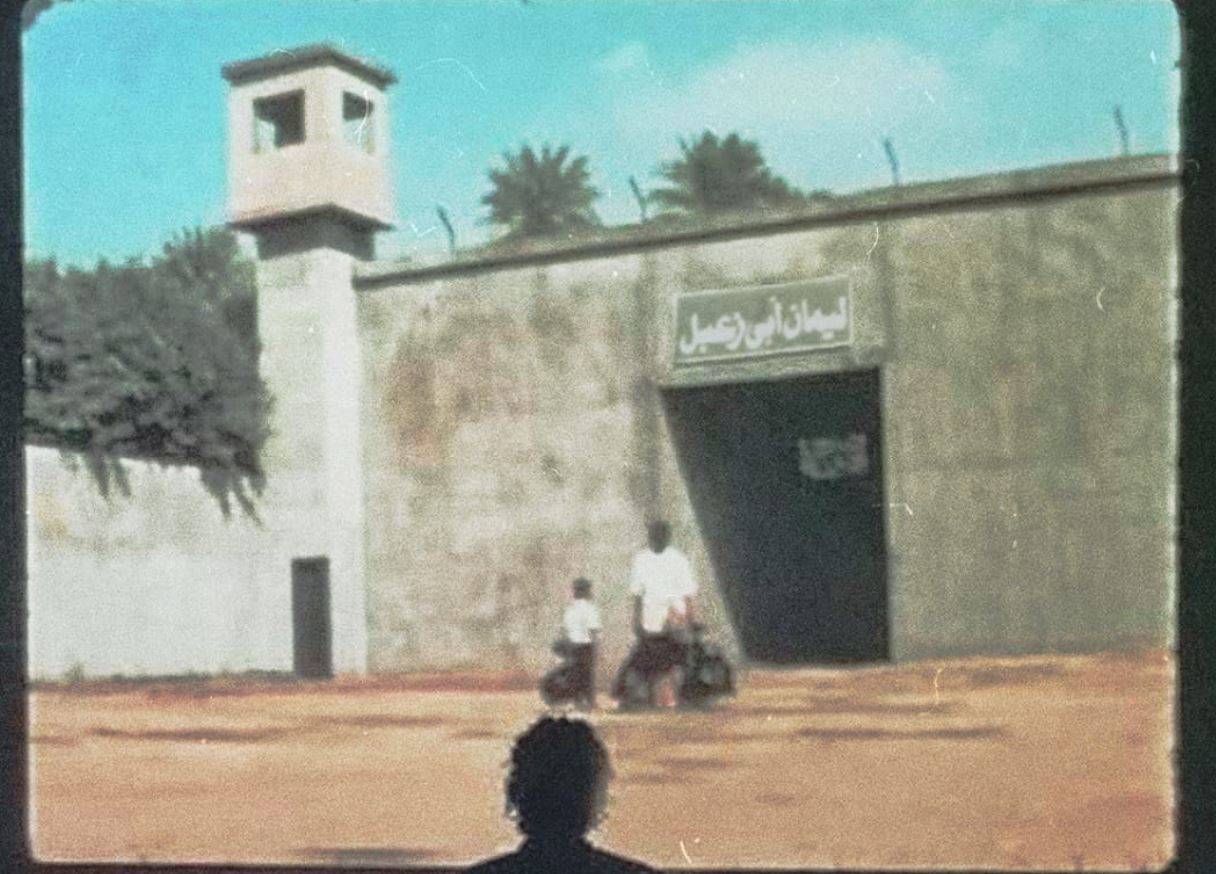لا شك في أن عالمنا المعاصر مبني على القوة والهيمنة. نعم، وحدها القوة تحدد أنماط العلاقات والتوازنات فيه. هذا هو التفسير الأقرب ليس فقط لتجذر ظاهرة الخوف من الآخر وانتشارها، بل إنها أيضاً تشكل أهم العوامل التي تحدث ارتباكاً وخللاً في تقاسم الثروات والكنوز الإنسانية، الاقتصادية منها والمعرفية، الأمر الذي يجعل الحروب تتكاثر وتتشعب، وبالتالي تتوالد الكراهيات، وتتشكل القطائع، وترفع الجدران الفاصلة والحدود الوهمية، بين من يملكون القوة ومن يفتقرون إليها. وتنتج عن ذلك ظواهر كثيرة أتجنب الإسهاب في تحليلها لأنني أركز هنا على الأعطاب الثقافية والاجتماعية والسياسية.
قد يضحي من البديهي أن يُؤدي رد الفعل الطبيعي الذي هو «الخوف من الآخر»، إلى التفكير في إيجاد طرق لحماية الذات، إلا أن هذا قد يؤدي أيضاً إلى التقوقع عليها، فتتحول حالة الخوف إلى حالة تعصب يتستر بحجة حماية الذات والخشية عليها مما ينعت بالذوبان، أو التفكك، أو التلوث، أو الاحتواء. لا يخفى على متأمل أو مراقب أن الخوف الإبستيمي، الخوف المعرفي، أمسى حالة تاريخية يعيشها الشمال كما يعيشها الجنوب ويحياها الشرق كما يحياها الغرب على حد سواء.
قد نذهب نحو التفكير في أن الخوف الثقافي طقوس لا تمارسها سوى الشعوب التي تعيش حالة من التخلف، وعلى علاقة مضطربة تجاه ما يُسمى بمشكلة الهوية الحضارية أو الوطنية أو القومية، إلا أننا قد نجد من جهة تقابلية أن تجليات الخوف المعرفي وُجدت أيضاً في الغرب المتحضر، بحيث إن الثقافة الغربية أنتجت في أوج حالة توسعها الاستعماري في أفريقيا ما بعد الصحراء، ثقافة الاحتقار حيال ذوي البشرة السوداء، ونعرف أنهم - إلى زمن ليس ببعيد - ظلوا سلعة رخيصة تباع وتُشترى، وتُستغل لخدمة السيد الأبيض، على الرغم من الاستقلالات الوطنية التي حازت عليها كثير من الدول الأفريقية. ولم تتغير النظرة الدونية لهم، إذ بعد وصول جالية من هذه البلدان، على شكل يد عاملة إلى أوروبا، ومع انتشار ثقافة حقوق الإنسان في العالم، وبعد توسع خبرات المعرفة والعلوم، فإن مجموعة من الأوروبيين الذين لم يستطيعوا التخلص من نوسطالجيا «الأسود السلعة»، فقد تولدت لديهم بوادر مرض «الزنجوفوبيا» Negrophobie، الذي سيتحول في مرحلة لاحقة مع انحسار الفكر الاستعماري المباشر الكلاسيكي، ليضحي هذا المرض: «فوبيا الآخر»، ويتخذ تجليات وصوراً أخرى كثيرة، تعكس الارتباك وحالة التأزم السياسي والثقافي والاقتصادي، الذي عاشته أوروبا قبل توحيدها، وقد تجلت من خلال كثير من الممارسات التي بدت في الحياة الاجتماعية اليومية، وأفرزت جراء ذلك سلسلة من المفاهيم المعرفية والاصطلاحية كـ«العربوفوبيا» Arabophobie التي محورها الخوف من الإنسان «العربي»، رعب يُغلف عادة بكثير من الأوصاف العنصرية مثل «الخائن»، «الوسخ»، «غير الوفي»، «المخادع»، «العنصري»، «المهووس بالجنس»، «غير الحضاري»، «المنتقم»... ولا يخفى أن هذا مستمد من ثقافة بمرجعيات تحمل مخلفات النظام الاقتصادي الكولونيالي، مستنداً على العنصرية التي تأسس عليها منذ بداية القرن التاسع عشر. تجدر الإشارة إلى أن هذه التهم والأوصاف الدنيئة الملحقة بالعربي لا تستثني الأمازيغي. إن هذا الاستعمار السابق، الذي كان يملك اليد الطولى المنبسطة على بلدان المغرب الكبير، وبشكل خاص الجزائر، وظل يعمل جاهداً على التفريق العرقي والسياسي بين السكان العرب والأمازيغ قصد تشتيت قواهم في المقاومة وبالتالي ترسيخ هيمنته، فإنه هو ذاته وبعد الاستقلالات الوطنية، لم تعد عينه المصابة بداء «العربوفوبيا»، وبثقافتها العنصرية تفرق بين هذا وذاك، فقد أضحوا كتلة واحدة تصدر ذات الخوف وذات الريبة، ومن ثم تستدعي المحاربة والتهميش، لا فرق بين عربي وأمازيغي.
ثم إن مصطلح «المغربوفوبيا» Maghrébophobie يعرّف الفوبيا التي ينتجها الوجود المغاربي المكثف والواضح داخل الحيز الأوروبي بشكل عام، خصوصاً في بلجيكا وهولندا، وفي فرنسا.
إن الوجود الاجتماعي الواضح، والمكثف la visibilité sociale، بعدد المقيمين المغاربيين الذي يبلغ نحو خمسة ملايين نسمة، أوجد ردة فعل ثقافية سياسية خائفة ورافضة، تتأكد يوميّاً في ثقافة أحزاب اليمين المتطرف، التي أضحت تحقق وجوداً سياسيّاً كبيراً، وتنتقل إلى حقول النخب، بحيث إن بعض بوادر هذه «المغاربوفوبيا» ظهرت في خطابات النخب الفلسفية والأدبية والإعلامية والفنية، الأمر الذي يعمق المرض، ويجعل الخوف من المغاربي سلاحاً سياسيّاً في الخطاب الاقتصادي اليميني، وأيضاً في بناء أو خلخلة الاتحاد الأوروبي.
مصطلح آخر وهو «الإسلاموفوبيا» Islamophobie ولعله من بقايا ذاكرة الحروب الصليبية، التي ما فتئت تتجدد سياسيّاً، في العشريتين الأخيرتين وبشكل واضح، وتقننت سياسيّاً وإعلاميا وعسكريّاً خصوصاً بعد هجوم الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) على المجمع التجاري الأميركي. وشكلت أحداث سبتمبر المفصل التاريخي للإسلاموفوبيا، بحيث أضحى كل ما يمت للإسلام يرتبط مباشرة وعضويّاً بالإرهاب، وتجدر الإشارة إلى أن عدوى «الإسلاموفوبيا» انتقلت من النخب إلى العامة، لتصير وباء اجتماعيّا عاماً متفشياً في مختلف الطبقات الاجتماعية الأميركية والأوروبية، ثم لا بد من التنبيه إلى أن كثيراً من المصابين بعلّة الإسلاموفوبيا لا يفرقون بين «العربي» و«الإسلامي»، بحيث لا يتصورون أن هناك عربيّاً مسيحيّاً، أو عربيّاً يهوديّاً، فكل عربي مسلم بالضرورة في مخيال الإسلاموفوبي الأميركي أو الأوروبي، وهو إرهابي بالحتمية الدينية. ولعبت شبكات القنوات التلفزيونية التي أصبحت أجهزة ملحقة بوزارات الدفاع وبالجيوش التي تجوب العالم برّاً وبحراً، شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً... لعبت دورها في تنمية ثقافة «الإسلاموفوبيا» بتناول ظاهرة الإرهاب التي أصبحت المادة الأساسية للإعلام العالمي، ودخلت «الإسلاموفوبيا» في الاجتماع، والدين والسياسة، والإعلام، والثقافة، والسياحة، والمال، والاقتصاد، والأعمال.
أما من جهة الخوف المضاد، فإن الحرب على الإرهاب وما تلاها من تفكك ببنية الدولة المنحدرة من منتصف القرن الماضي، نتاج الآيديولوجيات الوطنية أو القومية التحريرية التي لم تعد تجيب عن جميع أسئلة العمل السياسي ومتطلباته في هذا القرن، أدت إلى ظاهرة ثقافة الاستبداد، التي ولدت الغضب، والرفض، ثم الاحتجاجات والانتفاضات ثم الثورات التي تمثلت فيما سُمي بـ«الربيع العربي» في كل من تونس، وليبيا، ومصر، واليمن، وسوريا، والسودان، وتوسّعت مساحة ثقافة «الإسلاموفوبيا»، وبرزت أو تعمقت تنويعات في الدين السياسي. وزاد من حدة الوضع العمليات الإرهابية في أوروبا، وفي فرنسا خاصة - حادثة الهجوم المسلح على مجلة «شارلي إيبدو» واعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ثم العملية الإرهابية التي عاشتها مدينة نيس في 14 يوليو (تموز) 2016 – فلم تعد تنحصر في رقعة الخطاب السياسي لليمين المتطرف، بل تخطته لتصبح مادة في الثقافة والفن والمسرح والإعلام.
قضي الأمر وتعمقت الهوة بين الجنوب والغرب، واستيقظ شعور الخوف من حالة كمونه الطويلة، خوف ورثه الفرد في بلدان الجنوب من أيام الاستعمار ولم يبرح أعماقه، بعضه يجد منبته في المجال السياسي، وبعضه في منحاه الديني، والآخر في اللغوي - الثقافي، وفي اضطراب الهوية.
ويحاول حاملو الذاكرة الاستعمارية الداعون إلى فوبيا الآخر، أن ينقلوا الماضي بحيثياته وحمولة إرثه الثقيل إلى الحاضر، باستعادة هذه الذاكرة لا لنقدها وإدانتها، ثم الانتقال نحو البحث عن علاقة جديدة، مؤسسة على الاحترام المتبادل والاستقلال والشراكة دون إلغاء الذاكرة، وهذا واجب الذاكرة أيضاً، لكن مع الأسف، فإنها تُستدعى لتغليب ثقافة الحذر والتوجس وبالتالي الخوف من هذا الآخر، العدو قديماً، على أنه عدو الأبد. لعل الأمر يبدو طبيعياً في حالة ردة الفعل لدى المستعمَر «سابقاً» لموقفه هو الآخر وفوبياه من الآخر/ الغرب، ويعده غرباً متجانساً لا يزال يتربص به لاحتلاله. الخوف هذا يتغذى من مقولات آيديولوجية جاهزة، مؤداها أن الغرب كله دون تمييز يقف ضد العروبة، ويحاربها ولا يبحث سوى في القضاء عليها واندثارها. وظهرت مصطلحات ترمز لذلك مثل «حزب فرنسا» في الجزائر خاصة، ويرمي إلى نعت من يتربص بالعروبة ومحاربتها من الداخل، ويشير إلى فيلق المثقفين المفرنسين. وكثيراً ما تحقق هذه «الفوبيا» من الآخر أهدافها ببث التفرقة والبلبلة وقطع جسور الحوار بين المثقفين الجزائريين أنفسهم على أساس لغوي من جهة، ومن جهة أخرى بتر كل ما يربط بين الضفة الجنوبية المتميزة بثرائها اللغوي والثقافي والضفة الشمالية، وقطع كل إمكانية تواصل أو أمل في إمكانية التعامل عبر عنصري الثقافة واللغة المشتركة كعامل لتطوير علاقة شراكة وبناء مستقبل مؤسس على كل ما هو إيجابي، وتجاوز كل ما هو سلبي. يبدو لي أن الروائي الجزائري كاتب ياسين تفطن مبكراً إلى هذه العلاقة المرتبكة حين قال عن اللغة الفرنسية إنها «غنيمة حرب». عنصر حساس آخر يُستعمل لإذكاء نار العداوة بين الجنوب والشمال، يتمثل في القضية الفلسطينية التي لا أحد يشكك في عدالتها، يوظفه دعاة فوبيا الخوف من الآخر لغرض تأجيج ثقافة التفرقة وبث الكراهية عن طريق تعميم الأحكام، والزعم بأن الغرب موحَّد في عدائه تجاه هذه القضية العادلة، وهي في جوهرها قضية تصفية استعمار، وحق شعب في استعادة أرضه واستقلاله. هذا الادعاء يكذبه التاريخ، لذلك يجب التذكير بأنه كان للثورة الجزائرية أصدقاء من الأوروبيين، ومن بين الفرنسيين أنفسهم، حتى إن منهم من ضحّى بحياته من أجلها مؤمناً بعدالتها، وكما حدث بالنسبة للصورة الجزائرية فإن للقضية الفلسطينية كذلك رأسمال مهمّاً من أصدقائها في أوروبا وأميركا، يرافعون لأجلها، ولقد حضرتُ شخصياً لقاءات وتجمعات كثيرة في أوروبا إلى جانب شخصيات عربية وشخصيات أوروبية تدافع وبقوة عن القضية الفلسطينية.
إنها بعض من مداخل قراءة الزلزال الذي يضرب الإنسان منذ بداية العشرية الأولى من هذه الألفية، حاولت تقديمها واختصار عناصرها التي تسم زمننا بالصعوبة والعنف وضبابية الأفق. تسمه أيضاً بالخوف والخوف المضاد من الآخر، الأمر الذي يجعل الأمل في السلام يتلاشى، والخوف من بوادر حروب ثقافية وقيمية أخرى، بعضها قائم، والآخر على الأبواب.
- روائية وشاعرة وأكاديمية من الجزائر