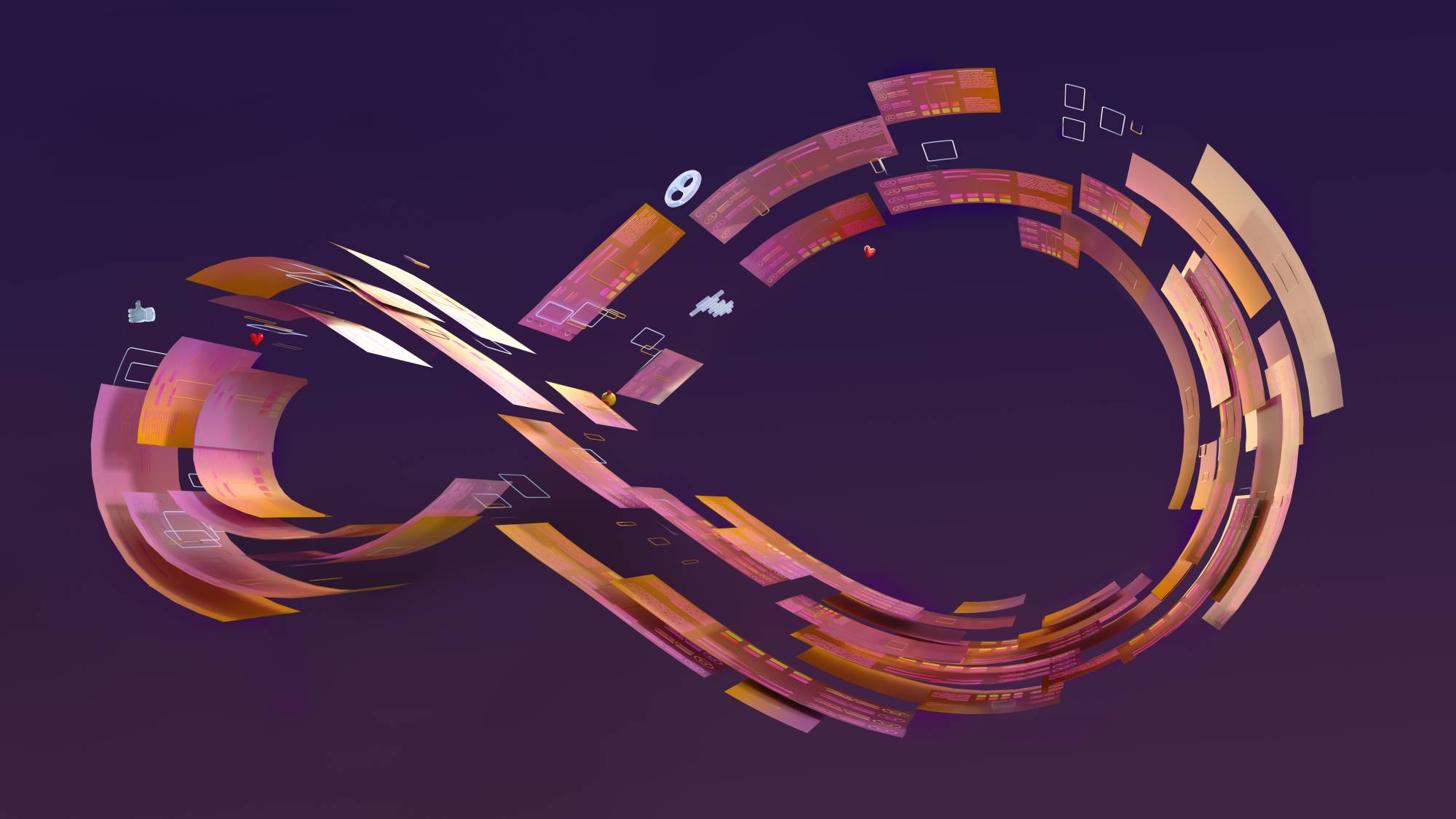يتوقع العلماء أن الاحتباس الحراري سيجعل الكثير من مناطق العالم غير قابلة للسكن، لكن توجد بعض الطرق التي تساعد في الحدّ من تأثيره.
أستراليا تفور
في أستراليا مثلاً كان الصيف الماضي حارقاً، حتى وفقاً للمعايير المحلية، واعتبر شهر يناير (كانون الثاني) 2017 الشهر الأكثر حراً في مدينتي سيدني وبريزبان، وشهدت مساحات واسعة في الجنوب الشرقي ارتفاعاً هائلاً في درجات الحرارة، تجاوز في أحيان كثيرة الأربعين درجة مئوية لأسابيع كاملة. وأدى الطلب المتزايد على الكهرباء في جنوب البلاد إلى انقطاع التيار؛ مما تسبب في حرمان 90000 منزل من التكييف الهوائي، وجعلها أسيرة القيظ والظلمة. كما اشتعلت الحرائق في 87 غابة على امتداد مقاطعة نيوساوث ويلز، فارتفعت درجات الحرارة وتسببت في وفاة الماشية التي تعيش في الحقول.
هذا النوع من موجات الحرّ ليس حالة عابرة، بل هو اتجاه جديد شهد على ارتفاع درجة الحرارة في العاصمة الأسترالية إلى ما فوق 47 درجة مئوية حديثاً، وهو الأعلى في هذه المدينة منذ 79 عاماً. ومن المتوقع أن تعيش سيدني وملبورن موجات حرٍّ شديدة أخرى تصل فيها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية بحلول عام 2040.
تقول سارة بيركنز كيرك باتريك، من مركز الأبحاث المتخصصة في الاحتباس الحراري في جامعة نيوساوث ويلز في سيدني: «نظراً لما سنعيشه بعد 40 أو 50 عاماً من اليوم، يمكن القول إن الصيف الماضي كان طبيعياً جداً؛ فأستراليا لم تصل إلى الأسوأ بعد».
ولكن الأستراليين ليسوا وحدهم؛ لأن غالبية سكان العالم لم تأخذ «التسخين» الناتج من الاحتباس الحراري على محمل الجدّ. عندما يعيش الناس في مكان معتدل المناخ، فإنهم لن ينزعجوا أبداً من ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يسهّل عليهم تنظيم المزيد من النزهات في الطبيعة، وإمضاء فترات من السكينة في الحديقة بعد الظهر. لكن هذا الترحيب ليس منطقياً؛ لأن موجات الحرّ قد تكون قاتلة حتى في أيامنا هذه، ومع تفاقم الاحتباس الحراري، سترتفع نسبة الوفيات.
إن تركيبة الجسد البشري غير مهيأة للتعامل مع درجات الحرارة المتوقعة خلال موجات التسخين في محيط الأرض، أي أن الكثير من المناطق قد تصبح غير صالحة للسكن. لحسن الحظّ، توجد بعض الأمور التي يمكننا القيام بها لتعويد أجسادنا ومحيطنا البيئي أكثر على العالم الحارّ.
موجات حرّ قاتلة
يعي الجميع أن الاحتباس الحراري الناتج من غازات الدفيئة بات منتشراً، ولو مع بعض الاستثناءات القليلة، وأن عواقبه تكون وخيمة أحياناً، ومن المستغرب أننا تأخرنا حتى اليوم لنفهم أنه قد يتسبب في موتنا. هذا الإغفال في رؤية الحقائق غير ناجم عن نقص الشواهد: ففي الولايات المتحدة الأميركية، فاق عدد الوفيات بسبب الحرّ الشديد بين عامي 1978 و2003 عدد الوفيات الناتج من الهزات الأرضية والبراكين والفيضانات والأعاصير مجتمعة. وحسب بعض التقديرات، سببت موجة الحرّ التي تمركزت في فرنسا عام 2003 في مقتل 70000 شخص، كما أدّت موجة أخرى ضربت موسكو عام 2010 إلى وفاة 10000 شخص.
في أكتوبر (تشرين الأول)، نشرت مجلّة «لانسيت» تقريراً يتضمن دراسة أجرتها 26 مؤسسة عالمية بالتعاون مع البنك الدولي، خلصت إلى أننا نواجه «وضعاً طارئاً عالمياً يلوح في الأفق». وتبعت هذه الدراسة دراسة أخرى ركزت بحثها على موضوع «الحرارة القاتلة»، بيّنت أن 30 في المائة من الناس حول العالم يمرّون بفترة ترتفع فيها درجات الحرارة إلى مستوى مميت خلال عشرين يوماً سنوياً. وقال فريق بحثي بقيادة كاميلو مورا من جامعة هاواي في مانوا في يونيو (حزيران): إن هذه النسبة ستقارب الـ75 في المائة بحلول عام 2100 في حال لم نبذل الجهود المطلوبة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة.
إنّ العامل المهمّ هنا ليس درجة حرارة الهواء، بل الحرارة التي يشعر بها الناس. فقد يستطيع الإنسان الاستمرار على قيد الحياة لفترة قصيرة في حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، ما دام أن جسده يتعرّق بشكل صحّي. لكن المشكلة هي الرطوبة. يقول غراهام بيتز، من جامعة كورتن غرب أستراليا: «إن الطريقة الوحيدة للتخلّص من الحرّ أثناء التعرّق هي تبخّر هذا العرق. لكن عندما تصل نسبة الرطوبة إلى 90 في المائة، يصبح الهواء مشبعاً بالكامل؛ مما يؤدي إلى سيلان العرق، وبالتالي يستمر الشعور بالحرّ».
يمكن قياس تأثير الحرّ والرطوبة مجتمعين، أو ما يعرف بدرجة الحرارة المحسوسة، عبر استخدام «ميزان للتعرق»، يُلفّ بقطعة قماش رطبة.
عندما يسجّل الهواء 35 درجة مئوية، أي ما يعادل درجة حرارة الجو 35 مئوية، ونسبة 100 في المائة للرطوبة - أو 40 درجة مئوية للحرارة و75 في المائة معدل الرطوبة، هذا يعني أن فرصة الإنسان في الاستمرار على قيد الحياة باتت مهددة. وعندما تصبح هذه الدرجات والمعدلات أعلى، لن يستطيع حتى أكثر الأشخاص صحة أن يعيش لأكثر من ستّ ساعات. لم تصل أي منطقة على وجه الأرض إلى هذا الوضع بعد، رغم أن منطقة بندر ماهشهر في إيران اقتربت من هذه المعدلات والدرجات في يوليو (تموز) 2015، بـ46 درجة مئوية و50 في المائة معدلاً للرطوبة، أي أن الأمر مسألة وقت ليس إلا.
معدلات مرتفعة
يقول ستيفن شيروود، عالم متخصص بالغلاف الجوي من جامعة نيوساوث ويلز: إن درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة كلتيهما تشهد ارتفاعاً. يتركز الخطر الأكبر في المناطق التي تعاني عادة من ارتفاع في معدلات الرطوبة كالأمازون ووديان السند، وغيرهما من الدول الاستوائية. ويرى شيروود أن بعض المناطق لن تحتاج إلى أكثر من ست أو سبع درجات حرارة إضافية فقط لتصبح غير قابلة للسكن، محذّراً من أن الدرجات والمعدلات سترتفع بشكل كبير في بعض المناطق خلال 100 أو 200 عام في حال لم نعمل على خفض الاحتباس الحراري.
يمكن القول حتى إن هذه التقديرات متفائلة بعض الشيء. فقد أظهرت دراسة نشرت عام 2017 أن أجزاء من الهند وباكستان وبنغلادش قد تشهد ارتفاعاً في معدلات حرارة الهواء إلى ما فوق 35 درجة مئوية مع نهاية هذا القرن. يبلغ عدد سكان هذه المنطقة 1.5 مليار شخص، أي ما يعادل خُمس سكان العالم، غالبيتهم من الفقراء ومعرّضون بشكل خطير إلى اللهيب المميت. كما سيواجه المزارعون الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر رزقهم خسائر متفاوتة في محاصيلهم؛ لأن إنتاج القمح والأرز والذرة، التي تشكّل مجتمعة مع الصويا نحو ثلثي السعرات الحرارية التي يستهلكها الناس، قد تشهد انخفاضاً بين 3 في المائة و7 في المائة مع كلّ درجة حرارة إضافية. ويؤثر ارتفاع درجات الحرارة أيضاً على إنتاجية العمال في المناطق الريفية، فقد تبيّن أنه ومنذ عام 2000، أدّى الاحتباس الحراري إلى تراجع أعداد القوى العاملة في الهند بشكل ملحوظ، بنحو 418000 عامل، بحسب تقرير مجلة «لانسيت».
من ناحية أخرى، يمكن لدرجات الحرارة التي لا تزال دون المعدلات الكارثية أيضاً أن تساهم في تجريد بعض المناطق من أهليتها للسكن، وقبل مدة طويلة من نهاية القرن. إذ تعتبر الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في الولايات المتحدة تجاوز درجة حرارة الهواء لـ31 درجة مئوية «خطراً شديداً»؛ لأن الجسم البشري يولّد حرارته الخاصة.
مدن ساخنة
غالباً ما تكون موجات الحرّ أكثر قوة في المدن، حيث يمتص الإسفلت والأسقف الداكنة المزيد من أشعة الشمس ويؤدي إلى ظهور تأثير «جزيرة الحرّ». لكن نادراً ما يأخذ مخططو المدن هذا الأمر بعين الاعتبار، وحتى في المناطق التي تعرف بارتفاع درجات الحرارة فيها مثل ملبورن وأبوظبي. في المقابل، توجد بعض الأمور البسيطة التي يمكنهم أن يقوموا بها. وقد نقلت مجلة «نيو ساينتست» عن بيركنز كيرك باتريك إننا نحتاج إلى تصاميم أفضل لمنازلنا، وهذه نقطة البداية. كما عبّرت عن رغبتها في رؤية المزيد من الأسقف البيضاء التي تعكس أشعة الشمس، مع قدرة أكبر على العزل وتزجيج مضاعف، حتى تكون منازلنا ملجأً لنا في حالات الحرّ الشديد، حتى ولو كانت خالية من التكييف الهوائي. وتحتاج المدن أيضاً إلى المزيد من المساحات الخضراء المظلّلة للمساعدة في الحدّ من تأثير جزر الحرّ.
تكفّل نهج جديد انطلق في مدينة نيويورك بتنفيذ برنامج إعادة تخضير مساحات كبيرة في مانهاتن خلال السنوات القليلة الماضية؛ وبعد موجة الحرّ التي ضربت أستراليا في الصيف الماضي، تمت مناقشة اقتراح تخصيص مساحات كبيرة مكيّفة يلجأ الناس إليها في الأجواء اللاهبة.
تحمل هذه الإجراءات فوائد إضافية أيضاً، ففي البلدان النامية، حيث تنتشر موارد الطاقة الملوثة بكثرة، لا شكّ في أنّ ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى انقطاع في التيارات الكهربائية، وبخاصة أن أفضل الدول تعاني عجزاً في سدّ الطلب المتزايد على الطاقة خلال موجات الحرّ. هذا بالإضافة إلى أن الحرّ يسبب مشكلات في توصيل الكهرباء؛ لأنه يؤدي إلى تمدّد وتدلّي الأسلاك. إن تصميم المنازل بشكل أفضل وتأمين مساحات خضراء وملاجئ مشتركة للعامة سيساهم في تخفيف الضغط عن الشبكات الكهربائية التي تعاني الأمرّين في التأقلم مع موجات الحرّ، وسيؤدي أيضاً إلى انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة.
هذا الأمر مهم جداً؛ فوفقاً لما ورد في اتفاق باريس للمناخ عام 2016، ومع ارتفاع درجات الحرارة بين درجة ونصف درجة ودرجتين، سيصبح فصل الصيف عبارة عن موجة حرّ طويلة في بعض المناطق الأسترالية بحلول عام 2100. وكشفت بيركنز كيرك باتريك، عن أن بعض المناطق الاستوائية قد تمرّ بموجات حرّ جزئية، وأن الأوضاع ستكون أسوأ بكثير في حال لم يصار إلى الحدّ من ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة. وترى بيركينز أن تأثيرات مدمّرة في طريقها إلينا إن لم تتمّ السيطرة على التغيّر المناخي الناتج من هذه الانبعاثات في أقرب وقت ممكن.