يصدر قريبا عن دار «الوراق» ببيروت كتاب «المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية» لليون جونييه، أحد المستشرقين الفرنسيين المعروفين، الذين نشروا بعض تراث فلاسفة الإسلام وترجموا شيئاً منه إلى الفرنسية، وأحد الذين نفذوا إلى حدٍّ كبير إلى الروح أو العقلية الإسلامية وتعمقوا في دراستها. والكتاب ترجمه إلى العربية وعلق عليه محمد يوسف موسى. وننشر هنا مقدمة المؤلف:
هذا البحث هو مجموعة المحاضرات التي ألقيناها عام 1907 - 1908م بمدرسة الآداب العليا بالجزائر، وهي المدرسة التي صارت كلية بعد ذلك التاريخ، وكان العنوان الذي جعلناه لهذه المحاضرات هو: «الفلاسفة المسلمون والإسلام»، على أن الجانب الغالب من المسائل التي تناولناها هنا بالدراسة، كان قد عولج من قبل في دروس الأعوام السابقة منذ عام 1899م. وقد ظل هذا البحث مخطوطاً زمناً طويلاً، إذ كان مُعدّاً للطبع منذ عام 1909م، ولولا ظروف حالت دون نشره لظهر منذ ذلك العام. واليوم - ونحن نقدمه للنشر - نقدمه من غير تعديل، ولذلك وقفنا بالمراجع عند هذا التاريخ.
ونعتقد مع هذا أن ذلك الإرجاء لم ينل قط من أهمية هذه الدراسة واتفاقها وسير العلم والبحث إلى هذه الأيام، بل حري بنا أن نعتقد أن الأمر بالعكس، وهو أن هذه الدراسة تجد فيما جدَّ من البحوث والدراسات سنداً وتأييدا. ولا عجب! فإن موضوعها هو البحث عن خاصة أو طابع مميز للعقلية الساميّة بالنسبة للعبقرية الآرية، وعلى الأخصّ العبقرية العربية بالنسبة إلى العبقرية الإغريقية، لنستطيع أن نلقي الضوء على ما كان يحيط بالفلاسفة المسلمين من أحوال وملابسات عند معالجة المسائل ذات الطابع الفلسفي، خصوصاً المسألة التي كانت تُعدّ في المكان الأول أهمية وخطراً في بيئتهم، وهي التوفيق بين الفلسفة الإغريقية التي تخصصوا فيها، والدين الإسلامي الذي نشأوا على اعتقاده.
وهذا الأمر ظل على ما كان عليه منذ عام 1909، ولذلك لا نعدّ متأخرين إذا ما رأينا نشر هذا الكتاب هذه الأيام بعد ظهور المؤلفات القيمة التي وضعها علماء الاجتماع الأعلام، أمثال دُورْكايم، وليفي بْرِيهل، وكورنْفُورْد. هذه المؤلفات التي بيّنت فكرة «التكوينات العقلية» التي كانت، بصفة عامة، مجهولة أو غير معترف بها، في الحين الذي كتب فيه هذا الكتاب.
وبعد قرنين من الزمن أخذ فلاسفة الإسكندرية الإغريق المعروفون بالأفلاطونيين المحدثين، وهم: أمونيوس ساكاس وأفلوطين وتلاميذه مذهب التثليث عن فيلون، خصوصاً هذا المبدأ الرئيسي، «إن الله يصل طبيعته إلى الغير دون أن يفقد منها شيئاً، فهو يعطي دون أن ينقص ما يملكه شيئاً». وهكذا نشأ الأقنوم الثاني عن الأول منذ الأزل، مع بقائه واحداً غير متغير، ودون أن يفقد من كماله المطلق شيئاً، وعن هذا الأقنوم الثاني نشأ الثالث، أي الروح الإلهية، وهو في الوقت نفسه روح العالم. والأقنوم الثالث أقل كمالاً من العقل، كما أن العقل أقل كمالاً من الله الذي لا يوصف، وهو - الأقنوم الثالث - من أجل هذا قابل للكثرة على نحو ما، وقابل للعمل الانتقالي، والتغير، ويصدر عنه دائماً بطريق الفيض جميع النفوس الخاصة أو الجزئية، والأجسام أخيراً تكون عن نفوسها.
وهكذا، ليكون المذهب الذي وضعه فيلون كاملاً، لم يبق على الفلاسفة الإسكندريين إلا تفصيل ما يكون فيه من إجمال وملء ما يكون فيه من فراغ، وذلك بتمييز روح «اللوجوس» تمييزاً أدق، وباستخلاص المادة من الله، على أنها الموجة الأخيرة التي ينتهي إليها الفيض الإلهي، وبذلك يزول كل ما للثنوية من وجود وأثر.
لقد حقّ بهذا للمذهب الأفلاطوني الجديد أن يزهو بأنه عثر أخيراً بحلّ المشكلة الرئيسية التي أتعبت كبار فلاسفة الإغريق، وهي كيف يكون صدور كل شيء من مبدأ واحد من كل وجه، دون أن يمس كماله وعدم تغيره وقداسته.
هذه هي المميزات العامة للجزء النظري من هذا المذهب، وهو مذهب مثالي حلولي. لكن كل نظرية تستخدم أساساً لعمل، وكل ميتافيزيقا تنتهي إلى مذهب في الأخلاق، وأخلاق هذه المثالية الحلولية ستكون حتماً أخلاقا تصوفية.
إنه إن كان كل شيء هو الله، فيجب أن يكون سبيل كل شيء العودة إلى الله والاتحاد به. فلماذا تنزل كل نفس في جسد، وتبدو هكذا مادية منثورة هنا وهناك في الأجسام المختلفة؟ هذا السقوط وهذا النزول، الذي يتميز عن الفيض بمعنى الكلمة، يرجع إلى ضرب من الضلال والوهم والجرأة، يخيل للنفس أن من الخير لها أن تحيا حياة الاستقلال في جسم خاص، أي في عالم خاص بها وإن كان صغيراً، لتستطيع عرض قواها جميعاً وإدراك ذاتها إدراكاً تاماً.
تتصل النفس إذن بجسمها وترتبط به، وتشعر بلذة في الأشياء المحسة، وهذا ما يؤدي إلى الميول الرذلة التي عليها أن تحاربها - متوسلة بالفضائل - لتعود إلى طبيعتها الحقيقية؟ بادئة أول الأمر بالفضائل العملية، ثم بالفضائل الأخلاقية، وأخيراً بالفضيلة النظرية. ولما كانت النفس ليست في الواقع إلا مثلاً، فليس من الممكن أن تدرك ذاتها الإدراك التام الذي تتشوق له إلا في ذاك المثل النقي الذي يكوِّن طبيعتها الحقة.
لكن المُثل، العقل، تتطلب أيضاً التعدد، ففكرة الفكر تفترض وجود ثنوية مثالية من ذات وموضوع، وعندما تعود النفس عقلاً، تحاول الصعود إلى أعلى، أي إلى منبعها الأصلي ومنبع كل شيء، أي إلى الله الواحد الذي لا يحيط به إدراك.
والواحد لا يمكن إدراكه إلا بحدس بسيط بساطة مطلقة وغير قابل للتحليل كالواحد نفسه، حدس ليس له علاقة ما بالعلم أو بالفكر بمعناه الحق. وهذا الحدس لا يوصل إليه إلا في حالة خاصة، هي حالة الانجذاب، بعد إعداد طويل ورياضة وتدريب، وزوال كل تمثيل محسوس وتفكير منطقي شيئاً فشيئاً، حتى يتلاشى الشعور فجأة فيحل محل الحدس الانجذابي، الذي هو الاتحاد بالواحد أو بالله الذي لا يدرك. وهذه المعرفة السامية العلوية، التي تكون عن الحدس الانجذابي، لا يمكن بداهة أن يعبّر عنها بالكلام، لأنها غير قابلة للتحليل، والكلام لا يعبّر به إلا بالتحليل.
فبفضل الانجذاب، هذه النعمة الإلهية التي يختص الله بها من شاء من عباده، وهم قليل نادر، يصل المرء في هذه الحياة إلى السعادة القصوى في لحظة خاطفة، غير أنه يعد نفسه في الوقت ذاته لحياة أخرى في العالم الأعلى حيث يتمتع دائماً بهذا الاتحاد الذي هو السعادة الإلهية أو السعادة الكاملة القصوى.
ذلك هو المذهب الفلسفي الذي سيرثه العرب عن الإغريق في القرن التاسع للميلاد. ولعل من العسير أن نتصور مذهباً أدخل في الحلولية والمثالية والتصوف منه، ولا مذهب - من ثم - موحداً ومجمعاً أكثر منه. إنه في هذا المذهب لم تُسَوَّ الهوّة بين الطرفين فحسب، الله وآخر الموجودات، بتدرج من الكائنات الوسطى، بل إن كل الموجودات في الحقيقة تكوّن وجوداً واحداً بطبيعتها وأصلها ونزعتها إلى السمو نحو أصلها، والعودة إلى الاندماج معاً في مبدئها المشترك.
مقدمة ليون جوثييه لكتابه «المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية»
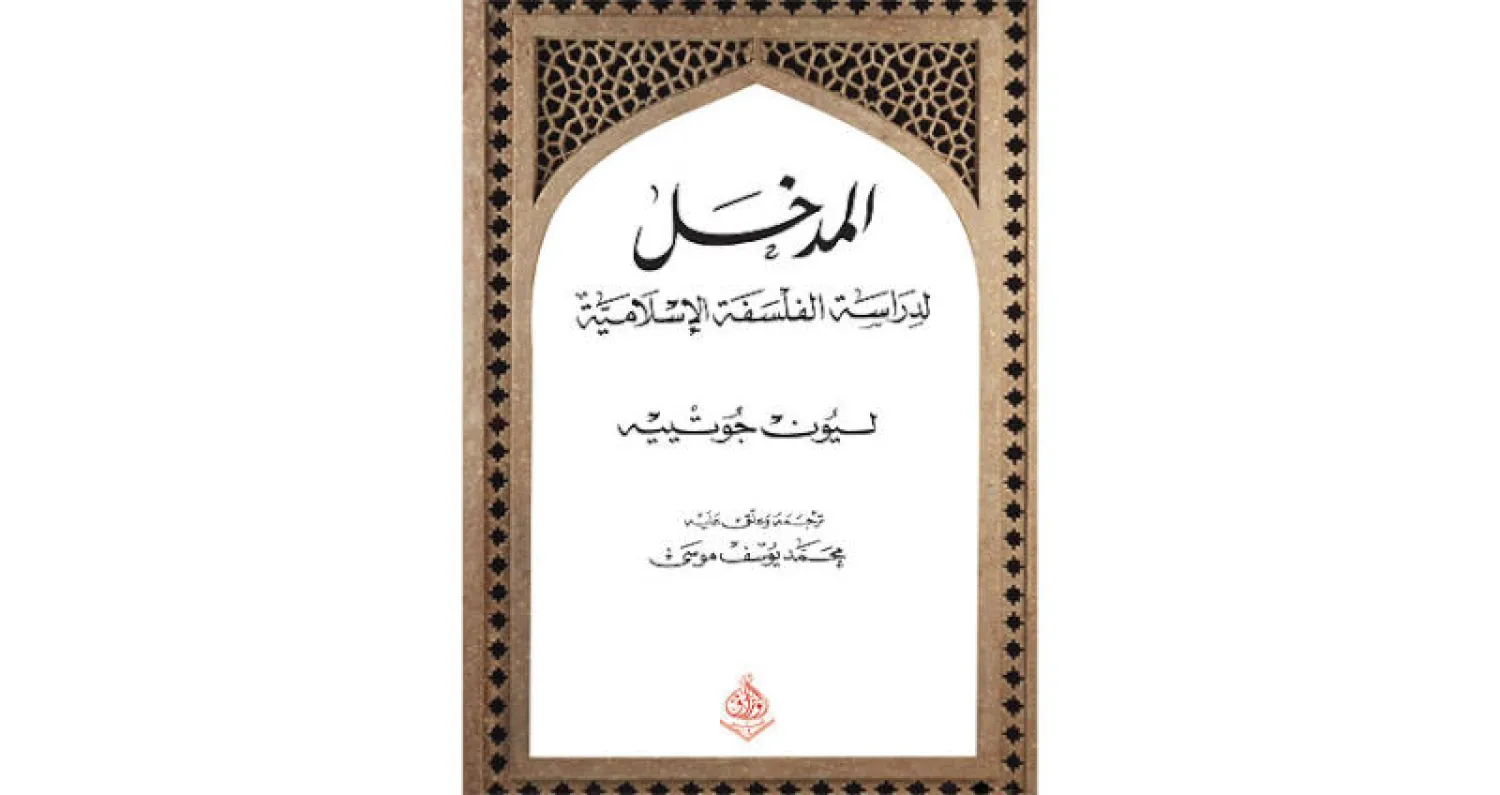

مقدمة ليون جوثييه لكتابه «المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية»
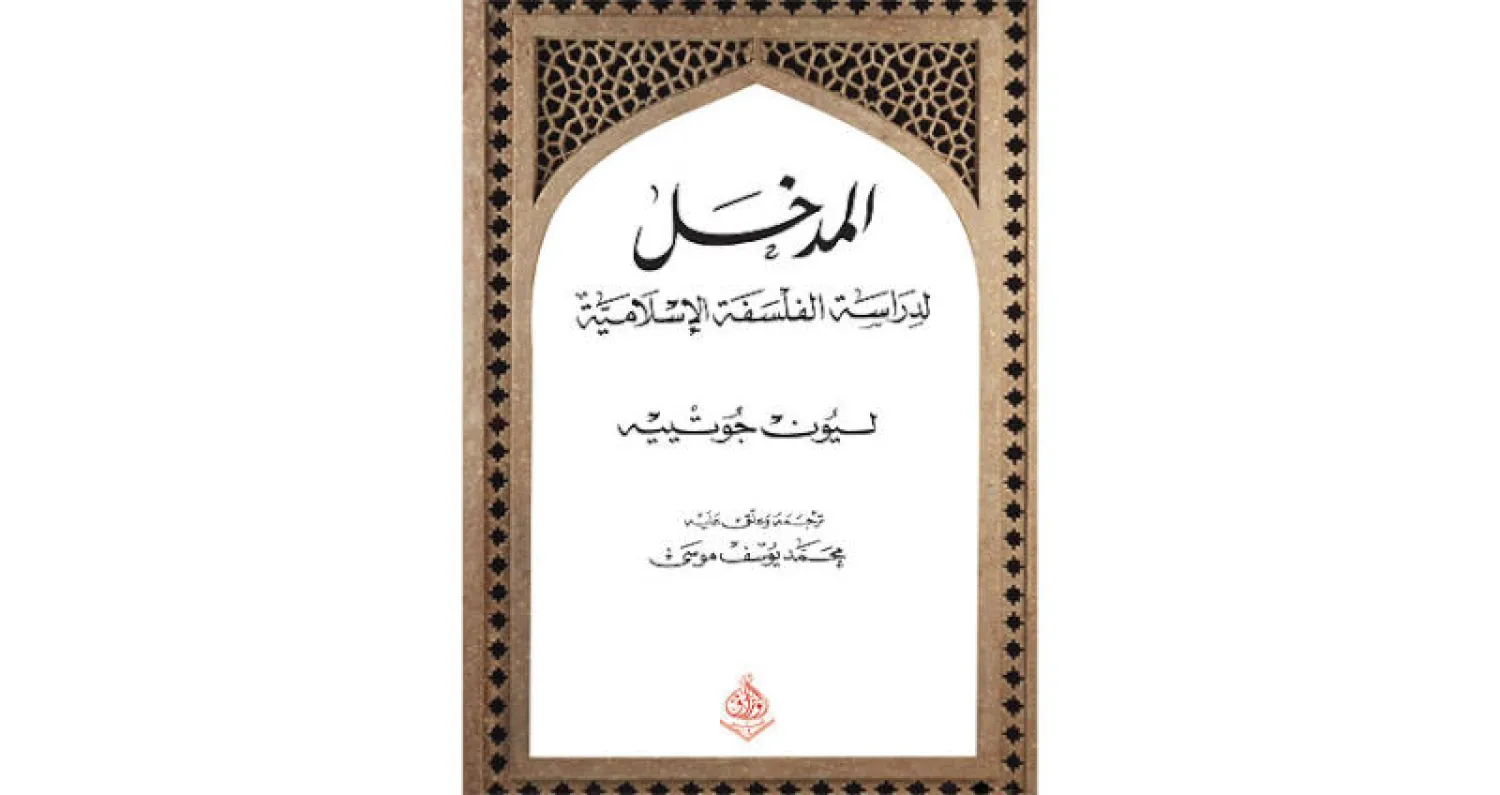
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة










