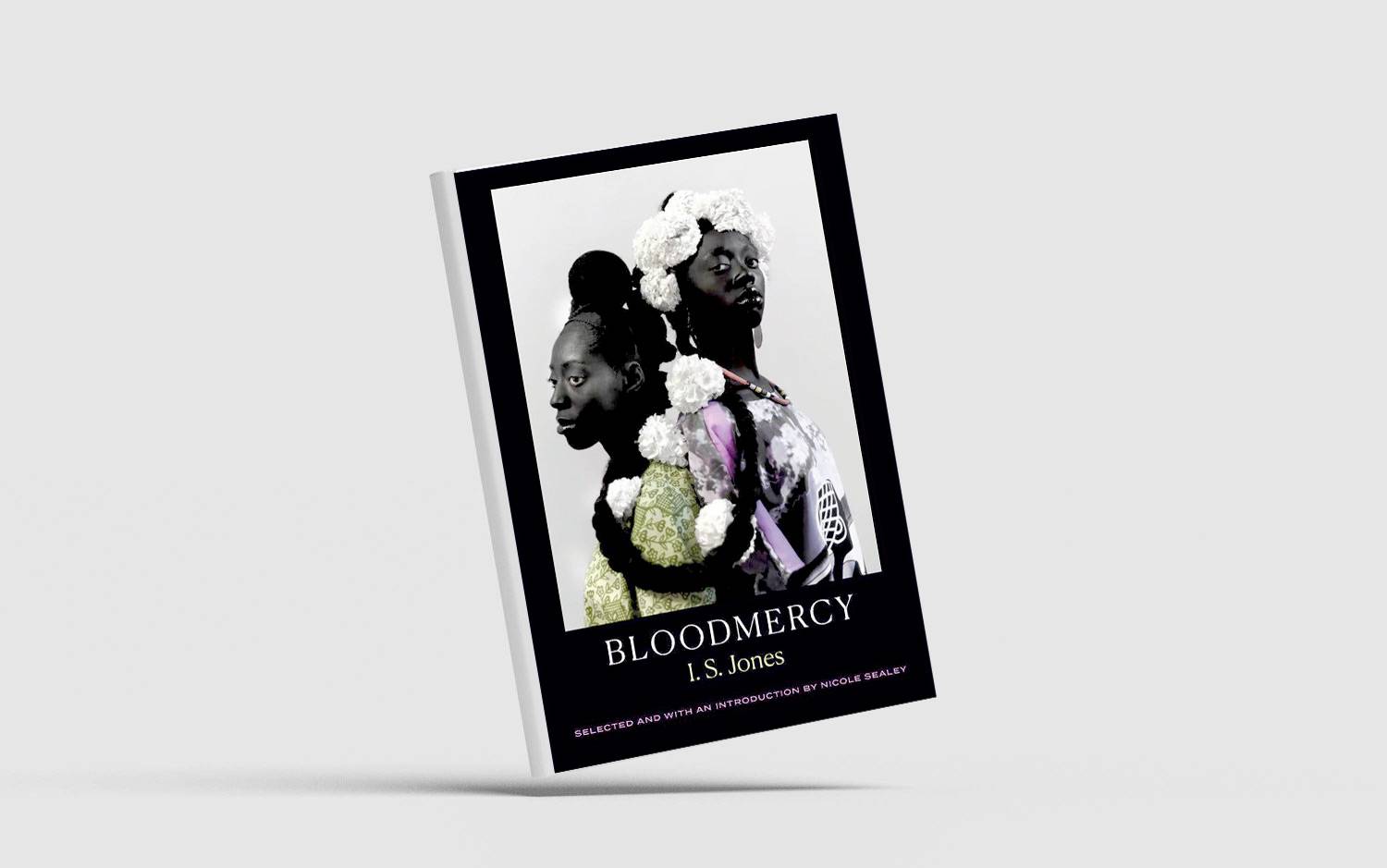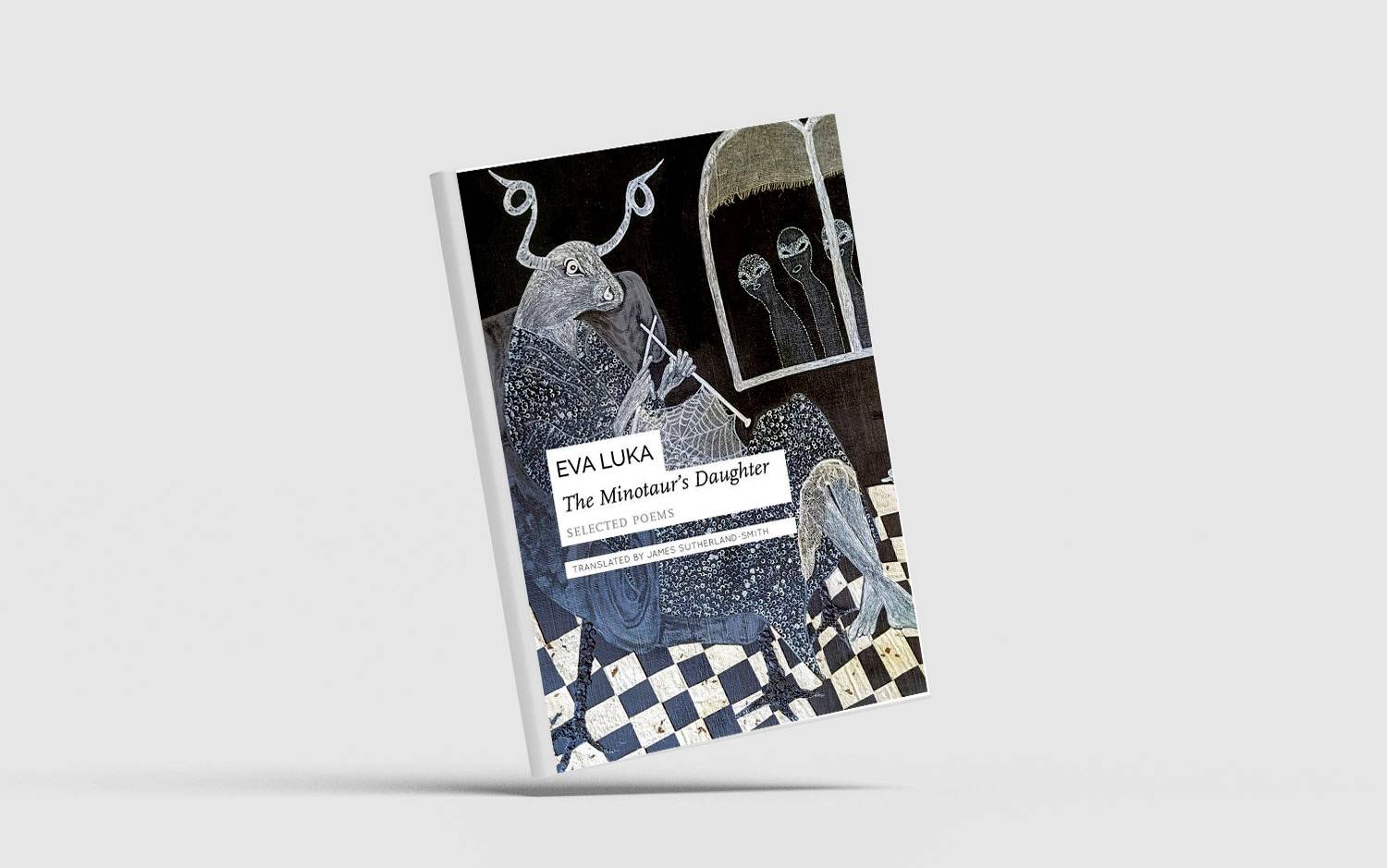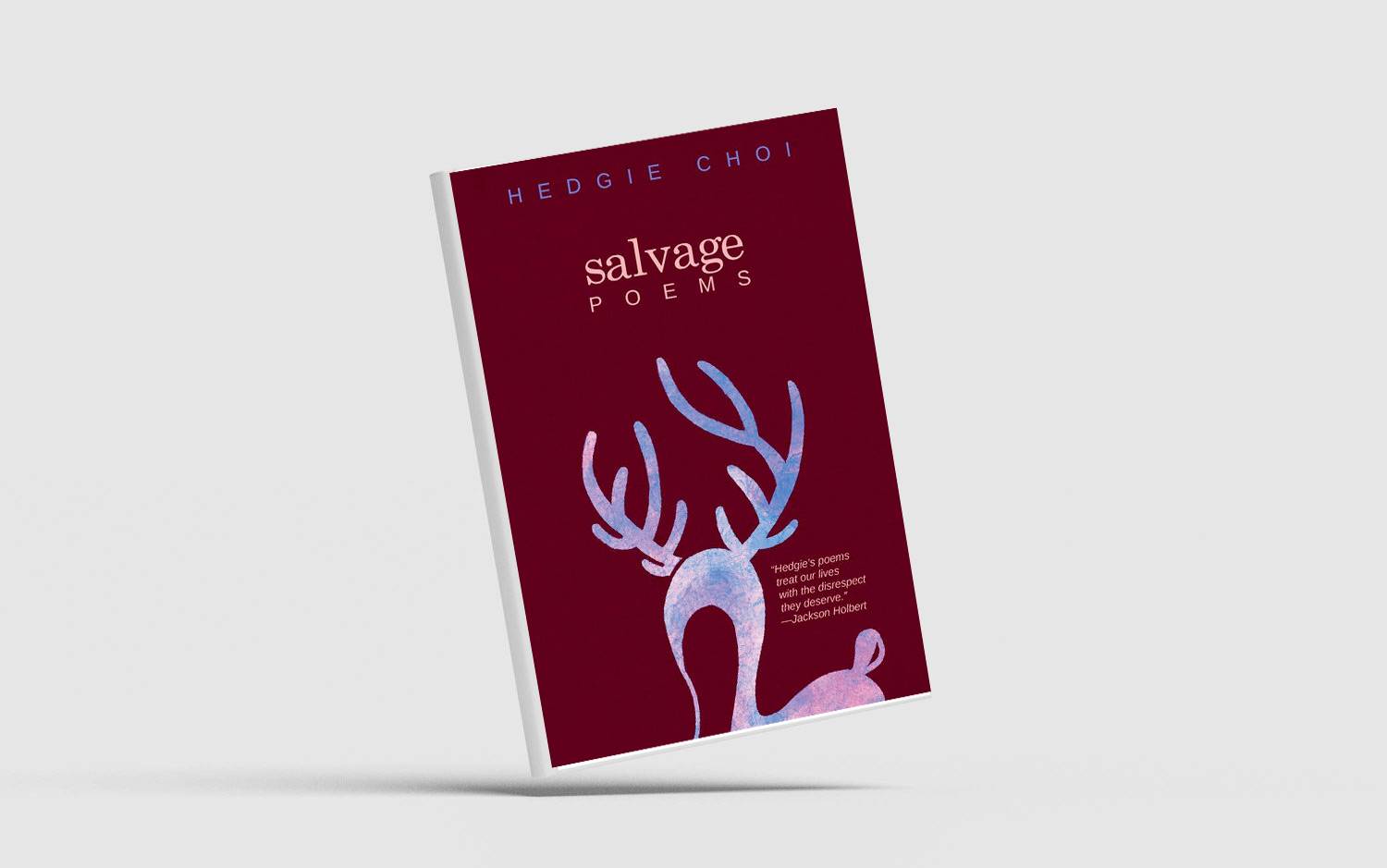نشرنا يوم أمس آراء عدد من المثقفين والأكاديميين والكتاب العرب حول أسباب هزيمة 67، وآثارها اللاحقة على حياتنا المعاصرة، سياسياً واجتماعياً وثقافياً. وكان أغلب المساهمين في الملف قد اتفقوا على أن هذه الهزيمة لم تكن عسكرية فقط، بل نتاج لذهنيات وممارسات لا تزال مستمرة جوهرياً على أكثر من مستوى، وأن أسئلة النكسة لا تزال حاضرة بقوة على الرغم من مرور نصف قرن.
أنكسة هي أم هزيمة؟ وما الذي تبقى منها؟ كيف؟ وهي لم تزل فاعلة في واقعنا السياسي والاجتماعي حتى اللحظة... ولعلي لا أجانب الحقيقة لو قلت إن النكسة مستمرة وعلى وزن «الثورة مستمرة».
هي في نكسات متتالية ما زالت تتشظى شرقا وغرباً في الجغرافيا العربية، والواقع العربي المتردي حالياً لا يمكن تفسير حالته إلاّ على وقع تداعيات هذه «النكسة» التي تولدت منها هزائم صغرى وكبرى، مهولة ونصف مهولة، وبعد خمسين عاما على مرورها ما زال الجرح النرجسي العربي نازفاً وغير قادرٍ على الاعتراف بمعنى الهزيمة وما زالت طريقة التلطيف الممجوجة والإنكار التاريخي تصف الهزيمة بـ«نكسة» على أمل أن يأتي نهوض ما بعدها، لكن اللحظة التاريخية تصرّح بلا مواربة بأن النكسة لم يقل عثارها بعد، ولم يحدث النهوض الحضاري الإبداعي المأمول بل إنها الهزيمة المتوالدة ما زالت تنتج لنا الهزائم البنيوية المتعددة، والتجزئات الجغرافية والتعثرات التنموية المميتة، والخرائب منتشرة في كل رقعة عربية، على المستويات كلها سياسياً واقتصادياً وجغرافياً وفي الوعي الجمعي وأكثر ألماً في عمق الوعي الفردي المنقسم.
سأذهب في تفسير ما الذي تبقى من النكسة - الهزيمة إلى ملامسة واستكشاف ما تركته النكسة في عدة حالات للواقع المتداعي حتى الآن، ومن أهمها الحالة الثقافية والحالة الإبداعية مروراً بالحالتين الشعر - فكرية والفكرية.
في الحالة الثقافية ما قبل النكسة - الهزيمة وما بعدها نجدها حصيلة لعدة أوهام ما زلنا نسبح في بحيراتها، بل ما زالت مستقرة في البنية العقلية العربية اليومية وفي العقل العربي التاريخي.
* تجربة المأساة
وقد حدد المفكر والروائي السوري صدقي إسماعيل هذه الأوهام بشكلٍ جذري ودقيق في كتابه: (العرب وتجربة المأساة)، وبالرغم أن الكتاب نشر قبل النكسة بسنواتٍ، فإنه وضع أصبعه على مكن الارتكاسات الفكرية والنفسية والحضارية التي شرخت الواقع العربي المعاصر وفتتت وعيه الموضوعي بالمأساة التاريخية المزمنة فقادته إلى حالة مزمنة من الانهيار الرأسي والأفقي.
من جملة هذه الأوهام: وهم «تملّك الحقيقة المطلقة» والاطمئنان الذهني اللاتاريخي الكسول في فهم الصيرورة التاريخية المتحولة فكراً وواقعاً، وما ينتج عنه من غيابٍ للروح النقدية في نهاية المطاف.
ومنها أيضا وهم «المغالاة في مفهوم الاستقرار أو التماسك الكياني والقيّمي (وهو وهم) يصدر عن التخفي أمام الواقع والفرار من الحس بالمأساة».. وما يقود بالتالي إلى سديم انفعالي أكثر من كونه حقيقة ماثلة ومتغيرة.
ويقول صدقي: «من المسلمات المستقرة في بنية العقلية العربية أننا فرديون».. حين يأتي الحديث عن وهم الفردية وهو لا يتحدث عن الفردية البراغماتية كما عرفناها في الفلسفة السياسية الأميركية، بل يردّها إلى الموقف السلبي من الواقع والاعتداد بالعقل البدوي الذي يرى الأشياء والمكونات الطبيعية من حوله كحقيقة ثابتة لا تتغير وفي إطار من الخرافي - البطولي.. الفردي.
والنكسة ما زالت تنتج المزيد من الأحزان، كما المزيد من الأوهام بعد خمسين عاماً وما زال التفكير العربي يعاني من داء الفردية واللاتاريخية واللاعقلانية، عجز عن نقد ذاته وأخطائه ناهيك عن تجديد حياته العقلية، وإعادة استئنافها حضارياً.
ولعل من أسوأ ما أفرزته «النكسة» هي هذه التيارات المتطرفة من حاضنته الإسلام السياسي وفرخت من تربته طيور ظلام دموية تعمل بيننا كالأشباح.
قدمت نفسها في وقتٍ عصيب كبديل جاهز لإزالة آثار النكسة والتحقت بها جموع من الموهومين والمجروحين والمهزومين، بعضهم خلع رداءه الآيديولوجي القديم، وآخرون وجدوا ضالتهم - وهماً - في الخروج من حالة الخواء الفكري والوجداني.
* «أحزان حزيران»
في النظر إلى الحالة الإبداعية العربية المتأثرة بالأجواء الكابية التي تركتها «النكسة»، وجدت من الأنسب هنا أن أسترجع وأعيد قراءة قصة قصيرة بديعة للراحل القاص سليمان فيّاض بعنوان: «أحزان حزيران» لما تكتنزه من دلالات فنية وفكرية، كواحدة من حالات الإبداع العربي المحزون والمتفاعل مع الحدث - الكارثة وكما عبر عنها شعراً نزار قباني في واحدة من قصائده العلامات: «هوامش على دفتر النكسة».
يقول «عربي» بطل القصة العاطل نائماً على سريره في المستشفى: (ما زال الخامس من حزيران يتجمع في القلب) وكأنه يقولها على لساننا اليوم.
إحساسه بوطأة الهزيمة يدفعه بلا وعي إلى تمزيق ورقة الخامس من حزيران قبله بيوم من نتيجة الحائط - التقويم، كي يبعد عنه الذكرى التي كانت لم تزل طازجة، لكن وعيه الحارق يدلّه بأن نزع ورقة التقويم لا يزيل الأحزان، والهروب من ذكرى الحدث الثانية لا يزيل المرارة من الحلق ولن يلغى ذلك اليوم من الزمن.
إن الوعي الحقيقي ليس الهروب والعيش في الوهم بل إزالة المعنى الذي انطوت عليه النكسة، أي إزالة أسباب الهزيمة وتجفيف ينابيع تجددّها. وعندما يقول «عربي» لأمه: (الخامس من حزيران سيظل يأتي).. ما زال المعنى الذي ينطوي عليه باقياً بيننا ولم يبرح مخيلتنا التاريخية.. معنى الهزيمة ومعنى العيش في الوهم والعيش في الظلام الذي لا نهار بعده.
عند خروج العرب من حالة الكساح هذه كما رمز لها القاص: «بطل القصة فاقد لساقيه»، وحالة الذهول والجنون كما يعيشها زملاء عربي المحاربون الخمسة في المصحة، حينها نكون قد وعينا معنى الهزيمة لكي نزيل انكساراتها.
* النكسة في الحالة الشعرية
في الحالة: الشعر - فكرية، والفكرية كما تلمستها في عملين مهمين للشاعر الكبير أدونيس والفيلسوف السوري الراحل صادق جلال العظم، في «فاتحة لنهاية القرن» و«النقد الذاتي للهزيمة» سنعي مدى راهنية المؤثر الفكري والنفسي للنكسة وليس ما تبقى منها فقط. أصدر أدونيس: «بيان 5 حزيران 1967» بعد شهر من الهزيمة وكتبه بلغة شعرية - فكرية طارحاً أسئلة حارقة كيانية مثل: من أنا؟ وهل أعرف نفسي؟ حتى يصل إلى مقولة دالة ساخرة:
«ليس العدو المباشر هو من يغلبني، يغلبني العدو الآخر اللامباشر المستتر فينا»..
ويكشف عن الأقنعة الهائلة التي تدثّرت بها حياتنا العربية اليومية والعقلية بدءاً من المثقف والمفكر والسياسي وصولاً للعامل الكادح البسيط.
كتب أدونيس مرثاة شعر - فكرية تليق بالحدث نعى فيها الحياة العربية كلها كما كانت تتبدى، فكراً وثقافة، شعراً وإبداعاً وفناً، سياسة ومجتمعاً، وعياً وعقلاً، وبروح خالية من نكهة اليأس لمح إلى معنى التغيير الذي نحتاجه، التغيير من الداخل أولاً كي نخرج من هذه النتيجة الفاجعة لحدث 5 حزيران.
السؤال الذي طرحه أدونيس في استطرادات بيانه اللاحقة بعد ثلاثين عاماً:
* هل حدث هذا التغيير؟
هو رأى ببصيرة شعرية رهيفة أن ما حدث في الحياة العربية وعقلها هو تغيير قشري من خارج، وما نحتاجه هو التغيير الكياني العمقي والجذري الذي يزلزل الثوابت ويجترح المتحول والتحوّل، التغيير الذي نروم هو تغيير ذات الإنسان العربي في عقليته وتصوراته وقناعاته المتكلسة وصورة علاقته بالآخر..
إنه التغيير الكياني الذي يقصر المسافة بينه وبين الفعل الإبداعي والإبداع الحضاري.
النكسة في السياق الفكري
في السياق الفكري ذاته يمضي الفيلسوف الراحل صادق جلال العظم متوسماً عقلاً نقدياً جديداً، عقل ينقد ذاته كما ينقد خارجه الموضوعي المضطرب، عقل لا يتخفى وراء التبريرات والتلفيقات والتوفيقات العقلية، عقل يسمي الأشياء بأسمائها ولا يخجل من قول الحق.
ويذهب أبعد إلى نقد كل من قال في شكل يقيني غيبي إن هزيمة حزيران ليست إلا ظاهرة طبيعية كظاهرة الزلازل والأعاصير أو كظاهرة قدرية..!
ويمضي عميقاً إلى نقد ظاهرة التخلف التنموي المجتمعي التي ما زالت مستفحلة في زمننا المعاصر، بل يصف ما نمر به من شكل ظاهري تنموي ليس إلاّ تنمية للتخلف.
انتقاده الشجاع لهذه «القدرية المطلقة» في تفسير الظواهر في واقعنا العربي بما فيها الظواهر السياسية والعسكرية قاده إلى نتيجة فلسفية فهم في ضوئها معنى العجز العربي الجوهري التي تمثّلت في السياسات السلطوية وفي السياسات الاقتصادية «استراتيجية تنمية التخلف» وفي معنى غياب الحريات وحقوق الفرد الطبيعية غير مبتعدٍ عن نقد الالتماس إلى يقينيات غيبية وفوقية.
إن منطق نقد الذات الذي دافع عنه العظم بعد الحدث الحزيراني كان مفصلياً في تصوره الفكري للخروج من الأزمة.
نقد الذات هو نقد منطق التبريرات والتهرب من المسؤوليات والتبعات، نقد منطق الشطط الفكري والوجداني في تفسير ما حدث.
هل تخلصنا من هذا المنطق؟
هل ما زلنا بعيدين عن أجواء هذا المنطق في تحليل أسباب الهزيمة وأسباب النهوض؟
الذي تبقى من هزيمة 5 حزيران كثير جداً ما زلنا نراه على مرمى البصر..!!
* ناقد سعودي