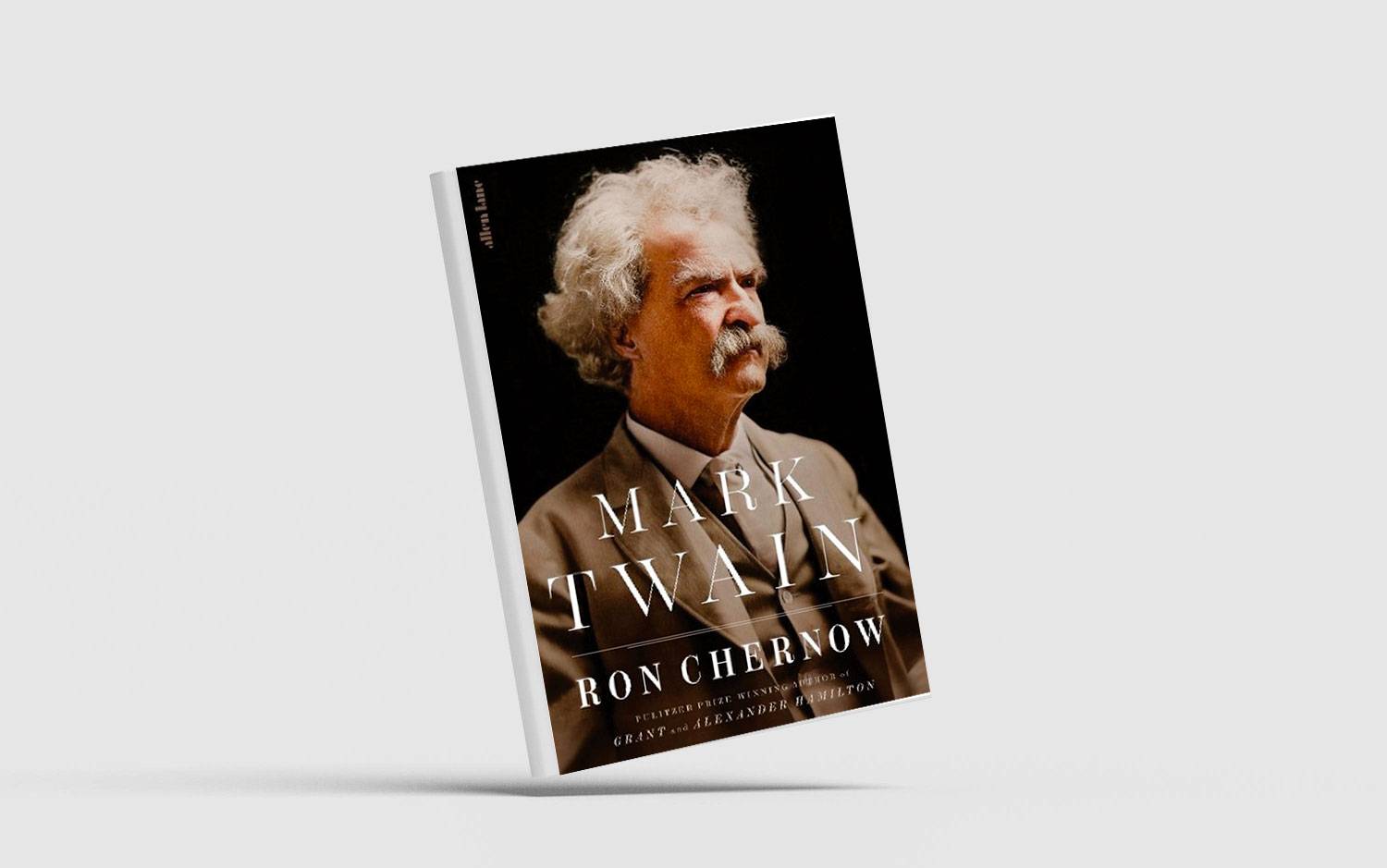كثيراً ما يوصف عصرنا بأنه عصر المعلومات، وهو بالتأكيد كذلك. الإنترنت والاتصالات بأنواعها، من إعلامية إلى هاتفية إلى شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها، كل ذلك خلق أوضاعاً غير مسبوقة في تاريخ البشرية، وأتاح للجميع قدراً هائلاً من المعلومات التي يمكن الوصول إليها وتخزينها وتبويبها وإعادة إرسالها، إلى غير ذلك من سبل إدارتها والإفادة منها.
لكن التعرف على هذه الحقيقة الواضحة، والإعلان عنها باستمرار، كثيراً ما يؤدي إلى نسيان ثلاثة أمور أساسية: الأول، أن نصيب الشعوب أو الدول والأفراد من المعلومات المتاحة ليس متساوياً. والثاني، أن مستوى دقة أو صحة أو جودة تلك المعلومات ليس مضموناً، أي أن الغث فيها قد يكون أكثر من السمين. أما الثالث، وليس الأقل أهمية، فهو أن المعلومة لا تعني المعرفة، وأن ثمة اختلافاً بين تراكم المعلومات وبناء المعرفة. وأود أن أفصل قليلاً في هذه الملاحظات تمهيداً للدخول في الموضوع الأساسي.
عدم التساوي في المعلومات حقيقة ماثلة، فنصيب الفرد من المعلومة يشبه نصيبه من أشياء أخرى كثيرة، وفي طليعتها العلم أو المستوى العلمي. وقدرة الإنسان على التحصيل والانتقاء والتحليل تختلف تبعاً لإمكانياته الذاتية المتحصلة نتيجة لما تلقاه من تعليم، أو ما اكتسبه من خبرات. والشعوب الأكثر تعليماً، أو بالأحرى الأفضل تعليماً، تحقق نصيباً من المعلومات المتاحة أكبر بكثير من شعوب تشيع فيها الأمية. والأمية ليست اليوم محصورة في القراءة والكتابة كما هو معروف، وإنما هي أيضاً أمية الحاسب والقدرة على الإفادة من شبكات التواصل وقنوات الإعلام.
القدرة المشار إليها على تحصيل المعلومة تتصل مباشرة بالأمر الثاني الذي أشرت إليه، وهو المتعلق بدقة أو صحة المعلومة. فتبعاً لقدرات الإنسان، وبالتالي المجتمع، تكون القدرة على فرز المعلومات واختبارها والإفادة منها. وكلما ارتفع المستوى، ازدادت القدرة النقدية في التعامل مع سيل المعلومات المتدفق من كل مكان، لهذا يرتفع معدل التصديق لما يرد على شبكات التواصل الاجتماعي لدى الفئات الأقل تعليماً، ويقل لدى الفئات الأفضل تعليماً، لكن الجميع في حقيقة الأمر يواجه صعوبة الفرز نتيجة لعوامل كثيرة، منها كثرة المعلومات وما تحمله من إغراءات القبول نتيجة لغياب البديل أو ضعفه أو صعوبة الوصول إليه. وقد وجدت الإشاعات والمعرفة الوهمية في تلك الشبكات تربة خصبة وغير مسبوقة في سرعة التوصيل، بحيث تنتشر وتصعب مقاومتها أحياناً.
أما الأمر الثالث الذي أشرت إليه، أي أن المعلومة غير المعرفة، فهو الأجدر بالتوقف عنده لصلته بموضوع هذا الحديث. فثمة تراتبية لما يمكن أن يحصله الإنسان من علم: تبدأ تلك التراتبية بالمعلومة، أي بالوقائع، أو ما نسميه حقائق أساسية. وفوق أو بعد المعلومة، تأتي المعرفة. المعلومة هي الأرضية الأساسية التي يحتاجها الجميع ولا يتصور العيش من دونها، لكن بينما تقنع أغلبية الناس بالمعلومات المتوفرة لديها، تسعى فئة أقل إلى تطوير المعلومات لتصبح بناء متسقاً ينظم المعلومات على أسس عقلانية أو فكرية أو عقدية. المعرفة هي المعلومات، وقد تطورت إلى أنساق وأبنية وتكوينات متصلة تتشابه حيناً، وتتعارض حيناً، والحاكم فيها هو سعي الإنسان للصعود من الشتات إلى الوحدة، من التشظي إلى التماسك.
لو نظرنا إلى المعلومات المتعلقة بالسياسة، وهي الأكثر تأثيراً، لوجدنا أنها تمثل تراكماً ضخماً يشترك فيه كثير من الناس. الكثيرون يتابعون الأخبار، والكثيرون أيضاً لديهم معلومات أساسية حول المشهد السياسي المعاصر، بدوله وشعوبه، وأنواع الأنظمة السياسية والاقتصادية، وما يتفرع عن ذلك ويؤثر فيه من أحزاب وصراعات ومصالح... إلخ. كل هذه معلومات تؤسس للتعامل مع الأوضاع السياسية في العالم، لكنها مجتمعة لا تشكل معرفة سياسية إلا حين تخضع للتحليل والربط والاستنتاج. المعلومات منتشرة وهائلة ومتاحة للجميع، ولكن المعرفة ليست كذلك. عصرنا عصر معلومات للأكثرية لكنه عصر معرفة للأقلية.
المعلومات السياسية تتحول إلى معرفة عبر منهجيات وآليات، أو عبر أدوات تحليل تحولها إلى معرفة سياسية. ولنأخذ الولايات المتحدة مثالاً، وهي البلد الأكثر حضوراً وتأثيراً في العالم دون منازع: ماذا يعلم الكثيرون عنها؟ أقول «يعلمون» وليس «يعرفون» للحفاظ على التمييز الذي أشرت إليه. المعلومات حول ذلك البلد كثيرة، حتى على مستوى الإنسان البسيط؛ الكثيرون يعلمون أن ترمب من الحزب الجمهوري، لكن سياسة الجمهوريين والأسس التي قامت عليها ليست معلومات وإنما معرفة ليس من السهل على الكثيرين الوصول إليها، هذا إن اهتموا بها. قد تهمهم بقدر ما تؤثر في حياتهم. ويشمل هذا كثيراً من الأميركيين أنفسهم. فالإنسان في حياته اليومية مشغول بالآني والسريع وما يمسه مباشرة. لذلك نلاحظ أن النقاش الذي يدور بين كثير من الناس في الوطن العربي والإسلامي حول الرئيس الأميركي ترمب لا يكاد يتجاوز موقفه من العرب والمسلمين، ومن إيران وإسرائيل، أي أن الأكثرية مشغولة بما يؤثر في حياتها مباشرة، سواء أكان وعداً أم وعيداً، وما يصل إليهم حول ذلك هو معلومات متناثرة، تصريح هنا وقرار هناك، وهذا كله مشروع بل وضروري، لكن الذي يغيب غالباً هو خلفيات ذلك، فهي في الغالب مجهولة بل هي مجال خصب للتخمين ولنظريات المؤامرة التي توفر «معرفة» سريعة وجاهزة ولكنها وهمية في معظم الأحيان، أي ليست معرفة حقيقية.
كيف تصنع المعرفة السياسية، بل كيف تصنع المعرفة بالكلية؟ بتعبير آخر: كيف تتطور المعلومات إلى معرفة؟ هنا مربط الفرس. لا شك أن الفرد مصدر مهم لتلك المعرفة، الفرد المفكر أو المتخصص أو الذي يملك القدرة على البحث والتحليل تأسيساً على قاعدة علمية أو معرفية. لكن الفرد وحده غالباً لا يكفي؛ هناك دائماً حاجة إلى مؤسسات تنتج المعرفة، وينتج الفرد من خلالها. والمؤسسات هنا نوعان: مؤسسات جامعية، أي الجامعات والكليات المتخصصة، ومراكز الأبحاث أو ما يعرف بـ«الثنك تانكز». والجامعات حين تنتج المعرفة في البلاد المتطورة، فإن ذراعها الرئيسية هي المراكز البحثية على اختلافها. لكن من المراكز البحثية ما يكون مستقلاً، بل إن أشهر تلك المراكز وأكثرها فاعلية هي المستقلة منها، سواء عن الجامعات أو عن الحكومات. لكن لكي يكون المركز البحثي فاعلاً، لا بد له من جهات تعتمد على نتاجه من الأبحاث التي تؤسس لسياسات أو لخطط أو لغير ذلك. ولو عدنا إلى الولايات المتحدة التي ضربت بها مثلاً قبل قليل، فسيتبين أنها الدولة الأولى والأقوى في عدد وأهمية مراكز البحث أو «الثنك تانكز».
على الرغم من اهتمام دول كثيرة بمراكز البحث كمصانع للمعرفة، فإن الولايات المتحدة تظل الأقوى في هذا المجال، كما هي في مجالات كثيرة أخرى. فحسب بعض الإحصائيات، هناك ما يقارب المائتي مركز بحثي (ثنك تانك) في الولايات المتحدة، من أشهرها وأكثرها تأثيراً «بروكنغز» و«كارنيغي ميلون». وهذه مراكز مستقلة عن الحكومة لكنها متصلة بها، من حيث إن تلك المراكز مصادر للمعرفة التي تسترشد بها الحكومة في وضع سياساتها ورسم خططها. ويصدق ذلك بالطبع على دول أخرى، مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها. ويلفت النظر هنا عدد مراكز الـ«ثنك تانكز» في إسرائيل، حيث تبلغ نحو الثلاثين، وهو عدد ضخم بالنسبة لدولة قليلة السكان ضئيلة المساحة محدودة في ثقلها الاقتصادي، إذ إنها تفوق في البحث دولاً كثيرة أكبر وأضخم اقتصاداً، وأكثر تأثيراً في السياسة العالمية، بل إنه يمكن القول إنه بالقياس لعدد السكان، تعد إسرائيل بين الأكثر عناية بهذا اللون من المراكز البحثية. وكما هو الحال دائماً، العبرة ليست بالعدد، وإنما بالمستوى وقوة التأثير.
أما إن تساءلنا عن البلاد العربية، فسنجد أنفسنا أمام قصة أخرى تحتاج إلى متابعة مستقلة.
من المعلومة إلى المعرفة... رحلة بيوت التفكير
الذراع الرئيسية في البلدان المتطورة هي المراكز البحثية

«بروكنغز» من أكبر مراكز البحث الأميركي

من المعلومة إلى المعرفة... رحلة بيوت التفكير

«بروكنغز» من أكبر مراكز البحث الأميركي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة