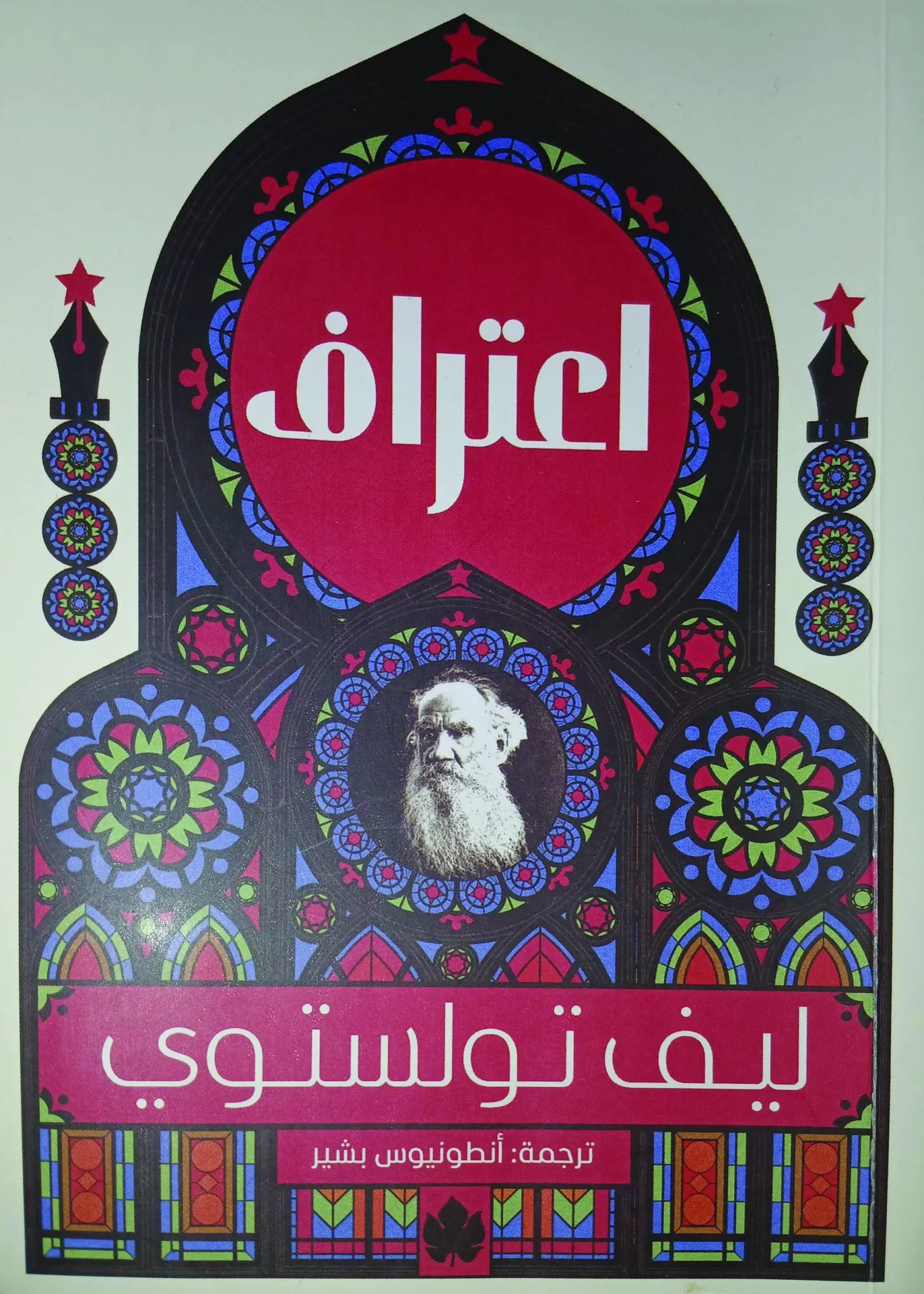ما زلت أذكر حين كنت في العشرين من العمر، كيف أقبلت على قراءة رواية الطيب صالح «موسم الهجرة إلى الشمال»، بكل جوارحي. كيف شدني الخيال الخصب لهذه الرواية، وكيف خاطب أسلوبها الجميل حواسي. فأنا لم أكن قد اعتدت من قبل مثل هذه الكتابة التي تتدفق حيوية وذكاء وسخرية. تتحدث عن شخصية مصطفى سعيد الأكاديمية حين ماج الحنين وعربد، فإذا بها تطفو من قاع النهر حيث طُمرت لسنوات طويلة، لتجد نفسها فجأة على سطح الماء وجها لوجه في مواجهة الشخصية الثانية التي حلت محلها، شخصية المزارع في قرية على ضفاف النيل في السودان، المتزوج من امرأة قروية أنجبت له اثنين من البنين، كأنه لم يكن أكاديميا عاش في لندن وحاضر في جامعاتها بعد أن أتم دراسة الاقتصاد في أكسفورد واشتهر بنبوغه، وألف ونشر الكتب، وقرأ الشعر الإنجليزي، وشاهد مسرحيات برناردشو، واستمع إلى بيتهوفن، وارتاد حانات همستد وتشيلسي وجمع النساء الإنجليزيات ليتحلقن حوله كأنهن مجرد حبيبات مسبحة له، فتسقط أكثر من حبة منهن في ظروف غامضة ومأساوية.
إنهما شخصيتان لإنسان واحد، تبحثان عن هوية واحدة في رحلتهما ما بين الشرق والغرب، ولكن الحضارتين الشرقية والغربية تصارعتا في داخله بحثا عن حقيقة صاحبهما أمام الحياة وشباكها، علما بأن جوهر الشخصيتين هو الإنسان ذاته. كل هذا بأسلوب أشبه بالمونولوغ، كأنه يصف حالة نفسية؛ لغة شعرية كالنثر، تتراوح بين العامية السودانية والعربية الفصحى، فإذا بي أقف أمام رواية نفاذة وشفافة في آن.
كأن الطيب صالح جمع كل تراث الروايات العربية من قبل وكومه حتى أصبح هرما وتركه خلفه، ليتقدم بكل صفاء يحسد عليه ويبتدئ ببناء هرم خاص به، شيده فوق أرضية من القرآن الكريم، والمتنبي... من الطفولة والخيال، ومن أحاديث الكبار حوله، وراح ينسج نسجا يتفرد به، فينقلني إلى القرية السودانية التي يصفها بجمل منسابة كالنيل، يسير حاملا معه أغصان الشجر الرقيقة وأعشاش العصافير، حاملا معه الحياة، لأجد نفسي أنا القارئة كذلك النهر؛ أنساب مع الكلمات بلا ملل ولا كلل، فينقلني إلى اللب، الجوهر، ولو بجملة واحدة على لسان إحدى شخصيات الرواية، وليدب الشوق بي - أنا الكاتبة ذات الرواية الواحدة آنذاك - إلى أشخاص من عائلتي ومحيطي، كنت قد أقصيتهم بعيدا عني بحجة أنهم ليسوا عصريين، ولا يماشون أفكاري، ولا يتلذذون الشعر الذي أقرأه، أو الأغاني التي أسمعها. وجدتني أعتذر منهم جميعا لأني كنت أخجل بهم، فأضمهم إلى صدري وأفكاري، وأدخلهم رواياتي وقصصي القصيرة، ثم لأذهب أبعد من ذلك، مؤكدة أن من حق الكاتب أن يكتب ما يشاء؛ أن يجهر بحقيقة مجتمعه من غير مواربة، ويتناول الحديث عن المحظورات بتلك الصراحة الجميلة، الجريئة ذات النزعة الإنسانية المتفتحة... وبتشجيع من شخصيات هذه الرواية، بخاصة بنت مجذوب التي كانت تجلس في مجلس الرجال بكل ثقة وتتحدث بشتى الموضوعات، وتحلف مثلهم بالطلاق، وتنفث سجائرها كما ينفثون.
أذكر عندما وصلت إلى نهاية الرواية، كيف وقفت خلف باب غرفتي خشية أن يراني أحد وأنا أضرب صدري وأهز رأسي بعنف غير مصدقة هول ما فعلتْه حسنة أرملة مصطفى سعيد بالرجل الذي زوّجت به غصباً عنها.
والآن، إذ أعود إلى هذه الرواية، فلأني متأرجحة بين الشرق والغرب كمصطفى سعيد، ضائعة في هويتين، في عالمين، بين الذي كونني، وبين الذي أعيش في كنفه، محاولة أن أتمثل به، والذي حتى إذا أبعدته عني؛ عاد والتصق بي كالدبق.
8:33 دقيقه
أنا مثل مصطفى سعيد متأرجحة بين الشرق والغرب
https://aawsat.com/home/article/900611/%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8



أنا مثل مصطفى سعيد متأرجحة بين الشرق والغرب

حنان الشيخ - «موسم الهجرة إلى الشمال» للطيب صالح

أنا مثل مصطفى سعيد متأرجحة بين الشرق والغرب

حنان الشيخ - «موسم الهجرة إلى الشمال» للطيب صالح
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة