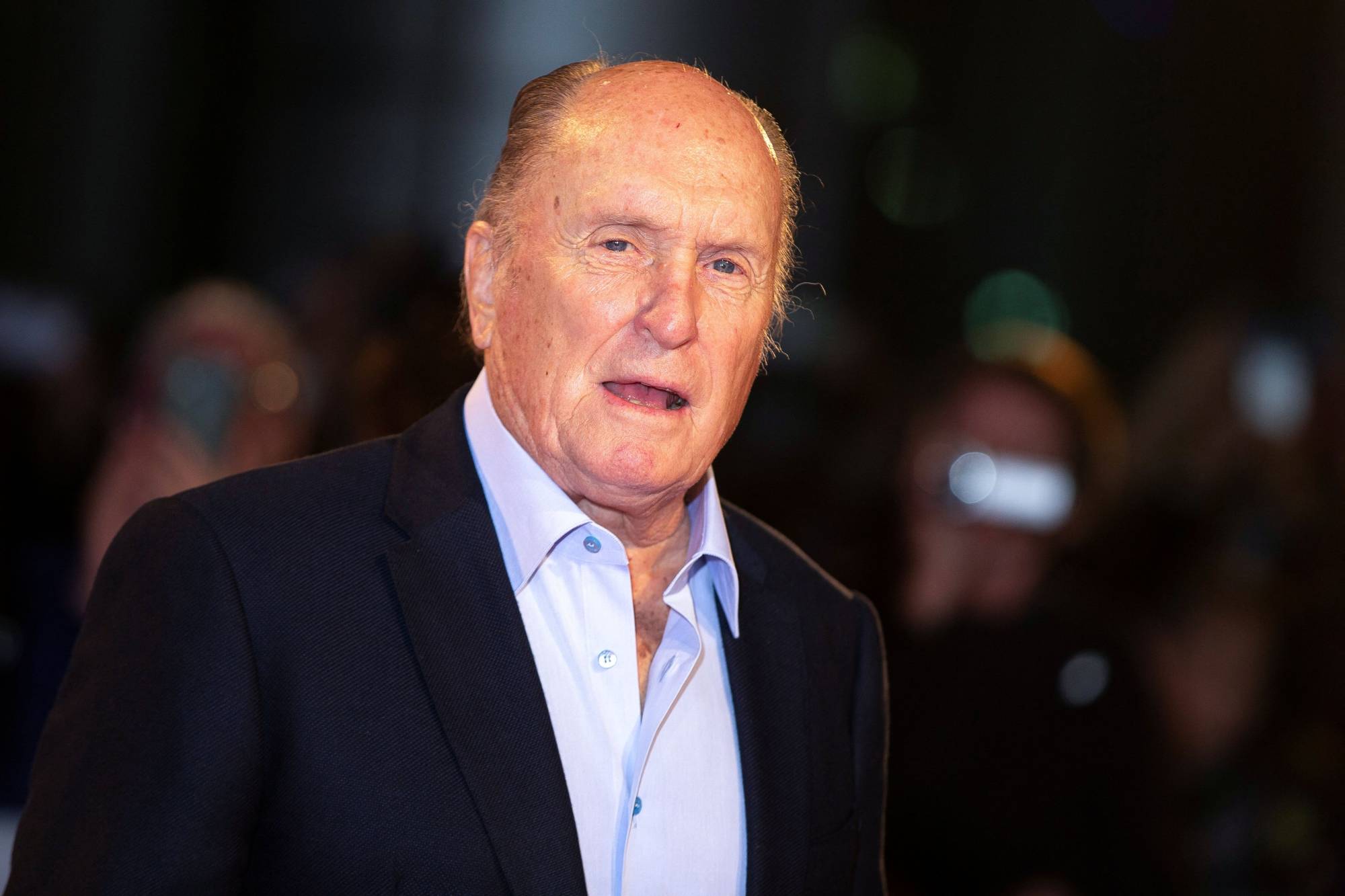في الشهر الأخير من العام الماضي، كان الموقف حيال فيلم «صمت» للمخرج مارتن سكورسيزي، وكما كتبناه هنا عنه، ما زال بدوره صامتًا. لم يكن قد باشر العرض وما جيء به من معلومات لم يكن لها علاقة بكيف تكوّن الفيلم أمام أعين المشاهدين، بل كيف توصّـل المخرج، وبعد معاناة أكثر من عشرين سنة بحثًا عن التمويل وسبل الإنتاج، إلى تحقيق حلم تحويل رواية شيساكو إندو إلى فيلم.
أما الآن فإن الفيلم ماثل في ساعتين و40 دقيقة أمام نقاد مجمعين (تقريبًا) على تقديره والاحتفاء به، وجمهور مؤلّـف من المداومين على أفلام سكورسيزي ويدركون الأبعاد الدينية التي عاش عليها وتأثر بها وبثها في أفلام كثيرة له.
هنا لا بد من ملاحظة أن الفيلم مبهر جماليًا. كل ما له علاقة بالبصريات، من تصميم مناظر وتصميم ملابس وتكوين الفترة الزمنية والموقع المكاني وكل ما يأتي في عداد تكوين الصورة رائع. ما هو في داخل هذا التكوين هو الإشكال الكبير لأنه من ناحية هو انعكاس لموضوع كبير لحكاية وقعت ولفترة زمنية تعاملت فيها حضارتان دينيتان مع بعضهما البعض، ومن ناحية أخرى هو إخفاق في نطاق معالجة كل ذلك على نحو يرتفع لمستوى الموضوع الواسع.
ما بين رواية شيساكو إندو، المنشورة سنة 1966. وبين هذا الفيلم المقتبس عنها، هناك فيلم ياباني رائع أخرجه ماساهيرو شينودا سنة 1971 بمعاينته يمكن التوقف عند حقيقة أن كلا الفيلمين، فيلم شينودا وفيلم سكورسيزي، اتفقا في جوانب كثيرة واختلفا في القليل منها.
عنف ياباني
رواية إندو، كما يمكن مطالعتها مترجمة، تدور حول وصول راهبين برتغاليين إلى اليابان في القرن الثامن عشر بحثًا عن راهب كاثوليكي اسمه الأب فيرييرا سبقهما إلى هناك واختفى وأخباره منذ خمس سنوات. الراهبان رودريغيز وغارابي يصلان في وقت متأزم. السلطات اليابانية في ذلك الحين منعت المسيحية في البلاد وعلى الراهبين أن يقوما بذلك البحث من دون إثارة ما يدل على وجودهما. لكن هذا شبه مستحيل وحال وصولهما إلى قرية كان زارها الأب فيرييرا وترك فيها فلاحين فقراء معدمين اتبعوا المسيحية بسببه تعرف السلطات بهما وتستنطق القرويين ثم تلقي القبض على رودريغيز بينما يمضي غارابي مستمرًا في بحثه في مناطق أخرى. ولاحقًا ما يُـلقى القبض على غارابي ويُـعاد إلى حيث ما زال رودريغيز يعاين احتمالات الموت والحياة على أيدي ساجنيه.
وفي الواقع، يعاين رودريغيز أكثر من ذلك. هو شاهد عيان على عنف السلطات اليابانية بحق المدنيين من قطع رؤوس إلى حرق أبدان إلى سلق في الماء الساخن وتعليق المحكوم عليهم من أقدامهم وتركهم ينزفون ببطء إلى إغراق مؤمنين في البحر. وغارابي هو أحد من يتم إغراقهم.
لكن المعاينة التي تساوي كل ذلك أهمية التي ترد في كلا الفيلمين هي تلك التي يعايشها الأب رودريغيز بينه وبين نفسه. إنه يمارس ما هو مؤمن به، لكن السؤال هو إلى أي حد هو مؤمن بما يمارسه؟
هذا السؤال مطروح في الفيلمين جيدًا فالصمت هو ما يثير دهشة الراهب بعدما وجد أن دعواته الحارة تمضي من دون استجابة ما يجعله يرتاب ويعبر عن ارتيابه ثم يرتد إلى رسالته ويذود عنها وكل هذا قبل أن يقنعه اليابانيون اتباع ديانة شينتو عوض المسيحية كونهم بحاجة لدحض صورته أمام تابعيه. اختيار صعب لكن رودريغيز يقبل به لكي ينجو من الموت.
في العملين هناك مواقع عدّة تعكس تلك الظروف القاسية للعيش بالنسبة للجميع من دون تغييب واقع من الفقر المرير بين سكان المنطقة التي تقع الأحداث فيها.
فيما يختلف الفيلمان فيه أن النسخة اليابانية سنة 1971 تعاملت، على نحو موسّـع، مع عنصر وقوع رودريغيز في حب امرأة يابانية، في حين يأتي هذا الأمر عارضًا في فيلم سكورسيزي ما يزيد هنا من ثقل أزمة الإيمان لديه من دون عناصر خارجية أخرى.
مسألة لغوية
يختلفان أيضًا في تصوير شدّة التعذيب. عند سكورسيزي أكثر إفصاحًا عن ضراوته. ليس أن ماساهيرو شينودا يميل إلى تقليل وقع العنف أو نقده لمواطنيه، بل هي طريقة تعامل مع مفهوم العمل وتعزيز الرسائل التي يحملها. لكن «صمت» شينودا له فضيلة لا يمكن للفيلم الحديث أن يجاريه فيها: إنه من صنع ياباني مائة في المائة بينما فيلم سكورسيزي أشبه إلى زيارة لتاريخ ومكان يابانيين. صحيح أنه لديه المبررات الوجدانية للقيام بهذه الزيارة إلا أن علينا، إزاء فيلمه، أن نتابع يابانيين فقراء معدمين يعيشون في قرى معزولة حتى عن حضارة القرن الثامن عشر لكنهم يتكلمون الإنجليزية بالقدر الكافي للتعبير.
لا حل سهلاً لذلك. الطريقة الوحيدة لتفادي الأمر هو جعل اليابانيين يتكلمون لغتهم والبرتغاليين يتكلمان لغتهما وبذلك يضيع التواصل بين الجميع ولا يتحرك الفيلم من مكانه مطلقًا. إلى ذلك، فإن رودريغيز وغارابي ومن قبلهما فيرييرا شخصيات برتغالية لم تتحدّث الإنجليزية أساسًا ما يجعل المسألة أكثر تعقيدًا واعتماد الإنجليزية كلغة مشتركة بين البرتغاليين واليابانيين الاختيار الوحيد المتاح.
ما هو معقد أيضًا، في فيلم سكورسيزي، أن الشخصيات البرتغالية ليس لديها في الكتابة ما يساعدها في التمثيل. نعم هناك الكثير من الحوار المتبادل وما يكفي من التعليق المعبر عن الذات وأكثر من ذلك من الوجدانيات، لكن شخصيتي رودريغيز، كما يؤديها أندرو غارفيلد وغارابي كما يمثلها أدام درايفر، تتحركان أكثر مما تكشفان. الشخصيات اليابانية حولهما ليس لديها مشكلة في أن تعكس ما تريده بإقناع. لكن حين نتابع رودريغيز وغارابي (الذي ينفصل عن الفيلم لنحو ساعة وربع قبل أن يعود قليلاً) فإن وجودهما ما يزال يبدو غريبًا لحد التأثير على مصداقية الوضع في الكثير من المشاهد.
ما يدور خلال ثلاث ساعات إلا قليلاً يمر بنبرة فاترة واحدة. مشاهد التعذيب تصدم قليلاً لكن ما قبلها وما بعدها يعود إلى حالة من انعدام الطاقة الكافية لسبر الموضوع باهتمام يتجاوز نجاح المخرج في تأليف بصرياته.
ما أن ينطلق الفيلم حتى نجد أنفسنا أمام عمل مشاد بصريًا ليكون أخاذًا. تصاميم إنتاجية وديكوراتية لجانب تصوير بكاميرا فيلم (وليس ديجيتال) من رودريغو برييتو (ثالث تعاون مع سكورسيزي) رائعة ومشاهد من على فوق الشخصيات كما لو أن هناك عينًا ما تراقب من فوق. هذا النجاح لا يواكبه قوّة دفع ذاتية تحرك المادة التي تقع في تكرار تجنّـبته نسخة شينودا.
صمت فيلم سكورسيزي من النوع الناطق
هل كانت نسخة شينودا أكثر مصداقية؟

«صمت» كما في نسخة مارتن سكورسيزي - نسخة ماساهيرو شينودا من «صمت»

صمت فيلم سكورسيزي من النوع الناطق

«صمت» كما في نسخة مارتن سكورسيزي - نسخة ماساهيرو شينودا من «صمت»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة