تتلخص المنهجية الاستقرائية في أن العالم يبدأ بملاحظة الظاهرة المفردة، ثم يفترض ويكثر من الظواهر المشابهة، ويغير ويبدل في شروط الظاهرة إلى أن يصل، بعد اختبار الفرضيات الممكنة، إلى تقرير فرضية منها، تصير، عند التوكيد، قانونا يصدق على كل الظواهر المشابهة للظاهرة، أو الظواهر، التي لاحظها.
بيد أن السؤال الذي يطرح هو: ما المسوغ المنهجي الذي يجيز هذا التعميم؟ فالعالِم لم يلاحظ إلا حالات معدودة، فكيف يجوز له أن يعمم ما لاحظه واستقرأه على حالات أخرى لم يستقرئها، ويجعل القانون الذي خلص إليه قانونا كليا وعاما؟
هل بالإمكان إنجاز تبرير منطقي لمنهج الاستقراء؟
لقد استشعر أرسطو والمناطقة المشاؤون هذه الثغرة في المنهج الاستقرائي منذ القديم، أي قبل التشكل المنهجي للعلم التجريبي، الأمر الذي دفعهم إلى إعطاء الأولوية للقياس الصوري، والنظر إلى الاستقراء بوصفه مفتقرا إلى اليقينية والقطع. كما انتهى كثير من العلماء والإبستمولوجيين المعاصرين إلى أنه ليست ثمة ضمانة ولا تبرير منهجي كاف لتقرير تماسك المنهج الاستقرائي.
ويستند نقد التبرير المعرفي لمصداقية الاستقراء منهجًا على مرتكزين اثنين؛ أحدهما منطقي، ويتعلق بطبيعة الاستدلال الاستقرائي ذاته، لأنه يقوم على نقلة من مقدمات مفردة إلى حكم/ نتيجة كلية. فالاستقراء يبدأ من الجزئي إلى الكلي، أي من حالات معدودة، يخلص منها إلى تقرير قانون كلي يشملها ويشمل مثيلاتها.
ويقوم المرتكز الثاني على نقد احتجاج الاستقرائيين بالتجربة، حيث يستند العلماء والإبستمولوجيون المدافعون عن المنهج الاستقرائي، على التجربة بوصفها الضمانة المنهجية المؤكدة على صدق وصلاحية هذا المنهج، وذلك بالنظر إلى التجربة بوصفها مبدأ للتحقق والتنبؤ.
ومن الملاحظ أن هذين المرتكزين لا يخلوان من هشاشة وضعف في بنائهما المنهجي والاستدلالي، فبالنظر إلى المرتكز المنطقي، لا نجد للإبستمولوجيا الاستقرائية إمكانية منطقية لتسويغ عملية الانتقال من الحالات المفردة المعدودة إلى تقرير القانون الكلي؛ فمن الواضح أن هذا الانتقال ليس نقلة استدلالية مضمونة، بل يمكن أن أعبر عنه بأنه قفز ليست له أي كفاية منهجية تجعله «منطقيا».
أما المرتكز الثاني الذي يقوم على تبرير الاستدلال الاستقرائي بالتجربة التي تعتمد دليلا على صلاحية الاستقراء وكليته بوصفه تنبؤا، فهو أيضا، مرتكز مختل لا يصلح استدلالاً، لأنه يعاني من اختلال منهجي بيّن، حيث يؤول بالمنهجية الاستقرائية إلى السقوط في مأزق الدور. فكما يقول شالمرز إنه «استخلاص لمبدأ كلي يسعى إلى تأكيد صلاحية مبدأ الاستقراء، انطلاقا من عدد من الحالات المفردة التي نجحت في الماضي، والحال أنه لا يجوز استعمال الاستقراء لتبرير الاستقراء». بتعبير آخر، إنه سقوط في مأزق الدور من جهة؛ كما أنه افتئات غير مبرر على حالات المستقبل، لأنه ليست ثمة ضمانة لكي يكون ما صدق على حالات الماضي، صادقا بالضرورة على الحالات المستقبلية.
إن هذه المآزق التي يعاني منها الاستدلال الاستقرائي، ستدفع فلاسفة العلم إلى التفكير في البناء النظري والمنهجي للعلم، بخاصة في نموذجه التجريبي المنتهج في العلوم الطبيعية. وكان لا بد لمعاودة النظر هذه، أن تقف مليًّا عند مسألة السببية لوثيق ارتباطها بالاستدلال الاستقرائي. ذلك لأن الذي يمكن العالِم من الزعم بأن النار ستحرق، ليس فقط حالات مفردة لاحظها في الماضي، بل تقريره لوجود علاقة سببية داخل الطبيعة ناظمة بين ظواهرها، فتصبح النار سبب الإحراق. لكن بصرف النظر عن الانتقادات التي وجهت إلى السببية مع «فيزياء الكوانطا»، فإن لها قبل اللحظة العلمية المعاصرة مراجعات نقدية كثيرة. ولعل أولى محاولات النقد المنهجي الصارم لها، هو ما نلقاه عند الإمام الغزالي في تراثنا الفكري، وعند ديفيد هيوم في الفكر الأوروبي. وبما أننا نناقش الآن وضعية العلم المعاصر وإشكالاته الإبستمولوجية داخل الثقافة الأوروبية، فلنقتصر على دراسة نقد هيوم، وكيفية استقباله من طرف الفكر العلمي والفلسفي الغربي من بعد.
يرى ديفيد هيوم أن العلاقة السببية هي مجرد علاقة اقترانية تكررت، فخلع عليها العقل صفة الاقتران السببي، في حين أن السببية ليست لها أي حقيقة وجودية (أنطولوجية). لهذا السبب، ينتهي هيوم إلى أن العلم القائم على الاستقراء، لا يمكن تبريره لا بالاعتماد على المنطق ولا بالاعتماد على التجربة. ومن ثم؛ فالإشكال المعرفي المرتبط بالمنهج الاستقرائي هو إشكال غير قابل للحل ولا للتبرير العقلي. إلا أن هذا الحكم الذي ينتهي إليه ديفيد هيوم ستكون له مراجعة ووقفة نقدية مع كانط، حيث يزعم أن الحكم العلمي القائم على الاستقراء حكم مبرر. كيف؟
هناك نمطان من الأحكام المعرفية: أحكام تحليلية تكون في بنائها استخراجا للنتيجة من المقدمات، ويسود بخاصة في حقل الرياضيات. وهذا النمط من الأحكام نحكم عليه انطلاقا من مبدأ عدم التناقض، وذلك باختبار النتيجة التي يخلص إليها الرياضي؛ هل هي منسجمة مع المقدمات المستنبطة منها أم لا؟
كما أن ثمة نوعا أو نمطا آخر من الأحكام مغايرا للنمط التحليلي، يتمثل في الأحكام العلمية التي تنتجها العلوم الطبيعية، التي هي أحكام تركيبية. فالاستقراء هو، في النهاية، حكم تركيبي، ما يضمن صدقيته، هو ارتكازه على مبدأ السببية. بمعنى أنه إذا كان ديفيد هيوم لم يجد أساسا يبرر هذه الأحكام، فإن كانط يرى أن هيوم على خطأ؛ لأن ثمة تبريرا عقليا للعلم وأحكامه.
فما مصدر هذا التبرير؟
إنه العقل ذاته؛ لأنه يحمل في داخله مبدأ قبليا هو مبدأ العلية أو السببية. ومن ثم؛ فالحكم العلمي المنجز في العلوم الطبيعية ليس حكما تركيبيا، بل هو حكم «تركيبي قبلي»، وقبليته راجعة إلى ارتكازه على مقولة عقلية سابقة على الاكتساب التجريبي، وهي السببية التي هي واحدة من اثنتي عشر مقولة، يحملها الكائن الإنساني، حسب إيمانويل كانط. هذا ما يمكن أن نسميه «الضمانة المتعالية»، (الترنسندنتالية)، التي يقدمها كانط للممارسة العلمية.
ويمكن القول إن هذا الموقف الكانطي، على الرغم من النقد الذي وجه إليه، في سياق تاريخ الفلسفة، أرى له حضورا في أكثر الدراسات الإبستمولوجية راهنية؛ فشخصيا أرى في أبحاث نوزيك Nozick، وكورنبليث Kornblith اللذين يبحثان عن خلفية بيولوجية لمبدأ السببية، نزوعا كانطيا يتلبس بلبوس العلم المعاصر، ويصطنع في التعبير عن ذاته لغة علم الأعصاب.
8:27 دقيقه
في القراءة الفلسفية للاستقراء العلمي
https://aawsat.com/home/article/817616/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
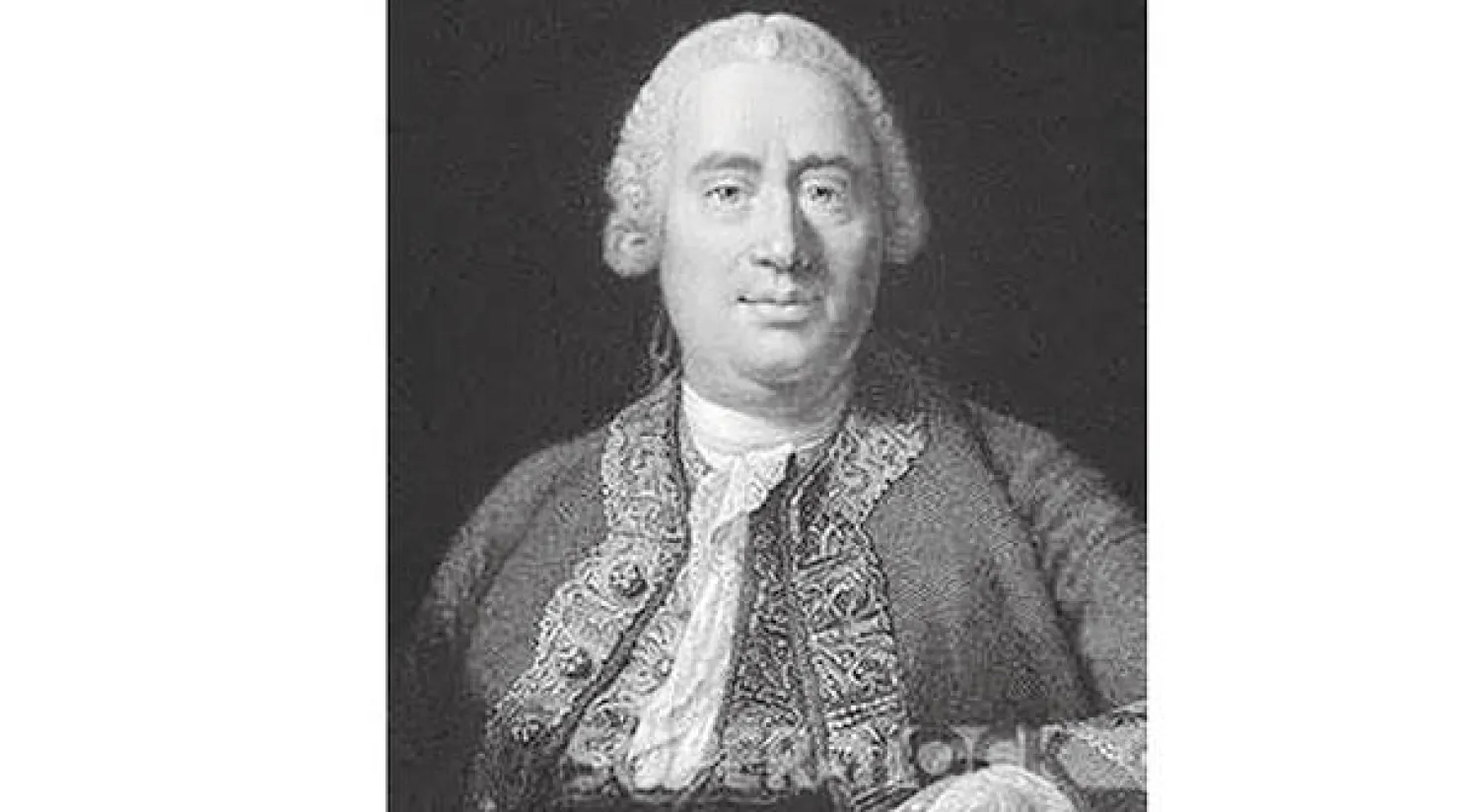

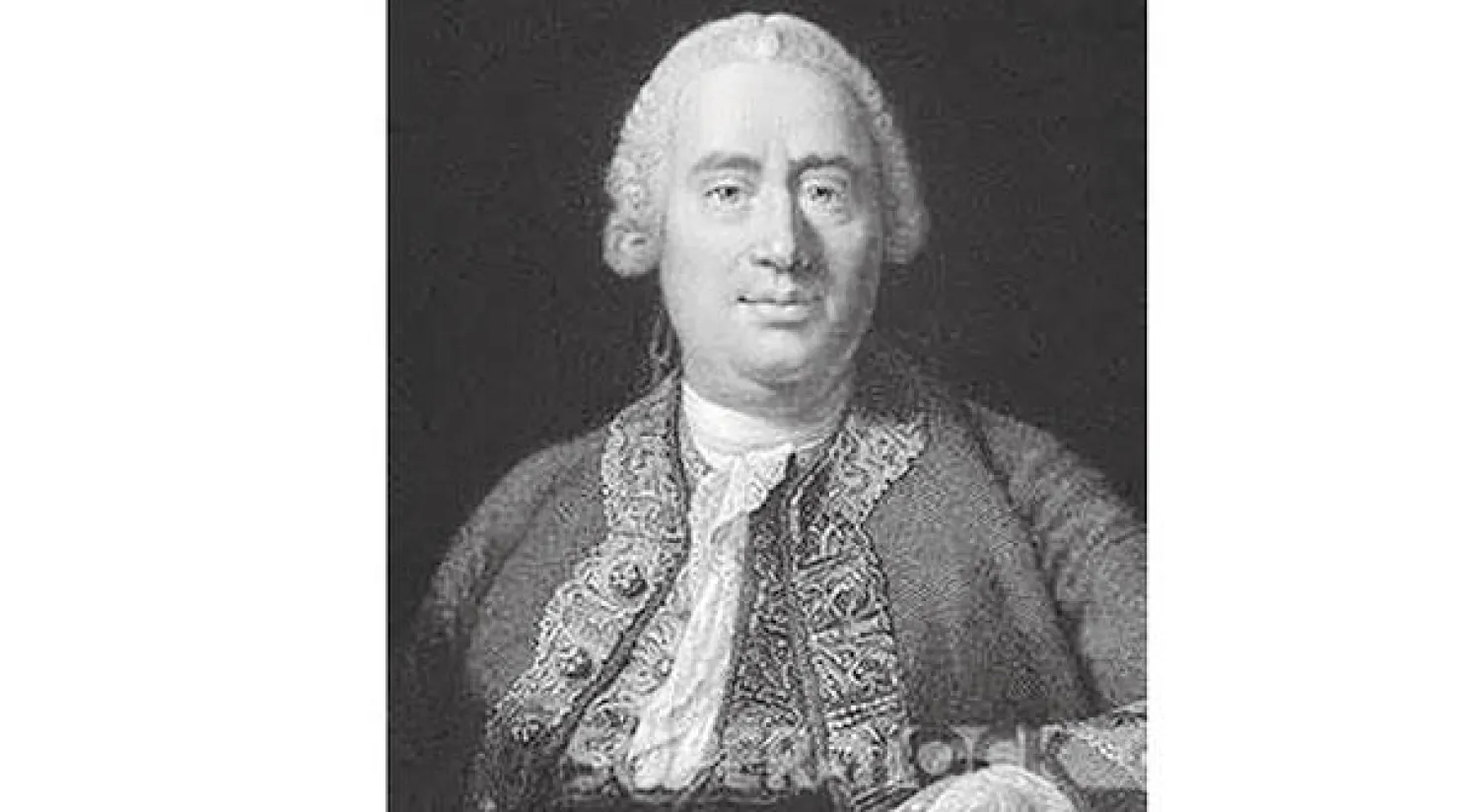
في القراءة الفلسفية للاستقراء العلمي
العلم القائم عليه لا يمكن تبريره اعتمادًا على المنطق أو على التجربة
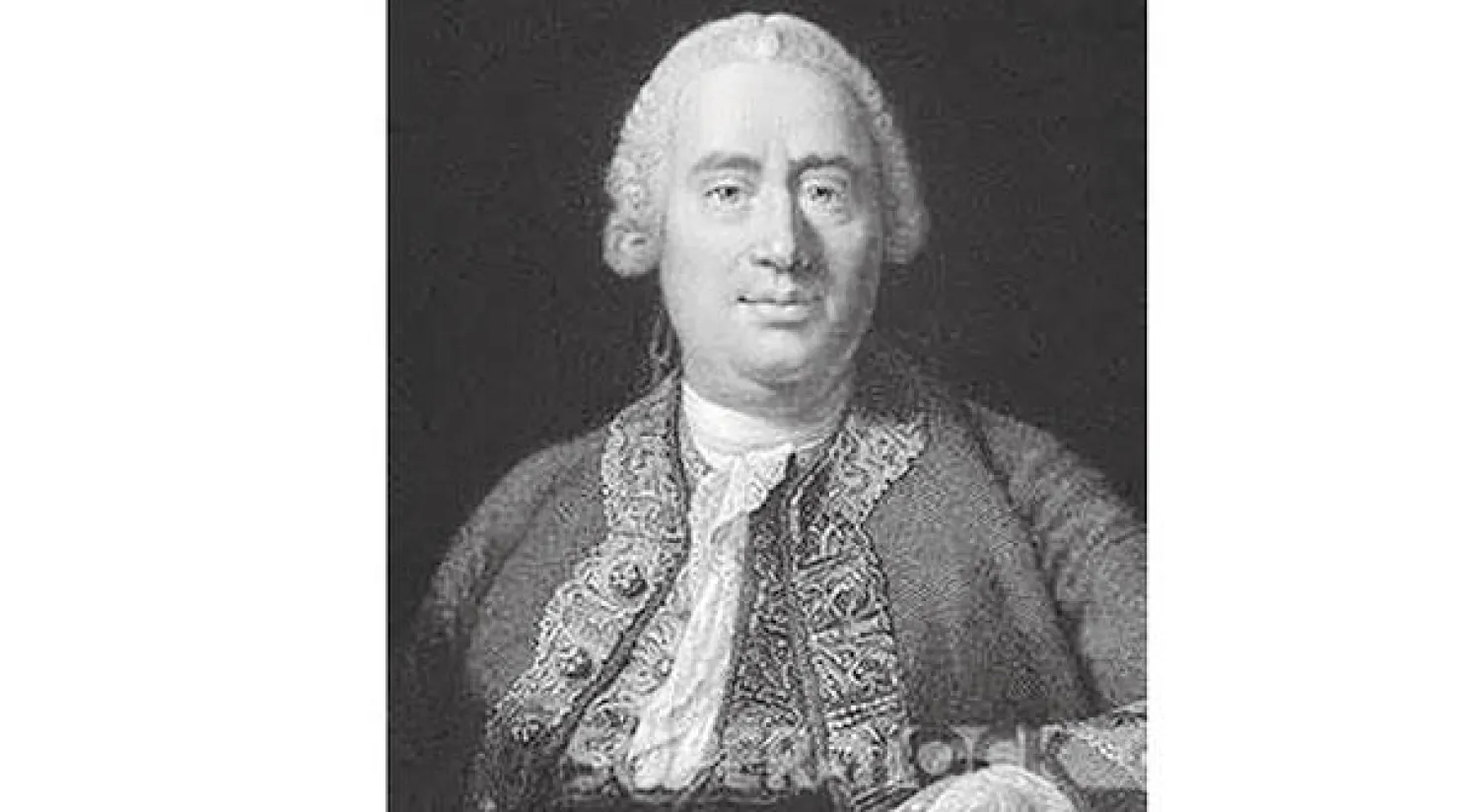
ديفيد هيوم
- طنجة: د. الطيب بوعزة
- طنجة: د. الطيب بوعزة

في القراءة الفلسفية للاستقراء العلمي
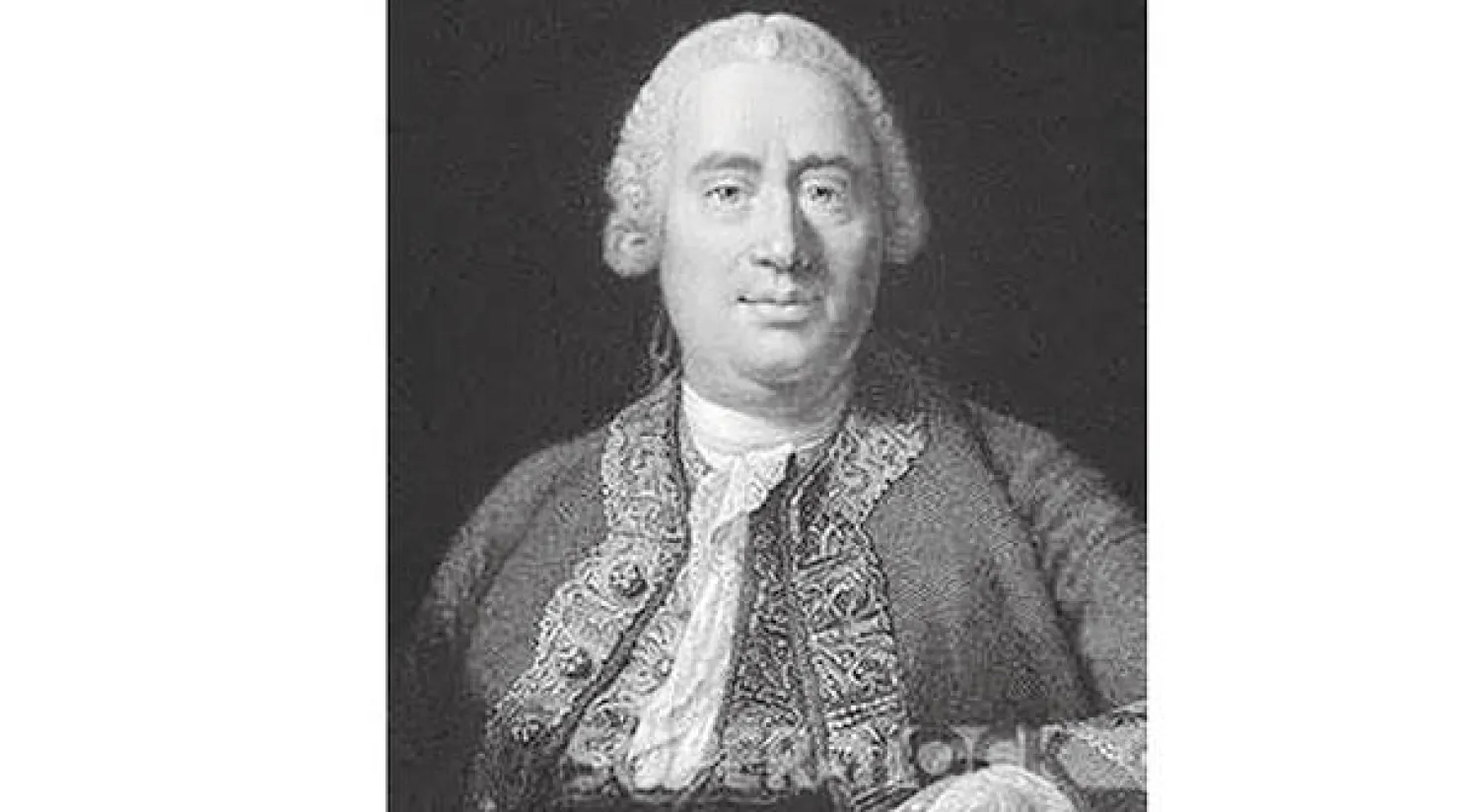
ديفيد هيوم
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة








