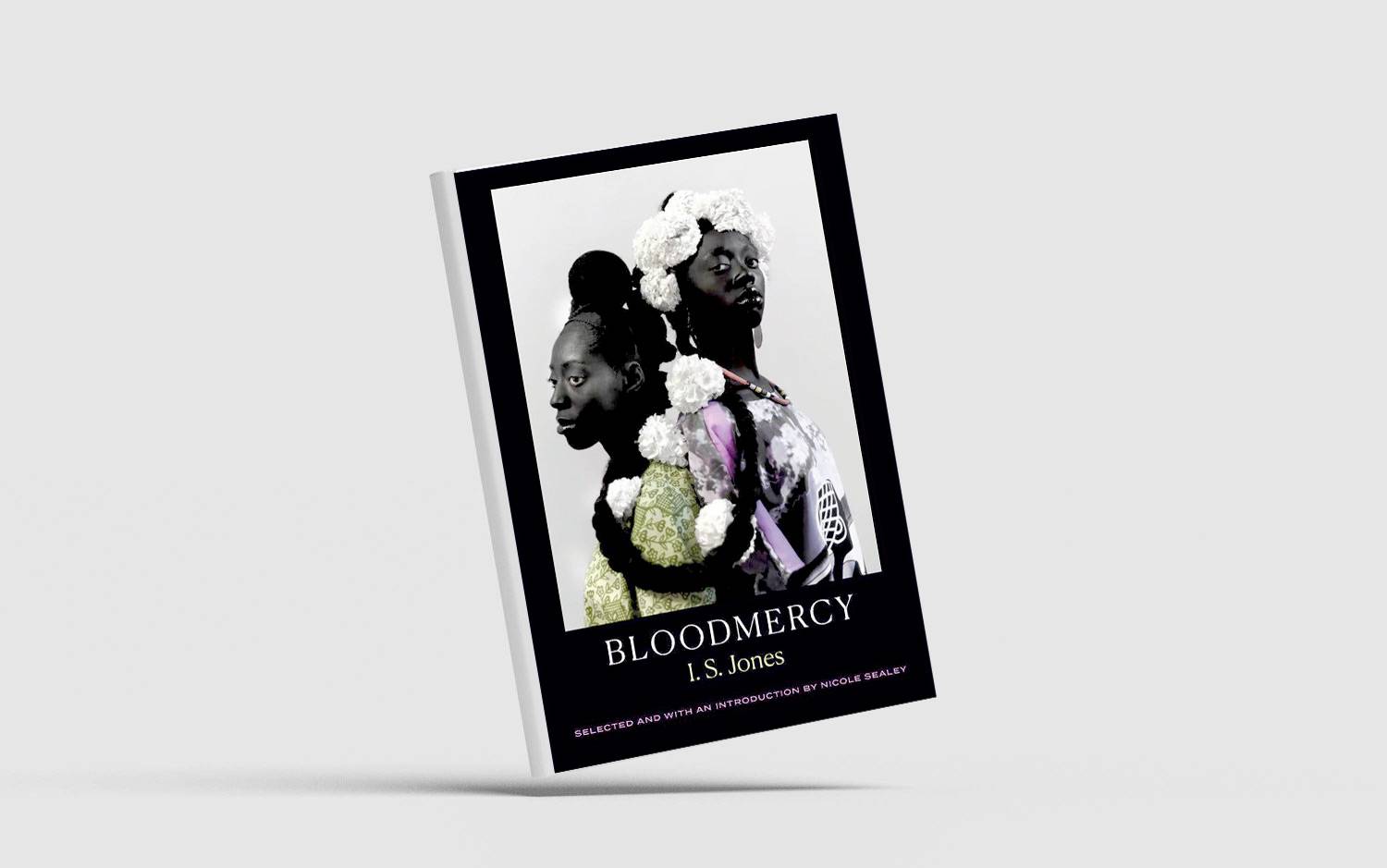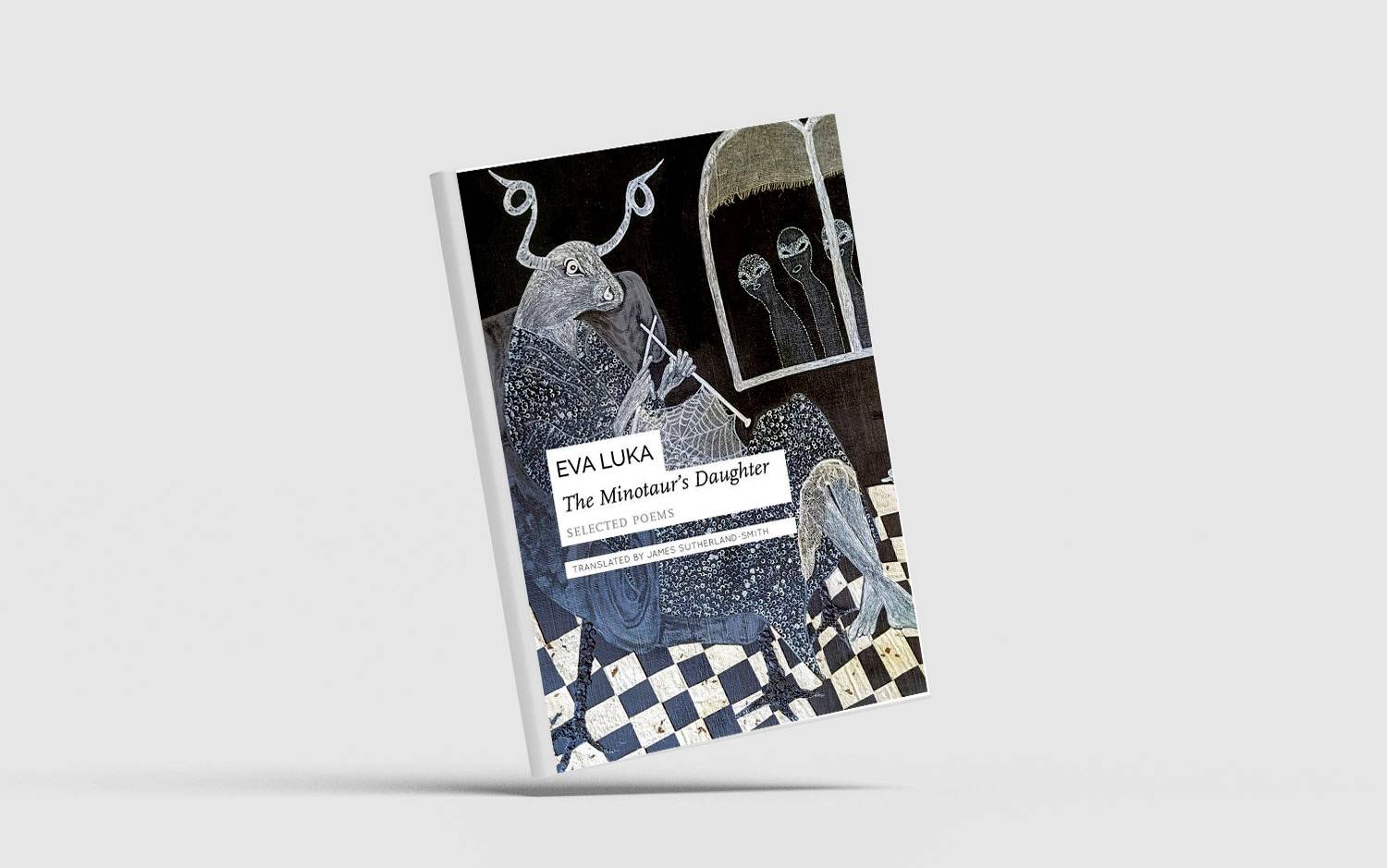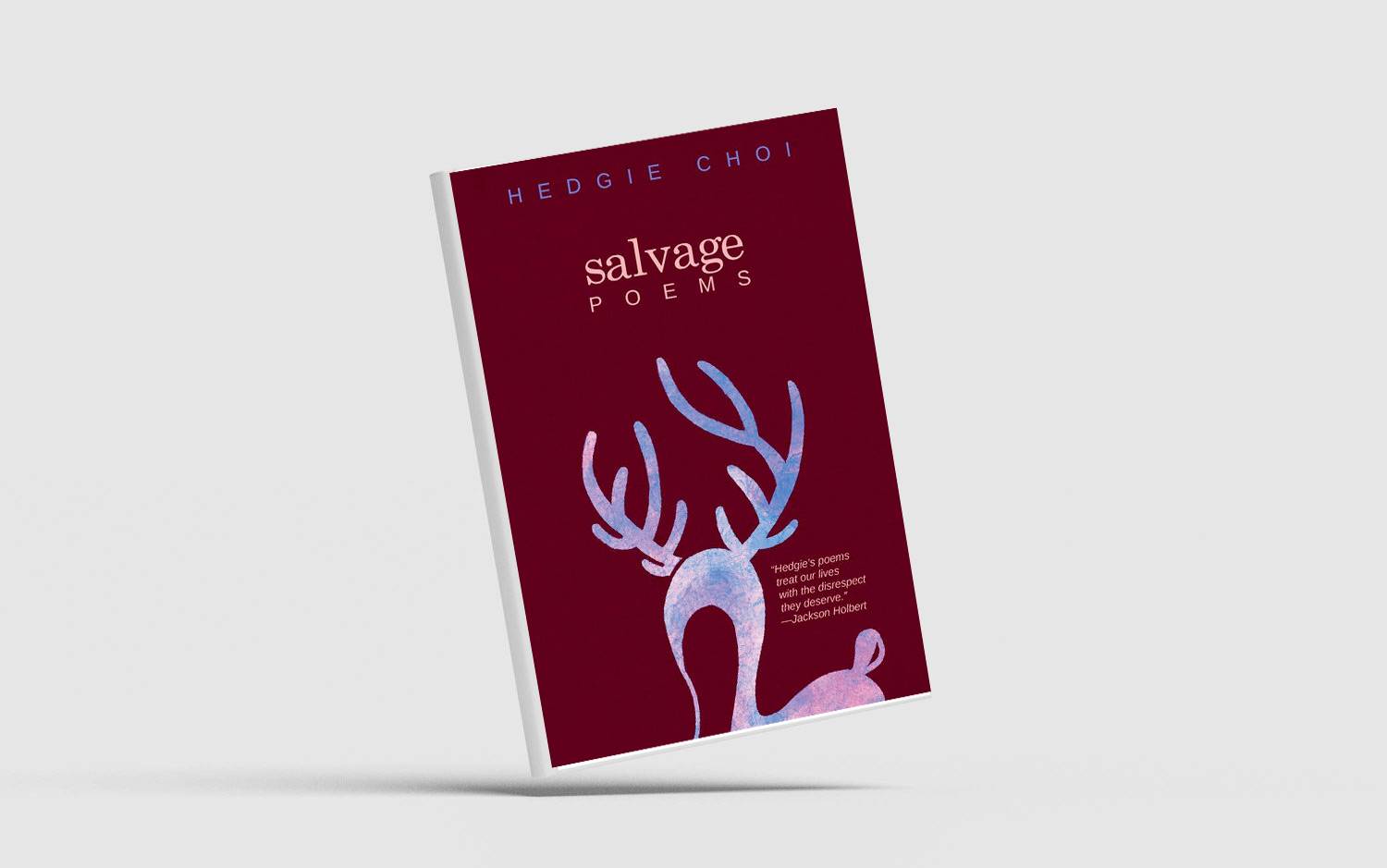اعتبر مبدأ الذاتية، مؤسس الأزمنة الحديثة، وعلى أساسه، فسر تفوق العالم الحديث، باعتباره أيضًا، عالم الهشاشة والضعف. ويتجلى ذلك في الأزمات التي تعرض لها العالم ولا يزال يتعرض. لذلك وجدنا بلاندييه يقول: «إن الحداثة تقلق وتغري»، ولهذا السبب، جعل هيغل من تحديد مفهوم الحداثة، نقدًا لها ومنذ النشأة.
إن ما يميز الأزمنة الحديثة، هو الارتداد إلى الذات أو الذاتية، ويتضمن هذا، في نظر هابرماس، أربعة مدلولات، وهي كالتالي:
1 - الفردانية: في العالم المعاصر، يحق للفردانية المسرفة في خصوصيتها، أن تبرز طموحاتها.
2 - الحق في الانتقاد: يتطلب مبدأ العالم الحديث، أن يبدو ما يتوجب على كل فرد تقبله، في نظره هو، شيئًا له ما يبرره.
3 - استقلالية الفعل: يعود للأزمنة الحديثة الفضل في إرادتنا أن نكون مسؤولين عما نفعل.
4 - وأخيرًا الفلسفة المثالية ذاتها: يرى هيغل أن من منجزات الأزمنة الحديثة، أن تدرك الفلسفة الحديثة الفكرة التي تعي ذاتها.
لقد فرضت الذاتية في نظر هابرماس، الأحداث التاريخية الكبرى. فقد عملت على إماطة اللثام عن كل الأشكال السحرية والأسطورية التي كانت الطبيعة تتخذها في القرون الوسطى، بحيث بلورت الثقافة في كل أشكالها، وخلصتها من الشوائب القروسطية، واتجهت إلى اختزال الطبيعة في مجموعة قوانين ومعادلات رياضية. أما فيما يخص المفاهيم الأخلاقية، فقد عملت على التركيز على حرية الفرد واستقلاليته ومسؤوليته في اتخاذ قراراته. وجرى ذلك في إطار قانوني ينظم علاقته بالآخرين، أي توافق استقلالية الإرادة الذاتية مع القوانين العامة. وأخيرًا، نجد الفن الحديث، يكشف عن جوهره في الرومانسية على مستوى الشكل والمضمون، اللذين يتحددان بالاستبطان المطلق.
أمام هذا الواقع الثقافي ذي البعد الفلسفي، استطاع هابرماس أن يغير بنيته، «بالانتقال من النشاط الإنتاجي إلى النشاط التواصلي، إذ حصلت إعادة صياغة مفهوم العالم المعيش اعتمادًا على نظرية التواصل»، على اعتبار أن هابرماس، قام بتركيب جديد لنظرية الحداثة، استنادًا إلى نظرية للتواصل. فنظرية «النشاط التواصلي تقيم بالفعل، علاقة داخلية بين الممارسة الإبداعية والعقلنة، وتدرس المضمرات العقلانية التي تفترضها الممارسة التواصلية، وتسعف المضمون المعياري الملازم للنشاط الموجه نحو التفاهم، ليتوصل إلى مفهوم العقلانية التواصلية»، التي تذهب بعيدًا عن التناول النقدي الجمالي للحداثة، ويعتبر الانخراط الوجودي فيها، موحدًا ومسجونًا وموضوعًا تحت تصرف التقنية بشكل كلياني خاضع للسلطة. وبناء على ذلك، تستمد مضامين الحداثة من عقل مجسد في العملية التواصلية للممارسة الاجتماعية، التي تنطلق من مقولة النشاط التواصلي في علاقتها بمكونات العالم المعيش المحدد في نظر هابرماس: في الثقافة، والمجتمع، والشخص البشري. ويعتبر «الثقافة، تلك المعرفة المهيأة والجاهزة التي تستمد منها الذوات الفاعلة في النشاط التواصلي، التأويلات ذات الطابع الإجمالي فرضيًا، وذلك بالبحث عن التفاهم حول شيء معين موجود في العالم والمجتمع. تلك الأنظمة المشروعة التي تستمد منها ذوات النشاط التواصلي، التضامن المؤسس على الانتماءات الجماعية المنتجة للعلاقات بين الناس. في حين أن الشخصية، وهو هنا لفظ تقني، يعني الإمكانات التي بفضلها تكتسبُ ذاتٌ ما قدراتها على الكلام والفعل، وبالتالي على المشاركة في عمليات التفاهم بين الذوات داخل سياق يختلف في كل مرة». لذلك، فإنه في الوقت الذي يتعقلن فيه العالم المعيش، فإن الذوات الفاعلة في النشاط التواصلي مضطرة لبذل جهود إضافية لضمان الاتفاق والتفاهم. وإذا تأملنا عن كثب، الشروط الضرورية التي ينبغي أن تتوافر من أجل أن نتفاهم، فيما بيننا، على شيء من الأشياء، فإننا «نكتشف وجود مسلمات ضمنية عملية محتومة، ذات مضمون معياري ضابط». هذا يعني أنه قبل أن ندخل في أي نوع من أنواع المناقشة أو المحاججة، بما فيها الكلام اليومي العادي الحالي بين طرفين، فإننا نفترض مسبقًا، وباتفاق الطرفين، أننا مسؤولون. أي أن أفراد العالم المعيش، ينطلقون من تقاليد ثقافية مشتركة، مصاغة في نسيج الأفعال التواصلية، التي تنجز اعتمادًا على التأويل المشكل من طرفهم، والمبني على أخلاق تواصلية، للاتفاق على الحقيقة المبرهن عليها داخل تنظيم مؤسسي للمناقشة العمومية. لذلك، فهابرماس، «يرفض كل إجماع معطى سلفًا، أو مؤسسًا على سلطة تحيل دومًا إلى التراث، ويفترض تدخلات برهانية عقلانية، في سياق تواصلي ينبذ المسبقات، ويشجع على إبراز تشكيلات خطابية للإرادة». إن وسيلة اللغة وغاية الفهم، مرتبطتان، داخليًا، ولا يمكننا أن نفصلهما عن بعضهما، كما نفصل، عادة، بين الوسائل والغايات. ولا يمكننا أن نفسر ما هي اللغة من دون اللجوء إلى فكرة الفهم والإدراك.
وعمومًا، إذا كانت الحداثة في جوهرها، تعني الابتعاد عن التقليد وإعادة إنتاج الماضي، وتتضمن في عملياتها وحركاتها، الأزمة وإمكانات تخطيها في الآن نفسه، فإن مشروع هابرماس الفلسفي، ارتبط، منذ عصر الأنوار إلى الآن، بالتنظيم المؤسسي للمجتمع، المرتبط بتوجهات الدولة السياسية، في عمليات التنظيم والعقلنة والتحديث، وما تطرحه من قضايا فكرية واجتماعية على العالم المعيش وعلى مستوى مختلف القيم، تستدعي النقد وإعادة النقد. وهذا ما يجعلها في نظر هابرماس، مشروعًا غير مكتمل، يحتاج إلى عقل تواصلي لممارسة هذا النقد. وبالتالي، تجاوز النزعات التي تريد أن تنفيها. لذلك يُطرح علينا سؤال أخير: ماذا نعني بنظرية التواصل عند هابرماس؟
التواصل في نظر هابرماس، هو علاقة حوارية بين فئات المجتمع المتعددة والمتباينة آيديولوجيًا وطبقيًا، وذلك عن طريق استخدام القوة المفرضة عقلانيًا، هذه القوة المتضمنة بالضرورة في أفعال النطق اللغوية. يضاف إلى ذلك، أن الفعل التواصلي، لا يمكن أن نستبدل به ممارسات من نوع آخر، أيًا كان السياق والظروف. فعملية التفاهم اللغوي، لا يمكن أن تحل محلها كيفما شئنا، آليات أخرى لتنسيق الأعمال. ولتوضيح هذا الكلام، يقول هابرماس: «إذا ما أردنا أن نربي أطفالنا أو نعلم طلابنا أو نحاول إنعاش الروابط الاجتماعية بطريقة مشتركة، فإننا لا نستطيع أن نرفض الدخول في هذه الممارسة ذاتها (أي الممارسة التواصلية اللغوية). وهذا يدل على أنه خلال الفعل التواصلي، ومن خلاله وحده، تجري عملية الانصهار الاجتماعي، وانتقال الإرث الثقافي من جيل إلى جيل، ودمج الفرد في المجتمع أو جعله حيوانًا اجتماعيًا».
والواقع في نظر هابرماس، أن الفعل التواصلي لا يمكن أن يتحرك كما يحلو له هكذا في الفراغ، وإنما هو بحاجة إلى عالم معيش يقدم له الخلفية والقاعدة الارتكازية. إذ لو كانت هذه المسلمات الضمنية المشتركة، محدودة كليًا، لما التقينا في العالم المعيش إلا بالأفعال الاستراتيجية لا التواصلية. لكنه يلاحظ في المجتمعات الحديثة، وجود كثير من العوالم المعيشة المختلفة، وكل وجود فردي هو بحد ذاته عالم ومشروع فريد من نوعه. فالنزعة الفردية والنزعة الشمولية، وجهان لعملة واحدة منذ هيغل. فلا يمكن وجود فردانية من دون شمولية معيارية ضابطة. لذلك، فإن مفهوم التفاهم، يحيل عند هابرماس إلى اتفاق مبرر عقليًا، تتوصل إليه مجموعة من المشاركين في التفاعل، المبني على ادعاءات الصلاحية القابلة للنقد والمشاركة، اعتمادًا على معايير أخلاقية، يسميها هابرماس «أخلاقيات التواصل»، أي أن للتواصل معايير أخلاقية تنظم الأفكار والادعاءات، من خلال المناقشة، عن طريق تقديم مجموعة من البراهين والحجج المرتبطة منهجيًا. يقول هابرماس إن «قوة برهان ما تقاس، داخل سياق معين، بصحة الحجج. وهذه الصحة تظهر من بين ما تظهر فيه، في قدرة تعبير معين على إقناع المشاركين في المناقشة، وعلى تبرير قبول ادعاء ما للصلاحية».
إن الحداثة الغربية، على الرغم من نزوعها المعلن نحو الكونية، وجعلها العالم عبارة عن «قرية» صغيرة تتفاعل فيها كل الثقافات والحضارات والأجناس واللغات، فإنها اصطدمت بأشكال حضارية وثقافية لدى شعوب لم تستسغ الحداثة بعد. هذا التفاعل أو التنابذ بين المرجعيات الإنسانية، جعل التفكير في التواصل، هو أصلاً تفكيرا في الحداثة، باعتباره تتويجًا للعقلانية. وهذه الأخيرة، تقتضي عمليات تحديث العقلنة وعقلنة التحديث، وإلى وضع شروط مجتمع ممكن «ما دام التفكير في التواصل، في شكله البرهاني، هو في العمق، تفكير فيما هو مجتمعي». وبالتالي تجاوز هابرماس النقد الجذري للعقل الذي دشنه نيتشه وهايدغر والفلاسفة الفرنسيون.
وعمومًا، فإن فلسفة هابرماس، تسهم في تغيير منطلقات الفكر الفلسفي، وأسلوب النظر إلى اللغة، والزمن، والمجتمع، والانتقال من التفكير الموجه نحو الغاية، الذي تؤطره العقلانية الأداتية، إلى التفكير الموجه نحو التفاهم، الذي تحدده العقلانية التواصلية. لذلك فإن الاتفاق اللغوي التواصلي، يتعين أن يحل محل السلطة المسنودة من طرف التصورات التقليدية نتيجة المناقشة المستمرة، التي تعبر عن التحرر والنضج والاستقلال، بحيث تبعد النظرية التواصلية العقلانية عند هابرماس، من كل يوتوبيا، وتجعلها أكثر ارتباطًا بالواقع.