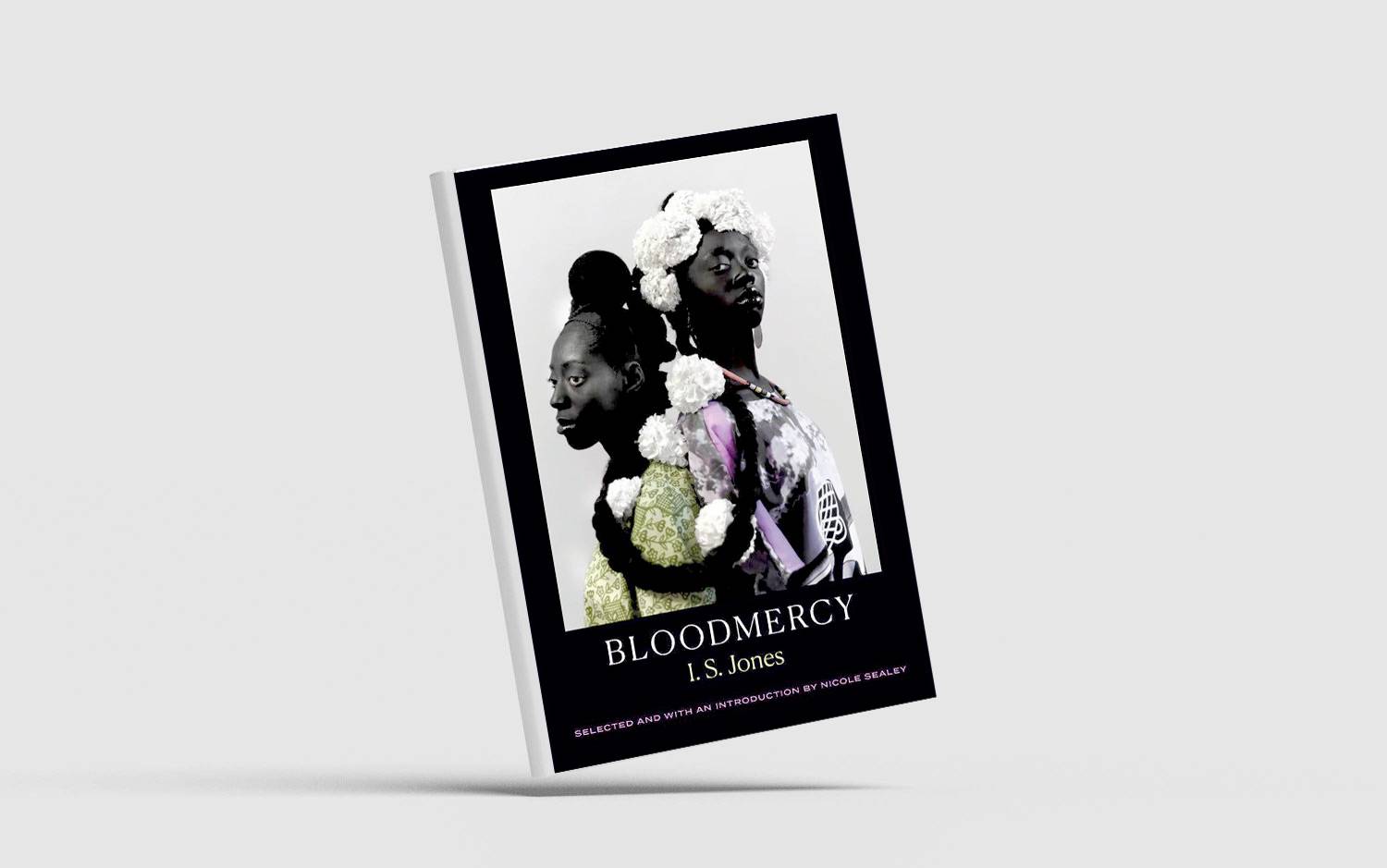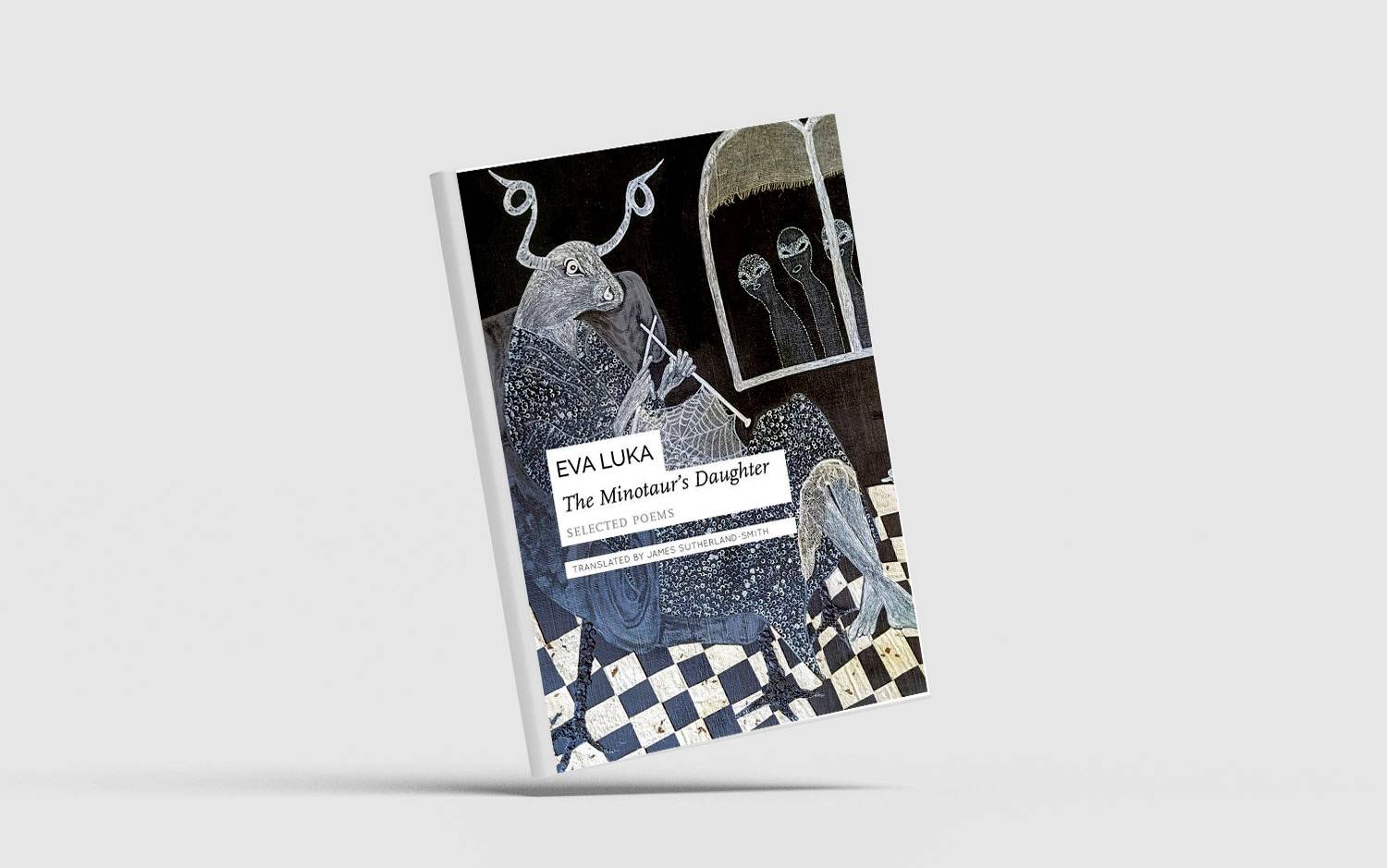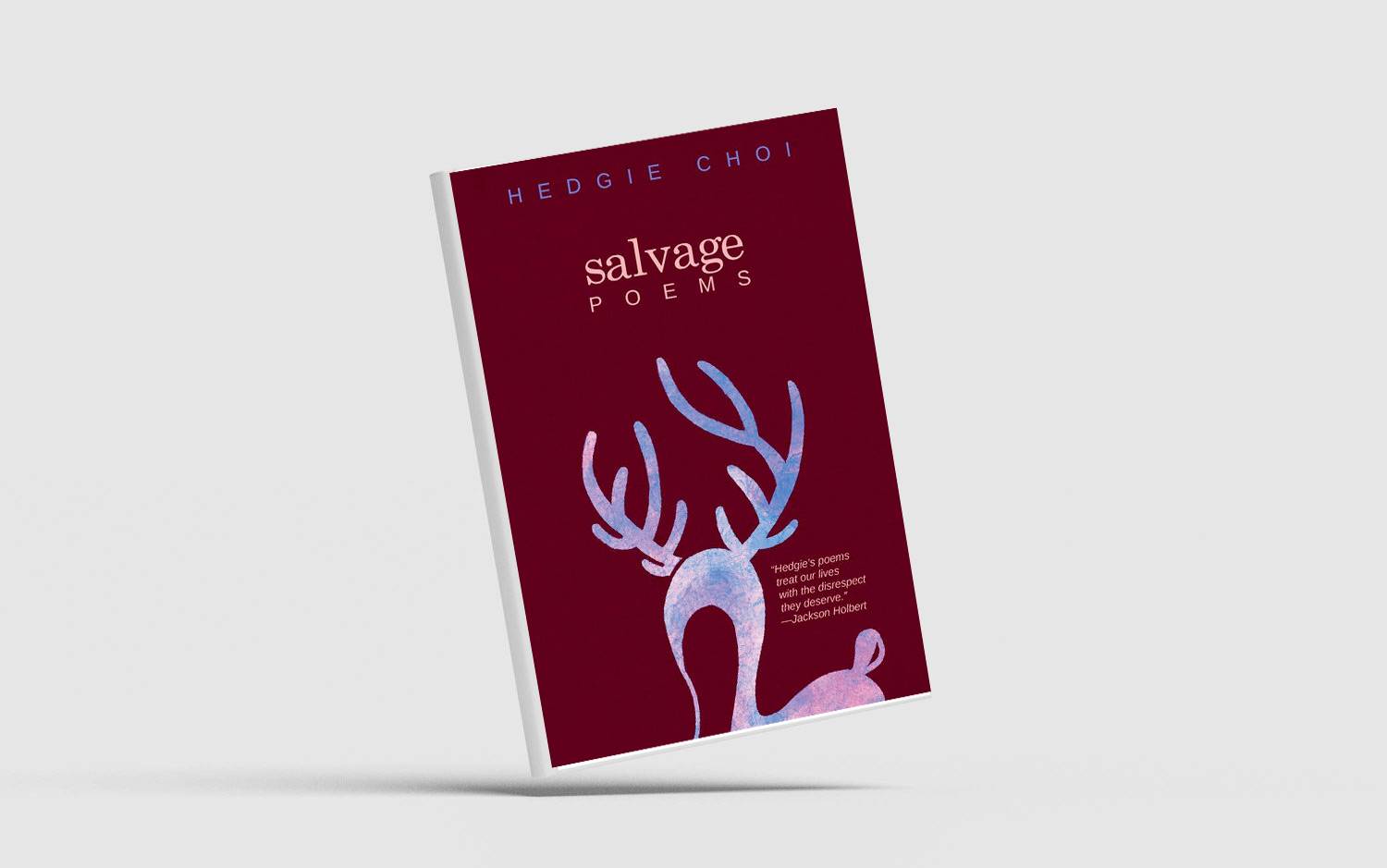رغم أن السعادة قد ظلت على مر التاريخ، مطلبا بشريا يتخلل كل الفكر الإنساني ومنجزاته، باعتبارها الهدف الأسمى وغاية الغايات، فإنها، في المقابل، ظلت مفهوما عصيا على البحث، وعسيرا على التقصي. ولا أدل على ذلك، من أن هذا المفهوم لا يتوفر على تعريف جامع مانع له. لهذا ظل المشتغلون به، متفرقين حول المعنى الحقيقي للسعادة والطرق الموصلة إليها. إذ تكفي إطلالة على الحكم الشرقية القديمة، كالبوذية والطاوية والكونفشيوسية، مرورا باللحظة الإغريقية ومجمل الفكر الغربي واللاهوتي، الذي اشتغل على هذا المفهوم، لنكتشف حجم التناقض والاختلاف القائم بين هذه المرجعيات، رغم اشتراكها جميعا في شيء واحد، هو الرغبة في الإمساك بهذا المفهوم الغامض داخل التشابكات التي تحيط به.
لا يشذ عصرنا عن العصور السابقة، في سعيه نحو السعادة. فسؤالها لم يزل مطروحا بحدة تضاهي العهود السالفة أو أكثر، خاصة أن هذا العصر المتسم بالتعقيد، قد جعلنا نتيه في بحثنا عنها، وأضاع كل أملنا في نيلها، حتى أصبح الحديث عنها نوعا من العبث وضربا من السخافة. وهذا أمر مبرر، بما أن الإنسان المعاصر، يعيش في عالم متطلب وسط زخم التقنية، وإغراء الاقتصاد، وتراجع القيم، وتفكك الأسرة، وتدمير البيئة وغير ذلك. وبالتالي، فعالمنا، رغم كل التقدم الحاصل فيه مقارنة بالماضي، لم يفلح في مدّنا بالوسائل والأدوات الأساسية التي من شأنها مساعدتنا على نيل تلك الحياة الطيبة الهادئة التي نحلم بها. فأصبح الإنسان المعاصر أكثر بحثا عن السعادة، وأكثر بعدا عنها في نفس الوقت، حيث أنهكه الواقع، وضاقت به دروب الحياة، وعم داخله الضجر والتعب، في عالم فقد المعنى، وسقطت فيه كل مرجعية دينية أو وطنية. وبالتالي، فبدلا من أن نقترب من السعادة، تهنا خلف أبوابها الموصدة ودروبها الملتوية. وهي الأبواب التي أحاول طرقها هنا، سائلا إياها عن الوعود التي تقدمها لنا باعتبارها سعادة.
* السعادة ودفء الحياة الروحية
عصرنا هو عصر شك وتقصٍ، حيث لا يقبل مبدأ أو رأي دون أن يمر من مدماك النقد والتحليل. مع العلم أن مجال الروحانيات، هو المجال الذي انهالت عليه مطارق الشك، منذ أن أصبح عقيدة مع الفيلسوف الفرنسي روني ديكارت، ومن بعده باروخ اسبينوزا، وأخيرا إيمانويل كانط، الذي رمى بالروح إلى غياهب المجهول وجعل بينها وبين العقل جدارا سميكا يصعب اختراقه، فأصبح كل مذهب روحاني مدعاة للسخرية أكثر منه مدعاة للإيمان. أما اليوم، فقد صار صوت الإلحاد يصدح في كل اتجاه، بل من الفلاسفة من صار يدافع عنه كطريق للخلاص، (ميشيل أونفراي، أندري كونت سبونفيل، ريتشارد داوكنز). أما الأديان، وخاصة السماوية، مثل المسيحية التي كانت خلاصا، فقد أصبحت سبة، لأنها ربطت سعادة الإنسان بعالم آخر مفترض، تتأسس فيه الحياة بعد الموت، وتضيع فيه الحياة من أجل الموت. وقد ضربت في وجودها عقائد قديمة كانت تؤمن بسعادة على الأرض، ترجع إلى الإنسان وعلاقاته بذاته وبالآخرين. هكذا أصبح الإنسان المعاصر شكاكا مرتابا، ينخره فراغ قاتل ووحدة قاسية، من عالم لا يؤمن بشرق أو غرب، ولا يعترف بتمثلاتنا حوله. وبالتالي، فالروحانيات التي كانت طريق الإنسان نحو السعادة، قطعتها فلسفات الشك، كما يسميها الفيلسوف الفرنسي بول ريكور.
* السعادة وحياة الملذات
النقاش حول السعادة واللذة قديم جدا. فقد تعرض اليونان لهذا الإشكال بشكل مسهب، حين حذر أفلاطون من مخاطر اللذات، وأعلى أرسطو من حياة الحكمة في مقابل اللذة الحسية، في حين دافعت الرواقية عن الأخلاق. ورغم أن الأبيقورية قاست الحياة السعيدة بمقدار انغماسنا في حديقة المتع، فإنها دعت في المقابل، إلى عدم الإسراف فيها، واتباع منهج التعقل، حتى لا تتحول اللذة إلى ألم والمتعة إلى شقاء. هذه الأصوات الحكيمة، لا تجد اليوم صدى. فقد عادت اللذة لتخترق الحكمة، بعدما أظهرت الداروينية طبيعتها وأصالتها فينا. وبين فرويد أنها المحرك الفعلي لفعلنا وسلوكنا، فأصبح الإنسان اليوم، محاطا باللذات، وأضحت سعادته مرهونة بحجم اللذات التي ينعم بها: أكل، وشرب، ونوم، وجنس، وسفر، وخمر وغير ذلك. في وقت أصبح فيه كبح جماح اللذات سلوكا محتقرا، انتشرت أندية المتع، وصارت رمزا للسعادة وميزة للعصر. وهي أندية يمكن أن نقول عنها إنها أندية للفرح وللذة وللاستمتاع. لكنها أبعد بسنوات ضوئية عن السعادة كإحساس دائم لا ينقطع، لأنها تستهلك نفسها بمقدار استهلاكنا لها. فكل لذة مشبعة تترك مكانها لأخرى غير مشبعة، كما يوضح شوبنهاور، لتولد بانطفائها ألما بالغا، فتتحول إلى حياة ملؤها الإدمان والاكتئاب والعزلة والانتحار والأمراض الجنسية، في احتفالية كبيرة بمشهد الجنس. وهذا ما نبهت إليه الباحثة والطبيبة الأميركية ميريام غروسمان، في كتاب بعنوان «الإباحية ليست حلا، أجيال في خطر»، حيث أشارت إلى أن حياة الجنس قد أصبحت تجد آيديولوجيا متكاملة، بعيدة كل البعد عن العلمية، تغذي تمثل الشباب الأميركي للجنس، الذي أضحى أكثر إصابة بالمشاكل النفسية الخطيرة، بسبب الغرق في الاستقلالية، وطغيان الهوية الجنسية والعلاقات، وزمالة السكن، في غياب حس أخلاقي يقاوم ذلك. وهي ظاهرة لا تمس الشباب الأميركي فقط، بل أصبحت ظاهرة عامة.
* السعادة وحضن الجماعة
ارتبطت السعادة في الكثير من المرجعيات الفلسفية، بالإنسان في علاقاته بالآخرين، وقدرته على الأخذ والعطاء، حيث يحصل الفرد على العطف والحنان، وينعم بدفء الجماعة. هنا يمكن أن نعود إلى العقيدة البوذية التي لا تتحقق عندها السعادة إلا للسعادة داخل جماعة «السانغا». فالسعادة الفردية غير موجودة في الواقع. لكن في مقابل ذلك، يلوح عندي التأمل الأليم الذي يورده الفيلسوف الفرنسي غاستون بيرجي، في كتابه من «القريب إلى الشبيه»، عندما أبرز بأن قدر الإنسان هو أن يكون وحيدا، أن يحيا لوحده ويتأمل لوحده، محكوم عليه بأن لا يشبع أبدا رغبته في التواصل. قدرنا هو أن نعيش معزولين أكثر من أن نعيش وحيدين. وبالتالي، فعزلتنا تبقى مستمرة مهما انخرطنا في الجماعة. لأن أي تواصل بيننا يبقى ناقصا، إن لم نقل معدوما، بتعبير بيرجي، دائما. ألم يقل الدالاي لاما، في كتابه الصادر أخيرا: «فن السعادة» «The art of happiness»، إنه إذا أردنا أن نكون سعداء، فلنبتعد عن الزواج وإنجاب الأولاد؟ ذلك أن ارتباطنا الشديد بهم، سيجعلنا بعيدين عن السعادة في حال فقدان فرد منهم. فحياة العزلة، هي الوحيدة التي يمكن أن تجعلنا سعداء. بذلك فحضن الجماعة قد يكون سبيلا نحو السعادة، بقدر ما قد يصبح طريقا نحو الجحيم.
* السعادة من منظور طبي
انخرط مجال الطب بدوره، في سباق محموم نحو جعل الإنسان أكثر سعادة. فبحث في أعماق وعي الإنسان عن الموصلات العصبية المتحكمة في السعادة، وحاول اكتشاف كيميائها، كما بحث أجدادنا عن الوصفة الذهبية لكيمياء الذهب، ولكنهم لم يعثروا على أي شيء. ما الذي يقدمه الطب عن السعادة؟
يقول الطب الدماغي، بأن هناك جزيئات موجودة في المخ تلعب دورا مهما في توازننا الشخصي. وهي تضطرب بسبب سوء التغذية وتدفق العواطف، وكذا نقص النوم، حيث إن الدوبامين، وهو عبارة عن مادة كيميائية، تساعد على التحفيز والتذكر. في حين أن مواد أخرى كالسيروتونين، تتسبب في الراحة واستقرار المزاج والإبداع والمرح. إلا أن هذه الكيمياءات جميعها، تظل سيفا ذا حدين. فهي يمكن أن تؤدي وظيفتها بشكل مبهر في حالة توازنها، لكن إذا اختل هذا التوازن لأي سبب من الأسباب، فإنها تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث تبرز مشاعر العصبية ونقص الثقة بالنفس، بالإضافة إلى الرعب المرضي والكدر والاكتئاب. ما يعني أن توازن هذا النظام يبقى مرتبطا بتصرفاتنا وتغذيتنا وطرق حياتنا. ومن ثم فالطب، وإن وضح الصيرورة الدماغية لحدوث السعادة، فإنه لا يرينا الطريق الملكي كي نكون سعداء. أما الطب النفسي، الذي صار يقدم تمارين مهمة جدا في تحصيل الهدوء والطمأنينة، ويحقق نتائج مبهرة في ذلك، فهو بتركيزه على الذات، لا يوفق في منحنا السعادة المأمولة، لأن هذه الذات، تعيش داخل صيرورة اجتماعية وسياسية لا بد أن تؤثر في سعادتنا بشكل أو بآخر.
لا بد أن الدروب الملتوية للسعادة، قادرة على أن تزرع في أنفسنا الشك والارتياب. فهل السعادة موجودة بالفعل أم محض وهم؟ هل يجب أن نتوقف عن السعي خلفها؟ بالتأكيد يظل مبحث السعادة جديرا بالاهتمام لأنه يمس كينونة الإنسان. ورغم أن هذا المبحث هو أقرب إلى الميتافيزيقا، فإنه مع ذلك، يظل في ارتباط بالواقع. ويمكن أن تكون السعادة بعيدة عنا يصعب الإمساك بها، إلا أن إحساسنا وتفاؤلنا بقربها منا، هو الذي يغذي هذه الرغبة الدفينة، في نيل تلك البهجة العظيمة.
* أستاذ الفلسفة - المغرب