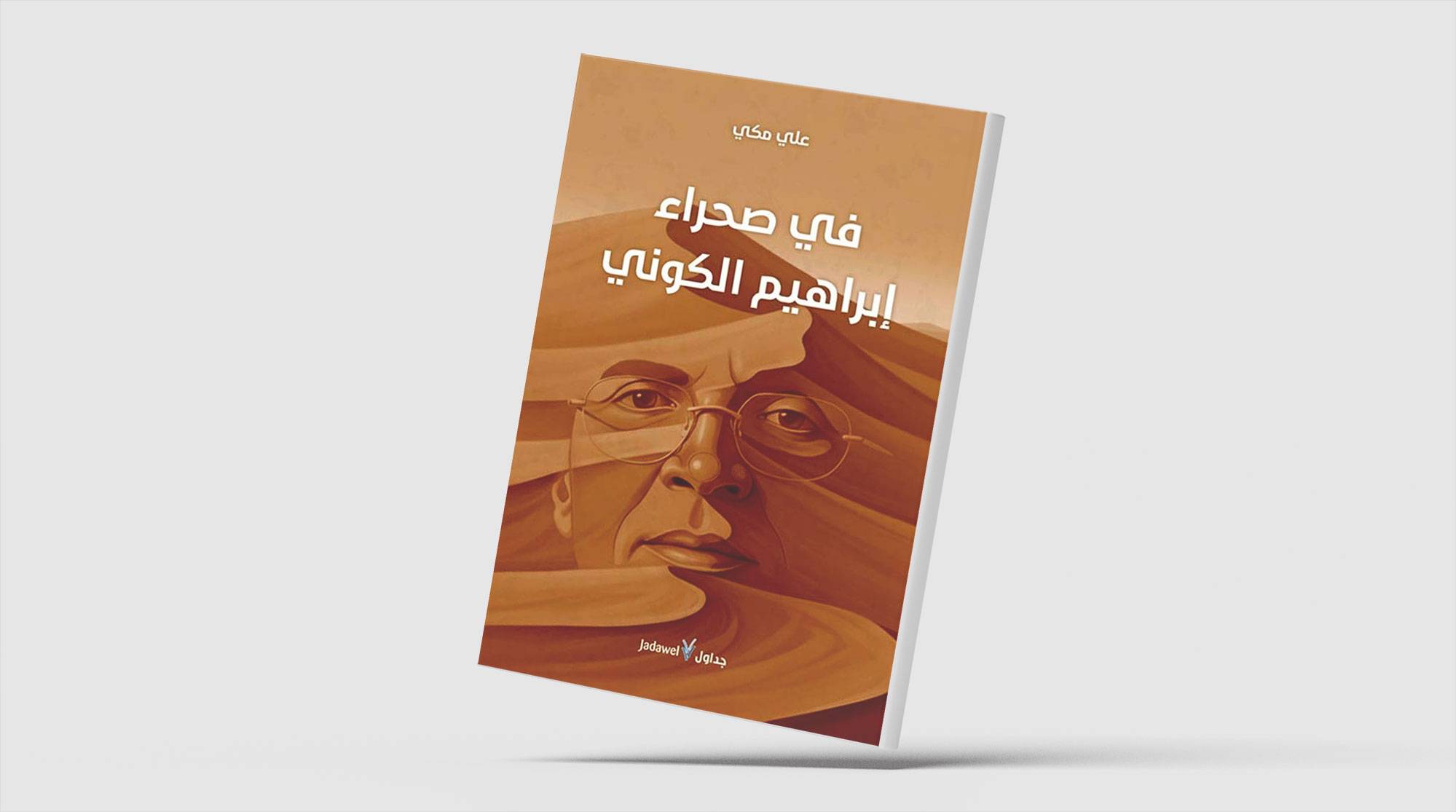* في رواية «قصة موت معلن» لماركيز، يشحن الأخوان بابلو وبيدرو فيكاريو سكاكينهما على الملأ، استعدادا لذبح سنتياغو نصار، انتصارا لشرف العائلة، ولكن لا أحد من الشهود يحذر الضحية من سكين الجزار. أما قصة القصف في رواية «قبل الحب... بعد الحب» فمعلنة، لكن الضحايا مجهولون، ثم إن الكثيرين حذروا الضحايا من سكين الجزار.
يشكر الشاب وصفي، التلميذ في المدرسة الثانوية، الحرب، ويشكر القصف الإيراني على البصرة، لأنهما أتاحا له أن يحيا أولى مغامراته العاطفية. وهذه المفارقة الاجتماعية - النفسية عن الحب والحرب، ليست المفارقة الوحيدة التي يسجلها محمود سعيد في روايته «قبل الحب... بعد الحب» عن المجتمع العراقي إبان التمشيط المدفعي المنظم والمتبادل للأحياء السكنية من قبل طرفي الحرب العبثية المذكورة. وربما سيجد الباحثون الاجتماعيون في رواية محمود سعيد عونا في دراسة أحوال المجتمع العراقي في ثمانينات القرن العشرين، لأنه يشرح بمبضعه، من خلال متابعة مصائر شخصياته، مثل أي جراح بارع، الوضع الاجتماعي والنفسي القائم آنذاك، ويكشف لنا كيف يجتمع شمل عنصري الرعب والعبث ليتلاعبا بمصائر ملايين العراقيين.
وتبدو رواية «قبل الحب... بعد الحب»، لصاحب «زنقة بن بركة»، أقرب إلى قصة «قصف معلن»، تجري أحداثها في أحد أحياء البصرة السكنية في العام الأخير من حرب الثماني سنوات، إذ يبقى القارئ بانتظار سقوط القذائف والصواريخ الإيرانية على الحي الذي تسكنه عائلة «أبو وصفي». بيد أن الكاتب، وبحبكة تشويق رائعة، لا يخط أسماء ضحاياه عليها إلا في نهاية الرواية، ويبقينا أسرى «الخوف والحب» حتى اللحظة الأخيرة.
يشعر القارئ، ومن خلال السرد التفصيلي الدقيق للأحداث، بأن محمود سعيد يروي لنا معايشته الشخصية للحدث، سواء من خلال الجندي الهارب الذي يساعده «أبو وصفي»، مجازفا بحياته وحياة عائلته، في النجاة من مطارديه، أو من خلال شخصيات الرواية التي يكاد القارئ يشعر بأنه قابل أمثالها في القصف على البصرة، أو في القصف على بيروت، أـو قابلها في ملجأ ما تحت الأرض في كابل. وتنطبق هذه الحال على الابن وصفي، وعلى طفل الجيران الفقير أمير، الذي تسكن عائلته الكوخ (الصريفة)، وعلى الضابط السكير الذي بلغ يأسه، بل ورعبه أيضا، مبلغ شتم النظام في الشارع على الملأ. هي شخصيات يجمعها الرعب من القصف، من الإعدام على أيدي النظام الحاكم، والخشية من مستقبل بلا مستقبل.
والقصف على الحي معلن، وهو حي مخصص لسكن الضباط، وهو ما يدفع معظم العائلات إلى الهروب من الحي باتجاه أحياء آمنة أخرى، أو إلى مدن أخرى، لكن بعض العوائل، ومنها عائلة أبو وصفي، تختار البقاء والاستسلام لمصيرها في حالة عبثية لا تنشأ إلا عندما يصادف الإنسان الموت في كل منعطف وتحت أي شجرة. تعجز عائلة أبو وصفي عن الرحيل بسب ديونها المتراكمة وانعدام القدرة على تمويل رحلة وبيت جديد، وتختار عائلة «أبو أمير» نقل الصريفة إلى غرب دار السيد جليل المهجورة بغية اتخاذها متراسا ضد القصف الإيراني القادم من الشرق. أما الضابط البعثي «أبو سحر»، الذي رسم سيناريو «القصف المعلن»، فيعلق حياة ابنته الشابة الجميلة سحر بمتانة الملجأ الكونكريتي الذي بناه بسمك متر تحت منزله.
في رواية «قصة موت معلن» لماركيز، يشحن الأخوان بابلو وبيدرو فيكاريو سكاكينهما على الملأ، استعدادا لذبح سنتياغو نصار، انتصارا لشرف العائلة، ولكن لا أحد من الشهود يحذر الضحية من سكين الجزار. وقصة القصف في رواية «قبل الحب... بعد الحب» معلنة، لكن ما يفرقها عن قصة ماركيز هو أن الضحايا مجهولون، ثم إن الكثيرين حذروا الضحايا من سكين الجزار. يزيت الإيرانيون مدافعهم بعيدة المدى، و«يشحذون» راجماتهم، انتقاما لقصف حي الضباط السكني الإيراني في الأهواز من قبل القوات العراقية. وهو القصف التحريضي الذي خطط له «أبو سحر» عربون «صموده» في الحي، رغم القصف المعلن، وهروب بقية الضباط، بهدف الحصول على وسام شرف وترقية عسكرية وحزبية. واختار «أبو سحر» يوم 6 يناير (كانون الثاني)، عيد تأسيس الجيش العراقي، لتحقيق هذه المنقبة، إذ كان «السيناريو» معروفا من قبل الجميع، في إيران والعراق، وحالما يقصف الطرف الأول حيا للمعلمين في الدولة المقابلة، يجيبه الطرف الثاني في اليوم التالي بقصف حي المعلمين المقابل. وهكذا دواليك، كان الطرفان يمشطان الأحياء السكنية في البلدين يوميا في حرب، تبث إذاعات الطرفين أهدافها مسبقا.
كان الضابط السكير «نايف»، بعينيه الحمراوين، أول من حذر أبو وصفي من القصف المقبل للحي الذي يسكنونه. تلاه بعد ذلك تحذير العميد أبو فراس، صديق أبو وصفي، ومن ثم جاء التحذير على لسان الطبيب العسكري الصديق «أبو ثامر» الذي تحدث عن «الدائرة الحمراء» التي رسمها أبو سحر حول موقع حي الضباط في الأهواز.
ونجد أن الشاب وصفي، وابن الجيران أمير، الطفل لامع الذكاء، تعايشا مع الحرب إلى حد أنهما صارا يتراهنان، من صوت صفير القذيفة، على تحديد نوعها وحجمها، ويتذاكيان بعضهما على بعض في القدرة على تحديد إحداثيات القصف وموقع سقوط القذيفة في البصرة. وإذا كان وصفي يحدد سقوط القنبلة قرب السوق في حي الجمهورية، فإن أمير يحدد مسار القذيفة مسبقا وهي تشق طريقها إلى أشلاء الناس في بهو البلدية بنفس الحي.
يلعب أمير دور «الوسيط» في قصة الحب التي تنشأ بين وصفي وسحر، وينقل، بكل طيبة خاطر، الرسائل المتبادلة بين الحبيبين مستغلا صغر سنه وعدم خشية «أبو سحر» منه على ابنته. وهي قصة حب تبدأ أساسا بسبب ولع وصفي بتحديد إحداثيات القذائف من فوق سطح بيتهم. إذ يترصد الشاب الفتاة يوميا، وهي «تسبح» في ضوء الشمس الشتوية، ويكتشف لاحقا أنها تعرف بذلك، بل وأنها رصدته أيضا رغم كل احتياطاته، وأنها تستجيب إلى مشاعره.
يتعمد محمود سعيد، وهو يشوقنا بقصة الحب الطفولية، والموعد الأول بين الحبيبين، الذي يرتبه أمير في دار السيد جليل الخالية، أن يجعلنا ننسى القصف الوشيك. ومع اقتراب لقاء الحبيبين، وارتفاع وتيرة الشوق واللهفة، ينسى أطراف قصة الحب الثلاثة القصف أيضا. بل تفاجئ القذيفة الأولى وصفي، العاشق الولهان، والخبير في إحداثيات القصف، فتسقط قربه دون أن يشعر بصفيرها أو يتمكن من تحديد هدفها. يصم الانفجار أذنيه، لكنه يخرج سليما منه، ولا يشغل باله لحظة ذاك غير مصير حبيبته سحر، وصديقه الصغير أمير، بعد أن استعاد توازنه، وقدر أن القذيفة الثانية تتجه إلى مكان اللقاء الأول الذي سبقه إليه أمير وسحر. وحسب وصفي، ثلاثون قذيفة سقطت في الحي شبه الفارغ من سكانه، لكنه عجز عن حساب عدد أشلاء أمير وأشلاء سحر التي جرفها الحب خارج ملجأ أبيها لحظة القصف.
وبين قصة القصف المعلن، والحب الخفي، يسرد لنا محمود سعيد جوانب أخرى من سيكولوجيا مجتمع الحرب من خلال قصة الشابة هناء، الحامل من حبيبها «جبوري» الذي وعدها بالزواج، ثم سقط شهيدا في الحرب. ثم يقص علينا ما لا يمكن للمرء تصور حدوثه في مجتمع بلا حرب، ولكن ما يمكن تصور حدوثه بالتأكيد في ظل القصف اليومي، والموت اليومي في مجتمع الحرب. يقرر وصفي وأصدقاؤه، وخلال أجواء الحرب والقصف اليومي، زيارة «حي الطرب» بالبصرة، وهو حي الغناء والفرفشة يقيمه الغجر في ضواحي مدينة البصرة. لكنهم يجدون الحي خاليا، لأن «القيادة السياسية» نقلت كل الراقصات إلى قصور أعضائها للتخفيف عنهم. هو الرعب من الموت حد العبث، يدفع الشبان إلى البحث عن المتعة بين أشلاء مجتمع الحرب، وهو نفس الرعب الذي يقض مضاجع القادة السياسيين، ويجمع شملهم داخل حالة رعب شمولية. ويصف الكاتب هنا منحى آخر اعتمده البصريون في أيام القصف اليومي، وهو قتل الرعب من الموت بالكحول. وربما يمثل العقيد السكير نايف، الذي بلغ مرحلة الاستخفاف بالموت، هذا المنحى في سيكولوجية المجتمع البصري خلال الحرب.
يجري إجهاض هناء في نفس ساعات القصف الذي قتل سحر وأمير، وسقطت القذائف في بيت السيد الجليل، الذي كان مسرحا لقصة الحب، والمخبأ المناسب للجندي الهارب الذي ساعده أبو وصفي على الاختفاء. وعندما التقيت محمود سعيد في كولون قبل فترة وجيزة قال إنه، في زيارته الأخيرة للبصرة، بحث عن الجندي المذكور، وعرف أين يعمل، لكن الجندي رفض استقباله والحديث إليه. علما بأن الانضباط العسكري، حسب الرواية، ألقى القبض على الجندي، وجرى تعذيبه بشكل بشع، لكنه لم يعترف باسم الشخص الذي ساعده على الاختفاء.
لم تختلف الحرب قبل الحب عنها بعد الحب، لكن أبرز ضحاياها كان الحب قبل كل شيء، ثم كان الطفولة والجيل الصاعد مجسدا بالعبقري الصغير أمير (12 سنة)، ومقتل الجميلة سحر أنظف ما في بيت الضابط اللئيم والحزبي البغيض «أبو سحر».
صدرت الرواية عن «دار المدى» بالقطع المتوسط وفي 211 صفحة. حمل الغلاف لوحة للفنان التشكيلي العراقي جبر علوان.