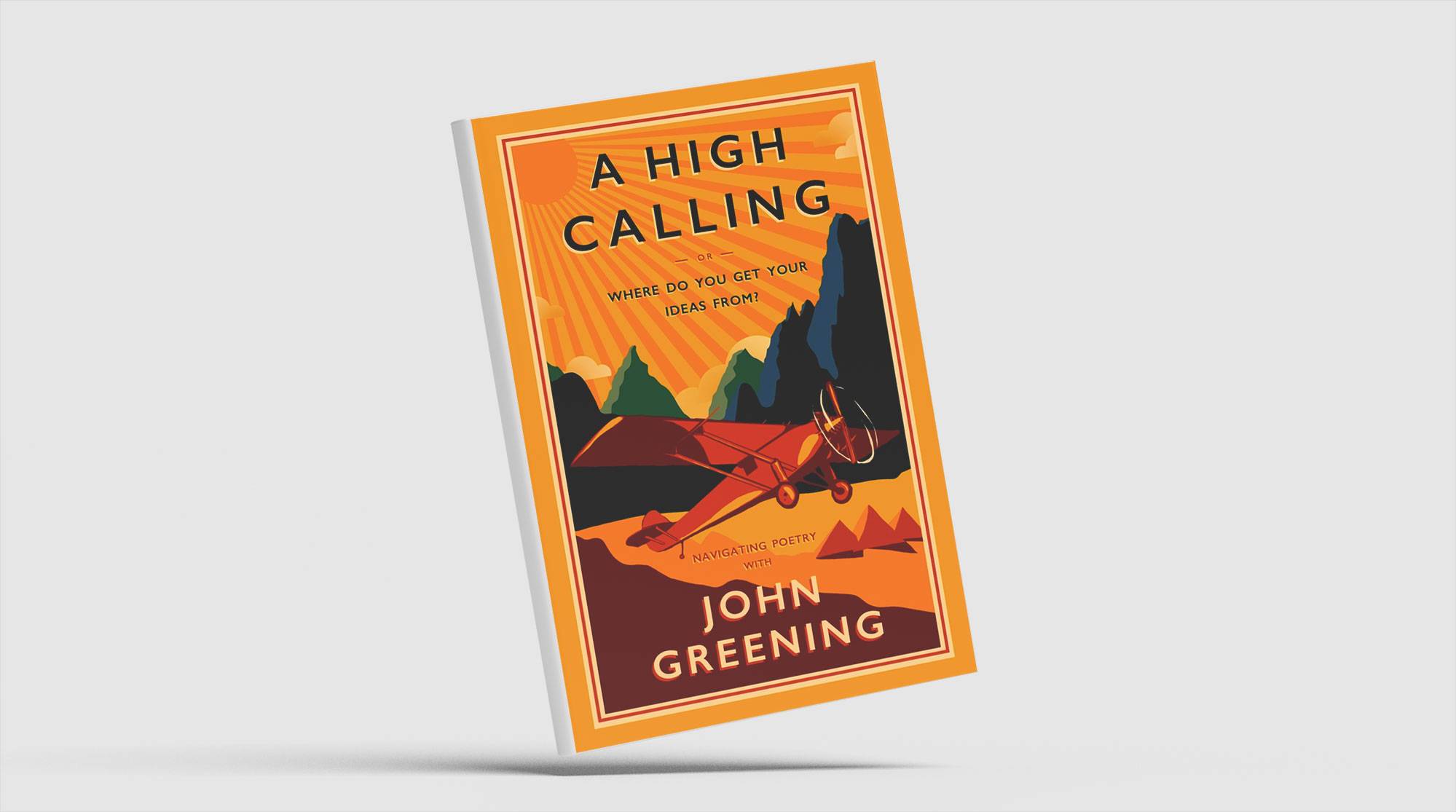استرعاني موضوع الهوية مند زمن بعيد. وحاولت أن أكتب فيه بطريقة تحليلية بسيطة وهادفة، بحيث تكون الرسالة واضحة، في موضوع متشعب تحدث عنه الفلاسفة الوجوديون والمثاليون على حد سواء. وتدرجت في الكتابات حول الموضوع، عند نخبة من المفكرين والباحثين من الشرق والغرب، من حسن حنفي، إلى أدونيس، مرورًا بطه عبد الرحمن، وصولا إلى أمارثيا صن وبول ريكور. ولكنني لم أستقر إلا عند الكاتب والصحافي اللبناني، أمين معلوف، في مؤلفه المعنون بـ«الهويات القاتلة».
يدخلنا معلوف، الجامع لثقافتي الشرق والغرب، الذي نصب نفسه جسرًا بين الثقافة العربية، ونظيرتها الفرنكفونية، وصاحب «التائهون»، و«اختلال العالم»، مباشرة إلى صلب الموضوع، والغاية الأساسية التي يثيرها عصرنا، من كل بحث في موضوع الهوية. وهو أن يتجه رأسا إلى الهوية في ارتباطها بالعنف والتدمير. كيف يمكن أن تصبح كل الصراعات السائدة في هذا العالم، مرتبطة بمواضيع حول الهوية؟ لماذا أصبحت الهوية تحمل كل هذا الخطر؟ ولماذا صارت منفلتة من كل سيطرة؟ لماذا أصبحت الهويات قاتلة؟
مر على صدور هذا الكتاب، المتجاوز للهويات، سبعة عشر سنة، وما زال تحليله هذا وافيا كأن الكتاب قد كتب البارحة. حيث لا تزال الهويات إلى اليوم، قاتلة بالفعل. بل وأكثر من أي وقت مضى. فقررت ألا أضيف أي شيء، وأن أقدم قراءة في الكتاب كما هو. وأن أسافر في لغته التي يختلط فيها الأدب بالفلسفة والفن، وفي أفكاره التي يختلط فيها العلم بالتاريخ بالفلسفة، وفي أحاسيس الكاتب المتقاطعة بين الحزن والألم والأمل، على واقع أصبح فيه الإنسان عبارة عن طاقة انفجارية كبرى، لأسباب ترتبط بالهوية التي تحولت إلى وقود سريع الاشتعال، تكفي شرارة واحدة، لتحترق الأوطان، ويضيع الإنسان.
الهوية مفهوم متعدد. فلا فرد إلا وتتشكل هويته من أشياء وخصائص شتى: الدين، والعرق، واللغة، والإثنية، والأهداف، والقناعات، والطموحات، والتاريخ، وغير ذلك كثير جدا. فما الذي يحدد هويتك إذن؟ تحدده كل هذه الأشياء. كما أنك في الوقت نفسه، عنصر فريد واحد لا يمكن استبداله. فنظرة واحدة للذات، تؤكد أنني كوكب مستقل مغلق لا أشبه أي أحد آخر. لكن هذا لا يعني بأن الهوية بناء وحيد ونهائي. بل هو بناء لين قابل للتطور والتغير والتمدد. أما التهجين فلا يأتي إلا من المجتمع. فهو الذي يجعل هذه الهوية قاتلة، بسبب تربيتنا على الأعراف والعقائد، وانغراس الجراح فينا، إلى جانب الأحقاد والإهانات التي لا تنسى، وتظل تتحين الفرصة للانفجار. ويختزل كل ذلك التنوع المميز للهوية، في موقف واحد ونهائي، أساسه اللغة، أو الدين، أو العرق، بشكل مذهبي متسلط. فيتذكر المرء والجماعة آنذاك، جراحاتهم الدفينة والمنسية. وينطلقون نحو الثأر من أصدقاء الأمس أعداء اليوم. ويتوارى ذلك الإيمان بالاختلاف الذي نردده وقت السلم، ليجري اتهام من ليسوا في الجبهة نفسها، بالخيانة والمروق. هنا تصبح الهويات قاتلة، خاصة لما يظهر من بين هؤلاء، قادة انتحاريون. فكم هي كثيرة الجماعات الجريحة التي لا تزال تتحين الفرصة من أجل الثأر. آنذاك يصبح الناس سفاحين من دون أن يدروا. ويستيقظ الجميع ملقين باللائمة على الدين والعقيدة: الإسلام أو اليهودية أو المسيحية، باعتبار أن الدين، هو الدافع الأساسي نحو العنف. وعلى الرغم من أن العقيدة ليست غريبة عن هذه الأحداث، فإنه لا ينبغي لنا اتهامها. فلقد بين القرن الماضي، أن كل العقائد تظل أياديها ملطخة بالدماء. وأسوأ مآسي القرن العشرين جاءت من أطروحات لا دينية. فلا أحد يحتكر التعصب، ولا أحد يحتكر الإنسانية. أما الحركات المتطرفة التي تنصب نفسها متكلمة باسم الدين والدفاع عن الهوية، فهي نتاج عصرنا وتوتراته وانحرافاته وخيباته. حيث يتوجب أن نقلب التحليل من تأثير الدين على الشعوب، إلى تأثير الشعوب على الدين. فنحن ندين مع أجدادنا بالعقيدة نفسها. لكن يجب أن نعلم أن ممارساتنا في الدين اليوم، إذا ما قيست بمعايير الأجداد لاعتبرت شعوذة وبدعًا. لأننا نظل أبناء عصرنا أكثر من أن نكون أبناء أجدادنا. وبالتالي يظل كل اتهام للعقيدة، وكل دفاع عن الهوية باسم العقيدة، مجرد كلام لا معنى له، بل إن ذلك هو الجنون القاتل.
إن هذه النظرة التي تحدد الهوية، من وجهة نظر عقدية دينية، ليست إلا حالة عارضة تميز عصرنا. فلماذا أضحت الهوية تختزل فقط في الدين؟ ولماذا تتنافى كل المحددات الأخرى ولا يظهر إلا الدين؟ يرجع ذلك بشكل كبير، إلى الحداثة التي جرحت الكثير من الشعوب، ومن بينها الشعوب المسلمة. حيث أصبحنا نعيش الإحباط والخيبة والإهانة في كل خطوة نخطوها. مما مزق هويتنا، وجعلنا نشعر بأننا في عالم ليس عالمنا. عالم يمتلكه الآخرون ويخضع لقواعدهم. فولد هذا في أنفسنا، ذلك اليأس الذي لا نخرج منه إلا عن طريق العنف الإنتحاري. وعلى الرغم من كل عمليات الإصلاح التي قام بها العالم العربي، فإنه لم يكتب لنا النجاح، بسبب الغرب ذاته الذي كان يقف دائما حجر عثرة. وفهمنا بلغة بليغة أن الغرب لا يريد أن يشبهه أحد، ويريد فقط أن نطيعه. فأصبحنا ننظر للغرب باعتباره حصان طروادة، ونبحث لنا عن ملجأ للاختباء. هذا الإحساس هو الذي سيساهم بشكل كبير، في بعث الفكر الديني من جديد، خاصة مند خمسينات القرن الماضي. وقد عززه سقوط الشيوعية وتناقضات النموذج الغربي على الرغم من انتصاراته، وخسارة القومية الماركسية، وفشل الوطن والعرق والطبقة، في تعويض الانتماء الديني وإغراءاته. فعندما يرى المجتمع في الحداثة يدا غريبة، فهو يميل إلى رفضها وحماية نفسه منها. مما يولد رفضا قاطعا وساخطا وانتحاريا كردة فعل. هي قوة الدين وإغراءاته وقدرته على احتضان الإنسان وتقديم البدائل، ولو كان ذلك مجرد وهم. هنا أصبح المسلم الفرنسي ذي الأصول العربية، يقدم انتماءه الديني على انتمائه الفرنسي. وأصبح اليهودي ذي الأصول الألمانية، يقدم انتماءه الديني على انتمائه الألماني. فالدين حماية وحصن وأمان، اتجاه تهديدات العولمة والخوف من تمزق الهوية. وهو ملاذ وطريق يحمينا من التيه، بعدما أصبحنا نحس بأن كل العالم معرض عنا. وبالتالي فإن كل عدم فهم لهذه المعطيات، يمكن أن يأتي بنتائج كارثية. فنتجه إلى غير الأسباب. ونتهم الجماعة ونحاربها ونزيد في أحقادها وجراحاتها. آنذاك نحن نطفئ النار بوقود قابل للاشتعال.
لا يمكن تجاوز خطر الهوية إلا عن طريق خلق تبادل عادل بين الشعوب، واحترام لغاتها وعاداتها وثقافاتها، بحيث لا يشعر أحد أنه مهدد أو محتقر، إلى درجة أن يكون مضطرا لأن يواري بخجل ديانته أو لونه أو لغته. وكذلك ضبط العولمة الحالية في اتجاه واحد، لأن العالم للجميع وليس لعرق بعينه أو قومية، بحيث لا يشعر أي إنسان بنفسه مستبعدًا عن الحضارة المشتركة التي تبصر النور، والعمل بقوة على فضح عيوب العالم وتعدياته ومظالمه وانحرافاته القاتلة، والتمكن من آليات المواجهة من أجل البقاء على قيد الحياة. كما أنه يجب على الشعوب المسحوقة أن تعرف كذلك، بأن العولمة لم تعد أداة لخدمة نظام واحد ونهائي. بل أصبحت بمثابة معركة تجري فيها ألف مبارزة ومبارزة. حيث يمكن لكل فرد أن يدخل إليها مزودا بشعاراته وأسلحته. ولنأخذ الإنترنت مثالاً على ذلك. فهو على الرغم من أنه يحمل الشعار الأميركي ويسوقه، فإننا بواسطته أصبحنا نعرف العالم كما لم نعرفه من قبل. وتعرفنا على ثقافات أخرى لم نكن نحلم أن نعرفها يوما. وتأتينا النماذج كل يوم، لتؤكد أن الذين يقاتلون ضد الجوع والطغيان، قادرون على كسب المعركة. حيث يمكن لأي فكرة مهما كانت شاذة أن تصبح مقبولة. كما أنه يتوجب علينا دائما العمل على القيام بفحص دقيق لهوياتنا مع الآخرين، من أجل رؤية التشابهات، وليس دائما الانحرافات. فنظرتنا هي التي غالبًا ما تسجن الآخرين داخل انتماءاتهم الضيقة. ونظرتنا كذلك، هي التي تحررهم. فالمؤمن الحقيقي، هو المؤمن ببعض القيم التي يمكن تلخيصها في كرامة الإنسان. وما الباقي سوى خرافات أو أضغاث أحلام.
يختار أمين معلوف حيوان الفهد، ليماثل بينه وبين الهوية. الفهد يقتل إذا طاردناه، ويقتل إذا تركناه طليقا. والأسوأ أن نتركه في الطبيعة بعد أن نكون قد جرحناه. لكننا نستطيع أن نروض الفهد. مما يعني أنه لا يجب أن تعالج الهوية بالاضطهاد والتواطؤ. بل يجب تفحصها ودراستها بهدوء، وفهمها ثم السيطرة عليها وترويضها، إذا كنا لا نريد أن يتحول العالم إلى غابة. وإذا كنا نريد تجنب أن يصبح أطفالنا بعد خمسين عاما أو مائة عام مضطرين، أن يشهدوا مثلنا نحن العاجزين، المذابح وعمليات الطرد، وأن يخضعوا لها أحيانا، فلا بد من التماهي مع العالم الذي نحيا فيه، وفي الوقت نفسه، نتماهى مع عالمنا. يجب أن ندرك بأن هويتنا هي حصيلة انتماءات مختلفة، بدلا من اختزالها إلى انتماء واحد ينصب أداة استعباد وحرب.
أمين معلوف و{الهويات القاتلة}
انتماءات مختلفة يجب ألا تختزل بواحد يصبح أداة استعباد وحرب

غلاف «الهويات القاتلة»

أمين معلوف و{الهويات القاتلة}

غلاف «الهويات القاتلة»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة