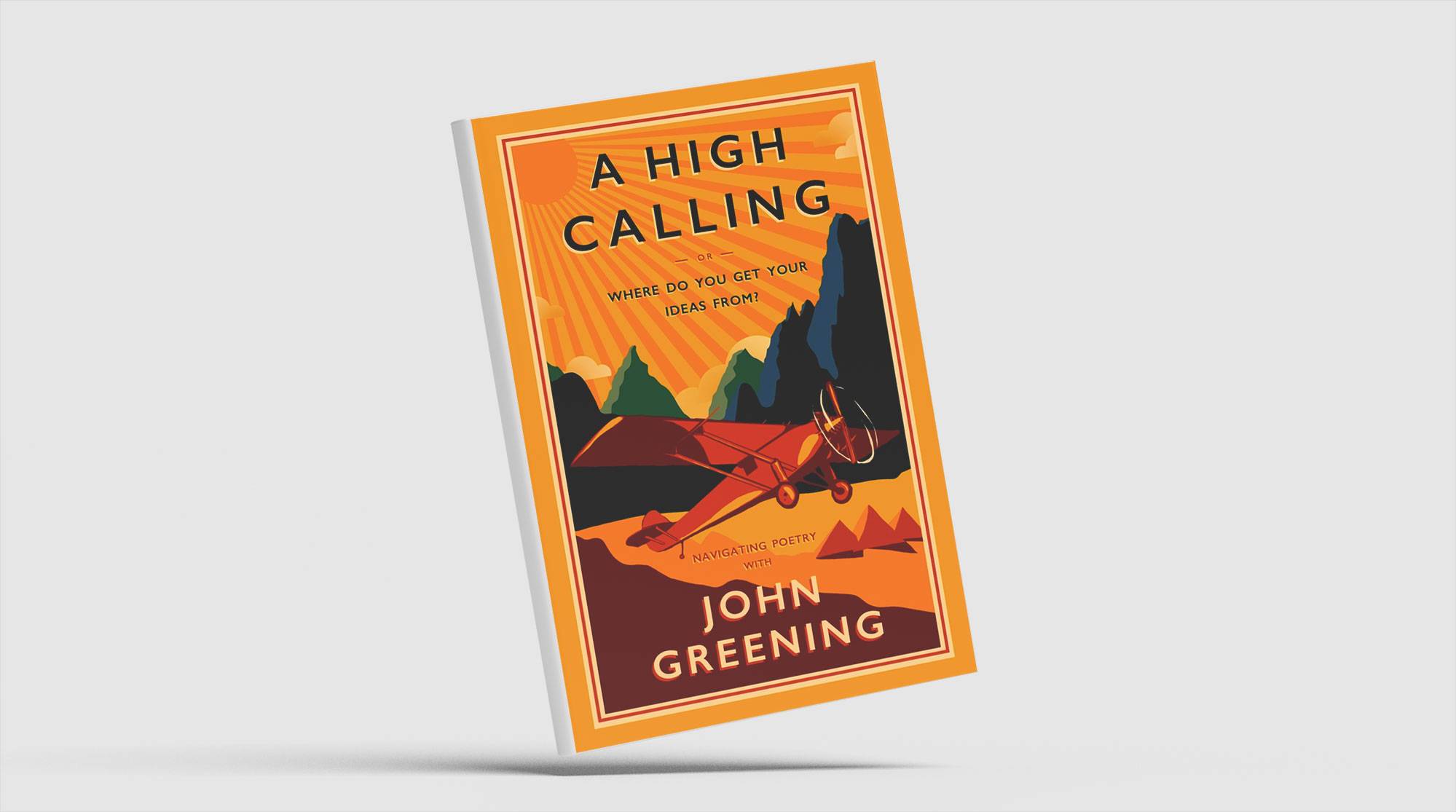في عام 49 قبل الميلاد، كتب الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر أول مذكرات شخصية: «تعليق على حروب بلاد الغال» (غرب فرنسا)، التي كان يقودها لزيادة توسعات الإمبراطورية الرومانية. لكن كانت هذه المذكرات مزيجا من أوامر عسكرية، وتعليقات خاصة وعامة. ولم تظهر المذكرات الشخصية بالمعنى المعروف حاليا إلا خلال عصر التنوير (بدا قبل خمسين عاما تقريبا من الثورة الفرنسية عام 1789).
في الولايات المتحدة، في عام 1854، كتب الفيلسوف هنري ثورو مذكرات تظل واحدة من أشهر المذكرات الشخصية الأميركية: «والدن: حياة وسط الأشجار»، (إشارة إلى بحيرة والدن، في ولاية ماساتشوستس). اشتهرت المذكرات بسبب كاتبها، وبسبب أسلوبه السلس، ولأن جزءا كبيرا منها عن الحياة الطبيعية (لا عن منافسات انتخابية، أو سياسية، أو تجارية).
كتب «قررت أن أعيش وسط هذه الأشجار الطويلة لأني أريد أن أعيش حياة حرة وبسيطة. أريد أن أستمتع بممتلكات ضرورية لا ممتلكات ترفيهية، بحياتي وحيدا لا حياتي منعزلا، بما أنتج، لا بما يعطيني آخرون».
خلال القرن العشرين، اشتهرت مذكرات شخصية عن الحربين العالميتين الأولى والثانية. وعن الحياة تحت حكم أدولف هتلر النازي في ألمانيا، وحكم بنيتو موسوليني الفاشستي في إيطاليا، منها مذكرات «الليل»، التي كتبها إيلي وزيل، اليهودي الذي نجا من الهولوكوست (ثم نال جائزة نوبل للسلام).
مع بداية القرن الحادي والعشرين، صار كل واحد تقريبا يكتب، أو يتمنى أن يكتب، مذكرات شخصية. ويعود ذلك إلى أسباب منها سهولة الكومبيوتر الكتابة، وتوفير الإنترنت مصادر سهلة، وفتح علم الوراثة لأضابير الآباء والأجداد، ثم ظهور المذكرات الإلكترونية. هذه محاسن، لكن توجد مساوئ، كما كتبت بولا بالزر، في كتابها: «كتابة وبيع مذكراتك: كيف تحسن تسجيل سيرة حياتك حتى يريد الناس، حقيقة، أن يقرأوها»، قالت فيه إنها ليست سعيدة لأن كتابة المذكرات لم تعد فنا وأدبا (مثل مذكرات هنري ثورو، أبو المذكرات الأميركية). وهي ترى أنها «صارت هوايات ومنافسات». وشنت هجوما عنيفا على مذكرات السياسيين، في حالتين:
أولا: مذكراتهم قبل أن يصلوا إلى الحكم (مثل مذكرات عدد كبير من المرشحين لرئاسة الجمهورية). وهذه، كما تقول «مذكرات انتخابية، حماسية وعاطفية».
ثانيا: مذكراتهم بعد أن الحكم (مثل مذكرات الرؤساء والوزراء)، التي «يفتخرون فيها بأشياء، ويخفون أشياء».
وكان الاتحاد الأميركي للمؤرخين الشخصيين (إيه بي إتش)، قد تأسس بداية القرن الواحد والعشرين بهدف «تشجيع تسجيل قصص الناس، والعائلات، والمجموعات حول العالم». وتقول بولا ستول، رئيسة الاتحاد: «ننصح الشباب بتدوين يومياتهم، وذلك لتساعدهم في كتابة مذكراتهم عندما يكبرون».
في نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، صدر كتاب: «لماذا نكتب عن أنفسنا: عشرون كتاب مذكرات يكتبون عن سبب نشر غسيلهم على الملأ». «ولكن هل هذا أدب؟ أو ترفيه؟ أو إباحية؟»، هذا هو سؤال ميريديث ماران، التي جمعت هذه السير الذاتية.
وهل نشر هؤلاء العشرون كل شيء في مذكراتهم؟
تقول بيرل كليغ (مؤلفة كتاب «حياة مثيرة») إنها فكرت في حذف علاقة غرامية مع رجل متزوج، لأن «الكتابة عن تفاصيل تلك العلاقة سيشوه سمعتي. لهذا، لم أكتب عنها بطريقة مثيرة، ولم أكتب تفاصيل. كتبتها في قالب فتاة جامعية تنمو، وتخطئ وتصيب، وتتعلم من أخطائها».
وقالت ساندرا لوه (مؤلفة كتاب «إلى أين؟») إنها مرت بنفس الوضع. وقالت: «كتبت بأني دمرت زواجي بسبب علاقة غرامية مع رجل آخر متزوج. قلت إنني كنت زوجة غير مسؤولة، دمرت زواجها بنفسها، ولا تلوم على هذا أي شخص غيرها».
من بين العشرين شخصا، قال نصفهم تقريبا إنهم كانوا يكتبون مذكرات شخصية منذ أن كانوا صغارا، وإن هذا ساعدهم في كتابة كتبهم. فذكرت كليغ أنها بدأت كتابة مذكراتها عندما كان عمرها عشرة أعوام، وفعلت كريستين (مؤلفة كتاب «الطبق الأزرق») الشيء نفسه.
في حالات كثيرة، كتب قسم من الكتاب مذكراته عندما كبر في السن. وقال آخرون إن كتابة مذكرات مثل الذهاب إلى عيادة طبيب نفسي أن «يطهر الشخص نفسه، مثل أن تواجه سلسلة مآسٍ، وتجبر نفسك على ألا تهرب منها»، كما قال ديفيد شيف (مؤلف كتاب «طفل جميل»).
وتذكر أدويدج دانتيكات (مؤلفة كتاب «أنا أموت»): «.. وكأني في عيادة طبيب نفسي، متمددا على كنبة، وناس غرباء يقفون حولي، يسمعون كل ما أقول».
ماذا عن نشر أشياء تؤذي زوجا، أو أما، أو أبا؟
تقول بات كونروي (مؤلفة كتاب «سانتيني الكبير») إنها كتبت عن أخواتها أشياء خاصة أغضبتهن، فقاطعنها كلهن. وتعترف داني شابيرو (مؤلفة كتاب «سنوات والدتي») بأن والدتها قاطعتها حتى توفيت. وكانت قد وصفت والدتها بأنها «امرأة قاسية».
14:31 دقيقه
الذين يكتبون مذكراتهم.. صادقون أم كاذبون؟
https://aawsat.com/home/article/568066/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%9F



الذين يكتبون مذكراتهم.. صادقون أم كاذبون؟
يوليوس قيصر أول من كتبها

هنري ثورو - غلاف الكتاب - يوليوس قيصر
- واشنطن: محمد علي صالح
- واشنطن: محمد علي صالح

الذين يكتبون مذكراتهم.. صادقون أم كاذبون؟

هنري ثورو - غلاف الكتاب - يوليوس قيصر
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة