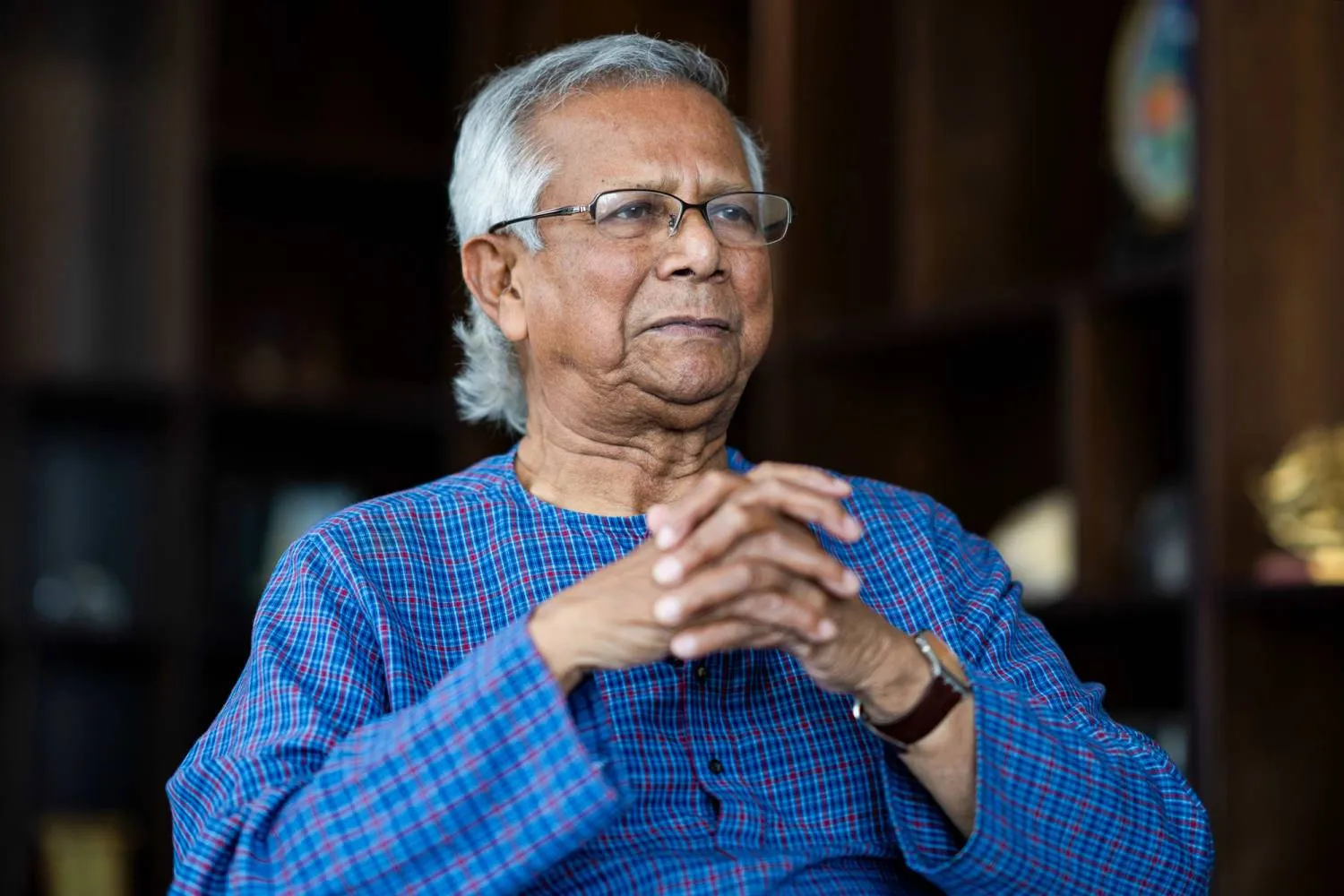المجازر البشعة التي ارتكبتها ميليشيات متطرّفة تدعمها إيران بحق مواطنين من المسلمين السنة في مدينة المقدادية بمحافظة ديالى العراقية، في أعقاب تفجيرات استهدفت عددا من المساجد السنّية ادعى تنظيم داعش مسؤوليته عنها، سلطت الضوء على المحنة التي تعيشها محافظة ديالى المختلطة عرقيًا وطائفيًا. ويرى المراقبون أن ما حدث ويحدث وسيحدث، في هذه المحافظة بالذات، من شأنه إعطاء فكرة عنى مسار الأمور في «عراق ما بعد 2003»، وما إذا كان الكيان العراقي الذي أبصر النور في مطلع عشرينات القرن الماضي ما زال قابلاً للحياة أم لا.
في محافظة ديالى الواقعة شرق مدينة بغداد العاصمة بمسافة لا تزيد على الـ57 كلم يتصارع التاريخ والجغرافية على نحو فريد، الأمر الذي خلق أحد أكثر صراعات الهوية في هذا البلد المختلف على هويته الوطنية بعد سقوط الدولة العراقية المركزية يوم التاسع من أبريل (نيسان) عام 2003.
ورغم أن إشكالية الهوية الوطنية طغت على ما عداها من إشكاليات كبرى في «عراق ما بعد الاحتلال»، فإن المحافظات المختلطة سكانيا على صعيد عرقي (عرب - أكراد - تركمان) مثل كركوك، أو عرقي - طائفي (عرب - أكراد - شيعة - سنة) مثل ديالى، دفعت ولا تزال وربما سوف تبقى تدفع، ثمنا باهظا لهذا لاختلاط أو التنوّع.
هذا الاختلاط تحوّل من نموذج كان يحتذى به طوال عمر الدولة العراقية الحديثة (1921 - 2003) بحيث كانت التسمية الدارجة لها هي أنها «عراق مصغر» إلى عبرة مؤلمة ونموذج للنزاعات السياسية العميقة. فهناك خلاف كبير حول «العائدية» (أي لمن تعود) بالنسبة لكركوك المحكومة كلها بالمادة 140 من الدستور العراقي، كونها منطقة متنازع عليها بين العرب - بقطع النظر عن الانتماء المذهبي سنة أم شيعة - والكرد. إذ بينما يصر الكرد على أن كركوك «كردية» ويجب أن تلحق بإقليم كردستان الذاتي الحكم يرى العرب أنها عراقية ويجب أن تبقى مرتبطة بالمركز. أما بالنسبة لمحافظة ديالى فالأمر لا يتعلق بـ«العائدية» إلا لبعض أقضيتها مثل خانقين وجلولاء التي يرى الكرد أنها يجب أن تلتحق بكردستان وتخضع الآن لنفوذ الأحزاب الكردية وميليشيا البيشمركة الكردية بل يتعلق الأمر بالنفوذ.
وبسبب استمرار المشاكل على كل الأصعدة في العاصمة العراقية بغداد بسبب «نظام المحاصصة العرقية والطائفية» الذي بُنيت عليه العملية السياسية على حساب الهوية الوطنية الواحدة المتلاشية أمام الهويات الفرعية، تفاقم الوضع في محافظة ديالى.
* إشكالية «العائدية»
ديالى، في الحقيقة، تعاني أساسًا إشكالية مزدوجة لـ«العائدية» والنفوذ نتج فيها فراغ سلطة تنازعت على ملئه ثلاث جهات، هي: أولاً، تنظيم القاعدة منذ عام 2004 وحتى ظهور تنظيم داعش عام 2014، وثانيًا الميليشيات والفصائل الشيعية التي تستمد غالبيتها نفوذها من إيران التي تقع ديالى على أقرب نقطة حدودية لها عن العاصمة بغداد بحيث لا تبعد أكثر من 120 كلم. وثالثًا، البيشمركة الكردية التي تبسط نفوذها على المناطق والأقضية ذات الأغلبية السكانية الكردية. وفي إطار هذا الفسيفساء السكاني (الخليط العرقي من العرب والكرد وبعض التركمان، والطائفي السني الشيعي) سرعان ما انزلقت ديالى إلى إشكالية مذهبية وصراع طائفي. وزحفت الجغرافية التي تتميز بها المحافظة لكي تغتال تاريخها الذي كان مبعث فخر بالتعايش السلمي. ولكي نعطي تصورا حقيقيا عن هذا الجانب فلا بد من النظر إلى خريطة هذه المحافظة التي جعلها في القطب من الصراع السياسي الذي يعاني منه العراق اليوم نظرا للأهمية الآنية والمستقبلية لها.
* لمحة جغرافية
تقع ديالى في القسم الشرقي من وسط العراق. وهي من المحافظات التي لها حدود دولية، وتحديدًا مع إيران من الشرق. بينما يحدها من الشمال محافظة السليمانية وجزء من محافظة صلاح الدين، ومن الغرب محافظتا بغداد وصلاح الدين، ومن الجنوب محافظة واسط. وتبلغ مساحة ديالى 17774 كلم، وهي تشكل ما نسبته 4.1 في المائة من مساحة العراق البالغة 434128 كلم. وهي ذات شكل طولي يمتد طولاً إلى أكثر من 200 كلم طول، بينما يصل أقصى عرض للمحافظة إلى 155 كلم. وتشتهر ديالى بالزراعة، وبالأخص زراعة الحمضيات، ولا سيما البرتقال، والرمّان بحيث تعد «سلة العراق الغذائية» الرئيسية في هذا المجال، إذ يجود فيها البرتقال، بينما يشتهر بالرمّان بالذات قضاء المقدادية الذي استحال اليوم بسبب صراع النفوذ إلى صاعق تفجير يمكن أن تنتشر شظاياه إلى كل العراق. بل إن الحالة الخطيرة التي انحدرت إليها ديالى من الصعب حله إلا بعودة سلطة الدولة وهيبتها.
* نماذج تعدّدية
الوضع السكاني المتعدّد مذهبيًا وعرقيًا في العراق قد يجد له نماذج مصغرة في أكثر من محافظة أو مدينة مثل بغداد العاصمة نفسها أو محافظة البصرة التي تعد عاصمتها كبرى حواضر الجنوب. بغداد، من جهتها، سبق لها أن عانت الأمرين خلال فترة العنف الطائفي عامي 2006 - 2007. ومن ثم وجدت «الحل النسبي» في نشوء شبه «كانتونات» معزولة يسكن هذه الشيعة وتلك السنة من دون اختلاط. أما بالنسبة لمحافظة البصرة فإن السنة فيها يشكلون أقلية تقطن قضاء الزبير لكنها تعاني في كثير من الأحيان من الفراغ الذي سرعان ما تسعى الميليشيات إلى ملئه رغم المشاكل والخلافات العنيفة بينها، بالإضافة إلى تفجّر صراعات عشائرية من لون واحد (شيعية - شيعية).
وبالتالي، ما يجعل من محافظة ديالى حالة مختلفة عن نموذجي بغداد والبصرة كون صراع الهوية هناك يكاد له أن يتطور في بعض جوانبه إلى صراع وجود وإلغاء. ذلك أن الأقضية التي يسكنها الأكراد مثل جلولاء وخانقين يخطط حركيو هؤلاء لسلخها جغرافيًا وإداريًا عن ديالى من أجل ضمها إلى كيان كردستان من منطلق الأحلام التاريخية للكرد. في حين أن الأقضية التي يسكنها العرب فإنهم عاشوا فيها متعايشين ومتصاهرين على مرّ التاريخ، وأبرزهم: عشائر العزّة وعشائر كنانة وعشيرة العبيد وعشيرة الجبور وعشائر بني قيس وعشائر الدُّلَيم والسعيد والعسكري وطيئ وبنو تميم وبنو سعد وبنو خالد وبنو حرب وبنو زيد وعشائر شمر والأجود وعتبة والبومحمد وغيرهم. كل هذه العشائر وجدت نفسها ضحية لما بات يعرف بعد عام 2003 بـ«الطائفية السياسية» حيث ظهرت الهوية المذهبية (الشيعية - السنية) وبسبب تمدّد تنظيمي القاعدة ومن ثم «داعش» المحسوبين على السنة والميليشيات المدعومة إيرانيًا المحسوبة على الشيعة تفاقم العداء وصراع النفوذ، وصار أكبر تجسيد له احتلال ديالى من قبل «داعش» عام 2014 ومن ثم طرد التنظيم منها عام 2015.
* التطهير المذهبي والديموغرافي
وفي حين ترتب على ذلك الاحتلال نزوح كبير لسكان المناطق المحتلة، فإنه حين جرت عملية استعادتها من سيطرة «داعش» بدأت الميليشيات والفصائل الشيعية المدعومة من إيران عملية التهجير القسري والتغيير الديموغرافي الممنهج وتمثل بتجاوزات طائفية ومنع النازحين السنة من العودة إلى مدنهم وقراهم، وهذا مع العلم أن الغالبية السكانية لمحافظة ديالى من العرب السنة.
وفي هذا السياق يقول الشيخ مازن حبيب الخيزران، شيخ عشائر العزّة في ديالى، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «السنة في ديالى ورغم كونهم الغالبية فإنهم يعانون من طرفَي النفوذ هنا في المحافظة، حيث يستهدفهم (داعش)، رغم أن التنظيم محسوب على السنة ظلمًا وعدوانًا، وكذلك تستهدفهم في المقابل الميليشيات الشيعية.. وهو ما يعني إن العشائر السنية تحديدا تقع بين مطرقة (داعش) وسندان الميليشيات الشيعية (الإيرانية الدعم)». ويتابع: «الفارق يكمن في أن الجميع هنا أعداء لداعش، لكن الميليشيات تملك سطوة وتمارس سطوتها باسم سلطة الدولة أحيانًا، الأمر الذي يجعلنا ضحية للطرفين في ظل انعدام الحماية من الحكومة رغم الوعود الكثيرة. هذا الوضع يؤدي إلى تكرار المآسي التي نتعرض لها مع أننا كعشائر سواء كانت شيعية أم سنية لا نشعر أن بيننا أي خلاف من أي نوع».
الصورة لا تختلف كثيرًا بالنسبة لمحمد الخالدي، وهو أيضًا أحد شيوخ عشائر ديالى بجانب كونه قياديا بارزًا في كتلة «متحدون للإصلاح»، ولا يختلف كثيرا عن الصورة التي رسمها الخيزران للوضع في ديالى. ومن ثم يوضح الخالدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «أهل السنة في ديالى دفعوا وسيبقون يدفعون أثمانا باهظة في حال بقي السلاح بيد الميليشيات والفصائل المسلحة، وفي حال بقي حال آلاف العوائل النازحة على ما هو عليه، إذ لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل عجز الدولة عن ضبط السلاح والسيطرة على حامليه». ويضيف الخالدي أن «نحو 40 ألف عائلة تعرضت للتهجير من ديالى بعد سيطرة (داعش)، ولكن رغم تحرير المحافظة منذ أكثر من سنة فإن عدد العوائل العائدة لا يتعدى الـ1500 عائلة، وهو ما يعني بقاء أكثر من 38 ألف عائلة في مخيمات النازحين. ومع ذلك كله، يجري تفجير المساجد العائدة للسنة فضلاً عن عمليات التغيير الديموغرافي التي يقوم بها الكرد في المناطق التي يدّعون إنها عائدة لهم وهي جلولاء وخانقين، وتستغل الميليشيات الشيعية في المناطق الأخرى عجز الدولة أو تراخيها على فرض حالات من الأمر الواقع على الأرض».
* الشق الكردي للأزمة
وفي خضم صراع الجغرافية والتاريخ داخل حدود محافظة ديالى يزداد الطين بلة مع البعد الكردي للمحنة. فالأكراد، كما سبقت الإشارة، يسعون إلى ضم الأقضية والمناطق ذات الغالبية السكانية الكردية فيها كجلولاء وخانقين ومندلي إلى إقليم كردستان الذاتي الحكم، وذلك بالاستفادة من الفوضى التي تشهدها هذه المحافظة نتيجة الحرب القائمة منذ أكثر من عقد من السنين بين التنظيمات الإرهابية كـ«القاعدة» و«داعش» والميليشيات الشيعية المدعومة إيرانيًا، الأمر الذي يؤدي باستمرار إلى فراغ سلطة في الحكومة المحلية. وللعلم، سجل على هذا الصعيد اغتيال أكثر من محافظ وعضو مجلس محافظة أو قيادي بارز في المحافظة تابع لهذا الطرف أو ذاك، فضلا عن استمرار التغيير في مناصب الحكومة المحلية التي تطال في الغالب منصب المحافظ المختلف عليه بين الشيعة والسنة.
وفي حين يتهم الميليشياويون الشيعة جيرانهم السنة في المحافظة بدعم التنظيمات الإرهابية المسلحة أو التعامل معها - وحقًا دفعت قوات «الصحوات» ثمنا باهظا بسبب اتهامات سابقة بانتمائها إلى «القاعدة» -، يثير إصرار قادة المظاهرات في المحافظات الغربية طوال عام 2013 على التعامل مع ديالى بوصفها إحدى المحافظات الست الغربية - أي المحافظات ذات الغالبية السنّية - غضبًا وسخطًا عند الشيعة.
ثم أن ثمة مراقبين يرون أن إيران تقف خلف الضغوط بشأن توسيع نفوذ الميليشيات المرتبطة بها من أجل تأسيس «منطقة آمنة» لهاـ كون ديالى محافظة حدودية كما أن فيها، النقطة الأقرب ليس إلى بغداد فحسب، بل إلى محافظة صلاح الدين أيضًا، حيث أصبح لإيران نفوذ كبير فيها من خلال «الحشد الشعبي» بمساعدة بعض العشائر السنية في المحافظة. وبالتالي، فإن ديالى باتت هي المنطقة الواصلة بين إيران وسوريا عبر محافظة صلاح الدين.
تراث محمود العزاوي، المتحدث السابق باسم محافظة ديالى، قال لـ«الشرق الأوسط» في حوار معه إن «من أبرز ما واجهه السنة في ديالى هو ثنائية الهيمنة الشيعية - الكردية على المحافظة بما ذلك المفاصل الإدارية والسياسية، الأمر الذي أدى إلى تهميش السنة برغم كونهم الغالبية السكانية في المحافظة». وأردف العزاوي أن «تشكيل قوات (الصحوات) السنّية قبل سنوات من أجل محاربة القاعدة والإمساك بالأرض ترتب عليه مخاوف مختلفة، سرعان ما أصبحت تلك (الصحوات) ضحية لها فهي باتت هدفا لـ(القاعدة) التي تحاربها بحجة أنها عميلة للحكومة الشيعية - مثلما ترى -، بينما رفضت الحكومة الوقوف معها، بل شنت عليها حربًا، إلى الحد الذي لم تصرف لها رواتبها تحت تبريرات مختلفة، رغم الأدوار التي أدتها في استقرار المحافظة في فترة من الفترات».
وهنا يقول العزاوي «إن الحكومة بدلا من أن تستوعب (الصحوات) وتضمها إلى المنظومة الأمنية حوّلتها إلى خصم، وهذا ما انعكس سلبيًا على وضع العرب السنة في المحافظة، الذين بدأوا يتذمرون ويبحثون عن أي قوة يمكن أن تخلصهم من هذا الواقع المزري. المسؤولية مسؤولية الحكومة العراقية السابقة التي كان يرأسها نوري المالكي التي تتحمل الوزر الأكبر للأخطاء والمحن التي يعانيها أبناء ديالى اليوم». ويستطرد فيقول إن «داعش تمكن من التغلغل تحت هذه الذريعة، لكن سرعان ما بدأ يفتك بالجميع، وأولهم السنة، الذين دفعوا ولا يزالون يدفعون ثمن ولائهم لعراق واحد خال من الميليشيات والمجاميع المسلحة، يمثله جيش واحد هو الجيش العراقي من دون تمييز».
المقدادية.. مدينة المساجد المحترقة
المقدادية، واسمها الأصلي الذي كانت تعرف به هو «شهربان»، وهي كلمة كردية، مدينة ذات غالبية سنّية في محافظة ديالى والعاصمة الإدارية لقضاء يحمل اسمها. وهو ثاني أكبر قضاء فيها بعد مركز المحافظة مدينة بعقوبة. سميت المقدادية بهذا الاسم نسبة إلى العالم الصوفي المقداد بن محمد الرفاعي، وهي على مسافة 40 كلم شمال شرقي بعقوبة ونحو 90 كلم إلى الشمال الشرقي من مدينة بغداد. تمتد المقدادية على أرض زراعية خصبة تزيد مساحتها على 200 ألف دونم وتشتهر بالبساتين، وخاصة النخيل والرمّان والبرتقال. ويخترقها نهر وهو أحد روافد نهر ديالى ويسمى بنهر المقدادية.
يبلغ عدد سكان مدينة المقدادية نحو 280 ألف نسمة عام 2005م، ونسبة ما بين 80 - 90 في المائة من السكان هم من العرب، و5 في المائة من الأكراد، وما بين 3 في المائة و4 في المائة من التركمان، بالإضافة إلى أقلية من الشيشان الذين قدموا إلى المنطقة قبل أكثر من 150 سنة من بلاد القوقاز هاربين من البطش القيصري الروسي أيام ثورة الإمام شامل الداغستاني.
أصبحت المقدادية رسميًا بمستوى ناحية عام 1920م، ثم تحوّلت بإرادة ملكية عام 1950م، لتصبح قضاءً باسم قضاء المقدادية.
ما يميز مدينة المقدادية هو كثرة مساجدها ولا سيما المساجد القديمة، ولعل أشهرها جامع المقدادية الكبير، وجامع الأورفلي، وجامع نازنده خاتون في الحي العصري، وجامع حي المعلمين، وجامع الحرية، وجامع حذيفة بن اليمان، وجامع أبو ذر الغفاري، وجامع الشهيد خليل عبد الكريم الصالح، وجامع الشهيد علي المهداوي. وفي المقدادية يقع معسكر المنصورية، وهو من أهم مواقع الجيش العراقي، ومنه انطلق منه الزعيم عبد الكريم قاسم، آمر اللواء 19. في ثورة 14 يوليو (تموز) عام 1958 التي أعلنت الحكم الجمهوري في العراق. ويعد معسكر المنصورية اليوم من أكبر مخازن أعتدة الجيش العراقي المحصنّة تحت سلسلة جبل حمرين.
المقدادية كانت في قلب الأحداث أخيرًا بعد تعرّضها لهجوم غاشم شنه «الحشد الشعبي» وميليشيات شيعية أخرى أقدمت خلاله الميليشيات على إحراق وتفجير 9 مساجد من مساجد المقدادية التي يعود تاريخ تأسيس بعضها إلى عدة مئات من السنين، وارتكاب مجازر بحق المدنيين. وحسب المعلومات المتوافرة، سبق الهجوم على المقدادية العملية التي قام بها تنظيم داعش في حي بغداد الجديدة بالعاصمة بغداد، وتمثلت باقتحام «مول الجوهرة» ما أدى إلى قتل وجرح العشرات من المواطنين. وتزامنت عملية «داعش» في بغداد مع عملية تفجير بالقرب من مكان سيطرة لـ«الحشد الشعبي» في إحدى مناطق بعقوبة بالإضافة إلى تفجير بحزام ناسف.
على أثر ذلك وقع ذلك الهجوم، مع العلم، أنه سبقت هذه الحملة ولا سيما حرق مساجد السنة في ديالى حملة مماثلة لحرق ثلاثة مساجد سنّية في محافظة بابل (100 كلم جنوب بغداد) على أثر إعدام المعارض السعودي نمر النمر. غير أن ما جرى في المقدادية فجّر صراعا سياسيا حادًا تمثل في مقاطعة «تحالف القوى العراقية» جلسات مجلسي النواب والوزراء احتجاجا على ما جرى هناك.
كذلك تضاربت المواقف حتى عندما زار كل من رئيس البرلمان سليم الجبوري - الذي ينتمي إلى مدينة المقدادية ويتزعم كتلة «ديالى هويتنا» البرلمانية - ورئيس الوزراء حيدر العبادي، المدينة. فالتصريحات التي أدلى بها كل من الجبوري (سنّي) والعبادي (شيعي) في المقدادية عكست عمق الخلاف بين الطرفين. إذ أكد العبادي سيطرة الدولة على الوضع وتجول في الأسواق والأحياء الشعبية إيحاءً بعودة الأمن والأمان فيها، بينما أخرج الجبوري ورقة من جيبه قال إنها تتضمن أسماء المتورّطين في أحداث العنف الذين لم تعمل الحكومة شيئا لتوقيفهم ومعاقبتهم. وذهب الجبوري من ثم إلى ما هو أبعد حين تحدى العبادي أن «يقدم الأدلة العملية» على محاسبته حارقي مساجد المقدادية.
والمعروف أن الهجوم على المقدادية لم يقتصر على حرق المساجد، بل شمل إعدامات ومجازر وحشية بحق شبان من السنة داخل المدينة. ومع استمرار عمليات القتل والقتل المضاد والتي طالت حتى الإعلاميين (اغتيال مراسل قناة «الشرقية» ومصورها عند إحدى السيطرات) فإن المساعي السياسية الهادفة إلى البحث عن حل لما جرى في المقدادية تصطدم بها مساع مضادة من أجل تدويل أزمة ديالى وطلب حماية دولية للسنة، وخاصة بعدما أثبتت الحكومة فشلها في تأمين الحماية للمواطنين.