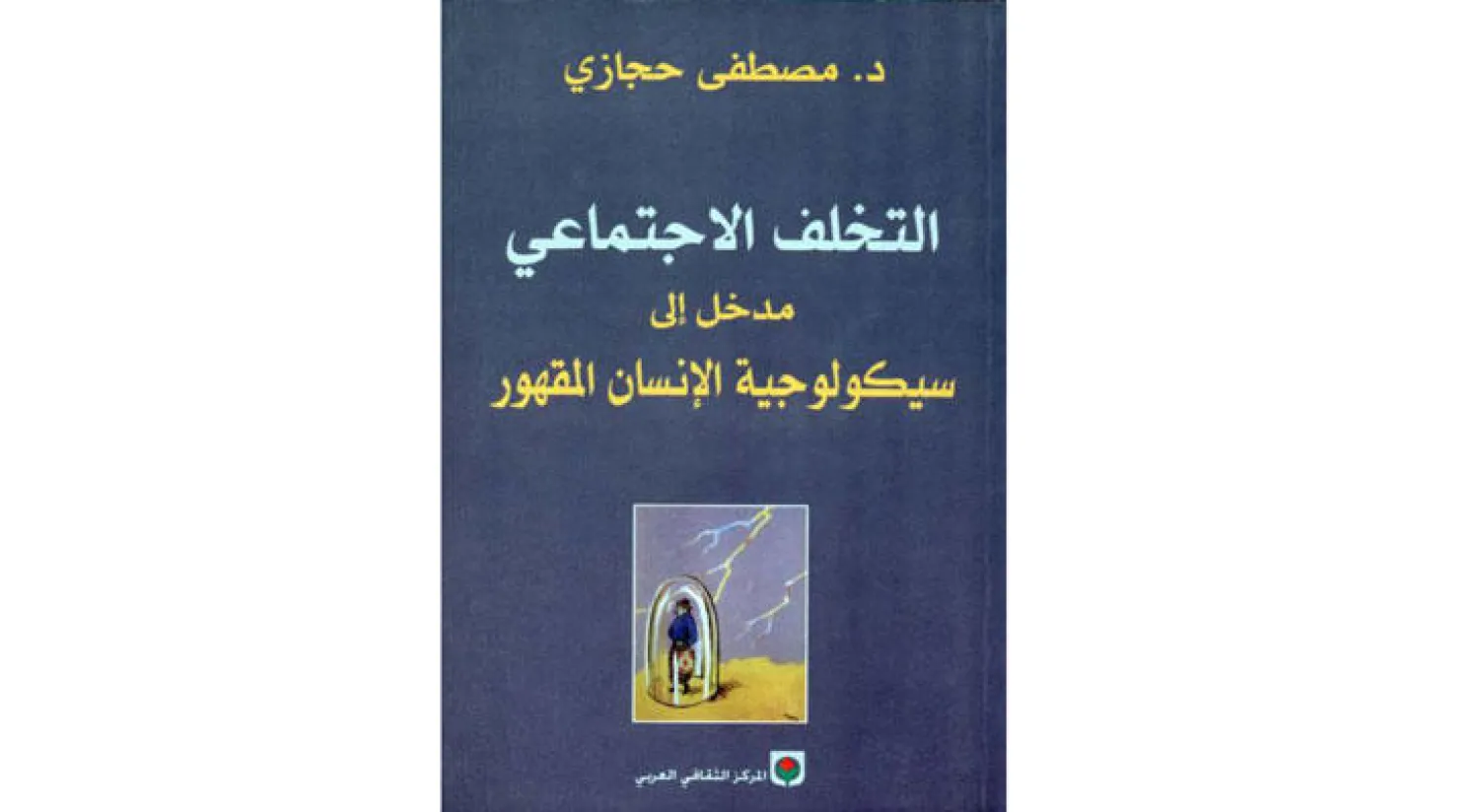في الوقت الذي كان فيه الإنسان الغربي يمضي بخطى ثابتة نحو بناء وجوده داخل العالم، وتثبيث دعائمه، انطلاقا من الدعوات التي وجهها فلاسفة العصر الحديث، الذين جعلوا الإنسان مركز هذا الوجود، ودفعوا به إلى أن يحيا بعيدا عن كل حجر أو وصاية، كان الإنسان العربي يعيش عصور انحطاطه، بعدما فقد البوصلة التي كان يبني بها العلم والمعرفة في مرحلة معينة من تاريخه.. انحطاط سيستمر قرونا طويلة، وسيبلغ ذروته مع الاستعمار الذي سيورث أنظمة استبدادية، ومجتمعا منحلا، وإنسانا مدمرا، وسيكولوجية مريضة، مشوهة ومبتورة، مليئة بالأعطاب والجراحات، تدل التحليلات السيكولوجية، سواء في علم النفس الفردي أو الجماعي، على أنها سيكولوجية غير متوازنة تحتاج إلى إعادة تحديد وفهم وتقويم.
في محاولة لدراسة الشخصية العربية والخصائص المميزة لها، قدم علم النفس العربي تحليلا هدفه رفع إنسانية العربي وإيجاد صيغة تصون بها الذات كرامتها وتتحرر، هي ومجتمعها، من الواقع القاسي، والمثل الأعلى الصعب المنال، «الهُوَ» و«الأنا الأعلى القمعي»..
أولا: شخصية مقهورة عاجزة، بأساليب دفاعية قوية، وعقلية انفعالية غير منطقية.
في كتابه «التخلف الاجتماعي - مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور.. الشخصية العربية المقهورة»، سوف يقدم الدكتور مصطفى حجازي، إسهاما مهمّا جدا في تحليل السيكولوجية العربية، فالذات العربية في نظره، ذات مقهورة، تعيش حالة من فقدان القدرة على السيطرة على مصيرها، ولا تتوفر على أي ضمانة تحميها، مما يؤدي إلى تضخم مشاعر العجز والقلق في داخلها، خصوصا أنها تتحرك في وسط متسلط لا ديمقراطية فيه، وهي عامل استقرار نفسي ضروري.. فلا يكون أمام هذه الشخصية سوى الرضوخ، ما دامت كل محاولة للتمرد تواجه بقمع شديد من الحاكم الذي لا يرى سوى ذاته عظيمة مضخمة، ولا يخطر بباله مطلقا أن لسلطته حدودا وأن عليها قيودا.
تؤمن الذات المقهورة، حسب حجازي، بعجزها، ما لا يؤهلها للرد والمقاومة، فيبدو وكأن الاستكانة والمهانة هي طبيعتها الأزلية، بل أكثر من ذلك، إنها تعتبر القهر الذي تعيشه بمثابة عقاب لها تستحقه على تخاذلها.. فتكثر في هذا الوضع الميول الانتحارية لما تتفاقم المشاعر العدوانية والإثم المرتد على الذات، وانعدام الثقة في النفس وفي الآخرين.
من طبيعة الحال أن تكون الأساليب الدفاعية في هذا الوضع شديدة الحيوية والفعالية، حيث يبرز الانكفاء الذاتي، والتقوقع، والانسحاب، محل مجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وذلك بتقبل المصير، أو إيهام الذات بتقبل هذا المصير، والغرق في البؤس، فلا يبقى لديها إلا التفكير الغيبي والسحر للتخلص من المأزق المعيش.
أما على المستوى العقلي، فالعقلية ترزح تحت انفعالاتها، وتلون العالم بصبغة ذاتية واضحة وغير موضوعية، في حين تظل قوالب التفكير المنطقي مغيبة بأحكام على الظواهر والأشخاص، يشوبها كثير من التحيز والقطيعة. هذه العقلية توازيها حياة غير واعية تتجاذب بين السادية؛ سادية الأب والحاكم المستبد، والمازوشية، عنف الذات على ذاتها.
يضاف إلى العمل الذي قام به مصطفى حجازي، عمل آخر لا يقل أهمية، وهو ما قدمه الباحث اللبناني علي زيعور، في كتابه «التحليل السيكولوجي للذات العربية»، وفيه يتتبع بدوره، انجراحات الذات العربية التي تبقى في نظره غير راضية عن نفسها، وعن الذات في المجتمع، وعن المجتمع أمام الحضارة العالمية.. فالشخصية العربية مصابة بارتجاج، وقلق، وتخلخل في القيم، وانجراح في مشاعر الأمن والانتماء، بل حتى الأسرة والعائلة ليستا فضاء يسمح بنمو شخصية سوية، أو الحصول على التوازن النفسي المنشود، أو توفر المناخ السليم لخلق الشخصية المستقلة، والاعتراف المتبادل بالحقوق والواجبات لكل أفرادها، أو إعداد المواطن للحياة الاجتماعية المتزنة. إن العجز عن تدمير الصورة السيئة للذات، المتوازي مع العجز عن تحقيق صورة مثالية لها، هو شعور يرتد إلى الذات السيئة التوافق والناقصة التكيف. من هنا تأتي الانفجارات هنا وهناك، والهروب السلبي من خطر الاندثار الذي يتجلى في لوم الذات وتسفيلها، وإكبار العدو.. وهي عملية تكيّف سلبية ندافع بها عن أنفسنا، ونخفف من توترنا، ونستعيد تقديرنا الذاتي، ونحاول توفير صحة نفسية وقتية ووهمية وغير إيجابية. ومن الوجهة المقابلة، علينا التنبه إلى الخطر الآخر، المتمثل في الهروب من النقائص والعدوانية ومشاعر الفشل، بإسقاطها على القواهر الخارجية، وعلى أعداء نخلقهم بأنفسنا بشكل لا واع ولأهداف لا واعية.
ثانيا: شخصية متمردة ينغرس الاستبداد في «لا وعيها».
تولد هذه المعاناة طاقة عقلية ونفسية قوية، تدفع الإنسان إلى محاولة التغلب عليها، فيندفع لعمل أي شيء لاستعادة التوازن النفسي، وتكون النتيجة: إما استخدام هذه الطاقة العقلية لتغيير واقعه، أي الثورة على الواقع، وإما أن يستخدمها في تغيير رؤيته هو عن الواقع ليرضى عنه، ولا يثور.
في العالم العربي، سوف يسلك المواطن الطريق الأول، وسوف يقوم ثائرا متمردا على واقع لم يعد يحتويه، في ما أطلق عليه اسم «الربيع العربي». وهكذا، فالشعب الذي ظل الجميع يقول إنه لا يرجى من ورائه أمل، يحزم الآن أمره ليكسر حواجز الخوف التي كانت تكبله من كل جانب، فيبدو أن هذه الشعوب التي كانت مقهورة قد استعادت الحق في الكلام، وبدأت تتحرر من المكبوتات النفسية التي تمارس عليها القهر وتحكمها في سلوكها وكيانها، بعدما ترسخت بنية الاستبداد السياسي في «لا وعيها».
سوف تعطي الثورات العربية انطلاقة أخرى لدراسة هذه الذات التي خرجت من وضع الرضوخ والاستكانة، إلى وضع جرى التنبؤ بأنه وضع قد يكون أحسن حالا من سابقه. لكن السنوات التي تلت هذا الحراك العربي، عادت لكي تؤكد شيئا أساسيا، هو أن الاستبداد منغرس في الوعي الفردي والجماعي، وأنه يبقى من الصعب على المجتمعات أن تغير في وعيها؛ إذ يحتاج ذلك إلى زمن غير يسير، ولا أدل على ذلك من كون الشعوب التي ثارت على مستبديها، عادت لتنصب أنظمة حكم استبدادية من جديد. كما أن الانفجارات والانفلاتات التي صاحبت محطات بارزة في مسار هذه الثورات، كمظاهر العنف الكبيرة، والتدمير، والإفراط في الحرية من دون احترام للقانون وللآخرين، تؤكد أن الإنسان العربي ظل، لعقود طويلة، في حالة من القهر والكبت النفسي الشديدين، وعندما زال هذا الكبت، تولدت طاقة نفسية كبيرة، أدت إلى انفجار انفعالي، وإلى انفلات نفسي، وإفراط مبالغ فيه في استغلال مناخ الحرية الناتج عن نجاح تلك الثورات في الإطاحة بالنظم السلطوية والقهرية.
هنا لا بد أن نعود إلى مصطفى حجازي، الذي يؤكد في تقديمه لكتاب مصطفى صفوان: «لماذا العرب ليسوا أحرارا؟»، على أن تحول الشخصية العربية من القهر إلى الحرية، لا يكفي بإسقاط الشعب لفرعونه، فالثورات العربية مجرد خطوة أولى على درب الخروج من القهر، والعبور إلى الحرية يستلزم بناء مؤسسات تمكن المجتمعات العربية من ولوج عوالم تنمية شاملة، فالاستبداد السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي والأسري، هو الذي يولد أنماطا من التنشئة، وعلاقات السلطة تعود فتولد، بدورها، نظاما من المكبوتات النفسية التي تستلب الإنسان من الداخل، مما يشكل أحد العوائق العملية للمرور إلى الحرية المنشودة. إن التسلط والاستبداد بمختلف أدواته القمعية لا يترسخ إلا عندما يصبح جوّانيّا، أي داخليا منغرسا في الذات، وحيث يصبح جو الاستلاب الجواني أداة ترسيخ الاستبداد السياسي. وبالتالي، فلا بد من تحرير الإنسان من الداخل؛ من مكبوتاته التي هي وليدة نظم السلطة المستبدة. إن التحرر النفسي الجواني ضمانة أساسية للتحصن ضد ممارسات الاستبداد السياسي، ذلك أن هناك تكاملا وتعزيزا متبادلا بين الأمراض الاجتماعية والأمراض النفسية. وهذا ما يتفق معه علي زيعور كذلك، فيؤكد أن الصحة النفسية للذات العربية، لا تجري إلا داخل نظام سياسي لا جارح، فهو أساس وضرورة في عملية رفع إنسانية العربي وتعميقها وعلاجها، على الرغم من أن النظام السياسي لا يكفي بمفرده.
* أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي