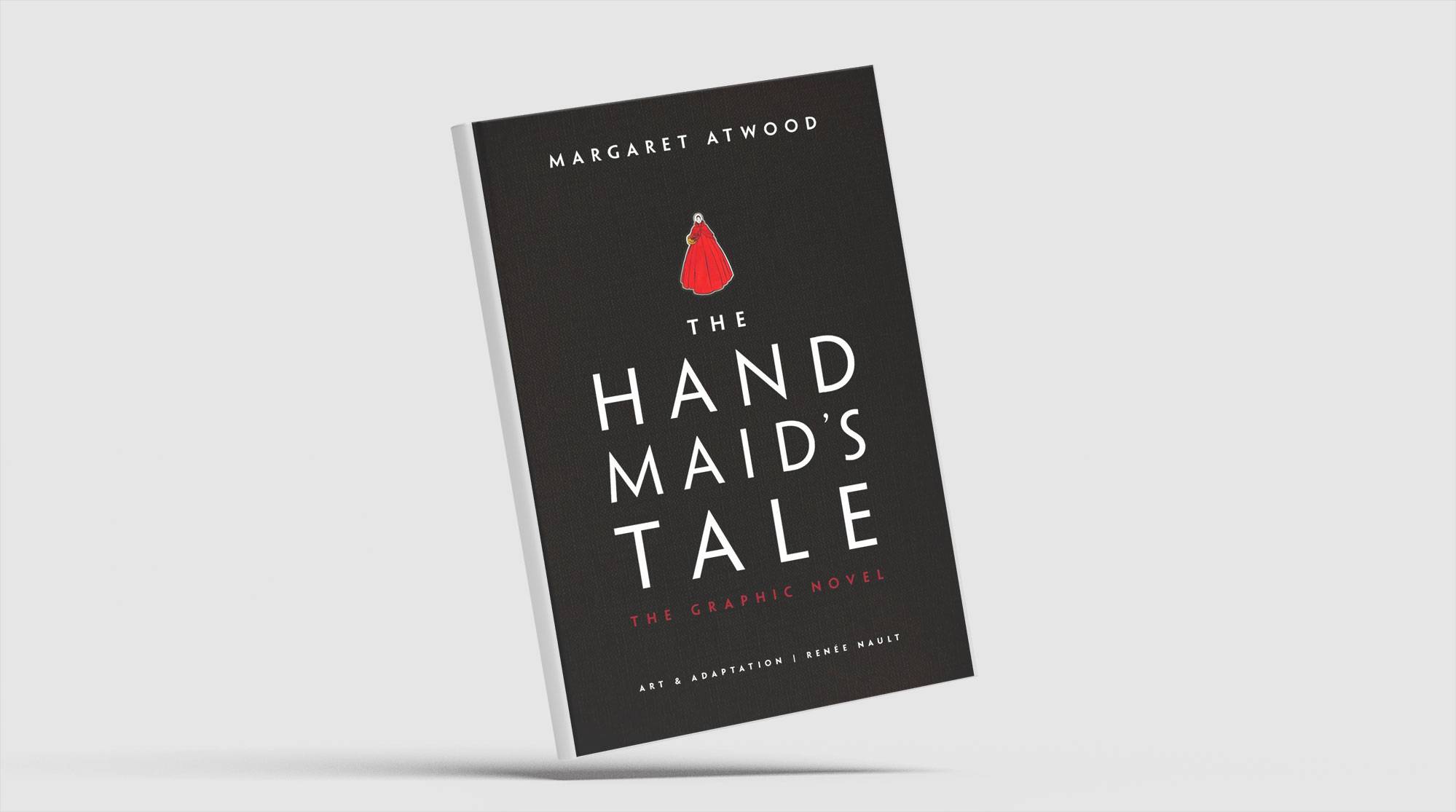عرفت القاصة والكاتبة السعودية الدكتورة هناء حجازي بنزعتها للتمرد، ورغبتها في الاختلاف عن كل ما هو «نمطي» و«سائد»، وهو ما جعلها تصيغ تجربة مستقلة ومختلفة، وهي ترى أن «الاختلاف ميزة إذا كنت تقدر الاختلاف».
في كتابها «هل رأيتني؟؟.. كنت أمشي في الشارع»، تقول: «حين قررت أن أدرس الطب، لم أكن أحب أن أرى الدم أو أشفي الناس.. كان همي الوحيد أن أختلط بالرجال وأمشي في ردهات المستشفى دون رداء أسود.. لكن الآن كثر اللون الأسود بين الطبيبات وأصبح معظمهن يمشين بقناع أسود.. وينظرن إلي باشمئزاز».
في الحوار التالي الذي أجري على هامش مشاركتها في مهرجان سوق عكاظ الذي أقيم في الطائف الشهر الماضي، تتحدث القاصة هناء حجازي عن تجربتها في الكتابة والقصة والترجمة، وعن نزوعها نحو الحرية «الحرية التي لا تجرح الناس ولا تؤذيهم.. فحين تكون حرا تصبح مسؤولا عن كل ما تقوم به». هذا نص الحوار:
«طفل الاسبرجر»
* ما حكاية رواية «طفل الاسبرجر»، ليست «رواية» وليست مجرد كتابة فكرية.. ماهي؟
- هي ليست رواية كما هو متعارف عليه. هي كتابة جديدة كما أطلق عليها الناقد سعيد الأحمد، حيث السيرة مكتوبة بطريقة السرد الإبداعي. تتحول فيه السيرة إلى كتابة إبداعية على شكل روائي.
* في هذا الكتاب، يبدو وكأنك تفتحين نافذة على أخطاء مجتمع، عبر التوجه لشريحة الأطفال المصابين بهذه المتلازمة؟.
- نعم جزء من هدف الكتابة هو فتح نافذة على أخطاء المجتمع في التعاطي مع شريحة المصابين بهذه المتلازمة (الاسبرجر: نوع من اضطرابات طيف التوحد). بالإضافة طبعا إلى الرغبة في البوح، وفي التدوين، وفي قول ما لم يقل، وفي كشف المستور.. الكتابة من أجل الكتابة. لا أعرف بالضبط. الكتابة كما يمارسها كل الكتاب من أجل شيء أو من أجل لا شيء. الكتابة هي بحد ذاتها دافع لكتابة حكاية ما.
* هذه التجربة الكتابية حصلت على جائزة معرض الكتاب، وهي تكشف تجربة شخصية ذات خصوصية مع هذا النوع من المرض.. كيف تمكنت أن تحولي هذه المعاناة إلى صيغة إبداعية؟
- أكتب بصيغة إبداعية. هذه هي البداية. منذ بدأت الكتابة وأنا أكتب إبداعا. لذلك حين قررت نقل قصتي الواقعية للناس كان لا بد أن يتم ذلك بطريقة إبداعية. لأنه الشيء الذي أحسنه والشيء الذي أحبه. وسيلتي لم تكن بشكل تقريري كامل لأنني هكذا أكتب. هذه هي وسيلتي التي أعرف.
* يحمل الكتاب / الرواية / السيرة: «مختلف.. طفل الاسبرجر مختلف لكن ليس أقل»، «ثيمات» متعددة.. خصوصا أن الكاتبة هي أم الطفل المصاب، دعيني أسأل عن مفردة «مختلف» كيف يصبح الاختلاف تميزا؟.
- الاختلاف هو تميز في معظم الأحوال. الفنان إنسان مختلف، الكاتب، العالم. كل من تركوا أثرا في الدنيا هم أشخاص مختلفون بطريقة ما. بالنسبة لي اختلاف ولدي كان شيئا مميزا جدا. جعلني أحبه أكثر. لأنني عرفت كيف أتقبله وأتعامل معه. تفرده في حبه للعزلة جعلني آلفه أكثر، ربما بحكم حبي أنا أيضا للعزلة، صدقا لا أدري، لكن الاختلاف بالتأكيد ميزة إذا كنت تقدر الاختلاف. أنا أيضا مختلفة عن السائد بشكل ما وفي نواح كثيرة، لذلك أدرك كم هو المختلف بحاجة لتقبل الآخر ومجاراته ومداراته أيضا، ربما هذا هو السبب الذي جعلني قادرة على التعامل مع الاختلاف وتقديره كميزة لا كعيب.
* هل للأمر علاقة بدراستك للطب، أم بالمعاناة ذاتها؟ بمعنى هل جعلك الطب أكثر إنسانية أم الألم صاغ مفردات الرواية؟
- المثير للاستغراب أن هذا السؤال جاء وأنا أقرأ موضوعا في جريدة أميركية عن إحساس الأطباء بالتعب وفقدان المعنى لأنهم فقدوا إحساسهم بالمرضى كأشخاص بحالة إلى التعاطف والحب. الطب للأسف لا يجعل الإنسان أكثر إنسانية. أقصد الطريقة التي ندرس بها وكثير من الأطباء الذين نقابلهم نشعر أنهم لا يمتلكون كثيرا من الإنسانية. هناك طبعا أطباء في منتهى الرقة والإنسانية وهؤلاء هم المختلفون من الأطباء، الإجابة على السؤال هي: أننا نجعل أنفسنا أكثر إنسانية حين نفتح قلوبنا للآخر.. ميزة الطبيب أنه حين يفتح قلبه للآخر، يكسب نفسه ومريضه معا، ما صاغ مفردات الكتاب هو أنني فتحت قلبي للقراء. كتبت بإحساسي كل ما مر علي وأثر في، لم أخبئ شيئا، لم أدع البطولة، ولم أستعطف القارئ. كتبت ما حدث. كما حدث. وكما شعرت به فقط!.
المرأة وسلطة الرجل
* في بعض نصوصك القصصية يجد القارئ شعورا أنثويا بالضعف أمام مجتمع ذكوري.. إلى أي مدى تتحمل المرأة مسؤولية هذا الواقع؟
- لو تحدثنا بشكل عام عن مدى تحمل المرأة مسؤولية واقع تسلط الرجل، فالمسألة معقدة، أحيانا أتسلط أنا نفسي على المرأة وأشعر بالعار لأنها تسمح للرجل أن يذلها ويتحكم فيها لهذه الدرجة، وأحيانا أشعر بالخجل من نفسي لأنني سمحت لنفسي أن أكون قاضيا وحكما على امرأة لا تملك من أمرها شيئا أمام سلطة وقانون ورجل يتحدث باسم الدين كي يتحكم فيها، هذا مع ملاحظة أن اعتراضي ليس على الدين ولكن على تحريفه من قبل أشخاص يتحدثون باسمه ويرهبون المرأة التي تطالب بحقوقها وإنصافها باسمه.
* كيف قرأت دخول المرأة لبعض المؤسسات الثقافية مثل جمعية المسرحيين وإدارات الأندية الأدبية؟
- نسير في المسار الصحيح، تأخرنا لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح، بقي أن لا تخذلنا المرأة التي دخلت إلى هذه المؤسسة على عاتقها كثير، لذلك يجب أن تتخلى عن الأنانية والفردانية وتعمل بشكل صحيح.
* لمن كنت تتوجهين في مجموعتك «هل رأيتني؟.. كنت أمشي في الشارع».. ألا يوحي العنوان بشعور عميق بالهامشية؟
- هامشية من؟ كنت أتوجه إلى كل من حلمت يوما حلما بسيطا ولم تتمكن من تحقيقه، أردت أن أثير هذا الشعور بالحسرة الذي يتركه عدم تحقق الأحلام البسيطة داخل الناس، ربما الآهة التي تصعد عندها تحرك شيئا راكدا ما في دواخلهم.
* كيف تختارين قصصك التي تكتبينها؟
- صدقني لا أختار، هو شعور يبدأ من كلمة أو ملاحظة أو مشاهدة ما، ثم يتصاعد حتى يصبح مشهدا كاملا يجب أن تتم كتابته فورا قبل أن تفر الحالة.
* لماذا تغفلين الشاعرة داخلك؟ لك نصوص شعرية قليلة لكنها مثيرة للاهتمام من قبيل: كسرت قلمي / فانتشرت رائحة نفاذة / لم تعجبهم / خبأتها تحت وسادتي
ونمت. الذي ورد في مقدمة كتاب: «هل رأيتني؟.. كنت أمشي في الشارع».
- نعم. كتبت عدة نصوص شعرية. ربما أغفلها لأنني لا أريد خوض جدل مع الشعراء من نوع هل ما أكتب شعرا أو ليس شعرا، وربما لأنني لا أريد أن أحمل لقب شاعرة، ربما.. لا أدري، لكنني فعلا أهرب من كتابة الشعر.
* قلت في حوار آخر إن مشاركتك في كتاب «طيور الرمل»، كان «محاولة للخروج من حصار المؤسسة الرسمية التي لا تهتم كثيرا بالمثقفين».. لكننا نعلم أن هذا العمل ترجم من قبل دار «طوى» وتم عرضه في معرض فرانكفورت بألمانيا.. أين يكمن حصار المؤسسة الرسمية إذن؟
- «طيور الرمل» يحتوي على مجموعة قصص لعدد من كتاب القصة في السعودية وهو عمل جميل كان منبع الفكرة فيها المثقف الجميل عادل الحوشان، لم يكن العمل محاصرا من المؤسسة الرسمية، الفكرة كانت أن يخرج عمل يشارك في المعرض لا يخضع لشروط المؤسسة الثقافية الرسمية لدينا، والمثقف بصفة عامة لديه دائما تحفظات على طريقة عمل المؤسسات الرسمية، هذا أحد أدوار المثقف أعتقد أو طبيعة تكوينه تحتم عليه الخروج على العمل الرسمي الذي عادة ما يشكو من الروتين والبيروقراطية.
الترجمة والرواية
* في المجمل ما هي علاقتك بالمؤسسات الثقافية الرسمية؟ كيف ترين علاقتها بالمثقف المحلي؟
- لا أريد أن أقف ضدها. وحين أدعى للعمل فيها لا أرفض بشكل قاطع، أتواصل مع المثقفين العاملين فيها لكنني دائما أشعر أنني لا أفهمها، لا أفهم لماذا لا تستطيع أن تعمل بشكل أفضل، لا أحب إلقاء التهم أو اتخاذ موقف المعادي لما تفعله، لكن أرى جمودا أتمنى أن تتخلص منه، بشكل عام أنا بعيدة عنها. لذلك لا يمكنني التحدث بشكل سلبي مطلق، دون محاولة مني للفهم لما يجري، حتى حين أصبحت عضوا في الجمعية العمومية في نادي جدة الأدبي وعلى الرغم من أنه لا يعتبر مؤسسة رسمية بشكل مطلق، لكنني فعلت ذلك محاولة للاقتراب والفهم وكي أخوض تجربة القدرة على انتخاب اسم ما. لكن بأمانة شديدة، لا أجد نفسي قادرة على الاستمرار في لعب هذا الدور، أحب العزلة والانزواء والكتابة بعيدا عن المؤسسات الرسمية.
* شاركت في برنامج الكتابة العالمي.. حدثينا عن هذه التجربة.
- هو برنامج عالمي سنوي، يحضره كتاب من كل أنحاء العالم يقومون بالترشح للسفارات الأميركية في بلدانهم، لكن بالنسبة لي رشحني للمشاركة فيه مدير البرنامج بنفسه وهو شاعر وأكاديمي بجامعة «إيوا» كريستوفر ميريل، حين كان في زيارة لجدة. وقد ذهبت في عام 2009. ومدة البرنامج ثلاثة أشهر. كانت تجربة رائعة. خلال الفترة التي تقضيها هناك يتركون لك المجال كي تتعرف على الكتاب الآخرين بالإضافة إلى ثلاث نشاطات يجب أن تقوم بها. أحدها قراءة بعض من نصوصك في مقر البرنامج أو المكتبة. والثاني كتابة ورقة في موضوع وقراءته أمام الجمهور في الجامعة والحوار بعد ذلك معهم حول نفس الموضوع، والنشاط الثالث لقاء مع طلبة الجامعة وإجراء حوار معهم، بالإضافة إلى نشاطات أخرى، فقد استضافتني جامعة أخرى وأجريت لقاء مع طلبة يتعلمون اللغة العربية. وحوارا مع طلبة في كلية أخرى أيضا. ومن أنشطة البرنامج الأخرى، قمت باختيار فيلم سينمائي وعرضه على المجموعة والتحدث والحوار حوله، حيث اخترت فيلم «كراميل» اللبناني. وقد كانت أياما رائعة برفقة 36 كاتبا وكاتبة من مختلف أنحاء العالم.
* ترجمت أعمالا أدبية لعمالقة الرواية العالمية مثل: «بورخيس»، و«ساراماغو»، و«ماركيز»، كيف أثرت هذه الأعمال على مسيرتك الأدبية؟
- الترجمة تجربة ساحرة. تتعرف من خلالها على مفردات جديدة، طريقة تعبير جديدة، طريقة ربط الكلمات ببعضها من ثقافة مختلفة، وتتعرف من خلالها على كيف يفكر شعب ما من خلال لغته، تكتسب أشياء كثيرة جميلة ورائعة عبر الترجمة، أعتقد أنها أثرت في ولا أعرف كيف، لكن بالتأكيد أثرت.
* كيف تقيمين الطفرة الرواية التي مر بها المجتمع السعودي خلال السنوات الماضية؟
- أمر طبيعي وبالنسبة لي كان أمرا جميلا، تخيل كنا نتهم الشباب أنهم لا يقرأون، وإذا بهم يكتبون، بالطبع لا يرقى كل ما كتب إلى مصاف الأدب، كان لا بد لهم أن يكتبوا، وكتبوا، مسألة النشر قضية أخرى كان لا بد للقائمين على دور النشر مراجعة ما كتب وإدراك ما إذا كان صالحا للنشر أم لا، بصفة عامة أنا مع التجربة ولست ضدها، قضية النقد والمراجعة وتصنيف ما كتب ووضعه في المكانة التي يستحق مسألة تعود للنقاد ومتذوقي الأدب، أما الكتابة فهي من حق الجميع.
* إلى أي مدى تشعرين أن موجة الرواية هذه قد استقرت اليوم؟
- أعتقد أنها بدأت تعود لمسارها الطبيعي، خفتت الفورة الأولى، الآن سيكتب من يحب الكتابة، وليس من كان يسعى للشهرة عبر الكتابة، هذا لا يعني أنني ضد الشهرة، لكنني لا أحب أن تكون هي الهدف الأول.
* سيرة أدبية
* هناء حجازي من مواليد مدينة جدة.
* منسقة برنامج مكافحة السكري بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة بجدة.
* طبيبة وقاصة وكاتبة صحافية سعودية. صدرت لها مجموعة قصصية بعنوان «بنت» 2001، ومجموعة نصوص بعنوان «هل رأيتني كنت أمشي في الشارع» 2007، وسيرة بعنوان «مختلف.. طفل الاسبرجر مختلف لكن ليس أقل» 2012، وهو الكتاب الفائز بجائزة وزارة الثقافة والإعلام للكتاب لعام 2013، وترجمت كثيرا من الأعمال الأدبية من الإنجليزية مثل «بورخيس»، و«ساراماغو»، و«ماركيز»، وقصائد أميركية، ومقالات أدبية.
* بدأت الكتابة القصصية عام 1987 وكانت أول قصة كتبتها هي «أغنية النوم»، ونشرت في مجلة «اقرأ».