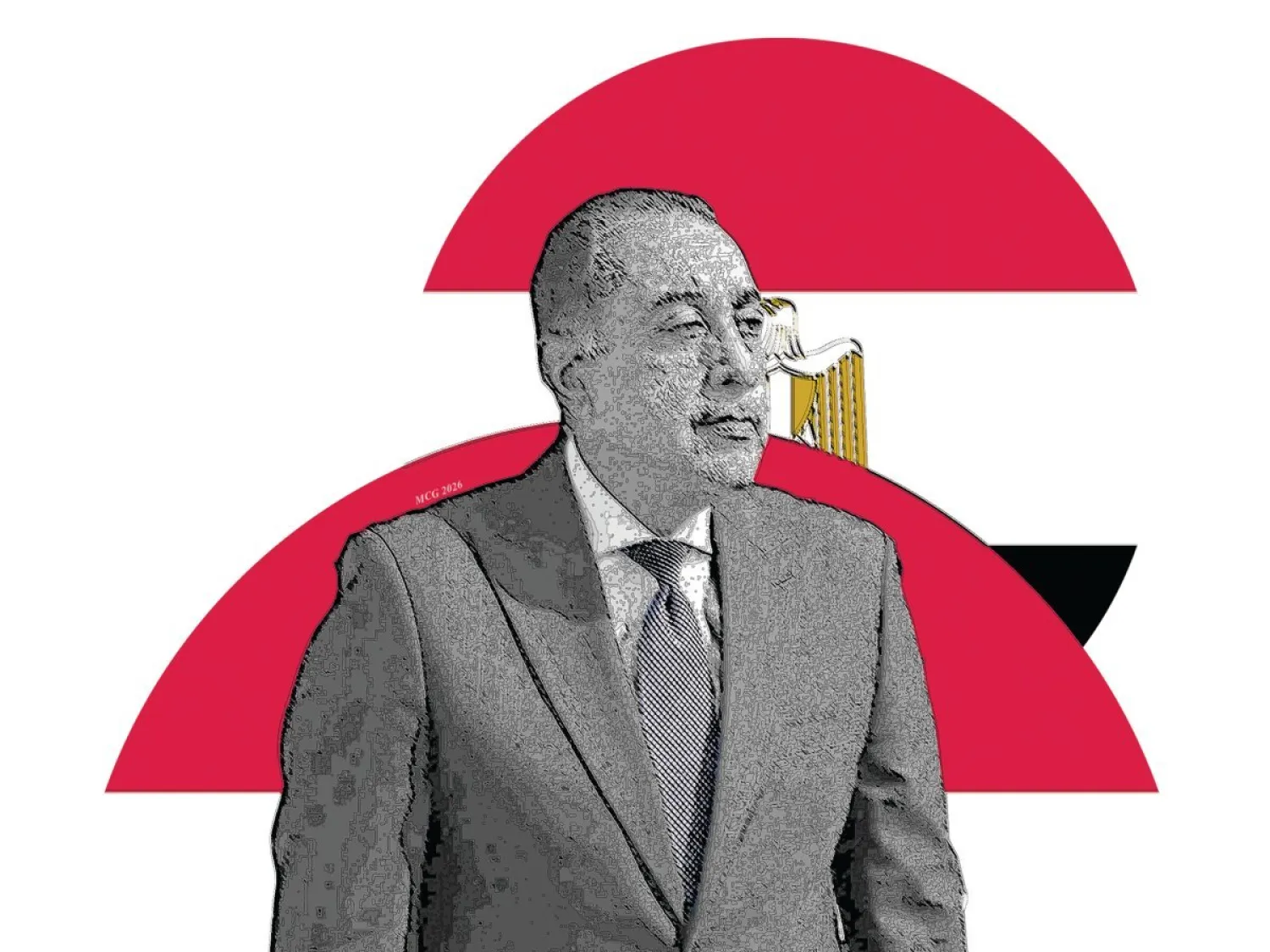إذا كانت ديمقراطية أثينا هي القبلة التاريخية والفكرية للنظم الديمقراطية لأنها أول مكوّن ديمقراطي منذ فترة زمنية طويلة، فإن التاريخ على مدار أكثر من ألفيتين من الزمان طورها بشكل مختلف شهد مراحل نموها بوصفها نظاما راسخا للحكم في كثير من الدول. ومع ذلك، فقد وضع التاريخ الديمقراطية على المحك في كثير من المناسبات، بل إنها شهدت في مناسبات كثيرة حالة إجهاض سياسي ليستعاض عنها بنظم أسوأ من الديكتاتوريات المتداولة، وهو ما جعل تاريخ مسيرة الديمقراطية من الفكر إلى التطبيق حافلاً بكثير من التأملات التي قد يكون من المناسب طرحها للمناقشة أو التفكر حولها على أساس الخطأ والصواب؛ منها ما يلي:
أولاً: الثابت أن الديمقراطية بوصفها نظاما سياسيا ليست بأي حال من الأحوال نتاجًا لسمو الإنسانية وفكرها بقدر ما هي نتاج لظروف المتغيرات السياسية والاجتماعية في الدول عبر التاريخ. فأثينا ذاتها لم تطبق هذا النظام رغبة منها في السمو السياسي، بل نتيجة طبيعية لظهور حالة نفوذ طبقي لا أعتقد أنها متطابقة مع الجدلية المادية الماركسية بقدر ما تمثل طموحًا طبيعيًا للمشاركة في عملية الحكم وصناعة السياسة من قبل الطبقات الاجتماعية في هذه الدويلة. والثابت تاريخيًا أيضًا أن هذا ما حدث نفسه في التاريخ الغربي الحديث، فلم نسمع عن الديمقراطية أو حتى الحكم الليبرالي بشكل مؤثر إلا مع ظهور المتغيرات الاجتماعية وظهور طبقة رجال الأعمال والصناعة وبداية ضمور طبقة الأرستقراطية مع تغير النظم الاجتماعية/ الاقتصادية القائمة، وهو مما يجعل الديمقراطية في التاريخ مسيرة أكثر منها قرارًا.
ثانيًا: إن الديمقراطية بوصفها نظاما للحكم متعدّدة النماذج، وأكثر المجتمعات التي طبقت الديمقراطية المباشرة كانت دويلة أثينا، وهو ما استعرضناه جليًا في مقال الأسبوع الماضي، ولكن الحقيقة الأساسية الثابتة أيضًا في هذا المجال هي أن سلوك الديمقراطيات أمر محفوف بالمخاطر يؤثر عليها بطبيعة الحال، فسلوك النظم الديمقراطية ليس معناه صيانة الديمقراطية ذاتها أو مبادئها. إن الديمقراطية وحدها غير كافية لضمان استمراريتها، بدليل أن الدويلة الأثينية كانت على الطريق القويم إلى أن بدأت تنحرف في سياساتها التوسعية، مما أدى إلى نهاية الدويلة ووأد فكرة الديمقراطية ذاتها. وفي أغلب الأحوال، فهي دائمًا ما تستلزم صيانة فكرية وسلوكية لشعوبها وسياسييها على حد سواء، فتطرف الشعب وتشنج الساسة في المجتمعات الديمقراطية بداية للعودة إلى الوراء.
ثالثًا: هناك فكر سائد في المجتمعات الغربية بأن الإنسانية وصلت إلى غايتها بالمنظومة الديمقراطية التي لا خلاف على سموها مقارنة بأي نظام سياسي آخر في ظل ظروف أغلبية الدول. ولقد شاب ذلك وجود نوع من الحتمية الفكرية بأن معركة نظم الحكم حسمها التاريخ لصالح الديمقراطية التي يعدها البعض أفضل النظم الإنسانية في «الحرب المقدسة» على النظم التي تخالفها. ولكن خطورة هذا الفكر في حقيقة الأمر أنه يحمل بين طياته ولدى معتنقيه، بداية ما قد يبدو أنه «نقيض الأطروحة» للمضمون ذاته، وهو ما يدفع المجتمعات الديمقراطية إلى حالات محددة لاتباع سياسات متناقضة مع مفهوم الديمقراطية ذاته. فلو اتبعنا فرضية الفيلسوف الألماني الشهير إيمانويل كانط بأن الدول الديمقراطية أكثر ميلاً للسلم في سياستها، أو الفرضية المغلوطة بأن الديمقراطيات لا تحارب بعضها بعضا، فإننا نجد أنفسنا أمام بداية الطريق إلى الخطر. وهذا ما حدث عندما تجملت دويلة أثينا سياسيًا واعتبرت نفسها سامية على غيرها من الدويلات المجاورة، فاتبعت سياسة خارجية عنيفة، فصارت دويلة معتدية، فانتهت بالقضاء على واقعها الديمقراطي. وهو ما حدث نفسه في مناسبات أخرى على رأسها الديمقراطية الألمانية عندما سقطت «جمهورية فايمار» لصالح الطغيان النازي، والأكثر استغرابًا هو أن سقوطها أتى من خلال الديمقراطية ذاتها التي أفرزت الحزب القومي الاشتراكي (النازي) بزعامة أدولف هتلر، إلى مقاليد الحكم.
رابعًا: يدخل المفكّرون في فرضية نوع من الصراع بين الخير والشر على أساس الديمقراطية مقابل النظم غير الديمقراطية، بما يعيد للذاكرة الفكر الأثيني السائد خلال تجربتها الديمقراطية عندما وضعت لنفسها معيار السمو على باقي الدويلات اليونانية ولجأت لسياسات توسعية. كذلك يعيد إلى الذاكرة أيضًا مفهوم الحروب الدينية على أساس السمو الديني، كما حدث في الحملات الصليبية، التي اتخذت لنفسها ساترًا لسياساتها التوسعية على أساس سمو المجتمع المسيحي على غيره. ويبدو أن مثل هذا الفكر ليس بعيدًا عن التطبيق الآن على خلفية فرضية أن الديمقراطيات لها مهمة مقدسة نحو المجتمعات غير الديمقراطية بما لا تأخذ معه في الاعتبار تطورات هذه المجتمعات وأنها إما غير قادرة على الديمقراطية أو أنها بحاجة للمتغيرات الاجتماعية والسياسية والفكرية لاعتناق النظام الديمقراطي السليم، والأهم أن يكون هذا النظام متناسبًا بل ومتسقًا مع تركيبتها السياسية والاجتماعية.
خامسًا: يبدو وجود خلط كبير بين فكرة السمو الديمقراطي للنظم السياسية والمنتج السياسي المستخرج منه. فصحة النظام ومناسبته ليستا بالضرورة ترجمةً لصحة السياسة ذاتها، ذلك أن كثيرا من النظم الديمقراطية لا تنتج عنها سياسات سليمة أو حتى حكيمة أو منطقية، خصوصا أن صحة النظام لا تعني بالضرورة صحة سياساته. والمثال الذي يرد إلى الذاكرة حاليًا – وسبقت لي إثارته في أحد المقالات السابقة - هو أن أول تجربة ليبرالية في الشرق الأوسط برمّته كانت مصرية، ولكنها وئدت على أيدي نظام بريطاني شبه ديمقراطي في عام 1882. إن سلامة هيكل النظام أو عقيدته تختلف عن سلامة سياساته، وهذه قاعدة لا بد أن تؤخذ في الحساب عند خلط السياسة والفكرة بالحاضر والماضي.
لقد طرح المفكر الأميركي فرنسيس فوكوياما في كتابه الشهير «نهاية التاريخ وآخر رجل» فرضية أساسية، هي أن العالم وصل إلى غايته الفكرية والحضارية المنشودة في التركيبة الغربية الحالية المبنية على أساس الديمقراطية والحقوق الأساسية والرأسمالية. ولا غضاضة في أن نعترف بأن الديمقراطية تظل في معظم الأحيان من أفضل النظم السياسية المتاحة للشعوب، غير أن المعضلة الفكرية الحقيقية تكمن في بعض الأطروحات السابقة حول «الحتمية التاريخية» التي أقرّها فوكوياما وأمثاله حول مسار المستقبل المرتبط بالتاريخ، وهو الخطأ الحتمي نفسه الذي وقع فيه مؤسس الفكر الشيوعي كارل ماركس قبله بقرن ونصف من الزمان عندما فرض على المستقبل مسيرة لا مناص عنها على أساس مؤشرات التاريخ وتفسيره لها.
وهنا يشير النموذج الأثيني إلى عكس ذلك أيضًا؛ فالديمقراطية والتوجه الليبرالي، رغم أنهما من أفضل ما توصلت إليه البشرية لأغلبية المجتمعات، فهما ليسا بالضرورة مستمرين أو غير قابلين للتطور أو حتى غير قابلين للانتكاسة.. ذلك أنه مع الإيمان باستمرارية تاريخ الفكرة، فإن نهاية تطورها هي لحظة إعلاننا لنهاية إنسانيتنا، فتقديري أن أخطر ما يمكن أن يواجهنا اليوم هو وجود ديمقراطية بلا ديمقراطيين تمامًا كما نخشى من وجود ديمقراطيين بلا ديمقراطية.
9:48 دقيقه
من التاريخ: تأملات في ديمقراطية أثينا وغيرها
https://aawsat.com/home/article/510026/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7



من التاريخ: تأملات في ديمقراطية أثينا وغيرها


من التاريخ: تأملات في ديمقراطية أثينا وغيرها

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة