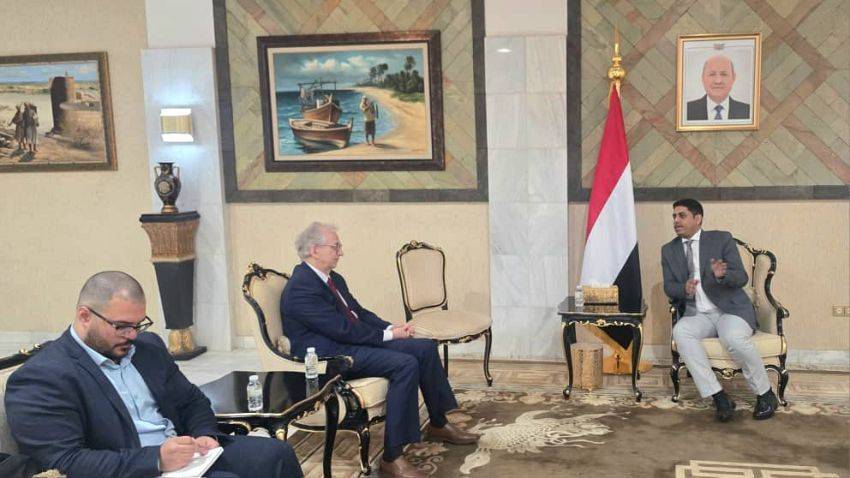تتفقد لوليانا علام، أزهارا زرعتها في باحات مدينة الهرمل (شمال شرقي لبنان)، بهدف تغيير صورة المدينة. «نصر على إبراز وجه الحياة هنا»، تقول علام، وهي مهندسة زراعية رومانية الأصل، تقيم في المدينة، «ردا على الصواريخ والتفجيرات التي ضربتنا، والقلق الذي يعيشه السكان».
تبدو مدينة الهرمل، التي تعد خزانا بشريا لحزب الله اللبناني، مدينة أشباح. تكاد تخلو طرقاتها من السيارات والمارة، باستثناء عناصر أمنية راجلة وأخرى تراقب في سيارات مدنية، تنتشر في شوارعها الرئيسة. هذه الإجراءات، اتسعت بعد تعرض المدينة لثلاثة تفجيرات انتحارية، منذ 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتبنتها مجموعات متشددة، قالت إنها تأتي ردا على تدخل حزب الله في القتال بسوريا.
تبدلت صورة المدينة منذ وقوع أول تفجير انتحاري فيها، بعدما «تأقلم» السكان مع الصواريخ التي ضربتها، انطلاقا من الأراضي السورية. ويقول علي ناصر الدين إن الأهالي «لم تخفهم الصواريخ التي كانت تسقط داخل الهرمل (تبعد 10 كيلومترات عن الحدود السورية) وكانوا يمارسون حياتهم الطبيعية»، مشيرا إلى أن التفجيرات التي تعرضت لها «بدلت صورة الحياة فيها، وتسببت في نزوح سكان إلى القرى المحيطة وإلى العاصمة، مما أدى إلى تراجع العمل التجاري في المدينة».
وتعرضت الهرمل، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 45 ألف نسمة، ومعظمهم من الشيعة، للقصف بـ205 صواريخ، على الأقل، انطلقت من ريف القصير بريف حمص بسوريا، ومن شمال القلمون بريف دمشق. أول الصواريخ كان في 20 أبريل (نيسان) 2013، بعد مشاركة حزب الله بالقتال في القصير إلى جانب القوات النظامية، وكان آخرها في 25 يناير الماضي، حين تبنت «كتائب عبد الله عزام» المرتبطة بتنظيم القاعدة إطلاق سبعة صواريخ على المدينة، قائلة إنها «رد على مشاركة حزب الله بالقتال في سوريا». واتخذ حزب الله والجيش النظامي السوري، منذ ذلك الوقت، سلسلة إجراءات عسكرية ميدانية داخل الأراضي السورية، أهمها استعادة السيطرة على منطقة النعمات السورية (شرق الهرمل)، ساهمت إلى حد كبير في منع المعارضة من إطلاق الصواريخ على المدينة اللبنانية.
غير أن القلق الذي يعتري السكان هنا، ناتج عن التفجيرات بالسيارات المفخخة ودخول الانتحاريين. فقد ضاعف الجيش اللبناني تدابيره الأمنية، وأقام أربعة حواجز ثابتة بين بعلبك والهرمل (45 كلم)، تدقق بالسيارات وتفتش ركابها، فضلا عن إجراءات احترازية أخرى، لمنع تعرض عناصره للتفجيرات. وكان حاجز الجيش على مدخل الهرمل تعرض في 21 فبراير (شباط) الماضي لتفجير انتحاري بسيارة مفخخة، أسفر عن مقتل ضابط وجندي وشخص مدني، وذلك أثناء تفتيش الانتحاري على الحاجز.
إلى جانب الإجراءات الرسمية، يتولى عناصر مدنيون، التدقيق بهويات الداخلين إلى المدينة، بعد حاجز الجيش. فعلى مسافة مائتي متر عن حاجز الجيش الكائن على جسر العاصي (مدخل الهرمل الشرقي)، يقف عنصران بلباس مدني، وغير مسلحين، للتدقيق بهوية السيارات العابرة وركابها. وعلى بعد أمتار منهم، ينتظر عناصر آخرون في سيارات مدنية، يراقبون العابرين إلى الداخل، ويتدخلون لإيقاف سيارات يشتبهون بأن ركابها غرباء.
ومن الصعب الحسم إذا كان هؤلاء منظمين في صفوف حزب الله، نظرا لأن سياراتهم، تختلف عن سيارات عناصر الحزب الرباعية الدفع التي يستقلها مسلحون على مداخل بلدة اللبوة، قبل نحو 30 كيلومترا من الهرمل، وهي الممر الإلزامي إلى بلدة عرسال، التي تقول تقارير إن السيارات المفخخة إلى لبنان تمر عبرها انطلاقا من مدينة يبرود السورية. ويقيم عناصر الحزب ببزات عسكرية، حواجز تفتيش للسيارات الغريبة، وهي القضية التي أثارت امتعاض السلطات اللبنانية، ودفعت وزير العدل اللواء أشرف ريفي لبحثها مع رئيس لجنة التنسيق والارتباط بالحزب وفيق صفا في أول اجتماع بينهما منتصف الشهر الماضي.
أما في الهرمل، فتختلف السيارات التي تستقلها عناصر المراقبة المدنيون عن آليات حزب الله في اللبوة، على الرغم من أن معظم سكانها يؤيدون حزب الله. وينفي أهالي المدينة أن يكون هؤلاء العناصر من الحزبيين. ويقول نائب رئيس البلدية عصام بليبل لـ«الشرق الأوسط»، إن هؤلاء «غير منظمين في حزب الله»، مؤكدا أنهم «لجان شعبية تطوعت لحماية المدينة». ويوضح بليبل أنه «بعد تعرض الهرمل للتفجيرات، انتدبت العائلات والعشائر، وهي المكون الرئيس للبيئة الاجتماعية في المدينة، شبانا منها لمراقبة الشوارع»، لافتا إلى أن شيوخ العشائر «طلبوا من حزب الله أن يقيم حواجز رسمية له هنا، لكن قيادة الحزب رفضت، كما رفض الجيش اللبناني إجراءات الأمن الذاتي، مما دفع بالعائلات لتطويع شبان لمراقبة المداخل والغرود المؤدية إلى المدينة، بهدف منع دخول السيارات المفخخة».
والعزلة التي تعيشها المدينة، ناتجة عن التفجيرات والتدابير الأمنية المشددة، إلى جانب إغلاق وسائل العبور إلى الداخل السوري بعد اندلاع الأزمة السورية. قبل الأزمة، كانت السوق الرئيسة بالنسبة للسكان، هي مدينة حمص السورية، وما لبثت أن تدهورت العلاقة بين الحالين، منذ سيطرة المعارضة على قرى ريف القصير في خريف 2012، وهو ما يعبر عنه السكان بوصفه «هجوما شنته المعارضة على قرى غرب العاصي، ما منعنا من زيارة الداخل السوري».
وكانت الهرمل، تقليديا، مفتوحة على القصير وحمص، ويستخدم السكان معابر حدودية شرعية وأخرى للتهريب، تتيح لهم تلقي الخدمات الطبية بتكاليف منخفضة، إلى جانب شراء المواد التموينية من السوق السورية. وتوترت العلاقة بفعل الحرب، مما أثر على القطاعين السياحي والتجاري في المدينة بنسبة 70 في المائة، لكن السكان ينفون أن تكون الأزمة أثرت على العلاقة بين أبناء المنطقتين.
وفي موازاة تأكيد حسام، وهو لاجئ سوري يقيم في الهرمل منذ فبراير الماضي، أنه لم يتعرض لأي مضايقات، ينفي نائب رئيس البلدية التعرض لأي سوري، بعد اشتعال الأزمة. ويؤكد بليبل أن «1400 عائلة نزحت من سوريا، تقيم اليوم في الهرمل، وتتلقى المساعدات الإغاثية والطبية، من غير أن يتعرض أي منهم للمضايقات»، مستدلا بتجربة السوري خالد حسيان الذي يقيم في المدينة.
ولحسيان، قصة مختلفة، يجمع سكان من الهرمل على سردها، وتعذر على «الشرق الأوسط» مقابلته في منزله بالهرمل بسبب ارتباطه بدوام عمل. يقول هؤلاء إن الرجل، سوري يقيم مع إخوانه في المدينة منذ قبل اشتعال الأزمة. وبعد اندلاع معارك القصير «توجه إلى سوريا للقتال إلى جانب المعارضة، حيث قتل شقيقاه في المعارك، فيما أصيب هو بجروح». وخلال نقله من سوريا إلى لبنان، طلب جيرانه في الهرمل أن يعالج في مستشفياتها، بدلا من نقله إلى مستشفيات طرابلس (شمال لبنان) المؤيدة بمعظمها للمعارضة السورية. واليوم، يؤكد السكان أنه «يعمل في نقل طلاب الهرمل إلى المدرسة، من غير أن يؤثر قتاله ضد النظام وحزب الله في القصير على رزقه في المدينة». ويقول شاب من الهرمل: «نؤمنه على أولادنا.. أليس ذلك كافيا للتأكيد بأننا لا نعاقبه على القتال ضدنا؟».
الأزمة السورية نفسها، غيرت معالم المدينة وسلوك قاطنيها. ينقسم السكان في هذا الوقت بين «لجان شعبية»، ومدنيين يحتمون خلف أكياس الرمل التي استخدمتها معظم المؤسسات دشما لواجهاتها الزجاجية. وكان إبراهيم علو، صاحب مقهى «برهوم» الكائن وسط المدينة، أول الساعين لوضع دشم من أكياس الرمل «بهدف توفير مكان آمن للرواد الراغبين بتدخين النرجيلة أمام المقهى في الهواء الطلق»، وذلك بعد الانفجار الثاني في الثاني من فبراير الماضي الذي ضرب محطة وقود، ويبعد نحو 200 متر عن المقهى. وخلافا للمؤسسات المصرفية والتجارية التي أغلقت واجهاتها بأكياس الرمل بشكل نهائي، ترك علو مساحة صغيرة، أشبه بنافذة، تسمح للجالسين خلف أكياس الرمل بمشاهدة ما يدور في الشارع. يقول: «نهدف من هذه النافذة، إلى الإعلان عن أن المقهى مفتوحة»، مشيرا إلى أن الطلاب والشبان الذين يرتادون المقهى «يفضلون التدخين في مكان مفتوح، وهو ما دفعنا لوضع دشم رملية تحميهم من عصف التفجيرات في حال وقوعها». وتفنن السكان بأنواع الدشم، إذ استخدم بعضهم البراميل المعبأة بالمياه «بهدف إخماد النيران الناتجة عن التفجيرات في حال وقوعها»، كما تقول سارة أمهز، وهي موظفة في متجر لبيع الأدوات المنزلية.
وتخلو السوق التجارية في المدينة إلى حد كبير من الرواد والزبائن. يقول وصفي علو (سائق سيارة أجرة): «لم نعتد جمودا على هذا النحو.. لقد قضت التفجيرات على أرزاقنا». وعلو، الذي ينقل سكان القرى من وإلى المدينة، يؤكد أن السكان «يعيشون هاجس التفجيرات»، وهو ما دفع بكثيرين منهم إلى النزوح نحو القرى المحيطة. ويضيف: «تضاءلت حركة أهالي القرى إلى حد كبير نحو المدينة، حيث يلزم اللاجئون بلدات مثل بريصة والتركمان (سبعة كيلومترات عن الهرمل) وغيرها، للحد من تنقلاتهم»، لافتا إلى أن أولاده غادروا المدينة «ولا يرتادونها إلا إذا دعت الحاجة».
القلق في الهرمل، وعزلتها الاقتصادية عن البلدات السورية، هاجسان يسيطران على السكان. ووسط الشائعات عن سيارات مفخخة ستعبر إلى المدينة، وتطورات الأزمة السورية، لا تزال يوليانا علام تزرع الورود، وتشرف على تقليم الأشجار، وتسدي النصائح للنساء حول العناية بشتلات الأزهار التي تزين الأرصفة ووسط الطرقات ومداخل المنازل. تعيش يوليانا في عالم من الجمال، تتحدى به قلقها، وقلق الناس من تفجيرات محتملة.
الهرمل تحولت إلى ثكنة عسكرية.. وسكانها تأقلموا مع الصواريخ
(«الشرق الأوسط») زارت المدينة اللبنانية المتاخمة للحدود السورية.. ولجان شعبية تدير أمنها

لبنانيان يدخنان النرجيلة في أحد مقاهي الهرمل خلف السواتر الترابية (تصوير: حسين درويش)

الهرمل تحولت إلى ثكنة عسكرية.. وسكانها تأقلموا مع الصواريخ

لبنانيان يدخنان النرجيلة في أحد مقاهي الهرمل خلف السواتر الترابية (تصوير: حسين درويش)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة