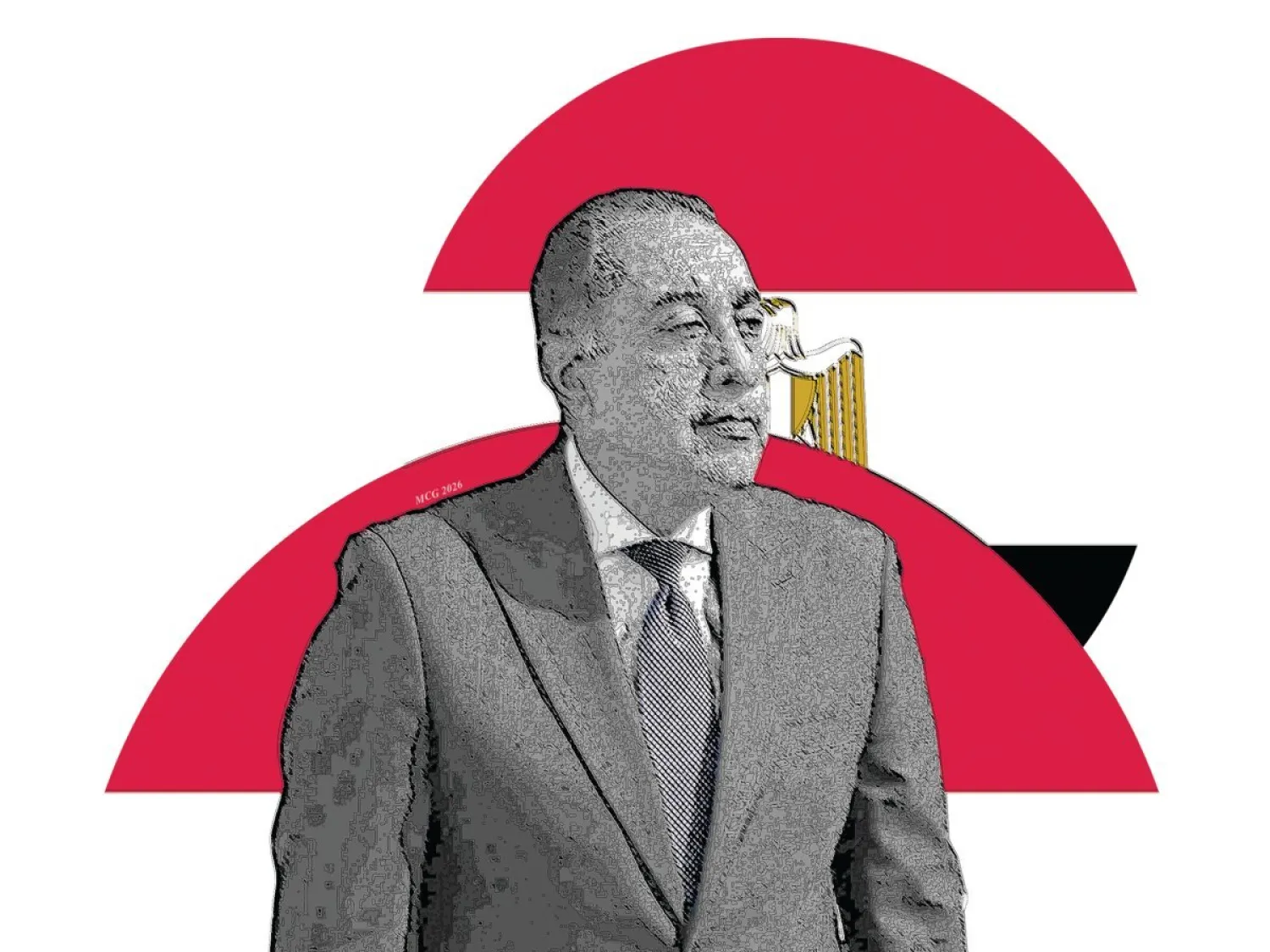رفع قبضته.. هز سبحته.. هتف من على أكتاف مرافقيه العسكريين بسقوط المحكمة التي تريد أن تنبش ماضيه بعد ربع قرن من الزمن، هكذا ظهر الرئيس التشادي السابق حسين حبري في الجلسة الأولى من محاكمته بالعاصمة السنغالية دكار، يُجر بالقوة للمثول أمام قضاة أفارقة وهو من أفرط في استخدام القوة لقمع من تشم فيه رائحة معارضة حكمه في الفترة ما بين 1982 و1990؛ سنوات الجحيم بالنسبة للتشاديين.
لم يكن ذلك الرجل النحيف وطويل القامة بزيه الأفريقي الأبيض ونظرته الحادة والغامضة المقبلة من خلف لثام صحراوي، ليوحي للوهلة الأولى بأنه متهم بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم تعذيب»، وأن ضحاياه يزيد عددهم على 40 ألف نسمة وفق تقديرات منظمة العفو الدولية.
دارت الأيام وتقلبت بشكل لا يصدق في سيرة حياة الرئيس التشادي السابق، فمن طالب في كليات الحقوق الفرنسية إلى متمرد لفت الأنظار بخطف رعايا فرنسيين في سبعينات القرن الماضي، ثم أصبح بعد ذلك الرجل القوي الذي تراهن عليه القوى العالمية للوقوف في وجه طموحات العقيد الليبي معمر القذافي، قبل أن ينتهي به المطاف مطاردًا في العاصمة السنغالية من طرف جيش من المحامين والمنظمات الحقوقية انتهت في الأخير بجره أمام المحكمة، كل هذا مر على الرجل وهو يمارس هوياته المفضلة: الصمت ثم الصمت، فلا شيء بالنسبة له يستحق الثرثرة وفتح ملفات الماضي.
ينحدر حسين حبري من شمال تشاد، حيث ولد عام 1942 لينشأ ويترعرع في بيئة صحراوية قاسية مع عائلة بدوية تمارس رعي المواشي، وبالكاد عرف الاستقرار في طفولته المضطربة، على الرغم من كل ذلك أظهر الفتى حبري قدرة كبيرة على التأقلم والصبر والتحمل، وأبان في وقت مبكر قدرة كبيرة على المناورة في الصحراء. استطاع المراهق حبري أن يشغل منصب نائب رئيس الإدارة المحلية، قبل أن ينتقل إلى فرنسا عام 1963، حيث تابع تعليمه في معهد الدراسات العليا لما وراء البحار، وبعد ذلك درس الحقوق في باريس، والتحق بمعهد العلوم السياسية، وأصبح يطالع كتب فرانتز فانون وارنستو «تشي» غيفارا وريمون ارون، غير أن الغريب في الرجل أنه لم يظهر طيلة مسيرته غريبة الأطوار هذه أي نوع من الانتماء الفكري الصريح.
عاد حبري من فرنسا عام 1971، وهو يحمل شهادة في الحقوق ترشحه ليكون سياسيًا مخضرمًا في بلده، غير أن خلفيته البدوية المتمردة وطبيعته الصحراوية القاسية لم تكن لتتركه يجلس خلف مكتب مريح لينتظر التعيين، فالتحق بجبهة التحرير الوطني لتشاد التي تولى قيادتها قبل أن يؤسس مع شمالي آخر، هو جوكوني عويدي مجلس القوات المسلحة للشمال، بدأ حبري يلفت الأنظار إليه في الخارج منذ عام 1974 عندما اختطف عالمة الإثنيات الفرنسية فرنسواز كلوستر، واحتجزها لثلاث سنوات أجبر خلالها فرنسا على التفاوض مع المتمردين.
ظل حبري يتدرج في المناصب حتى شغل منصب رئيس الحكومة في عهد الرئيس فيليكس مالوم غير أن حبال الود بين الرجلين لم تلبث أن انقطعت، عاد حبري إلى المناصب وزيرًا للدفاع في عهد رفيق دربه وصديقه غوكوني عويدي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت عام 1979، لم يتأخر الصدام بين الرفيقين حبري وعويدي، فالأخير كان مؤيدًا للعقيد معمر القذافي الصاعد بقوة في الجارة الشمالية ليبيا، فيما كان حبري لا يخفي عداءه للقذافي الذي يمثل بالنسبة له خطرًا واضحًا على بلده.
تطور الخلاف بين عويدي وحبري إلى حرب أهلية عنيفة في أنجامينا، تعرض فيها حبري لخسائر أجبرته على الانسحاب من المدينة عام 1980، غير أنه تمكن من جمع صفوف مقاتليه في مناطق الغابات بشرق تشاد، ليبدأ رحلة من الكفاح المسلح ضد نظام عويدي المدعوم من طرف القذافي، غير أن ذلك لم يمنع حبري من دخول أنجامينا عام 1982، حيث بدأ يتضح أن قوى كبيرة تقف وراءه.
بعد أن هزم عويدي وأزاح الموالين للقذافي من أنجامينا، التفت حبري إلى الشمال، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من حياة حسين حبري أصبح خلالها العدو الأول لنظام القذافي الذي يحتل جيشه مناطق واسعة من شمال تشاد، فنجح حبري في طرد الجيش الليبي من الأراضي التشادية عام 1987، خاض حبري معركته ضد القذافي وهو يسند ظهره إلى المخابرات الأميركية والفرنسية، وقد استقبل من طرف الرئيس الأميركي رونالد ريغان والفرنسي فرنسوا ميتران، اللذين قدماه للعالم على أنه «بطل تحرير»، وإحدى الركائز التي لا بد منها لتحقيق السلام في منطقة الصحراء الكبرى، وهكذا أصبح حبري الرجل الذي اختاره الغرب ليقف في وجه القذافي، غير أنه في الوقت الذي كان يحقق النجاحات على الصعيد الخارجي كانت قبضته الحديدية تخنق التشاديين.
في هذا السياق يقول الصحافي النيجري صديق آبا في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن «كل ما كان يجري من فظائع في ظل حكم الرئيس حسين حبري كان بمباركة من فرنسا والولايات المتحدة، فالوثائق تشير إلى أن عناصر من الشرطة السرية لحبري تلقوا تدريبات خاصة في الولايات المتحدة وفرنسا، وأن وحدات خاصة فرنسية وأميركية كانت تنشط في تشاد، بعض هذه الوحدات كان يوجد في مقرات قريبة جدًا من أماكن احتجاز وتعذيب السجناء»، من جهة أخرى يقول هنري ثولييز، وهو باحث في منظمة العفو الدولية، إن «حبري ارتكب جرائم الاغتيال، الاختفاء والتعذيب.. وفرنسا لم تكن تجهل جميع هذه الجرائم التي قام بها حسين حبري وشرطته السرية».
لم تلبث أن اهتزت القبضة الحديدية للرجل أمام الصعود القوي لعسكري آخر قاد تمردًا من داخل الأراضي السودانية، إنه الرئيس الحالي إدريس ديبي إيتنو، الذي نجح في هز أركان حكم حبري وأرغمه على الفرار مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 1990، إلى الكاميرون ومنها إلى السنغال.
حرص حبري على الابتعاد قدر الإمكان عن الأضواء طيلة 25 عامًا عاشها في السنغال، مستفيدًا من ثروة كبيرة جمعها قبل مغادرته لتشاد، قدرتها جهات حقوقية بأكثر من 128 مليون دولار أميركي، فكان يقطن في بيت متوسط الحال في أحد الأحياء الشعبية العادية في دكار، غير أنه يملك قصرًا كبيرًا في واحد من أرقى الأحياء السكنية في دكار، يقول جيرانه السنغاليون إنه قليل الكلام ولا يميل إلى مخالطة الجيران، غير أنه يحرص في الوقت نفسه على حضور جميع المناسبات الدينية، ويؤدي الصلوات الخمس في المسجد المحاذي لبيته. منذ وصوله إلى السنغال استطاع حبري أن يربط صلات قوية مع نقاط النفوذ في المجتمع السنغالي، فالمصادر تتحدث عن أموال وزعها على بعض الأحزاب السياسية وأسر دينية تتمتع بنفوذ كبير، ونجح بفضل ذلك في خلق رأي عام سنغالي متعاطف معه.
كل ذلك لم يمنع الملاحقة القضائية للرجل في معركة استمرت لأكثر من 15 عامًا، حيث بدأ الحديث عام 1999 عن «الجرائم» التي ارتكبها جهاز الشرطة السرية التابع لنظامه بعد أن قام رجل يدعى سليمان غوينغوينغ، بالكشف عن مئات الملفات التي دفنها في حديقة بيته تسرد تفاصيل الرجال والنساء الذين تعرضوا للتعذيب والقتل بأيدي رجال إدارة التوثيق والأمن المروعة في سجون النظام السرية، لتبدأ المعركة من طرف منظمات حقوقية تشادية قبل أن تدخل على الخط منظمة «هيومان رايتس ووتش» التي لعبت دورًا كبيرًا في تحريك الملف، وزارت تشاد بشكل سري في مناسبتين سجلت خلالهما ووثقت ملفات 12321 ضحية من ضمنها 1208 حالات وفاة خلال التعذيب والاعتقال.
في غضون ذلك، يشير تقرير صادر عن هذه المنظمات الحقوقية إلى أن «حبري قضى في السلطة 8 أعوام ملطخة بالدماء، شابها إعدام 40 ألف شخص بإجراءات موجزة، وعمليات إخفاء قسري. كما عانى من التعذيب ما يقرب من 200 ألف شخص، بأيدي الشرطة السرية المخيفة، أو إدارة التوثيق والأمن».
نجحت هذه المنظمات في نقل المعركة القضائية للمرة الأولى إلى السنغال عندما تم الاستماع في جلسات مغلقة إلى بعض الضحايا، وأصدر حكم بالإقامة الجبرية في حق حبري، غير أن المحكمة العليا نقضت الحكم، وأمام الضغط الدولي لوح الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد إلى إمكانية ترحيل حسين حبري إلى تشاد، ومنحه فرصة شهر ليغادر السنغال، رغم مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرها القاضي البلجيكي في حقه، اعتمادا على وجود 3 مواطنين بلجيكيين بين الضحايا، رفعوا دعواهم أمام المحاكم البلجيكية.
ارتفع مستوى الضغط الدولي على السنغال، عندما دعا الاتحاد الأفريقي إلى محاكمة بـ«اسم أفريقيا» في المحاكم السنغالية، وهو الأمر الذي ظلت السلطات السنغالية تتلكأ فيه حتى وصول الرئيس الحالي ماكي صال، الذي أعلن نيته الوفاء بالتعهد للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما تم عبر تعديل القوانين السنغالية لتشكيل الغرف الأفريقية غير العادية، التي أقيمت في السنغال بدعم من الاتحاد الأفريقي، في فبراير (شباط) عام 2013.
بدأت محاكمة حسين حبري أمام قضاة أفارقة وعلى أراضٍ أفريقية، وهي محاكمة وإن كانت تمثل انتصارًا بالنسبة لضحايا نظامه، فإنها في الوقت نفسه تمثل بالنسبة للأفارقة نهاية للعهد الذي يحاكم فيه الرؤساء الأفارقة أمام محكمة الجنايات الدولية، فيما يعدها آخرون خطوة أولى في مشوار طويل وشاق نحو بناء عدالة أفريقية صلبة.. أما حسين حبري فوصفها بالمسرحية، فيما جلست زوجته في وسائل الإعلام السنغالية لتتحدث عن «محاكمة صورية لآخر رجل مخلص لقضايا القارة الأفريقية».