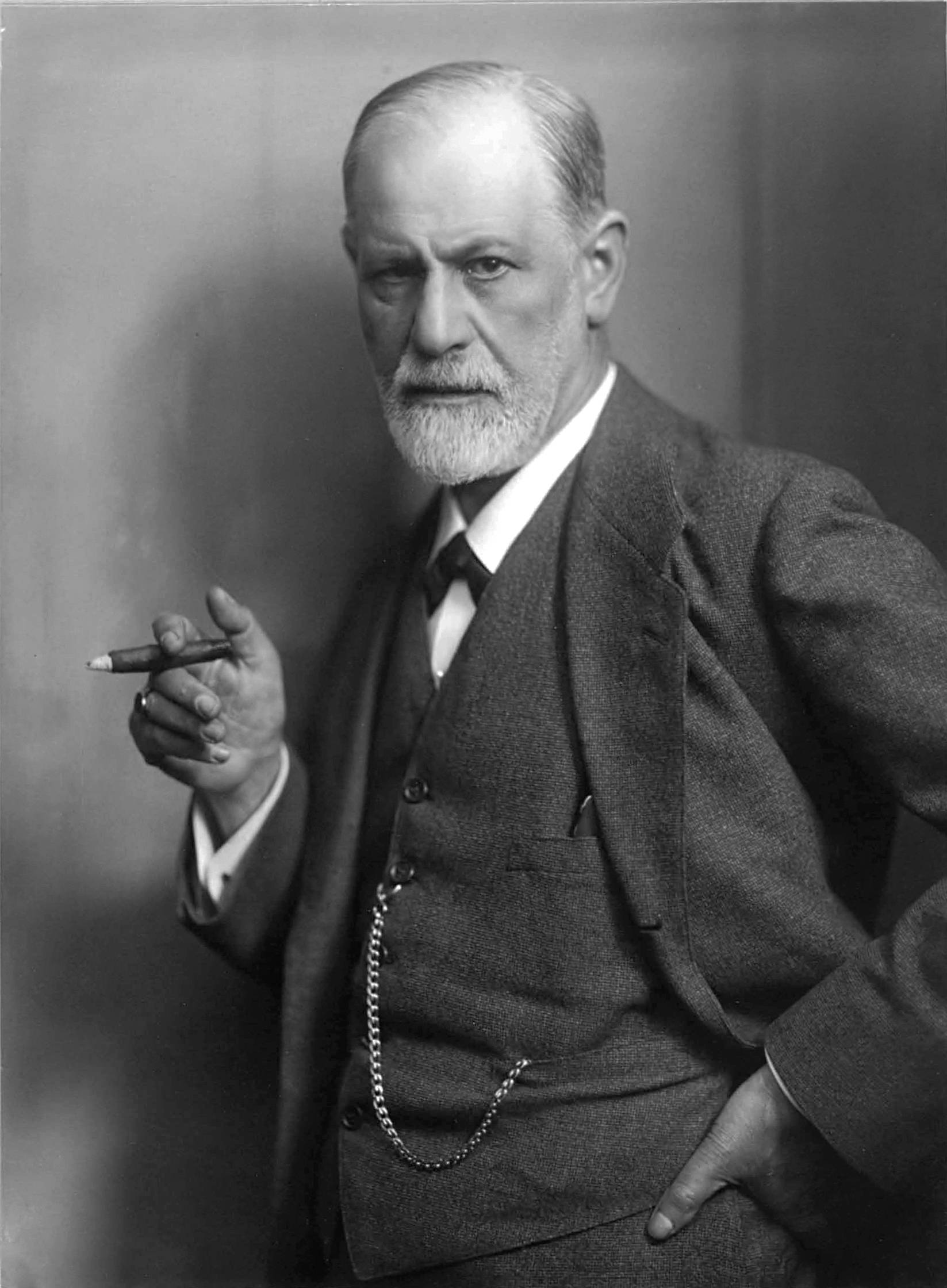يفتتح علي جعفر العلاق سيرته الذاتية «إلى أين أيتها القصيدة؟ سيرة ذاتية» (دار الشؤون الثقافية، بغداد، 2022) بتبريز الصلة غير المعلنة، عندنا في الأقل، بين السلطة وتأسيس المدن، ربما الأفضل أن نقول إن الشاعر يدشن سيرته باستظهار الصلة الخفية بين تأسيس المدينة «واسط: بناها الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 78 هجرية وأتمها سنة 86 هجرية لتكون مقراً جديداً لجنده»، وحاجات السلطة لديمومة بقائها واستمرارها، وفي الطليعة منها، حاجة حكامها للاستبداد.
لكن «واسط» لم تكن، فقط، المدينة التي ابتلعت صرخات الجند والفلاحين على يد الحجاج، إنما هي، كذلك، سردية أخرى تعيدنا لمصائر المدن التي تظل محكومة بلحظة تأسيسها الأول. هكذا كانت واسط مقراً لجند الحجاج، وهي المدينة (السجن) التي مارس فيها الحجاج سلطته وشهواته العارمة نحو الاستبداد، مثلما تحكمت، في زمن آخر، لحظة التأسيس الأولى لـ«بغداد»، فكانت لحظة حرق الأساسات التي أمر بها مؤسسها، أبو جعفر المنصور، ليرى «بغداده» تاريخاً، أبدياً، يروي لنا الحكايات المختلفة عن المصائر التعيسة لبغداد، كما لو أنها تستعيد لحظة حرقها الأولى. لكن الاحتفاء بـ«واسط» المشبعة بالقمع والدماء يقابله تغييب جزئي لحاضرة «واسط» الحالية: الكوت «تأسست على الأرجح سنة: 694»؛ إذ يجري ذكر «الكوت» بصفتها قصة تتبع حكاية الشاعر الكبرى: قريته، أو أسطورته الأولى كما سيكتب في صفحات لاحقة من سيرته. لا احتفاء، إذن، إلا برغبة «الشاعر» بالاعتراف «هل يعني الاعتراف معنى الاحتجاج؟ لا أظن!»، ضد السلطة القامعة التي صنعت واسط، وهي سلطة مماثلة لأخرى شهد وعاش بطشها الشاعر ذاته في مراحل أساسية من حياته، فكان أحد «المتضررين»، بقدر ما، من إدارتها لملفات الثقافة.
سيرة ذاتية... أين الاعتراف إذن؟
لكن المفارقة أن السيرة لا تشهد اعترافات «أساسية» أو «صادمة» ضد السلطة القامعة، مثلاً، أو بعض مراتبها من «نخب» سياسية، أو ثقافية، أو حتى أدبية؛ ما دامت السيرة ذاتها تفتتح نصها بالغمز من قناة السلطة وتستعيد صراخات ضحاياها. لا أثر لهذا النوع من «المكاشفات» الجذرية سوى في نقطتين اثنتين، وبحدود ضيقة: حديث الشاعر، أولاً، عن جيله الستيني الصاخب سياسياً وثقافياً. ثمّ في حديثه، ثانياً، عن إدارته «المختلفة»، حقاً، لمجلة الأقلام العراقية الرائدة ذات التأثير الكبير على حركة الحداثة والتحديث الأدبي في العراق والعالم العربي كله. وهي، بهذا الوصف، ذاكرة أخرى للثقافة في العراق.
في استعادته لتجربة جيله الستيني الصاخب لا نجد تلك الرغبة المحتدمة، شأن شعرائه المشهورين بتأميم صخب الجيل ونسبته لكاتب «الشهادة» ولاتجاهه السياسي، كما حال سامي مهدي أو فاضل العزاوي. نحن هنا، إزاء سيرة تحاول، قدر المستطاع، أن تنأى بنفسها عن تلك الصدامات العنيفة بين قطبي ذلك الجيل المحتدم. ولعل لزمن كتابة السيرة، المتأخر على أي حال، دوره الفاعل في «تهدئة» النفس، ودفعها صوب التأمل الهادي لتجربة يصعب فيها فصل الثقافي عن السياسي. هي كذلك؛ منذ بداياتها الأولى، وليس ختاماً بمجلتها الشهيرة «69» وبيانها الشعري.
وظلت على حدتها، حتى بعد عقدين ويزيد، عندما جرى فتح الملفات مجدداً منتصف التسعينات؛ فكانت النتيجة أن جرى اختصار الجيل الستيني كله بعنوان مشبع باللحظة العابرة؛ فهو محض «موجة صاخبة»، فيما جعلها المقصي والخصم «الروح الحية».
فلا حدود وسطى، لا حياد يُعترف به. ظلت «سردية» الجيل المنتصر على سواه، لكن المنشطر على نفسه بين «داخل» تقلبت به أحوال البلاد بين ديكتاتورية لا حدود لبطشها وحروب لا تنتهي ثم حصار انتهى باحتلال البلاد، و«منفى» مطرود إلى أقصى الدنيا وممنوع من «العودة»، هي النسق المعلن والخفي، معاً، لأي «سيرة» تُكتب عن الجيل الستيني. حتى العلاق، صاحب هذه السيرة، وبرغم إشاراته الحذرة لهذه الحقائق، فإنه يعود ليؤكدها ويحاول، من ثمّ، أن يحيِّد شعره ووجوده الإنساني المتفرد؛ فهو يقول لنا إنه كان «ينمو» في مكان «بقعة» يحاذي الجيل الستيني. ولا سبب لهذا «التعفف» عن تصدر مائدة الستينيين سوى اثنين. الأول، يخص الشعر نفسه الذي رغب العلاق بكتابته والاختصاص به. وهو شعر يتقاطع مع الرغبة الجامحة للستينيين أنفسهم في الثورة على كل الأشكال الشعرية السابقة، لا سيّما ما يتصل منها بتجارب الرواد، مما يسميه العلاق نفسه بـ«الهرج الستيني الصاخب». ويتقاطع، كذلك، مع عمود الشعر العربي الذي تنتسب إليه قصيدة العلاق. والثاني شخصي يتصل بـ«التعفف» عما يمكن تسميته بالأسطورة الشخصية - الشعرية المبنية على نظام الشلل الحزبية أو الثقافية. فهل اختلف الأمر مع إدارة الشاعر لمجلة «الأقلام» الشهيرة؟
ذاكرة أخرى للثقافة في العراق
ربما تكون «شهادة» الشاعر علي جعفر العلاق الأولى في سياقها؛ إذ لم يسبق لي أن قرأت شهادة حقيقية يكتبها «شاعر» أو «كاتب» أو «مثقف» معروف تولى إدارة «مجلة» أدبية معروفة مثل «الأقلام» في حقبة البعث، وتأتي شهادته في سياق «كشف» حقيقة ما حصل. أكتب هذا الكلام وأنا أستعيد صرخات أحد الموقعين على البيان الشعري الشهير، وكان يعترض على كلامي في ندوة نظمتها إحدى كليات جامعة بغداد لمناسبة الميلاد الخمسين لمجلة «الأقلام» قبل سنوات. في وقتها، كنت أتحدث عن «الأقلام» بصفتها ذاكرة أخرى للثقافة في عراق مبتلى بالاستبداد وثقافته. لكن «شهادة» العلاق عن مجلة «الأقلام» أكثر من مجرد شكوى من «تطفل» أو «نميمة» مغرضة ضده شخصياً، أو حتى تقرير حزبي يُرفع مباشرة لوزير الثقافة آنذاك (لطيف نصيف جاسم)، بسبب ملف أدبي معروف بعنوان «الشاعر العربي الحديث ناقداً»، نُشر في أحد أعداد المجلة عام 1985، وتضمن مشاركة لأكثر شاعر عربي إشكالية، والمقصود أدونيس ولا شك، مع كمال أبو ديب؛ فهذا مما كان يحصل كثيراً، وربما بانتظام مذهل، في وسط ثقافي، عراقي أو عربي، يعتاش على النميمة الشخصية والحزبية. إنما لشهادة العلاق قيمة مضافة، تاريخية ذات ترميز عميق؛ فالعلاق هو ابن المؤسسة الثقافية العراقية، وإن شئت فقل: المؤسسات التي أعيد بناؤها في عهد البعث، وهي التي أحكمت قبضتها على مفاصل الثقافة العراقية في العقود الثلاثة الأخيرة حتى سقوط النظام واحتلال البلاد.
ولا أظن أن هذا التوصيف يضر شاعراً وناقداً مكرساً مثل العلاق؛ فهو قد تحول للعمل الوظيفي «الثقافي» في عهد البعث الثاني، وأكمل في عهده دراسته العليا بلندن، وأدار مجلة «الأقلام» (1984 - 1990) بتكليف من وزير الثقافة والإعلام. مثلما لا يضير العلاق قولهم إنه كتب شهادته بعد طرد صدام من الكويت «وهل كان هناك سبيل آخر غير الصمت أو الموت؟!»، ربما يؤخذ على العلاق صمته الطويل، حتى بعد خروجه من العراق مطلع التسعينات عن كتابة شهادته - سيرته، ولا بأس، فالسير الشخصية تُكتب لاحقاً، وهو الشاهد الحي على ما حصل في عهد إدارته لـ«الأقلام»، وفي بلاده حتى خروجه من العراق وإقامته الطويلة بعيداً عنه.
في النهاية؛ فإن السيرة تتضمن، لا سيّما في كلام الشاعر عن جيله الستيني وإدارته لمجلة «الأقلام»، إشارات نصية واضحة لتحكم السلطة بالثقافة وإدارتها لمؤسساتها، بل إن السيرة تقول الكثير ضمناً عن مثقفي السلطة، أو من صنعتهم وفرضتهم على المؤسسات والجامعات، ثم تسربوا خارج البلاد فصاروا يكتبون باسم «المنفى» والمعارضة الثقافية للنظام الذي صنعهم. لا يقول علي جعفر العلاق هذا الكلام بنصه، إنما يترك القارئ يستنتج كيف جرت محاربة فكرة الحداثة وتحديث الشعر والخطاب النقدي، كما حاولت مجلة «الأقلام» تقديمه بإدارة العلاق، وليس إقصاء كتاب أدونيس التأسيسي «الثابت والمتحول» من التداول النقدي في العراق سوى صيغة أولى وشائعة، أيضاً، للرقابة الصارمة، وبرغم ذلك، فقد ترك العلاق نفسه أن تواجه مشقة الصدام مع الممنوع.
وفي كل مرة، وكلما جرى الكلام في السيرة عن خراب البلاد، نستعيد دلالات افتتاح السيرة بمشهد الحلاج ومدينته واسط، كأن هذا الافتتاح «تميمة»، أو كناية عن أي مدينة «تصنعها» السلطة على مقاسها، تصنعها مرة وتخربها مرات.
خلال اللحظات الثلاث «السلطة - المدينة، جيل الستينات، مجلة (الأقلام)»، فإن السيرة تمضي هادئة؛ إنها حكاية عائد إلى قريته النائمة قريباً من دجلة، على مقربة من مدينة الكوت التي تمر على ذكرها السيرة سريعاً؛ وهي «عودة» متأخرة، أو استعادة لحياة مضت بعيداً عن بداياتها الأولى. لكنها سيرة أي عراقي، وربما أي عربي، عاش الظروف والحياة ذاتها. الفارق، فقط، في الاحترافية البالغة في كتابة السيرة؛ فالسيرة تبرع في الاقتصاد السردي، فيما يتصل بعرض المقاطع المثيرة الجاذبة لانتباه القارئ، لا سيّما ما يتصل منها بحياة ذلك الفتى الفقير النازح مع عائلته إلى بغداد من وسط العراق.
فلا نرى السيرة ساعية لتوريط القارئ في «تراجيديا» تعلِّق «الشاعر» بأمه، كما يحدث كثيراً في السرديات السيرية العربية، برغم أنه يذكر ويسرد أصول علاقته بأمه، لا سيّما موته بعيداً عنها، لكنه لا يجعلها «دراما» كلية ووحيدة. إنما يجري التركيز على سيرة الأب حتى لحظة موته. وأظن أن هذا التركيز يرجع لإغراءات سردية «الفقدان» المبكر والمؤسس للمسارات اللاحقة في حياة الشاعر.