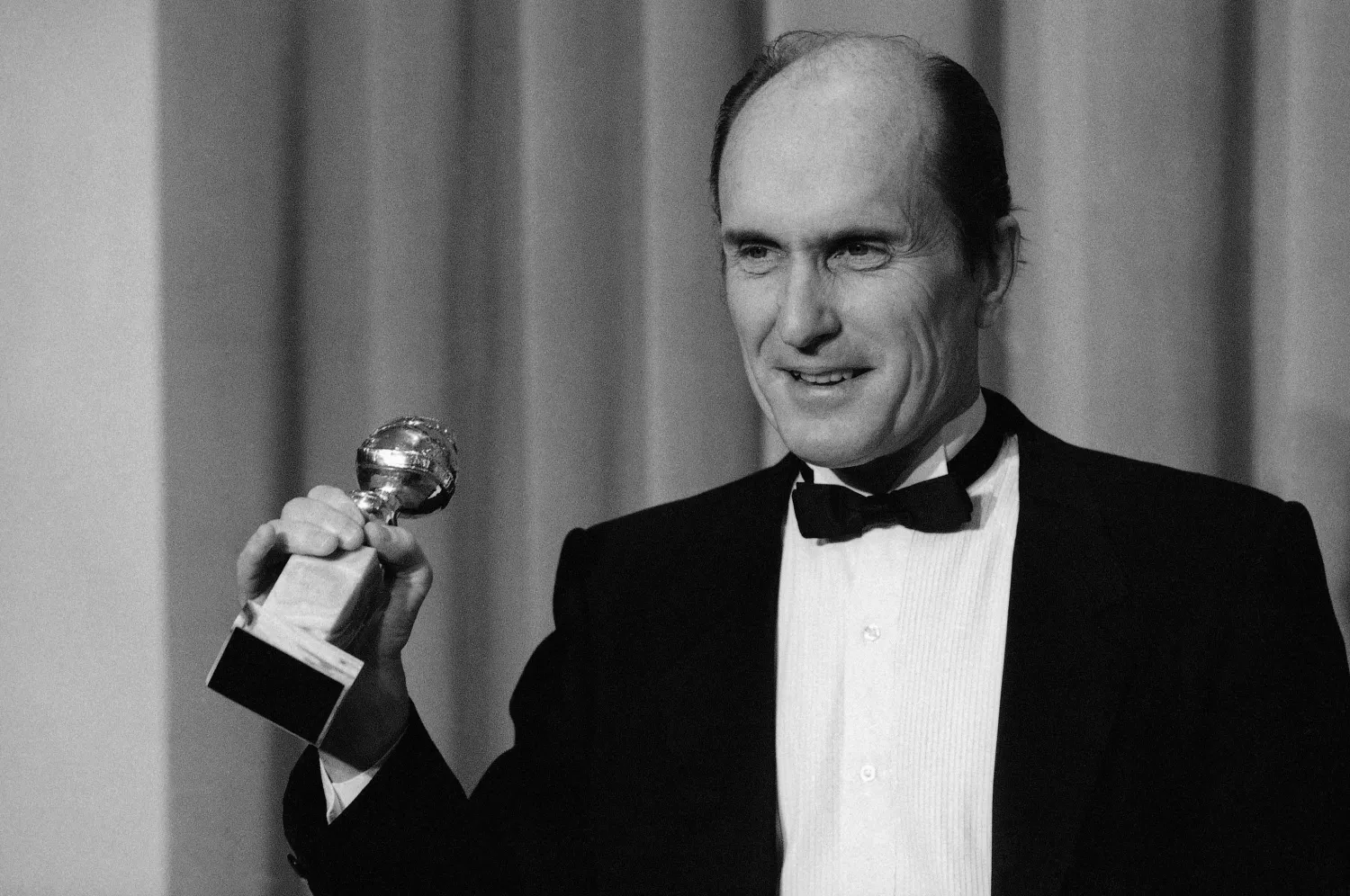احتوى فيلم يوسف شاهين «الإسكندرية كمان وكمان» (1989) حكاية مخرج (شاهين نفسه) وهو يحاول الإقلاع بمشروعه ماراً بالتجارب المختلفة الموزّعة بين فنانيه وفنييه، وكذلك تلك التي يمر بها في كل مرّة يقف وراء الكاميرا لتحقيق نفسه سينمائياً. على عكس فيلمه الآخر «حدوتة مصرية» (1982) الذي منح نور الشريف فرصة تمثيل شخصية شاهينية، قام يوسف شاهين ببطولة «الإسكندرية كمان وكمان».
شاهين (1926 - 2008) طالما غازل نفسه عبر أفلامه («الإسكندرية - نيويورك» أيضاً)، أو على الأقل، عبر عناوين بعضها («القاهرة كما يراها شاهين»)، لكنه كان يلتزم بمبدأ ما يعرضه عن نفسه وتجربته ونظرته إلى ما يسرده من مواقف (هذا بعد استثناء أفلام البدايات الأولى). بذلك دارت أفلامه حول نفسه أكثر مما دارت حول أزمات محددة حتى عندما تعرّض لمواقف سياسية («الاختيار»، 1971. و«العصفور» 1972) هي، في طرحها، استمراراً لمنهجه الفني والذاتي أكثر مما هي أي شيء آخر.
حتى في «الإسكندرية، كمان وكمان» و- إلى حد - في «سكوت ح نصوّر» (2001) كان في وارد الحديث عن تجربته وليس عن السينما بذاتها والموضوعات المتعددة التي كان يمكن طرحها في هذا النطاق.
غاية القول إن المخرج (وهذا ليس للتقييم) وسواه من المخرجين العرب قلّما عاينوا متاعب العمل السينمائي أو عالجوا الأزمات والأحداث التي تقع داخل الصناعة نفسها.
ما يتداوله النقاد والإعلام عموماً حول «أزمات الفيلم العربي» و«السينما العربية»، لا تعكسه معظم الإنتاجات العربية. آخر المحاولات كانت قبل نحو سنة عبر فيلم إيلي خليفة «قلتلك خلص»، حيث يحاول المخرج - الممثل، إقناع المنتجين بمشروعه المقبل ليجد أنهم يريدون فرض أفكارهم عليه.
موجة جديدة
مع خروج فيلم «بابيلون» (Babylon) جديد داميان شازِل إلى العروض السينمائية، تكتمل موجة حديثة من الأفلام الأميركية التي تتداول النظرة إلى تاريخ السينما في هوليوود عبر أعين مخرجيها. هي ليست المرّة الأولى في تاريخ هوليوود التي طُرحت خلالها هوليوود كقضية على الشاشة. فيلم «سنست بوليفارد» لبيلي وايلدر (1950)، و«السكين الكبير» (The Big Knife) لروبرت ألدريتش (1955)، من بين أمثلة متعددة لكيف اشتغلت بعض أفلام هوليود على موضوعها الشائك.
يُستبعد كذلك، الأفلام، من فترات متعددة، التي تناولت حكاياتها مواضيع حول سينمائيين يحاولون دخول هوليوود أو الحكايات التي تتخذ عاصمة السينما مكاناً لأحداثها مثل «The Big Picture» («الفيلم الكبير»، لكريستوفر غست، 1989)، و«Get Shorty» («اقبض على شورتي» لباري سوننفلد، 1995) أو حتى «مولهولاند درايف” (ديفيد لينش، 2001).
الموجة الجديدة تلقي نظرة فاحصة (قد لا تكون برّاقة) على هوليوود المخفية وراء هوليوود التي نعرفها. نتحدث عن «هايل سيزار» لجووَل وإيثان كووَن (2016)، و«مانك» لديفيد فينشر (2020)، و«ذات مرّة في هوليوود» لكونتِن تارنتينو (2019)، و«بلوند» لأندرو دومينيك (2022)، و«بابيلون» لداميان شازل (2022).
الحقب مختلفة لكنها، بالنسبة لهذه النماذج المساقة، تاريخية كما لو أن مخرجي هذه الأفلام وجدوا في الماضي ما يتلألأ تحت الرماد، أو، في المقابل، ما لا يُثير الاهتمام إذا ما كان الحديث عن هوليوود اليوم. هذا ربما موعده بعد بضعة عقود من اليوم.
هوليوود، بحد ذاتها، مثيرة للحبكات المختلفة. تستطيع أن تكتب حكاية بوليسية تقع أحداثها فيها أو كوميدية أو عاطفية أو تتخذها كموقع كارثة طبيعية. تستطيع أن تُمحور موضوعك حول شخصية محددة فيها، قد تكون شخصية مخرج أو كاتب أو ممثل. لكن ما يجمع الأفلام الواردة هي أن هوليوود التي نراها في هذه الأفلام هي المقصودة بذاتها حتى وإن بدا «بلوند» حديثاً عن مارلين مونرو كما أدّتها الكوبية آنا دي أرماس.
سقوط
هذا لأن حكاية مارلين مونرو هي نفسها حكايتها مع هوليوود وحكاية هوليوود معها، تماماً كما كان الحال في الفيلم المنسي «فرانسيس» لغرايم كليفورد (1982) الذي قصّة حياة ممثلة موهوبة قضت على مستقبلها الإشاعات والضغائن وعوملت بقسوة بالغة ليس من هوليوود وأركانها فقط، بل - ومثل حال مارلين مونرو - من والدتها، مما أدّى إلى إدخالها، عنوة، لمصح نفسي قضت فيه سنوات من شبابها وطموحاتها.
في «بلوند» لم يكترث المخرج دومينيك لسرد حكاية مارلين مونرو بمنأى عن محيطها الفني. سبق لأفلام ومسلسلات تلفزيونية أن قامت بهذه المهمّة متناولة حياتها الفنية ومتاهات حياتها الشخصية. دومينيك هو من ربط، أكثر من سواه وبوضوح لم يجرؤ عليه أحد ممن سردوا حكاية الممثلة الشقراء، بين متاعبها وبين الطريقة التي عاملت هوليوود هذه الموهبة كدمية أنثوية مثيرة. يذكر، بالأسماء، من اغتصبها ومن استغلّها ورئيس الجمهورية الذي كان يطلبها لكي تلبي رغبته الجنسية بينما يتحدّث في السياسة على الهاتف.
هوليوود ملتصقة بحياة مونرو على نحو موحٍ لحكايات كثيرة من المنوال نفسه ولمستوى من العلاقات التي خيّمت على مدينة الأحلام في ماضيها.
مثله، يلقى «بابيلون» لداميان شازل، نظرة فاحصة على تلك المدينة المزدحمة بالنوايا والثغرات التي تنسل منها النواحي والجوانب الإنسانية لتبدو المدينة كما لو أنها النموذج الحاضر لما يعرف بسدوم وعموره، المدينتين الوارد ذكرهما بالاسم في الإنجيل (وبالإيحاء في القرآن الكريم) كمثال على الفساد والسقوط الأخلاقي.
الفترة التي اختارها شازل هي نهاية العشرينات ومطلع الثلاثينات عندما تهاوت أحلام ممثلين وممثلات فشلوا في الوثوب من السينما الصامتة إلى الناطقة. ليس هذا موضوعه الوحيد، بل يشغل نفسه بمواضيع عدّة تحت سقف واحد: هوليوود التي كانت، في ذلك الحين، مرتع الشهوات وتداول المنافع الشخصية وانحداراتها ما بين الإدمان على الكحول والإدمان على المخدرات والجنس.
أشباح الموت
لا نجد في «مانك» لديفيد فينشر الحديث نفسه، لكن هذا لا يعني أنه لم يتطرّق لتاريخ هوليوودي شائك.
تقع أحداث هذا الفيلم في الأربعينات عندما كان المخرج أورسن وَلز على أهبة تحقيق فيلمه الروائي الطويل الأول «المواطن كاين». مفتاح الفيلم هو ركوب موجة الادعاء بأن هرمان مانكيفيتز، هو الذي كتب ذلك الفيلم الرائع وليس مخرجه. لكن معظم الفيلم استعادات لمرحلة حياة الكاتب في تلك الفترة، ومن خلالها يوجهنا المخرج فينشر لمعاينة هوليوود كما كانت ولطرح مشاكل التبعيات الدينية (هوليوود واليهود)، والسياسية كالانتخابات وصراع اليسار واليمين وسطوع شمس النازية في ألمانيا وكيف سكت رؤساء الاستوديوهات اليهود على ما كان يصيب يهود ألمانيا حتى لا يخسروا السوق الألمانية حينها (سبق لهذه الصفحة أن تناولت سياسة غض النظر الهوليوودية حيال النازية في الثلاثينات). يقدّم لنا الفيلم مانك وسط هذا التجاذب. هو كان مجهولاً لدى أرباب هوليوود ويُنظر إليه بهزء (في أحد المشاهد يناديه أحدهم بـ«مونكي ويتز»).
ينجح الفيلم في توظيف مشاهد الفلاشباك، لكنه يفقد قدراً من أهميّته قبيل النهاية. هو فيلم ضروري أكثر مما هو فيلم جيّد، لكن في مقابل كل تقصير هناك حسنات تُعين الفيلم على التحكم بمستواه. ولا ينفع كثيراً أن أولدمن، رغم تمثيله الجيد، أكبر سناً من الشخصية التي يؤديها بنحو 20 سنة.
أما فيلم «ذات مرّة في هوليوود» (Once Upon a Time in Hollywood) لكونتن تارنتينو فيستدير صوب فترة أخرى منتقلاً إلى الستينات مع أفول نجومية ممثلي أفلام الوسترن في الحقبة السابقة واضطرارهم للتوجه إما لمسلسلات تلفزيونية أميركية أو لبطولة أفلام سباغيتي وسترنز في إيطاليا.
بتناول ثلاثة محاور مختلفة ومتوازية، اثنان منها يدوران حول ممثل و«دوبليره» (ليوناردو دي كابريو وبراد بيت)، والثالث يدور حول الممثلة شارون تايت (مارغوت روبي) التي أجهضت أحلامها قبل أوانها بفعل المجزرة الشهيرة التي وقعت ضحية لها.
في محصلته هو عن أشباح موت متعددة المصادر والرؤوس: موت النجومية، وموت فترة من الحياة التي لا تعود، وموت شارون تيت، ومن ثَم الموت الأكبر الذي تجسده هوليوود كما كانت وكما لن تعود.
وكان الأخوان جووَل وإيتان كووَن حققا فيلماً في الفترة نفسها التي انطلق منها فيلم أندرو دومينيك «بلوند» وانطلق منها كونتن تارنتينو في «ذات مرّة في هوليوود». في ذلك الفيلم اختارا الخمسينات لعرض حكاية رئيس الإنتاج في أحد استوديوهات (جوش برولن) يواجه عدة مشكلات: بطل الفيلم التاريخي الذي تنتجه شركته (جورج كلوني) يتعرض لعملية خطف مقابل فدية. وهناك ممثل آخر، في فيلم آخر (شانينغ تاتوم) يخطط للجوء إلى الاتحاد السوفياتي. هذا لجانب مشكلات أخرى على رئيس الشركة مواجهتها.
لا بأس بالمنظور العام كون الفيلم يسبر جوانب تلك الفترة ويتعرض بالنقد الساخر إلى مسائل بعضها (كالخلاف بين يساريي هوليوود ويمينييها) كان موجوداً بحق.
ما هو مناقض للواقع شخصية مانيكس- برولن الناصعة على نحو شبه منفرد، إذ إن الشخصيات الأخرى تتبدّى سلبية كما حال الشخصية التي لعبتها سكارلت جوهانسن (ممثلة أنانية وعدائية)، وتلك التي أدّاها كلوني (ساذج وجبان)، وتاتوم (خائن لبلاده) ... إلخ.
للتذكير فقط، سبق للأخوين كووَن أن تعرّضا لهوليوود وبعض عناصر حياتها في «بارتون فينك» (1991) عن ذلك الكاتب النيويوركي الذي انتقل للعمل في هوليوود فوجد نفسه مثل سمكة خارج الماء.