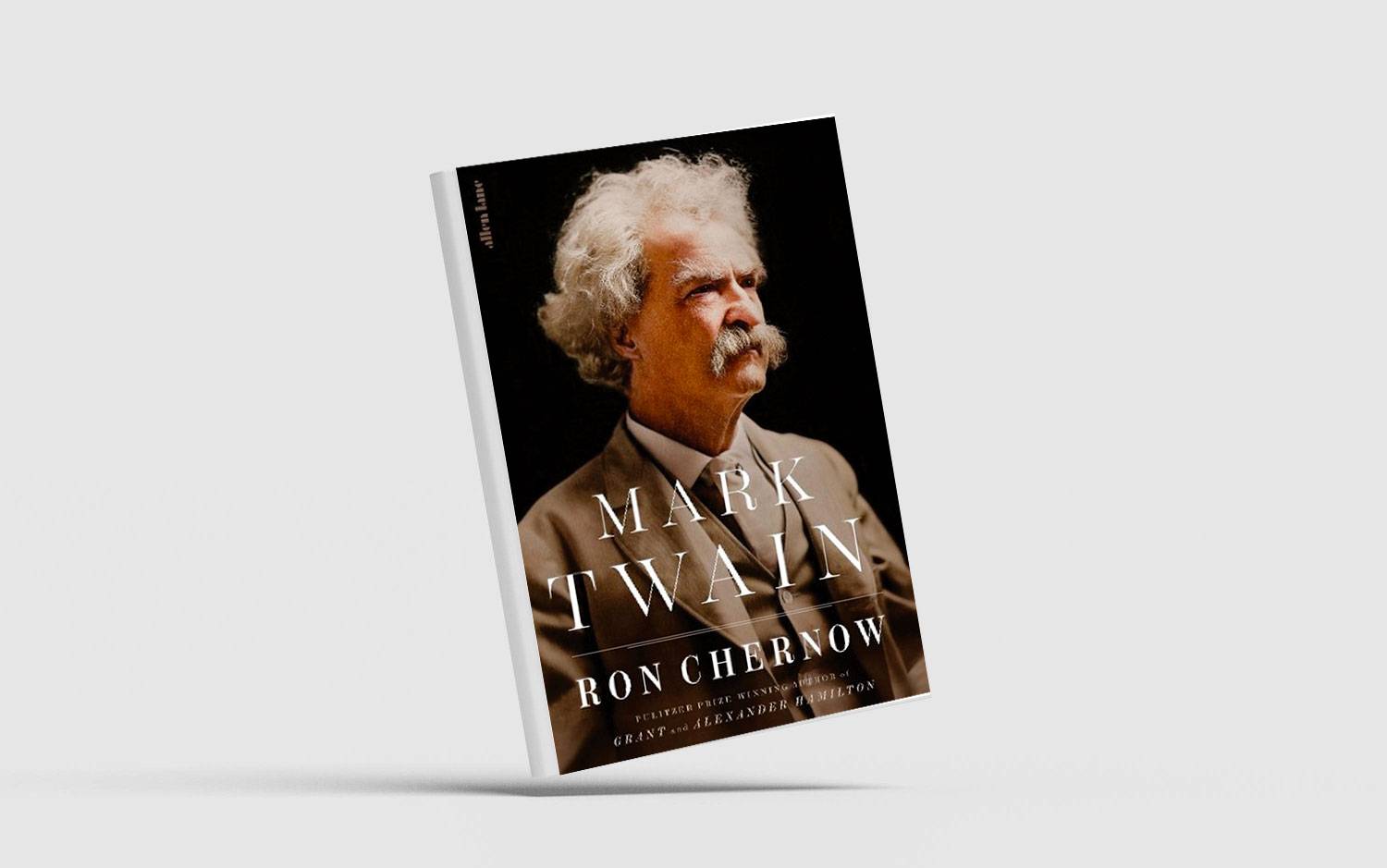أصدرت دار نشر جامعة نوتردام الأميركية في نهاية أبريل (نيسان) 2015 الكتاب العاشر بالإنجليزية للأستاذ الدكتور محسن جاسم الموسوي، أستاذ الأدب العربي والمقارن في جامعة كولومبيا في نيويورك. والكتاب الجديد بالإنجليزية ظهر بعنوان (جمهرة الآداب في العصر الإسلامي الوسيط: البنية العربية للمعرفة). والكتاب يعنى بالفترة بين القرنين الثاني عشر والثامن عشر، ويشمل المساحة الشاسعة بين الصين وبغداد ودمشق ومراكش والأندلس. ويصف روجر ألن الكتاب أنه لا بد منه لتكذيب أسطورة (العصور المظلمة) و(عصور الانحطاط) التي صادق عليها دعاة (النهضة).
ولأن الكتاب يشكل مفصلاً معرفيًا خطيرًا، كان لنا هذا اللقاء بالدكتور محسن الموسوي:
* لماذا وقع اختياركم على هذه القضية؟ لا سيما أن معظم الدارسين العرب والمستشرقين نفضوا أيديهم منها وتعاملوا مع نتاجها كـ(ركام) ومخلفات عصر تدهور وانحطاط؟
- جئت إلى هذه القضية من نقطة القطيعة هذه وسعيت لتبين المحنة التي تدفع بالبحاثة إلى صرف النظر عن فترة طويلة، من القرن الثاني عشر إلى الثامن عشر، تحت أعذار ومسميات شتى.
ورأيت أن التسمية التي نالتها تلك المرحلة ومنتوجها المعرفي جاءت في نهاية القرن التاسع عشر عندما أخذ المستشرق ومعه الدارس العربي يطمئن إلى آليات التفكير التي أخذت بها أوروبا في عصر التنوير، وهي آليات تقوم على ثنائية العقل والخرافة. وكان إعلاء العقل الذي ميز المرحلة التنويرية في أوروبا وازدهار الفلسفة العقلانية يعني ضمنًا رفضًا للعصور الأوروبية الوسطى، تلك العصور التي أطلق عليها (غوته): رداء التبن الرث. ووجد النهضويون العرب في ذلك الرفض مثالاً يحتذى، خاصة أن العصور العربية الوسطى هذه اقترنت بسقوط المركز، أي بغداد العباسية، وأفول النجم السياسي للمركزية العربية. ورغم ازدهار القاهرة أيام المماليك، وظهور مراكز إشعاع متفرقة في المغرب العربي وآسيا، إلا أن ضياع المركز مثلت لواحد مرموق كالقاضي والمؤرخ المصري ابن دقمقاق (بقاء الدنيا بلا خليفة).
هذا الفقدان أصاب العرب باضطراب عجيب، وهو ما نلاحظه في كتابة المؤرخين عن انهيار المركز.
لهذا السبب رأيت لزوم تجاوز هذا (الجرح) الذي حال دون التمعن في المنتوج الثقافي وقاد إلى شطب تاريخ كامل من دون تدقيق أو تمحيص.
* لكن ابن خلدون تعامل أيضًا مع انهيار الحضارات كأمر حتمي، أي أن سقوط بغداد جاء نتيجة حتمية لازدهار بالغ؟
- نعم. كان ابن خلدون من بين قلة قليلة من المؤرخين الذين جمعوا (العلوم الاجتماعية) بالوعي التاريخي ولذا نظر إلى الأمر، في الأندلس، كما في الحضارة العباسية، على أساس جدلي: فكل تنام بالغ ينتهي بتفكك (العصبية) وانفراط الجامع الذي كان يشد الأطراف المختلفة. ولهذا لم يقرن ابن خلدون السقوط أو الأفول السياسي بانهيار ثقافي حتمي.. فكلاهما له خطه المتباعد عن الآخر. والطريف أن ابن خلدون عند لقائه بتيمور لنك خلف أسوار دمشق استخدم اللقاء لتعزيز نظرته للتاريخ: إذ لاحظ كيف أن قادة المغول يشاركون عصبتهم ما يملكون وما يأكلون، وعرف من ذلك سر قوتهم وانشدادهم بعضهم للآخر. وكما نعلم، كان جنكيز خان يفعل ذلك أيضًا عندما غزا بغداد وهتك ثراءها وقتل نبلاءها. ورغم المأساة السياسية والحضرية التي نالت المشرق العربي ودولاً أخرى اجتاحها المغول، لكن الثقافة أخذت مسارات خطيرة، هي ما دعتني إلى عدم الرضوخ لمبدأ معادلة التدهور السياسي بالانهيار الثقافي، ذلك لأن النتاج الثقافي تزايد وأخذ مسارًا ومنظورًا يبرر القول بوجود أجواء نشطة من الجدل والحوار والتراسل والفن.
* لكن التهمة التي كررها العرب إلى يومنا هذا هو أن المنتوج ما هو إلا (إعادة إنتاج)، و(شروح) و(حواشٍ) حتى أن الدارسين العرب منذ جورجي زيدان قالوا عن المرحلة إنها ثقافة (الشروح والحواشي).
- هنا تكمن المأساة. نعم، توجد شروح، وتوجد وفرة من الحواشي. ولكن هذه الرؤية التي بالغ فيها زيدان وآخرون لم تر حتى الجانب المضيء في الشروح والحواشي، رغم أن هذه لا تشكل إلا نسبة اعتيادية في الكم الهائل من الإرث الثقافي لتلك المرحلة: فالشرح يعني (تلبية لحاجة) واستجابة لرغبة أي أن الشارح يتعامل مع قرائه مباشرة في هذه الشروح. ولولا الحاجة لما رغب في ذلك. أما الحاشية فهي فن فريد في حينه، شأنها شأن الهوامش التي ترافق البحث الأكاديمي في القرن العشرين. فالهامش، شأن الحاشية ليس فائضًا، بل يأتي مكملاً للنص.
ومن الجانب الآخر تميزت المرحلة بما يلي:
1- ظهور المعاجم الكبرى، كلسان العرب لابن منظور والقاموس المحيط لفيروز آبادي وتاج العروس للزبيدي.
2- تميزت بأكبر موسوعات في السير لابن خلكان وياقوت الحموي، ومن أضاف إلى ذلك من ملاحق وتجديد طيلة المراحل التالية كابن شاكر الكتبي وصلاح الصفدي وابن معصوم، وعشرات غيرهم.
3- ظهرت حينذاك الموسوعات المعرفية كخزانات أدب، لابن حجة الحموي والبغدادي وغيرهما.
4- ازدادت نزعة تحقيق النص الشعري ودراسته، وهذا ما فعله الصفدي وابن نباتة.
5- ظهرت السيرة الذاتية كمنتوج متميز، عند ابن منقذ، وعين القضاة الهمذاني، وابن معصوم.
6- ظهرت فنون الشعر السبعة، وكتب فيها صفي الدين الحلي وابن حجة وابن تغري بيردي.
وهذه الفنون نالت الدرس المستفيض لأول مرة على أساس أنها تشغل المساحة بين (الصالون) والشارع. كما ظهرت دراسة الموشح الأندلسي عند ابن سناء الملك أولاً، ثم ابن الخطيب وآخرين.
وهذه تحولات مهمة في الذائقة الشعرية العربية، درستها بعناية ووضعت بعض الأسس التي تتيح للمتمعن أن يتحرر من القيود التي وضعته داخلها المدرسة التقليدية في قراءة الشعر ونقده طيلة القرن العشرين.
7- وتميز العصر بحوار جاد بين الفلاسفة والفقهاء والعلماء والبلاغيين، ولهذا تتابعت الردود والتعليقات وشغلت هؤلاء وهم يقيمون بين سمرقند والقاهرة وحلب وقرطبة وفاس والقيروان وأصفهان وشيراز ومرو. وعندما نبصر هذه الظاهرة وتوالد النقاش على مدى قرن أو أكثر ندرك كم أن مشعل المعرفة لم يمت، كما يراد لنا أن نعتقد، ولم تخمد جذوة التحليل والدرس والحجاج. ولو تأملنا مثلاً ما يكتبه فخر الدين الرازي وما يلتقطه الطوسي وما ينشغل به ابن خلدون والتفتازاني والأجي، ندرك كم نخطئ عندما نتصور العصر خلوًا من حوارات جادة وعميقة تستمر بعد رحيل أصحابها وتستأثر باهتمام المجايلين والتالين.
8- ولو تأملنا الظاهرة (البديعية)، أي الجهاز البلاغي النقدي الذي يرافق قصيدة المديح النبوي لزومًا والذي شرعه أولاً صفي الدين الحلي، ولو تأملنا هذه الظاهرة التي استمرت منذ نهاية القرن الثالث عشر ولغاية القرن العشرين. وعرفنا التراكم البلاغي للبديع وأصنافه ومسمياته لتبين لنا أن هذا لا يمكن أن يكون إسرافا، وإلا كيف نفسر هذا التراكم إن لم تكن هناك رغبة جمهور مستمع وقارئ؟ هذا الجمهور لم يعد يكتفي بالإصغاء بل يريد شراكة فعلية في استيعاب التكوين البلاغي للقصيدة.
9- تنامي مفهوم الرحلة، وكان ابن بطوطة يمضي شوطًا أبعد بكثير من ابن جبير وهو يصل الصين، ويقيم في الهند ويصف اللقاء بأفراد عرفهم في طنجة، إذ بدت ممالك الإسلام مفتوحة أمام الرحالة، فلا قيود ولا مصاعب. والرحلة هي من مواصفات (الجمهرة) التي أنا بصددها في هذا الكتاب: فكما أن الحج كان سبيلاً للاحتكاك والمعرفة والتأليف (عند ابن عربي بخاصة)، كانت الرحلات والمواقع المعينة كالزوايا مثلاً والمساجد، تتيح اللقاء والاجتماع وتبادل المعرفة، إضافة إلى المألوف من مدارس وجامعات.
* ولكن، ما الذي يسوغ استخدامكم لمصطلح (جمهورية الآداب)، الذي تقترح ترجمته أنت كـ(جمهرة الآداب الإسلامية في العصر الوسيط: البنية العربية للمعرفة)؟
- المسوغات كثيرة، فهناك أولاً وجود سبل التواصل والاتصال من حج وأسفار وزوايا المتصوفة والمدارس والمساجد، وهناك أسفار الكتاب نفسه الذي يقيم علاقته مع آخرين يكتبون عنه ويجدون في التعليق والرد. ولنأخذ مثلاً على ذلك كتاب السكاكي، مفتاح العلوم. فأنت يمكن أن تراه كتابًا في النحو، كما ألفناه. لكنه ليس كذلك. إنه الأساس الفقهي لا لعلم النحو وفقه اللغة فحسب وإنما للبناءات أو اللبنات المعرفية التي يستند إليها الفيلسوف والبحاثة والدارس. ولهذا كان القزويني يرفده بالمختصر، ويخصه آخرون بالمطولات والمختصرات، وفتح (مختصر) القزويني جادة للتفتازاني وآخرين. وهكذا توالدت شجرة نسب هائلة تمتد عبر سمرقند ومرو وحلب والقاهرة وفاس مثلاً. وهناك ما يشبه ذلك. أما إذا ما ذهبنا إلى (الظاهرة) الأدبية، كظاهرة الفنون (الشعبية في الشعر) كالكان كان والدوبيت والمواليا.. إلخ، نرى أن هذه ازدهرت كثيرًا في ذلك العصر. وعلى المتأمل الناقد أن يتريث قبل إطلاق الأحكام جزافًا على ضعف (النثر): فالظاهرة ليست اعتيادية. وأصحابها يجمعون بين فصيح اللغة وعاميتها، وأغلبهم من أصحاب المهن والحرف.
وهكذا للظواهر تفسيرها وأسبابها، بما يعني أن (الشارع) سرق المبادرة من (البلاط العباسي) وغيره، خاصة أنه لم يعد قائمًا، وآلت الظاهرة الأدبية إلى الجمهور المنتوج. وهنا، علينا أن نتوقف عند هذه الظاهرة التي ميزت ذلك العصر: فالمعرفة لم تعد حكرًا على الفئة المترفة وعلية القوم.
وهناك ظواهر تلقائية، وأخرى جدلية، وثالثة بالإكراه. فمثلاً عند التمثيل للظاهرة ببعدها الأخير، علينا أن نتوقف عند هذا الأمر: وهو أن تيمور لنك أخذ أسرى إلى سمرقند حرفيي دمشق، أولئك الشجعان الذين لم يبدعوا في صناعة نسيج الحرير وغيره وإنما كانوا وحدهم المقاتلين الذين حموا أسوار دمشق وصنعوا الأسلحة الدوارة على هذه الأسوار لتذيق تيمور وجيشه المر الكثير. أخذ هؤلاء أسرى إلى سمرقند ليحيوا هناك صناعة الخز والحرير.
ليس هذا فقط، كانت الغزوات تفرض كرهًا انتقال مفكرين وأدباء من مدينة إلى أخرى، فكان ياقوت يكتب عن بقائه في مرو (يرتع) بين مكتباتها وهو يؤلف معجم البلدان بمجلداته الذائعة. وأمثاله كثر. وما نقوله عنه مثلاً، يقال عن ابن عربشاه، الذي أسره تيمور وهو لم يزل صبيًا، وذهبوا به إلى سمرقند. لكنه خرج في النتيجة حانقًا على تيمور، متعلمًا لعدد من اللغات بين ثقافات إسلامية متعددة، ومؤلفًا مشهورًا يشهد له تلامذته المبرزون بالمعرفة الواسعة. وهناك عشرات الأمثلة التي تضمنها الكتاب والتي تبرر التسمية المذكورة.
* ولكن إذا ما طالبتك بتحديد التسمية، لماذا وقع هذا الاختيار؟ لماذا لم تكتف مثلاً بـ(الآداب) في العصر الإسلامي الوسيط؟
- السؤال وجيه. هناك كما قلت ظهور الامتياز الذي يمكن أن نسميه (المجال العقلاني للتحاور) هذا المجال أتاح حركية المعرفة وتناميها بعيدًا عن حدود (البلاغة) التي عطف بها الجرجاني حرة من جديد وهو يأتي بـ(النظم) تعريفًا للسياق المعرفي في ميدان البلاغة بصفتها ساحة المنازلة في شتى المجالات، وصاحبة آلياتها وأدواتها. فمن دونها لا حوار ولا سياسة ولا جد ولا اجتهاد. وظهور هذا (المجال) هو الذي أتاح أن يتحاور حتى (تيمور لنك) مع علماء دمشق، وأن يصبح بلاطه (مقرًا) للمتحاورين الكبار من أمثال الشريف الجرجاني والتفتازاني مثلاً. وهذا المجال هو الذي أتاح كل ظاهرة، ومنها (الظاهرة البديعية) أن تشكل شجرة نسب على مدى عدة قرون. ومن الجانب الآخر، علينا أن نعي أن العالم الإسلامي وما يخص العلماء منه خاصة، استخدم هذا المجال كثيرًا، حتى أن ابن خلدون مثلاً كتب كيف كانت كتب التفتازاني معروفة ومتداولة في القاهرة، إذن، نحن بإزاء عدة أمور، التراكم المعرفي، التحاور عبر الأزمان والأمكنة، وتكوين أشجار نسب لمجموعة من الظواهر.