في الوقت الذي أصبحت فيه «سلة خبز العالم» مهددة جراء الحرب الروسية - الأوكرانية، حيث تصدّر الدولتان ما يقرب من ثلث صادرات القمح في العالم، حسب الإحصاءات الرسمية، يلقي الباحث الكرواتي د. بريدراج ماتفليجيتفيتش، في كتابه «الخبز» الضوء على الأهمية الثقافية والخصوصية الرمزية لواحد من أقدم الأطعمة التي عرفها البشر لدى الحضارات والأمم المختلفة.
وحسب هذا البحث الذي قامت بترجمته للعربية ندى نادر، فإن نشأة الخبز تعود إلى قديم الأزل فهو أقدم من الكتب بل أقدم من الكتابة نفسها فأسماؤه الأولى وُجدت منقوشة بلغات بائدة على ألواح مصنوعة من الطين، وربما كانت طوبة البناء هي ما أوحى لأول صانع للخبز بشكل الرغيف، ففي ذاكرة الشعوب يُصنع الطوب اللبن من الطين باستخدام النار فيما يشبه طريقة صنع عجين الخبز.
كما أنه لا أحد يعرف متى أو أين نبتت أول سنبلة من الحبوب، لكن لا بد أن مظهرها قد جذب الانتباه وأثار الفضول، فالتوزيع المنظم للحبوب الموجودة على الجذع قدم مثالاً للانسجام والاعتدال وربما المساواة، في حين أن تنوع وجودة الحبوب المختلفة كشف عن مزايا الاختلاف.
ويذكر الباحث أنه يمكن العثور على آثار الحبوب الأولى في عدة قارات، ففي العصور القديمة ازدهرت تلك الحبوب في سهول الهلال الخصيب وهي منطقة تمتد اليوم إلى العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن ومناطق وادي النيل في مصر جنباً إلى جنب مع المنطقة الجنوبية الشرقية لتركيا والأطراف الغربية لإيران... وقد نما القمح في منطقة القرن الأفريقي بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بالقرب من أكسوم وأسمرة وأديس أبابا وفي نهايات الصحراء عند هضاب إثيوبيا وإريتريا حيث يكون المناخ أكثر اعتدالاً والأرض أكثر خصوبة وذلك بالقرب من منبع النيل الأزرق الذي يتدفق ليلتقي بالرافد الآخر لهذا النهر الرائع النيل الأبيض، وتتمتع المنطقة بوفرة من أشعة الشمس على نحو يذكّرنا بمقولة الشاعر الألماني هولدرين: الخبز هو ثمرة الأرض التي يباركها النور».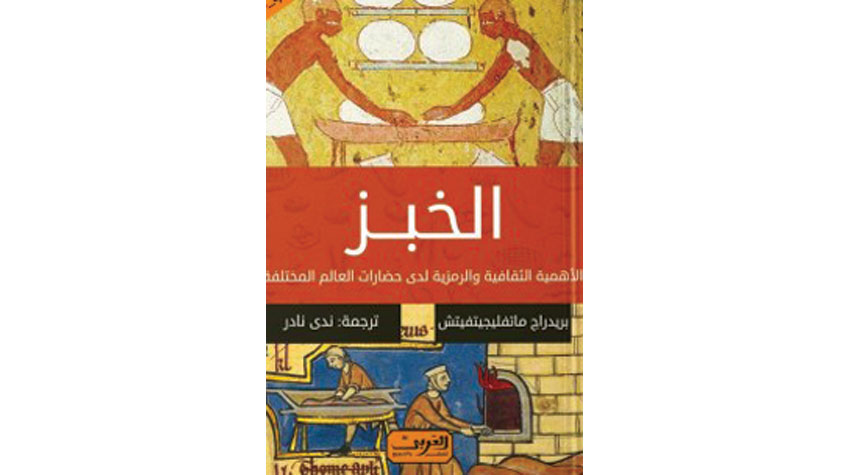
خطوات أولى
يرجح الكتاب أنه ربما كانت مصر هي أول من استقبل الحبوب من الشرق الأوسط لكن اكتُشفت كذلك بذور متفحمة في الأجزاء الغربية من الصحراء الأفريقية في حفر تم تجهيزها لإشعال النيران تحت الأرض يزيد عمرها على 8000 عام وذلك دليل على أن شخصاً ما مرّ هنا مارس الزراعة والحصاد.
اقتربت القبائل الصحراوية القادمة من الصحراء الكبرى التي كانت تشبه السافانا في يوم من الأيام من النيل في محاولة لتتبع النهر لمعرفة اتجاه سريانه فوجدوا أنه يتقاطع مع جداول المياه، حيث يمكن للبدو أن يرووا عطشهم ويمكن للجمال والغزلان أن تشرب أيضاً، وهكذا توقف البدو في الواحات قبل مواصلة طريقهم، وهذه الرحلات والقصص أيضاً ترجع لقديم الأزل. تعود أصول الخبز إلى الوقت الذي أصبح فيه البدو مستوطنين وأصبح الصيادون رعاة وعمل الجميع بالزراعة فانتقل البعض من أرض إلى أرض ومن مرعى إلى آخر، في حين نظّف آخرون الأرض وعملوا بها مثلما عمل قابيل بالزراعة وهابيل بالرعي. تميل حياة البدو نحو المغامرة في حين تتطلب حياة المستوطن الصبر والاستقرار، وهناك تلك الرسومات الجدارية المكتشفة على الكهوف التي سكنها البدو وغالباً ما تصور خطوطاً طويلة أو مكسورة تأتي من مكان مجهول وتؤدي إلى مجهول آخر في حين أن الرسومات التي رسمها المزارعون تميل إلى أن تكون أكثر استدارة وأكثر تحديداً مع وجود مركز واضح. وأدت عملية الزراعة والحصاد إلى تقسيم الوقت إلى أجزاء والسنة إلى شهور ثم إلى أسابيع وأيام، وقصّرت الطرق الجديدة المسافات بين الأماكن وبُنيت الأكواخ في الوديان وبُنيت مناطق سكنية ذات كثافة عالية بجوار الأنهار. وغيَّر حفر الأخاديد مظهر الحبوب وسمح لسنابل الحبوب بتغطية الأرض وتغير المشهد بمرور الأجيال.
طبيعة خاصة
يقول فيثاغورس: «يبدأ الكون بالخبز» فقد اكتُشفت بقايا الحبوب والخبز المحفوظة بجانب التوابيت والجِرار في القبور وفي الأهرامات وفي الأماكن التي يودع فيها المرء هذه الحياة على أمل الحياة السماوية الأبدية. فالخبز هو نتاج الطبيعة والثقافة، كان بمنزلة شرط للسلام، وسبباً للحرب، ووعداً بالأمل، وسبباً لليأس، وباركته الأديان، وأقسم الناس به. وتذكر ملحمة جلجامش مجيء سبع سنوات من الجفاف في مدينة أوروك عندما لم يجد أهلها حبة قمح واحدة.
ويذهب فلاسفة اليونان القدامى إلى أن الخبز الذي يغذينا يحتوي فعلاً على أشكال لا حصر لها من المكونات التي تشكّل جسد الإنسان! حاول المترجم الروماني لهذا النص القديم توضيح المعنى هنا فقال: «انتقل الفيلسوف من الخبز إلى الحبوب ومن الحبوب إلى الأرض ومن كليهما إلى الماء والنار نزولاً إلى المبادئ والعناصر الأولية ومن ثم يمكن ربط الجسد والطعام بالحالة المزاجية إما متفائل وإما سريع الغضب، إما هادئ وإما حزين». ويخطو بعضهم خطوة أوسع في النظر للعلاقة بين الجسد والخبز قائلاً: «عندما يرى الإنسان رغيف الخبز فهو يرى نموذجاً لجسده ﻷن الخبز الذي يدخل الجسد يصبح الجسد نفسه»!
وكثيراً ما يقال إن الجسد والخبز يفهم أحدهما الآخر لأن الخبز ينخرط في حواسنا كافة، وأكثر ما يُذكر في هذا السياق هو رائحة الخبز اللذيذة، فعند وصولها إلى الأنف تدخل الجسد وتنخرط بداخله، إذ يمتزج الأثر الذي تتركه تلك الرائحة بذكريات الطفولة والشباب وأجواء المنزل والعائلة. كما يرتبط طعم الخبز ارتباطاً وثيقاً بالذكريات القديمة فيجعلك تسأل نفسك: هل ذلك الطعم هو الذي اعتدته؟ أم أنه تغير؟ وإذ تغير فهل أصبح أفضل أم أسوأ ؟ ولا يمكن أن نغفل ملمس الخبز، فهل هو ناعم أم هش وهل له قلب طري أم لا؟ وكيف تشعر راحة اليد والأصابع عند الإمساك به وكسره ؟ ولمن نقدمه وكيف ومتى وأين؟
أسماء متعددة
تخبرنا أسماء عدة سواء عن طريق التراث المكتوب أو الشفاهي حول كيفية صناعة الخبز ونوع الدقيق المستخدم وكذلك نوع الفرن بما يتضمنه ذلك من قيم روحية وأرضية مثل: «خبز الحياة وخبز الدموع والخبز الحي» وفي الكتب المقدسة وصف الخبز على أنه «القربان والمبارك والذبيحة وخبز الملائكة وخبز الصداقة» المذكور في المزامير. وحتى الموتى كان لهم خبز خاص بهم يدعى خبز الموتى ويكون يابساً وغير مُحلّى، ولا ننسى الخبز المقدس الذي يُحتفل به في عيد القديسين.
أطلق المصريون القدماء على الأرض الخصبة المطلة على نهر النيل اسم «خمي»، ويرجع أصل الكلمة إلى كلمة «الخيمياء» أو ربما لمصطلح آخر مشابه هو «الكيمياء»، فصنّاع الخبز على مدار آلاف السنين لم يعرفوا سوى القليل عن العمليات الكيميائية والتغيرات التي تحدث عند إنتاجه مثل: العلاقة بين البروتينات والكربوهيدرات وتحويل الكربوهيدرات إلى سكر والسكر إلى كحول ذلك الكحول الذي يتناغم مع الخميرة فتنتج عنه الغازات التي ترفع العجين وتعطيه مساماً، وهي الطريقة التي يصبح بها وسط الخبز خفيفاً وطرياً في حين تصبح القشرة صلبة ومقرمشة، وذلك يمنح الخبز روحه وهيئته من شكل وطعم ورائحة.
كما اهتم صانعو الخبز الماهرون بنوعية المياه التي يستخدمونها سواء كانت حالتها طازجة أم راكدة، وهل بها رواسب أم أُزيلت منها. ومياه البحر هي المفضلة في استخدام صناعة الخبز لاختلاف تركيبتها، لكنّ ملح البحر لا يذوب بسهولة وعند مزجه بالعجين يتحول إلى اللون الرمادي أو الأزرق ولكي يتغلبوا على هذه المعضلة لجأوا إلى غسل الملح أو نقعه في الماء العذب أو وضعه على النار، وأفضل حل هو طحنه قبل وضعه على العجين. وفي الإسكندرية القديمة كانت لديهم مطاحن تطحن كتلاً كبيرة من ملح البحر حيث تجعله ناعماً مثل الدقيق ويعطي الخبز طعماً خاصاً، كما حظي الخباز بالاحترام، وبنى المهندس المعماري «خا» مقبرة في دير المدينة لإيواء مومياء زوجته «ميريت» وبجوار جثمانها وضع أكثر من خمسين رغيف خبز من أجل حياتها في الآخرة.
وهناك الكثير من الاستعارات في الأعمال الكلاسيكية المرتبطة بالحبوب والخبز، فيصور هوميروس في «الإلياذة» أبطاله ومآثرهم ليس فقط في البحر ولكن أيضاً على أرضية البيدر وفي مخزن الحبوب: «كما تبعثر الرياح التبن على أرض البيدر المقدسة وتعزل ديميتر ذات الشعر الجميل وسط الرياح المتطايرة فمثلما تتطاير قشور التبن عن القمح الحقيقي كان يتطاير الغبار من حوافر خيول أخيل وهي تدوس على دروع وأجساد القتلى».
وغالباً ما ارتبطت الحبوب بالنجوم وبريقها حتى إنه كان هناك اعتقاد قديم بأن الحبوب تنمو أسرع في الليل منها في أثناء النهار فكان الزارعون والحصادون يحدقون إلى السماء المرصعة بالنجوم ويلاحظون مراحل القمر. وعندما ظهرت الصوفية في القرن الثامن الميلادي بدأت في نشر مفاهيمها الخاصة عن الحياة والغذاء والسلوك ففضل الصوفيون الخضار والفاكهة على اللحوم وفضلوا الخبز على كل شيء آخر.
صدر الكتاب عن دار «العربي» بالقاهرة في 214 صفحة من القطع الصغير، واكتسى الجهد البحثي المبذول فيه بلغة أقرب إلى روح السرد المشوق المتدفق كأنك تطالع نصاً روائياً وهو ما نجحت المترجمة في نقله والمحافظة عليه.
باحث كرواتي يرصد «تجليات الخبز» ثقافياً وحضارياً عبر التاريخ
نشأة الخبز تعود إلى قديم الأزل فهو أقدم من الكتب بل أقدم من الكتابة نفسها


باحث كرواتي يرصد «تجليات الخبز» ثقافياً وحضارياً عبر التاريخ

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة






