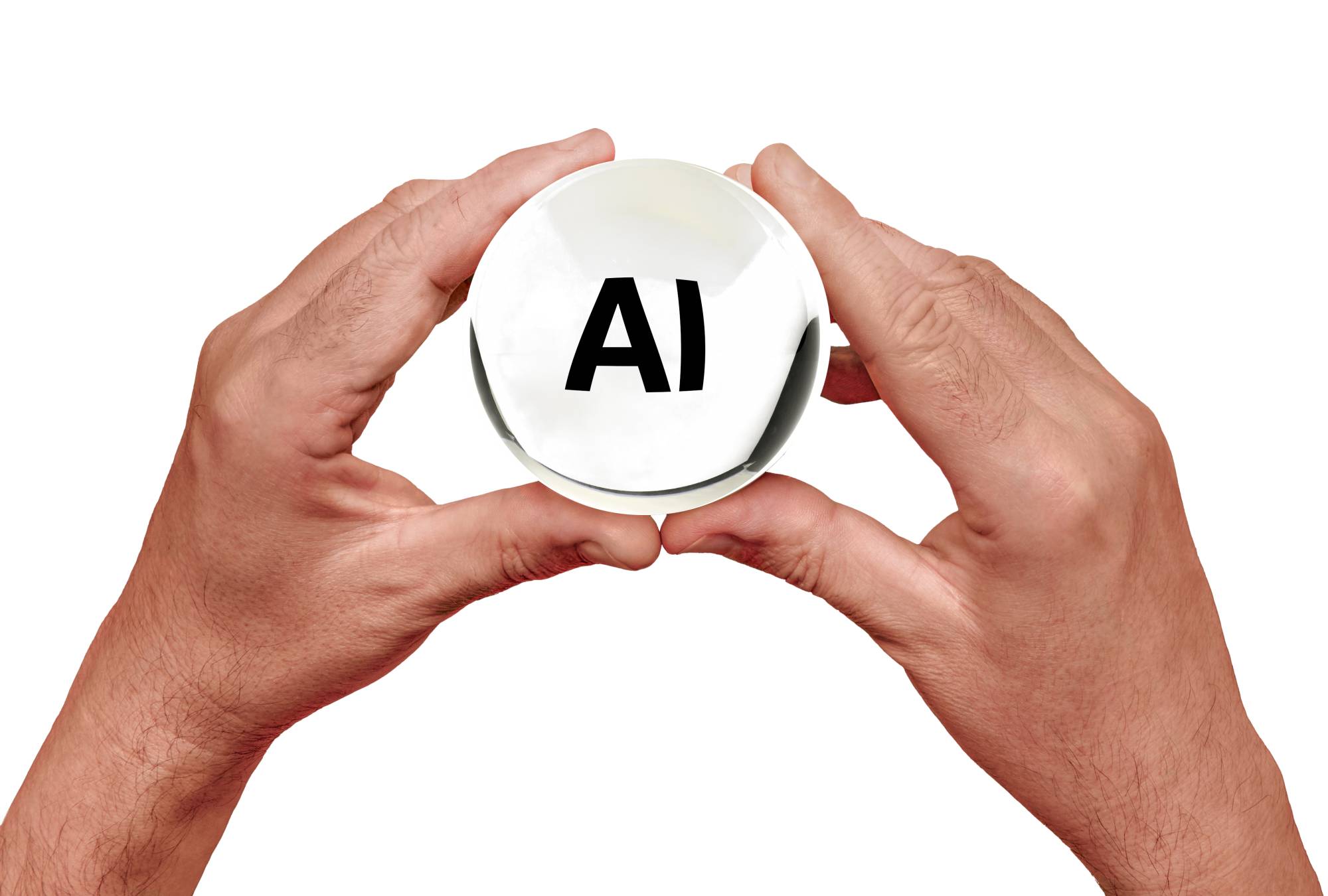يرى تشاك ماك جينلي، المهندس الكيميائي الذي ابتكر أداة محمولة لقياس الروائح، في مساعدة النّاس في فهم ما يشمّونه... جانباً علمياً مهماً.
ترجّل جينلي من سيارته ونظر إلى مداخن مصانع معالجة اللحوم الظاهرة من فوق الأشجار العالية، فأخذ نفساً عميقاً. في البداية، لم يشمّ شيئاً باستثناء الرائحة الجميلة والخفيفة المنبعثة من الأشجار المجاورة.
ولكنّ الرياح نشطت فجأة، فاشتمّ ماك جينلي رائحة «بشعة للغاية».
عندها، عمد أحد زملائه إلى حشر أداة «نَيْزَلْ رَيْنجر Nasal Ranger» في أنفه، وهي عبارة عن جهاز صغير لقياس الروائح بمقاس 14 بوصة، بتصميم يتقاطع بين مسدّس الرادار وبين البوق، ويُعدّ أحد أهمّ اختراعات المهندس.
«أدوات» الشم
لتوصيف الرائحة المقرفة، استعمل الفريق أداة أخرى من تطوير ماك جينلي أيضاً، وهي عبارة عن عجلة للرائحة على شكل رسمٍ بياني أشبه بعجلة تدرّجات الألوان التي يستخدمها الفنّانون، عمل المهندس على تطويرها لعقود. فقال أحد الزملاء إنّ الرائحة «حامضة»، بينما قال آخر إنّها أشبه «بالعفن المخلوط ببعض الوقود».
من مختبره غير التقليدي في إحدى ضواحي ولاية مينيسوتا (الذي يبدو أشبه بكوخٍ للتزلج)، أسّس المهندس وابنه ميداناً كبيراً في مجال قياس وفهم الروائح. إذ إنهما جهّزا العلماء في جميع أنحاء العالم بأدوات اخترعها ماك جينلي الأب، وقدّما المشورة للحكومات لوضع القوانين التنظيمية الخاصة بالروائح، وساهما في تمكين المجتمعات الصغيرة القاطنة بالقرب من أماكن تنبعث منها الروائح من استخدام المصطلحات الصحيحة في الشكاوى، ومن قياس الروائح التي تشتمها أنوفهم.
تكاد تكون حاسّة الشمّ الأكثر مراوغة وقوّة من بين الحواس البشرية، لأنها قد تستيقظ في أي وقت، ككبسولة زمنية تعيدنا إلى ماضٍ نسيناه، وقد تترك أثراً طويل الأمد لتحرّك مشاعر لا يمكن تحديدها أو وصفها.
تولّد حاسة الشمّ إنذارات قيّمة، إذ تستطيع نفحة صغيرة أن تعلمكم ما إذا كان الحليب غير صالح للشرب، وما إذا كان جوربكم نظيفاً أم متسخاً. تحوّلت حاسة الشم أيضاً إلى أداة تشخيصيّة، إذ إنّ خسارة القدرة على الشمّ قد تعني أنكم مصابون بفيروس «كوفيد - 19». من جهته، يرى ماك جينلي أنّ «الأنف هو إنذار مبكّر على أنّ أمراً ما لا يسير على ما يرام».
يصف النّاس عادةً ما يرونه ويسمعونه والأشياء التي يلمسونها بثقة كبيرة، ولكنّهم يرتبكون غالباً عندما يتعلّق الأمر بالروائح، ما يدفعهم إلى الاستعانة بالاستعارة دائماً لوصف ما يشمّونه... أي إنّ «الرائحة» تشبه دوماً شيئاً آخر كالورود، أو الكلب المبلل، أو حتّى منزل الجدة.
إحساسات الأنف
تَنتُج الرائحة ببساطة عن تفاعل المواد الكيميائية في الهواء. والأنف البشري هو حتّى اليوم الأفضل في رصدها. توجد روائح بارزة أكثر من الأخرى ككبريتيد الهيدروجين (رائحته كالبيض الفاسد)، التي يمكن شمّها ولو كانت بتركيزات منخفضة جداً لا تتعدّى جزءاً واحداً في المليار.
يشرح د. كوزييل من جامعة ولاية «آيوا»، الأمر على الشكل التالي: «إذا حاولتم تحديد مسافة الطريق بين نيويورك ولوس أنجليس، يمكن القول إنّ الجزء الواحد في المليار يعادل بضع بوصات فقط من هذه الطريق».
ولكنّ هذه الحقيقة تسلّط الضوء على صعوبة تنظيم الروائح قانونياً خصوصاً أن كبريتيد الهيدروجين لا يشكّل خطراً على الصحّة بهذه التركيزات الطفيفة، إلّا أنّه قد يكون «مسبباً جدياً للاضطراب» لدى الناس، على حدّ وصف سوزان شيفمان، الطبيبة النفسية التي تدرس حاستي الشم والتذوّق منذ 50 عاماً.
من جهتها، ترى باميلا دالتون، عالمة النفس التي تدرس مجالات التقاط الروائح في مركز «مونيل كيميكال سنسز» في فيلادلفيا، أنّ «قياس الانبعاثات شيء وقياس الرائحة شيءٌ آخر، لأن الأخيرة عبارة عن إحساس يمكن أن يختلف بشكلٍ كبير بين الناس، وهذا الأمر يقيّد تنظيم الروائح»، لافتةً إلى أنّ جميع أنواع المصانع يمكن أن تُصدر انبعاثات، وحتّى تلك التي تصنع البسكويت.
يزداد يوماً بعد يوم عدد الأطباء الذين يدعمون نظرية تسبب الروائح بمشكلات صحية جسدية ونفسية. فقد أظهر أحد الأبحاث أنّ النّاس الذين يعيشون بالقرب من مواقع سيئة الرائحة قد يعانون من عوارض كألم الرأس وحرقة العينين والغثيان، بالإضافة إلى تحديات نفسية كالاكتئاب والقلق العصبي.
يعود قرار عدم تنظيم الروائح على المستوى الفيدرالي إلى السبعينات. ففي سلسلة من استطلاعات الرأي، وجدت الوكالات الفيدرالية أنّ نصف المشاركين يرون في الروائح مشكلة جدية، ولكنّ وكالة حماية البيئة الأميركية قرّرت أخيراً ترك الأمر للحكومات المحلية لوضع قوانين متعلّقة بمضار الروائح كما فعلت مع مضار الضجيج.
أمّا اليوم، فتطبّق عشر ولايات تقريباً قوانين تنظيمية للروائح، وبادر الكثير من الحكومات المحلية إلى إقرار مراسيم خاصة للروائح، إلّا أنّ النظام العام لا يزال ناقصاً ويتسبب بالكثير من الخلافات التي تتطلّب حلاً في المحاكم.
قياس الرائحة
اقترن قياس الروائح لقرون بالكيمياء. ففي خطاب ألقاه في حفلٍ للتخرّج عام 1914، شرح المخترع الشهير ألكسندر غراهام بيل، أهمية القياس في تقدّم العلوم، مضيفاً أنّ الصوت والضوء قابلان للقياس، ولكنّ الرائحة ليست كذلك. وقال: «إذا كنتم تطمحون لتطوير علمٍ جديد، أعملوا على قياس الرائحة».
تعمل أجهزة قياس الروائح التي طُوّرت منذ مائة عامٍ تقريباً، على مبدأ سحب الهواء من فجوة صغيرة ومن ثمّ تخفيف تركيزه حتّى يصبح الإنسان غير قادر على شمّه، ليتمكّن العلماء من تحديد قوة الرائحة بناءً على درجة التخفيف. لاحقاً، طورت حكومة الولايات المتحدة جهاز قياس محمول للرائحة على شكل علبة صغير شفّافة مصنوعة من الأكريليك وتضمّ فجواتٍ مختلفة الأحجام ولها هدفٌ واحد: الحصول على قراءة مناسبة لقياس الرائحة من خلال تغطية الفجوات بالأصابع ومن ثمّ رفع كلّ واحد منهم على حدة. ولكنّ استخدامها كان معقّداً.
راودت ماك جينلي فكرة تطوير جهازه الخاص خلال إجازة في هاواي، عندما رأى بركان «هالياكالا» ووجد أنّ الشكل المخروطي يصلح كأداة لقياس الشم. وهكذا طوّر «نَيْزَلْ رَيْنجر» الذي يعد أكثر بساطة وسهولة للاستخدام من علبة الأكريليك ذات الفجوات والأصابع، لأنّ كلّ ما يتطلّبه هو تعديل العجلة باستمرار حتّى يصبح مستخدمها عاجزاً عن شمّ الرائحة العابقة. وحديثاً، وصفت د. دالتون من مركز «مونيل» أداة «نَيْزَلْ رَيْنجر» بالقفزة النوعية مقارنةً بأجهزة قياس الروائح القديمة. ويسعى العلماء اليوم بالتعاون مع شركات ناشئة لتطوير أنوف إلكترونية قادرة على قياس الروائح وتحديدها كالأنوف الحقيقية، ولكنّهم لم يتوصلوا إلى التقنية المطلوبة بعد.
* خدمة «نيويورك تايمز»