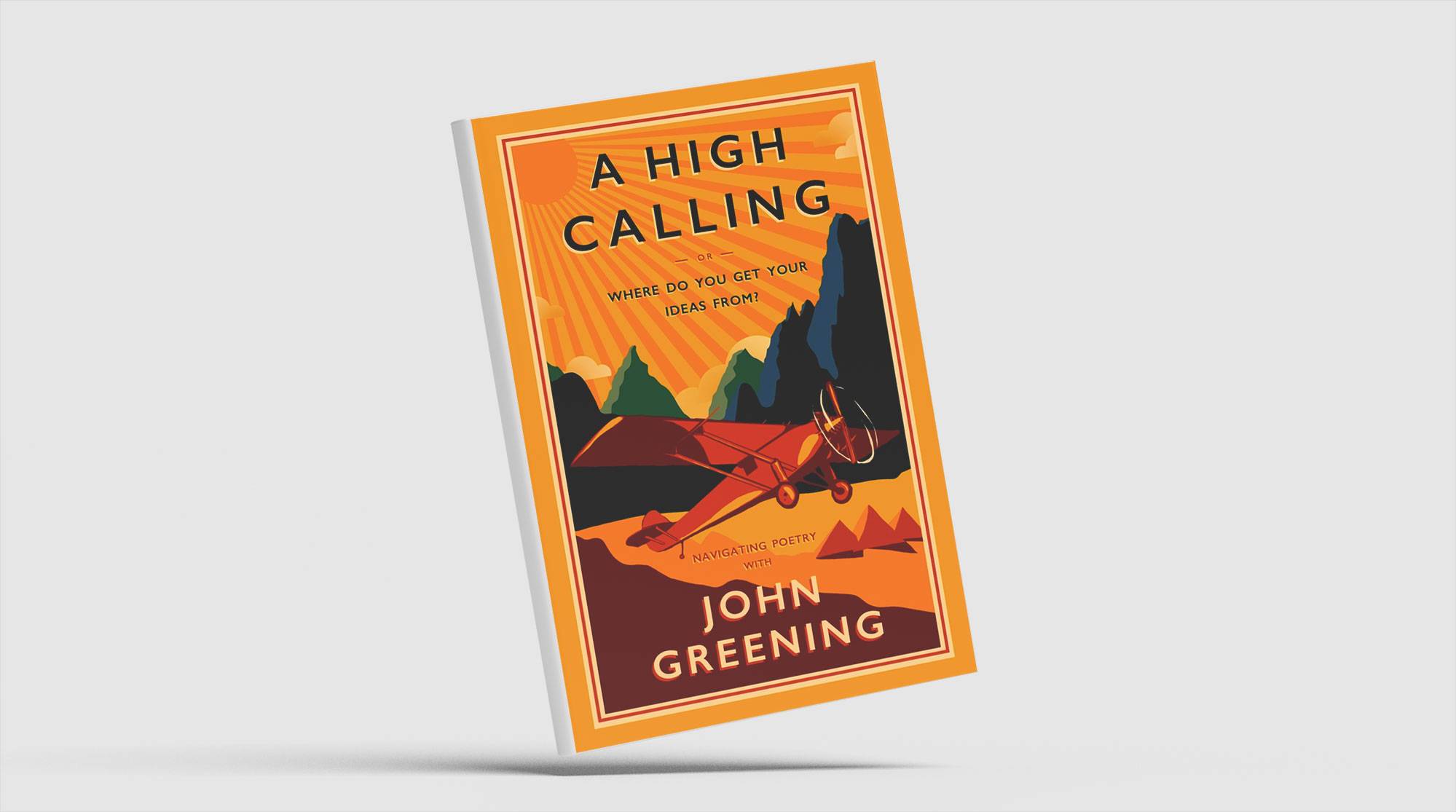يضيء الدكتور ثائر العذاري، أستاذ النقد الحديث في كتابه الجديد «المتواليّة القصصية: الأصول والتجنيس والتمثلات» الصادر عام 2020، واحداً من المصطلحات الإشكالية الحديثة التي أثارت خلافاً كبيراً بين النقاد والباحثين. وقد انعكس ذلك على المشهد النقدي، حيث شهدنا مساجلات خصبة بين الدكتورة نادية هناوي، والدكتور ثائر العذاري خلال السنوات الماضية حول ماهية هذا المصطلح وحدوده وحمولاته وتجلياته. وشخصياً، كنت قد أضأت جوانب من هذا المفهوم النقدي وطبقته على بعض الأعمال القصصية، منها مجموعة «غيمة عطر» وأشرت إلى أن هذه المجموعة تعدّ مثالاً على مفهوم المتوالية السردية أو المتوالية القصصية، وخاصة بعد أن أدرج المؤلف عنواناً فرعياً تصنيفياً مهماً هو «متوالية قصصية» بوصفه عتبة نصية دالة. وبيّنت أن النقد الحديث اعتاد على إطلاق مصطلح المتوالية السردية على الوحدات السردية الصغرى التي تشكل سرداً أوسع، إلا أن التوظيف الجديد يذهب أبعد من ذلك لأنه يحيلنا إلى ظاهرة اشتراك قصص مجموعة قصصية معينة في مشتركات أسلوبية رؤيوية، يجعلها مترابطة إلى حد كبير وتقترب في تضافرها من الرواية الحديثة. وأشرت إلى بعض النماذج العالمية الممثلة لهذا المنحى، وفي مقدمتها مجموعة «أهل دبلن» للروائي الآيرلندي جيمس جويس، و«في زماننا» لإرنست همنغواي، إلا أننا يجب أن نعترف بأن السجال النقدي بين الدكتورة نادية هناوي، والدكتور ثائر العذاري، هو الذي وضع المصطلح تحت ضوء ساطع وأغنى جوانبه المختلفة. ومما أكده العذاري، أن القاص إدوار الخراط هو أول قاص عربي أطلق مصطلح «المتوالية القصصية» على مجموعته «أمواج الليالي» الصادرة عام 1991 كما تحمس الدكتور العذاري لفكرة عدّ المتوالية القصصية جنساً أدبياً مستقلاً، وهو ما أثار حفيظة د. نادية هناوي التي رفضت فكرة التجنيس هذه؛ إذ ترى أن لا جدوى من الخلط بين ما هو تقانة واشتغال مخصوص، وبين ما تجنيس مؤطر بالنظرية، وقد نشرت هنادي حصيلة سجالها في كتابها النقدي الموسوم «في الجدل النقدي» الصادر عام 2021.
ويبدو أن الدكتور ثائر العذاري قرر أن يخوض المواجهة حتى النهاية من خلال المباشرة بكتابة كتابه الجديد هذا. ويعترف الناقد بأنه اصطدم بهذا المصطلح عام 2011 عندما كان أستاذاً زائراً بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية؛ فراح يتقصى أصوله ومصادره وتمثلاته. ولم يقتصر جهد الناقد على الاطلاع المضني على المراجع الأساسية، بل عمد إلى إجراء عملي يحسب له، وذلك من خلال إقامة حوار مباشر حول المصطلح مع أحد أبرز النقاد المهتمين به هو روبرت لوشر، والذي سبق للقارئ العربي أن اطلع على دراسته المهمة حول المتوالية السردية في كتاب عن نظرية الأجناس الأدبية. يأخذنا الناقد العذاري في كتابه هذا في سياحة نقدية واسعة لاستقصاء أصول المصطلح الذي يرى أنها تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، من خلال انشغال عدد كبير من النقاد في الولايات المتحدة بهذا المصطلح ودلالاته. وحاول الناقد التمييز بين المجموعة القصصية التقليدية التي تكتب في أوقات متباعدة، وبين المتوالية القصصية التي تشترك أقاصيصها في مقومات كثيرة منها البنية المكانية الموحدة، كما هو الحال في «أهل دبلن» لجميس جويس. كما يذهب الناقد إلى الاعتقاد أن مجموعة نجيب محفوظ «أولاد حارتنا» هي واحدة من أقدم المتواليات في الأدب القصصي العربي الحديث، والتي تدور أحداثها داخل مكان محدد، وقد تبنى المتوالية القصصية، كما يرى الناقد من خلال التركيز على «شيء» واحد مثلما فعل الكاتب الكويتي طالب الرفاعي في متوالية «الكرسي» التي تمحورت حول الكرسي وتنويعاته الوظيفية المتنوعة. وقد تتشكل المتوالية القصصية على زاوية النظر التي يتعامل بها القاص مع التجربة القصصية أو على وحدة الشخصية القصصية، كما هو الحال في مجموعة أحمد المديني «عند بوطاقية» التي تتمحور حول شخصية واحدة هي «بوطاقية». ويخلص الناقد إلى استنتاج مركزي في كتابه هذا يرى فيه، أن المتواليات القصصية ليست مجاميع قصصية تقليدية، بل هي جنس أدبي قائم بذاته، له خصائصه وتقنياته المتعلقة به. وعبر استضاءاته النقدية، توصل الناقد إلى أن الناقد الشكلاني الروسي شكلوفسكي هو من أوائل الذين شخّصوا ظاهرة المتوالية القصصية وعدّوها أصلاً للرواية، من خلال التركيز على دور البنية الإطارية كما هو الحال في «ألف ليلة وليلة». وأكد الباحث، أن معظم النقاد الذين درسوا المتوالية القصصية عدّوا «ألف ليلة وليلة» الأصل التاريخي لها.
ولا يكتفي الناقد باستضاءاته على الأدب العالمي، بل فحص تمثلات مهمة لهذا الضرب السردي في تراثنا العربي من خلال التركيز على نماذج دالة منها «كليلة ودمنة» لابن المقفع و«مقامات الهمداني» و«ألف ليلة وليلة» والتي كان لها أثر بالغ في نشوء جذور القصة والرواية التي مثلتها «حكايات الديكاميرون» لبو كاشيو و«حكايات كانتزبري» لجوسر، وذلك من خلال الاعتماد على فكرة الحكاية الإطارية التي تضم مجموعة من الرواة الذي سيروي كل منهم حكاية.
ويلفت الناقد النظر، وهو يستقصي أصول المصطلح إلى أن أوروبا وأميركا قد شهدتا خلال القرن التاسع عشر ظهور لون من المتواليات الشعرية، قبل أن تظهر المتواليات القصصية.
لكن الباحث يرى أن أول متوالية قصصية في القرن العشرين هي مجموعة «أهالي دبلن» لجيمس جويس التي تدور داخل مدينة واحدة وتكشف عن حياة الناس وطباعهم وأسواقهم وبيوتهم، وكأنها تريد أن تؤشر خصوصية الهوية الآيرلندية التي كانت تعاني من وطأة الاحتلال البريطاني آنذاك.
كما توقف الناقد أمام ظهور مجموعة قصصية مهمة عام 1919 للقاص شيرود اندرسن هي «واينسبرغ - أوهايو» التي عدّت متوالية قصصية كان لها تأثيرها اللاحق في إشاعة هذا الجنس القصصي. ولاحظ الناقد وجود عناصر مشتركة في هذه المجموعة، فضلاً عن وحدة المكان وهي تشابه في طبائع الشخصيات التي دفعت المؤلف إلى وضع عنوان أولي لها هو «كتاب الشخصيات غريبة الاطوار» كونها أيضاً تعاني من الوحدة والانعزال.
أما النموذج الثالث الذي استرعى اهتمام الناقد فكان مجموعة «في زماننا» لإرنست همنغواي الصادرة عام 1924، التي ركزت على بشاعة الحرب العالمية الأولى كثيمة مركزية، كما أن قصصها القصيرة كانت تحكي تجارب شخصية مركزية واحدة هي «نيك آدمز»، وهو شخصية مركزية في الكثير من قصص همنغواي.
لكن الناقد يرى أن المرحلة الحقيقية للاعتراف بالمتوالية القصصية جنساً أدبياً مستقبلاً بدأت مع صدور كتاب الناقد فورست انغرام عام 1971 حول الموضوع، والذي درس حلقة القصة القصيرة في القرن العشرين، موظّفاً مصطلح «حلقة» بدل المتوالية القصصية. ويرى انغرام في كتابه ذاك، أن المتوالية القصصية هي «حزمة من القصص القصيرة المترابطة مع بعضها، بحيث تتعدل التجربة القرائية لأي منها بعد قراءة الأخريات»، كما أضاف إنغرام فقرة جديدة تذهب إلى أن الحلقة القصصية هي «حزمة من القصص القصيرة التي ترتبط إحداها بالأخرى بطريقة توازن بين استقلالية كل قصة منفردة، وبين ضرورات الوحدة الكلية».
ومن المهم هنا، أن الناقد لم يقتصر على التعريف بأداء الناقد إنغرام، بل سجل عليه بعض المآخذ المتعلقة بدور القارئ بين المتواليات القصصية التي اقترحها الناقد، فضلاً عن المقارنة بين أفضلية حلقة القصة القصيرة و«المتوالية القصصية» والتي ينحاز فيها الناقد إلى التسمية الأخيرة؛ لأنها أكثر مقبولية بالنسبة للقارئ العربي الذي سبق له وأن اطلع عليها في توصيف مجموعة إدوار الخراط «أمواج الليالي» الصادرة عام 1991. لكن العذاري في رأيه هذا يستند إلى رأي الناقد روبرت لوشر الذي عبّر عنه في اتصال مباشر عبر الإنترنيت، والذي أكد فيه أن المتوالية القصصية جنس سردي مستقل، منفصل عن الرواية، وعن القصة القصيرة نفسها، لكن حدودها سائلة؛ ما يجعلها تشتبك مع مجموعة من الأشكال المتنوعة. ومن الجانب الآخر، يتفق الباحث مع رأي الناقد رالف لندن في تقسيم المتواليات القصصية إلى أربعة ضروب أساسية، هي المتوالية القصصية العنقودية والمتوالية القصصية المتسلسلة والمتوالية القصصية الحلقية والنوفيلا، ويفرد الباحث صفحات عديدة للتعريف بهذه الضروب وتمثلاتها في الأدبين العالمي والعربي.
ويختتم الباحث كتابه بالحديث عن بنية التماسك في المتوالية القصصية، حيث يذهب إلى أن هذا الجنس الأدبي ينهض على ثنائية، هي التوتر والتعدد الناتجين من كون كل قصة في المتوالية لا بد أن تكون مكتفية بذاتها. وخلص إلى القول، إن كتاب المتواليات القصصية اكتشفوا بمرور الزمن أنها ميدان واسع للإبداع وابتكار أساليب لا يحدها سوى خيال الكاتب لبناء «التماسك». ويحاول الباحث أن يتلمس مظاهر التماسك في عدد من المتواليات القصصية، والتي سبق لي وأن درستها ومنها متوالية «ألف صباح وصباح» للروائي حامد فاضل التي كتبت مقدمتها والتي أشرت فيها إلى انتمائها إلى مفهوم المتوالية السردية، ومجموعة «غيمة عطر» لحميد الربيعي التي درستها بوصفها متوالية سردية.
كتاب الدكتور ثائر العذاري جهد أكاديمي ونقدي متميز ويمثل إضافة مهمة للنقدية الأدبية العربية الحديثة.
«المتوالية القصصية» جنساً أدبياً مستقلاً
إدوار الخراط أول قاص عربي أطلق المصطلح على مجموعته «أمواج الليالي»

إرنست همنغواي

«المتوالية القصصية» جنساً أدبياً مستقلاً

إرنست همنغواي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة