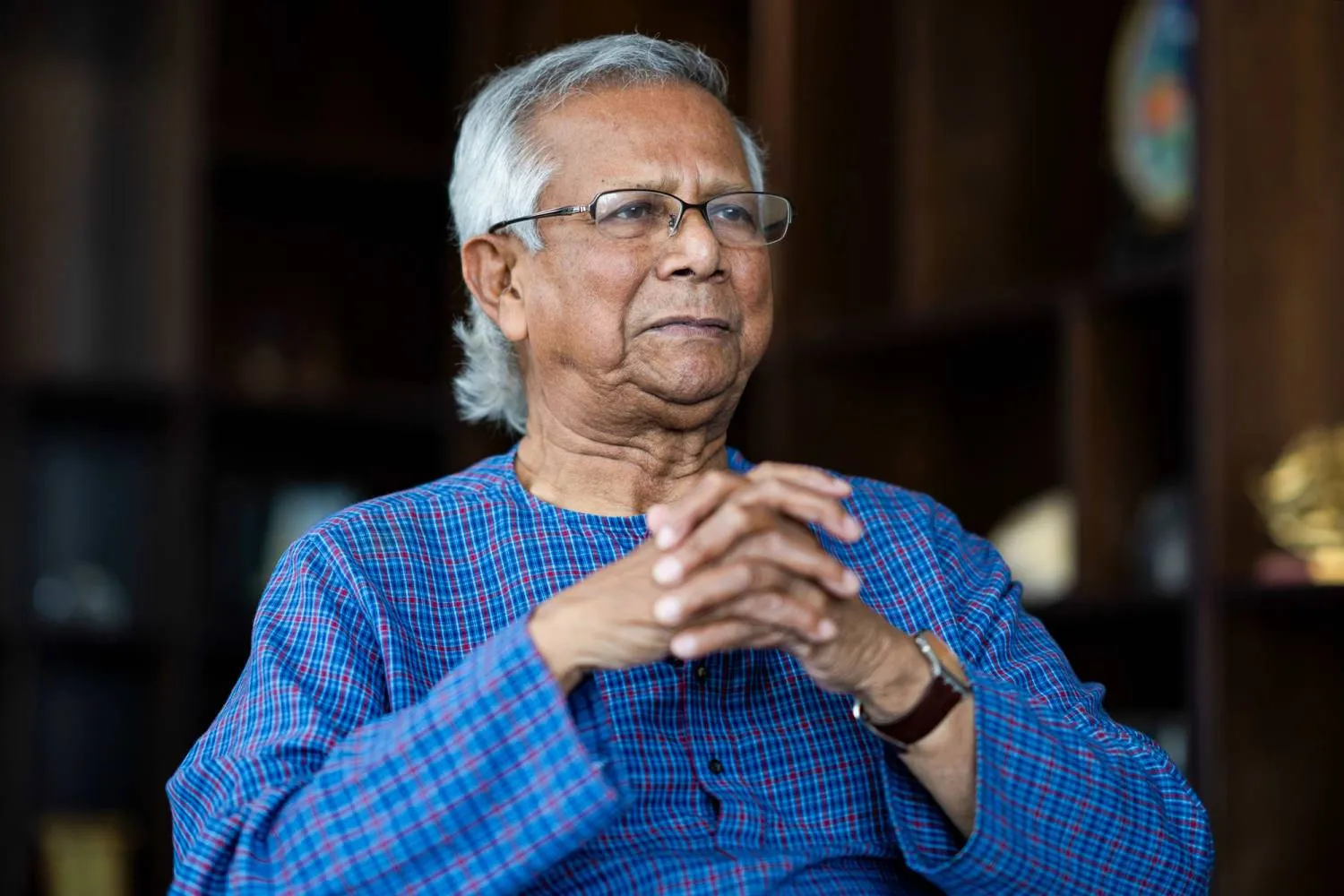شهد القرنان الأول والثاني الهجريان حركة فتوحات واسعة النطاق جعلت الدولة الإسلامية ممتدة الأطراف، ومع هذا التوسع جاء كثير من الظواهر الجديدة بعدما اختلطت العرب بالحضارات والثقافات الأخرى، وعلى رأسها الحضارة الغربية ممثلة في الفكر اليوناني القديم، وعلى رأسه أفكار أرسطو وأفلاطون وسقراط.. وغيرهم. وقد شهد العصر الأموي حالة نأي بالذات عن هذه التيارات الفكرية ولم يرغب الخلفاء الأمويون الدخول في عملية التعرف على هذه الثقافات لسببين رئيسيين؛ هما: التعصب للثقافة العربية في إطار تثبيتهم للعنصر العربي على ما سواه ممن دخلوا الدين الإسلامي، إضافة لأن عصرهم لم يشهد المشكلات المرتبطة بأثير هذه الأفكار على المسلمين والمتأسلمين في الدولة الإسلامية الفتية، ولكن هذا الأمر لم يستمر طويلا، خاصة بعدما تولى العباسيون الخلافة الإسلامية في عام 132 من الهجرة، فلقد كان السند الرئيسي لهم في حربهم ضد بني أمية هم الفرس الذين كان لمعتقداتهم قبيل اعتناق الإسلام أثرها الكبير في نشر بعض أفكارهم التي خرجت عن الرداء الفكري الإسلامي خاصة فرق «المانوية» وارتباطها بمفهوم الخير والشر، إضافة إلى أفكار وتيارات «الغنوصية» في الغرب التي بدأت تضرب في أساسيات الدين الإسلامي من التوحيد والنبوة والطبيعة الإلهية.. وغيرها. لذلك نجد الخليفة أبا جعفر المنصور أول من اهتم بعملية ترجمة الفكر الفلسفي اليوناني لمحاولة الذود عن الإسلام وأفكاره ومعتقداته، مستخدما الفكر اليوناني القديم، خاصة الأرسطي، ثم جاءت خلافة المأمون بن هارون الرشيد لتشهد أقوى عملية ترجمة واسعة للمؤلفات اليونانية القديمة بشكل ممنهج، وعلى الرغم من أنها ساهمت بشكل كبير للغاية في الرد على الأفكار التي هجم بها على الإسلام، فإن هذه الظاهرة اقترنت أيضا بظهور تيارات فكرية داخل العباءة الإسلامية تخرج عن المعتقدات الراسخة والفكر الإسلامي القويم.
وفي ظل هذه الظروف، ولد الإمام أبو حامد الغزالي سنة 450 من الهجرة في خراسان لوالد صوفي، وقد رباه صديق لوالده بعد موته، وسرعان ما بدأ الشاب في السفر لتلقي العلم في ربوع العالم الإسلامي؛ في نيسابور، ثم في بغداد، ليتولى بعد فترة مسؤولية الإشراف على المدرسة النظامية إبان حكم الوزير السلجوقي نظام الملك، ثم مر الرجل بمرحلة عدم استقرار نفسي أدت به إلى اللجوء للتصوف والانعزالية لمحاولة التقرب إلى المولى عز وجل، وقام برحلة طويلة إلى الشام ثم إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، ومنها عاد إلى بغداد ثم إلى مسقط رأسه في طوس، ودخل إلى مرحلة من التصوف إلى أن توفي في عام 505 من الهجرة، تاركا من الإرث الفكري الكثير من المؤلفات؛ على رأسها «تهافت الفلاسفة»، و«إحياء علوم الدين».. وغيرهما من المؤلفات المهمة التي رسمت فكر هذا الرجل.
لقد اعتنى الإمام الغزالي بالتعرف على وسيلة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فكان هذا الفكر هو الأساس الذي اشتق من خلاله الكثير من مؤلفاته ورؤاه، وبعد دراسات متعمقة للغاية في الفلسفة اليونانية، خاصة المنهج الأرسطي وما كتبه المسلمون من أمثال الفارابي وغيره، وصل إلى قناعة كاملة بأن الطريق إلى الإيمان لا يمر بالعقل، وهنا وضع نقده للحواس والعقل بوصفها وسيلة للوصول إلى المعرفة النهائية، فلقد بدأ بالشك في الحواس التي رأى أنها كثيرا ما تخدع الناظر إليها، وضرب مثلا بالشمس التي تراها العين المجردة كأنها عملة معدنية بينما هي أكبر من الأرض، لذلك فالبصر والسمع واللمس وغيرها من الحواس يمكن أن تكون مخطئة، وهو ما أكد له أن ضروب المعرفة الحسية يمكن أن تصبح أداة لإخفاء الحقيقة أو اليقين الإيماني، بالتالي لجأ إلى العقل، ولكنه رأى فيه أيضا أداة لا تصلح للتقرب إلى المولى عز وجل، لأنه غير كاف، ومداركه لا تستطيع وحدها أن تدرك فاطر السموات والأرض، بل إن قوة الله سبحانه وتعالي وهيبته وعظمته أقوى من أن يدركها العقل. وهنا وضع الغزالي لبنة فكره الأساسية؛ وهي أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالي لا يكون إلا من خلال الإيمان بوصفه وسيلة للعلم اليقيني، فالإيمان هنا يصبح قوام اليقين، وهذا لا يتأتي بالحفاظ على طقوس الدين أو الفروض فقط، ولكنها مرحلة أقوى وأعمق بكثير من هذا كله، فهي تجربة إنسانية عظيمة لمحاولة التوصل بالإيمان إلى طريق الهدى الذي رسمه المولى عز وجل، مقدما بذلك تجربة أقرب ما تكون إلى التصوف هدفها تطهير الروح والجسد والقلب، داعيا إلى ما يقرب من فكر جهاد النفس لإبعاد الروح عن متاع الدنيا للوصول إلى اليقين، ولكنه يرفض أيضا كثيرا من أفكار بعض فرق المتصوفة، التي ضلت الطريق من وجهة نظره باتباع أفكار غير مقبولة وبدع غير مفهومة.
وبمجرد أن وضع الإمام الغزالي أسسه الفكرية في هذا الإطار، توجه إلى نقد الحركات الفكرية التي شاعت في ذلك الوقت، ومعهم المشتغلون بالفلسفة، فلقد تحفظ على كثير من علماء الكلام لأنهم، من وجهة نظره، يستخدمون العقل في الرد على ناقديهم، مؤكدا أن الطريق إلى معرفة الله يتأتى من خلال الإيمان وليس بالحجج العقلية والبراهين المنطقية المستقاة من الفلسفة، وبالتالي تصبح وسيلة خاطئة للوصول للهدف السامي.
كذلك فقد شن الغزالي هجوما ضاريا على فرقة «الدهرية» التي نعتها بالكفر مباشرة لأنهم يؤمنون بأن العالم موجود منذ الدهر، وهو ما يشكك في النص القرآني الواضح. كما أنه رفض فكر بعض الفرق التي رأت في الحساب والعقاب في الآخرة تجربة روحية غير مادية، كما تصدى لأفكار فرق دخيلة على الإسلام نادت ببدع فكرية لا أساس لها في الدين الإسلامي من قريب أو بعيد.
لقد شن الغزالي هجومه مستندا إلى مبدأ علمي قوي؛ وهو رفض قانون السببية في التعامل مع الإيمان، فلقد وصل إلى قناعة كاملة بأن السببية غير قابلة للتطبيق في الطريق إلى الإيمان وإلى الله سبحانه وتعالى، فهو يرى أن قانون السببية غير ثابت، فاقتران ظاهرتين عمليتين كلتيهما معا بقانون السببية أمر غير محسوم علميا، ولكنه مأخوذ على أساس فكري لارتباطهما وتكرار هذا الارتباط مع مرور الزمن، مثلما هي الحال بين الرعد والمطر، فالأولى تتزامن مع الثانية، ولكنها ليست بالضرورة مبنية على مبدأ السببية، فقد يكون هذا المبدأ راسخ في العلوم الطبيعية بالتجربة، ولكنه غير راسخ في الطريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
كذلك عني الغزالي بمفهوم صناعة الكون الذي رأى فيه أنه مبني على مفهوم الوحدانية الذي هو حجر الزاوية الأول في الدين الإسلامي، بالتالي لا يمكن الدخول هنا في مهاترات الفكر حول خلق العالم من عدمه، فالأمر أكبر من إخضاعه للمفاهيم العقلية الضيقة والأدوات الفكرية غير الكافية للوصول إليه، مؤكدا فكره بأن الإيمان هو قوام العلم في هذا الإطار، وأن الإنسان بفطرته خير، ولكنه يكتسب الشر من تجاربه ونتيجة العوامل الخارجية، وأن أصله روحي وليس ماديا، بالتالي فإن كل إنسان قادر على الوصول إلى تجربة الإيمان.
مما لا شك فيه أن الإمام أبا حامد الغزالي يظل علامة فارقة في الفكر الإسلامي والعالمي على حد سواء، فلقد ساهمت كتاباته بشكل مباشر في تنقية الإسلام من كثير من الأفكار الهدامة التي كانت كفيلة مع مرور الزمن بالتشكيك في العقائد الأساسية للدين الإسلامي الحنيف، وعلى الرغم من تشدده في رفض كثير من المفكرين الذين سبقوه، فإن كتاباته، خاصة ما يتعلق منها بمبادئ الفلسفة والفكر والمنطق، لم يكن هدفها هدم هذه المبادئ، التي يمكن أن تكون أدوات عظيمة للحياة الطبيعية للإنسان وفي فهم الظواهر المختلفة، ولكنه فقط يرى أنها لا تتناسب مع غاية الوصول إلى الله، وحذر من أن تتحول لوسيلة للبعد عن الله سبحانه وتعالى.
8:33 دقيقه
من تركة الحضارة الإسلامية: أبو حامد الغزالي
https://aawsat.com/home/article/320066/%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A



من تركة الحضارة الإسلامية: أبو حامد الغزالي


من تركة الحضارة الإسلامية: أبو حامد الغزالي

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة