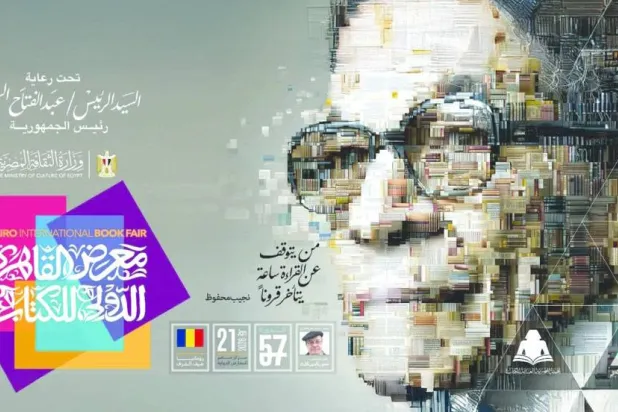في عام 1966 أصدر عدد من طلبة بجامعة ستراسبورغ من أعضاء الاتحاد الوطني للطلاب الفرنسيين بيانا بعنوان «حول البؤس الطلابي ومقترح متواضع لعلاجه» تضمن نقدا جذريا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في فرنسا وأوروبا بشكل عام، متأثرين بأفكار الفيلسوف الألماني المقيم في أميركا «هربرت ماركوز» لا سيما كتابه «الإنسان ذو البعد الواحد» الذي ينتقد فيه التكنولوجيا الحديثة وكيف عملت على تكريس النزعة الاستهلاكية لدى إنسان العصر الحديث وتفاقم قلقه وخلق احتياجات وهمية لديه طيلة الوقت.
وفي مارس (آذار) من 1968 انطلقت مسيرات طلابية تندد بالحرب الأميركية على فيتنام، قوبلت بعنف شديد من الشرطة فاشتعل الموقف وزادت الاحتجاجات صلابة لتعم معظم الجامعات والمدارس في البلاد ثم انضم العمال إلى التمرد وقام ما يقرب من 11 مليون عامل بالإضراب الأقوى في تاريخ فرنسا، وبدا أن باريس ستسقط في حرب أهلية لا محالة وفر الرئيس الفرنسي شارل ديجول إلى ألمانيا سرا.
وبعد مرور 7 أسابيع هدأت الأمور وأجريت الانتخابات وتراجع السيناريو الدموي مع إصلاحات واسعة في الأجور وأوضاع الطلبة.
سارتر وجودار في المظاهرات
لم تقتصر هذه الانتفاضة على فرنسا، بل امتد صداها لأنحاء كثيرة من العالم، كما اشتعل الموقف في فيتنام، وكانت المطالب الداخلية الملحة آنذاك من أهم الأسباب التي أشعلت الثورة الثقافية الصينية التي قادها الزعيم الصيني ماوتسي تونغ ضد فلول البرجوازية، داعيا الشباب للثورة عليهم واجتثاثهم، وكان ماو ذائع الصيت في فرنسا، وإلهام الشباب حول العالم للتحرك ضد الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة على السواء، كذلك لم يكن قد مر وقت طويل على اغتيال أميركا للمناضل الكوبي تشي جيفارا.
بعد مرور أكثر من خمسين عاما على هذا الحدث لا يزال هناك انقسام في النظر إليه، حيث يراه البعض مجرد «تمرد طلابي مراهق واحتجاج عمالي يطالب بزيادة الأجور» بينما يراه البعض الآخر «محاولة ثورية لتغيير العالم» بمشاركة عدد من أبرز مثقفي وفناني فرنسا مثل جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار، وجيل دولوز، وجان لوك جودار.
من هنا تأتي أهمية كتاب «لغز مايو 68 - لنا الحق في التمرد» الصادر عن دار «صفصافة» بالقاهرة للفيلسوف الفرنسي اليساري آلان باديو، وترجمه للعربية أحمد حسان، في «74 صفحة من الحجم الصغير».
ظاهرة عالمية
بداية يشير باديو إلى أن ما حدث في ذلك التاريخ كان بالفعل انتفاضة، تمردا لشبيبة الطلبة والتلاميذ، معتبرا أن هذا هو الجانب الأكثر «استعراضية» وشيوعا، على نحو ترك صورا قوية نعاود الرجوع إليها مؤخرا مثل: المظاهرات الحاشدة، المتاريس، المعارك مع الشرطة، صور العنف والقمع والحماس. مؤكدا أن مثل هذه الانتفاضة في حينها شكلت ظاهرة عالمية تردد صداها في كثير من البلدان: من المكسيك حيث المذابح في ميدان عام إلى ألمانيا حيث الهبات الطلابية القوية، ومن صين الثورة الثقافية إلى الولايات المتحدة، حيث زادت الحركات ضد حرب فيتنام، من إيطاليا التي بها الكثير من الكيانات المستقلة ذاتيا إلى يابان الجيش الأحمر، من الانتفاضات الإصلاحية في تشيكوسلوفاكيا إلى الانتفاضات الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني. كان الشباب في كل مكان يهب ضد العالم كما أعيد تأسيسه في نهاية الحرب العالمية الثانية ليصبح «مايو 68» التنويعة الفرنسية لظاهرة عالمية.
يتابع باديو: كان طلبة الجامعات وحتى تلاميذ المدارس الثانوية يمثلون أقلية بالغة الضآلة من الشباب في مجمله، كما تبين لاحقا أن التماسك الآيديولوجي، بمعنى القناعات الفكرية لدى الأحزاب والنقابات ذات التوجه اليساري كان ضعيفا بخاصة لدى من احتلوا وظيفة قيادية في تلك الأحزاب والنقابات. وكان لافتا أنه في الأعوام التي تلت هذا الحدث أن عددا من المثقفين كانوا يضربون صدورهم وهم ينبذون أفكارا وقناعات يسارية قديمة مثل «الماوية» أو «التروتسكية» أو «الستالينية» وينحازون جماعيا إلى جوانب الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وهنا لا يتردد باديو في التأكيد على أن الشعار النهائي لمايو 68 هو «الانتخابات... فخ الحمقى»، مشيرا إلى أن هذا ليس مجرد تحمس آيديولوجي، فثمة أسباب محددة تبرر هذا العداء للديمقراطية النيابية، إذ في أعقاب شهر هائل من الاستنفار الطلابي ثم العمالي والشعبي غير المسبوق نجحت الحكومة في تنظيم انتخابات وكانت النتيجة هي أشد برلمان شهدته البلاد رجعية، ومن ثم أصبح واضحا للجميع أن الجهاز الانتخابي لا يصلح لتمثيل الشعب وتحقيق آماله، بل إنه كذلك جهاز قمع للحركات الشعبية!
تجربة ذاتية
وعلى ضوء تجربته الذاتية يواصل باديو تحليله لما حدث في ذلك التاريخ باعتباره أحد شهود العيان على تلك الانتفاضة، فقد كان يعمل آنذاك أستاذا مساعدا في إحدى مدن الأقاليم، ويذكر أن الكلية دخلت في حالة إضراب وهي في الحقيقة مركز جامعي لا يتضمن سوى الدراسات التمهيدية مع التفاوت الفرنسي الكلاسيكي بين ما يحدث في العاصمة باريس وبين ما يتبعه في الأقاليم البعيدة «في البداية، بدا هذا الإضراب الطلابي وكأنه لا يتميز في شيء عما يجري في أي مكان آخر: خليط من المعتقدات والثرثرة والتصريحات السياسية والإصلاحية الأكاديمية لكنه مثلما في كل مكان آخر يقدم قاعدة للعمل الجماعي. فجأة ينتشر الإضراب العمالي إلى كل مصانع تلك المدينة التي كانت في تلك الفترة من أكثر المدن عمالية في فرنسا طبقا لتعداد السكان. وهكذا ذات يوم مثلما هو الحال الأماكن الأخرى أيضا».
نظم الأكاديميون والمثقفون مسيرة نحو المصنع الرئيسي المضرب في المدينة. في تلك الفترة كان باديو يعد «كادرا» محليا للحزب الاشتراكي. كان المصنع محاطا بالمتاريس، ترتفع بين جوانبه الرايات الحمراء، مع بعض الشعارات التي تؤكد أنه تم احتلاله من جانب العمال. اندمج الجميع في نقاش سياسي حامي الوطيس سرعان ما تفرعت عنه اجتماعات منظمة جيدا في وسط المدينة.
في ختام الكتاب يخلص باديو إلى عدة دروس منها أهمية المضي من اللاضرورة إلى الممكن تطبيقا للشعار الذي تم ترويجه في أحداث مايو: «كن واقعيا واحلم بالمستحيل». ويرى أنه يجب الحفاظ على اللغة التي لم يعد يتجاسر أحد على نطقها بحجة أن العالم تغير ولم يعد كما مضى، اللغة التي تتضمن كلمات من نوعية: الشعب، العامل، العدالة الاجتماعية، فاستنكار التفوه بمثل هذه الكلمات يعد برأيه نوعا من الإرهاب اللغوي. كما أنه من الأهمية بمكان، تجريب أشكال جديدة للتنظيم السياسي بعيدا عن الأشكال الكلاسيكية كالحزب والنقابة.
وتبقى ملاحظة على هذا الكتاب المهم تتعلق بلغة المترجم، فرغم الجهد المبذول جاءت اللغة أحيانا جافة، شديدة التعقيد، والتراكيب الاصطلاحية على نحو يشي بأنه استسلم للترجمة الحرفية في كثير من الأحيان.