منذ مجموعاته الأولى «صور» وحتى عمله الأخير «الحياة تحت الصفر»، يبدو الشعر عند عباس بيضون محاولة مضنية للملمة شظايا حياةٍ مهددة بالزوال السريع، أو مسرات عابرة لم ننتبه إلى انزلاقها من بين أصابعنا إلا بعد فوات الأوان. وهو من هذه الناحية لا ينتظر غروب الأيام لكي يحولها إلى أطلال، بل هو يرى منذ البداية المآل القاتم للوجود الإنساني، والطابع الخلبي لكل ما يتصل بالحب أو السعادة أو نشوة الظفر. وهو أمر ينسحب على الأفراد كما على الجماعات، على المدن كما على الحضارات. وحين كتب عباس «نقد الألم» في مطالع تجربته، كان يحاول في الحقيقة حرف أنظارنا عن الآلام التي يكابدها، تماماً كما فعلت حبيبة عمر بن أبي ربيعة حين طلبت منه أن ينظر إلى سواها، تمويهاً للحقيقة ومحاولة لإخفائها. ومع أن الشاعر لا يستسيغ التفجع ولا الحزن الرومانسي، فإن ما يشيع في شعره من حزن وجودي، ليس سوى المحصلة الطبيعية لبصيرته النافذة ولطريقة تحديقه في المصائر، بحيث يصبح اللاوعي عنده حالة من حالات الوعي المفرط، أو الكشف المأساوي عن النواة الفاسدة للأشياء.
ومع ذلك، فإن التأمل العميق في تجربة صاحب «خلاء هذا القدح» الشعرية، تقودنا إلى الاستنتاج بأن هذه التجربة لا تندرج في خانة واحدة ولا تأخذ مساراً تصاعدياً، بل هي تتقدم وتنكفئ تبعاً للحظة الكتابة، أو لطبيعة الحالة الشعورية التي تواكب تلك اللحظة، قوة وخفوتاً. ولأن الأنا عند بيضون هي متفاقمة ومجروحة في الوقت ذاته، فإن لغته الشعرية لا تتوهج وتصبح أكثر دقة وملموسية إلا حينما تكون لصيقة بأناه، أو حين تتحول إلى نوع من السيرة الذاتية، الفردية منها والجمعية، كما في مجموعاته «صور» و«حجرات» و«صلاة لبداية الصقيع» وغيرها. كما أن إلحاح عباس، المحاط بكل أولئك الذين جعلوه وحيداً، وفق تعبيره الحرفي، على استخدام ضمير المتكلم الجمعي في كثير من قصائده، ما هو في قرارته سوى محاولة الأنا المهددة والخائفة للاختباء من وطأتي الشيخوخة والموت، عن طريق التماهي مع مكابدات الآخرين، أو الاختباء خلف الكتلة الكثيفة لحيواتهم السديمية. لكن الأمور لا تكون دائماً على هذا المنوال، إذ إن اللغة في بعض الحالات تتحول، في غياب ملموسيتها ومعادلها الحياتي، إلى نوع من المثاقفة والكدح المعجمي، وحشد المفارقات الصورية والتعبيرية التي لا معادل لها على أرض الواقع.
في مجموعته الأخيرة «الحياة تحت الصفر»، التي يذكّرنا عنوانها بكتاب رولان بارت الشهير «الدرجة صفر للحياة»، يعيد عباس بيضون الاعتبار للكتابة اللصيقة بالذات والطالعة من أتون التجربة، بعيداً عن أي مخاتلة للمعنى أو «دوران» حوله. ذلك أن الهلع الذي أصيب به الشاعر جراء وباء كورونا، حرر لغته من أي ترف تأليفي أو مناورة أسلوبية، وجعله يسددها بشكل مباشر نحو المخاوف الكابوسية التي تعصف بوجوده. والواقع أن من يتابع تجربة بيضون منذ بداياتها لا بد أن يلحظ وقوفه اللافت على هشاشة الحياة وقابلية الأشياء السريعة للتلف والاضمحلال بفعل ثقبٍ غير مرئيٍ في الوجودات والأزمنة، أو خطيئة «جينية» أصلية سابقة على الوباء، ولا سبيل إلى تداركها. وهو ما يؤكده قول الشاعر: «هذا الخطأ الذي عاد إلي من طفولة أبنائي \ لا يزال يكبر في رأسي.. \ اسمي يجري تعذيبه \ ويقع تحت إعدامات موصولة \ خالياً من أحشائي وفكرتي \ أستدير إلى حيث تعاد تسميتي \ وتسمية من حولي \ حيث يصلني ذلك في عظام صغيرة في سلال \ علينا أن نكمل هكذا احتفالنا العائلي \ ونجد ألقاباً للجميع».
لقد نجح الوباء من جهة أخرى في تفكيك العالم وتحويل البشر إلى كائنات هشة ومحكومة بالانغلاق على نفسها بشكل تام. أما العزلة التي يرى فيها الجميع ضالتهم وملاذهم من الخطر، فهي لا تشبه بأي حال تلك العزلة الخلاقة التي يَنشدها الكتاب والفنانون للإخلاد إلى رُبات الشعر وشياطين الإبداع، بل هي أقرب إلى الزنازين الانفرادية أو المحاجر الإلزامية المفروضة على ملايين الموبوئين أو المصابين بالجذام. هكذا يحس الشاعر بأنه بات منفياً داخل غرفته، وبأنه يجرّ أناه الكسيحة من التلفزيون إلى السرير، ومن المكتبة إلى البرّاد، ومن الأمس إلى اليوم، حيث المكان والزمان يدوران حول نفسيهما بلا هوادة ولا جدوى. كأن الحياة الفعلية قد انقضت تماماً، وما يحدث الآن هو «كلام يعاد تسييله»، وما يتراءى لنا أنه الحياة هو في حقيقته «قفا الحياة» وشبحها الصرف. وفي مناخ الرعب هذا لا يعود التلامس وحده مصدراً لهلع البعض من البعض الآخر، بل النظرات والأصوات والروائح والأنفاس، وكل وسائط الاتصال بين البشر. وهو ما يعبر عنه بيضون بقوله: «إننا نتبادل الألم ونتعادى بالنظرات \ الفراغ الذي نُحتنا منه يُباعدنا \ ويجعلنا نتنقل بين الأصفار \ فقط كراهية صامتة وبلا رائحة \ تستطيع أن تتلصص فيه \ وأن تلسع \ بدون أن تترك أثراً».
ومع أن عبارة سارتر «الجحيم هو الآخرون» تكتسب مع كورونا أبعاداً إضافية تتعدى الإطار المعنوي والنفسي لتتصل بقابلية الجسد الآخر للقتل عن طريق العدوى، فإن الشاعر يلح كعادته على النطق بلسان الجماعة، ليس لأن هذا النوع من الطقس الإنشادي بات واحداً من مفاتيحه التعبيرية فحسب، بل لأن الخطر المتقاسم بين الجميع هو أقل وطأة من الخطر الشخصي الذي يواجهه الأفراد؛ كلّ على حدة. وكما الحال في كثير من مجموعاته السابقة، فإن عمل بيضون الأخير يتغذى من مواد أولية شديدة المحسوسية. فالقصيدة عنده هي تعقّب بارع لما يعتبره البعض جزءاً من نثريات العيش أو سقط متاع الشعر. على أن القول الشعري الذي يوضع في عهدة الحواس الخمس مجتمعة، مع غلبة واضحة لحاسة البصر، لا يكتسب أهميته من عناصره المحسوسة وحدها، بل من استدراج النص إلى خانة الأسئلة المقلقة، ومن تشريع الباب واسعاً أمام التأويل، حيث المرئي واللامرئي يتبادلان الأدوار في لعبة المرايا المتقابلة.
كما يبدو الشعر في «الحياة تحت الصفر» أشبه بمجسات متناهية الدقة لالتقاط كل ما يصدر عن أولئك الذين لم يهلكوا بعد، من إشارات البقاء على قيد الحياة، أو هو فهرس الحشرجات التي يرسلها الناجون من الغرق باتجاه سماء مصابة بالصمم. وفي وضع كهذا، لا يعود الجمال الأسلوبي واحداً من هموم الشاعر وأولوياته. وهو لن يكترث كثيراً لتشذيب اللغة وإعادة صياغتها وتنقيحها من الشوائب، أو لتخليصها من التكرار، إذ سيبدو الأمر في هذه الحالة نوعاً من الترف البلاغي أو «الإكسسوارات» الفائضة عن الحاجة، في ظل الخراب المحقق الذي يتهدد الكائنات. هكذا تتحول الكتابة إلى نوع من الرقائم والتعازيم، أو إلى محاولة شبه يائسة لرتق أوصال الحياة المتناثرة التي تقطعت بها السبل. وحيث تضيق إلى أبعد الحدود المسافة الفاصلة بين الناجين والمصابين، كما بين الأحياء والموتى، لا يتوانى الشاعر عن الإعلان «إنني الآن الرأس المقطوع لبقية المدينة \ وأنا أيضاً الكمامة الأولى التي تدمغ المدينة \ وكالفيروس الأصلي إنني أُعدي بكلمة \ بفنجانٍ بلاستيكي \ بوجهٍ في طبق \ وربما بغلطة \ وبوجهي الذي أخسره في اللعب».
الكشف المأساوي عن النواة الفاسدة للأشياء
https://aawsat.com/home/article/3148901/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1
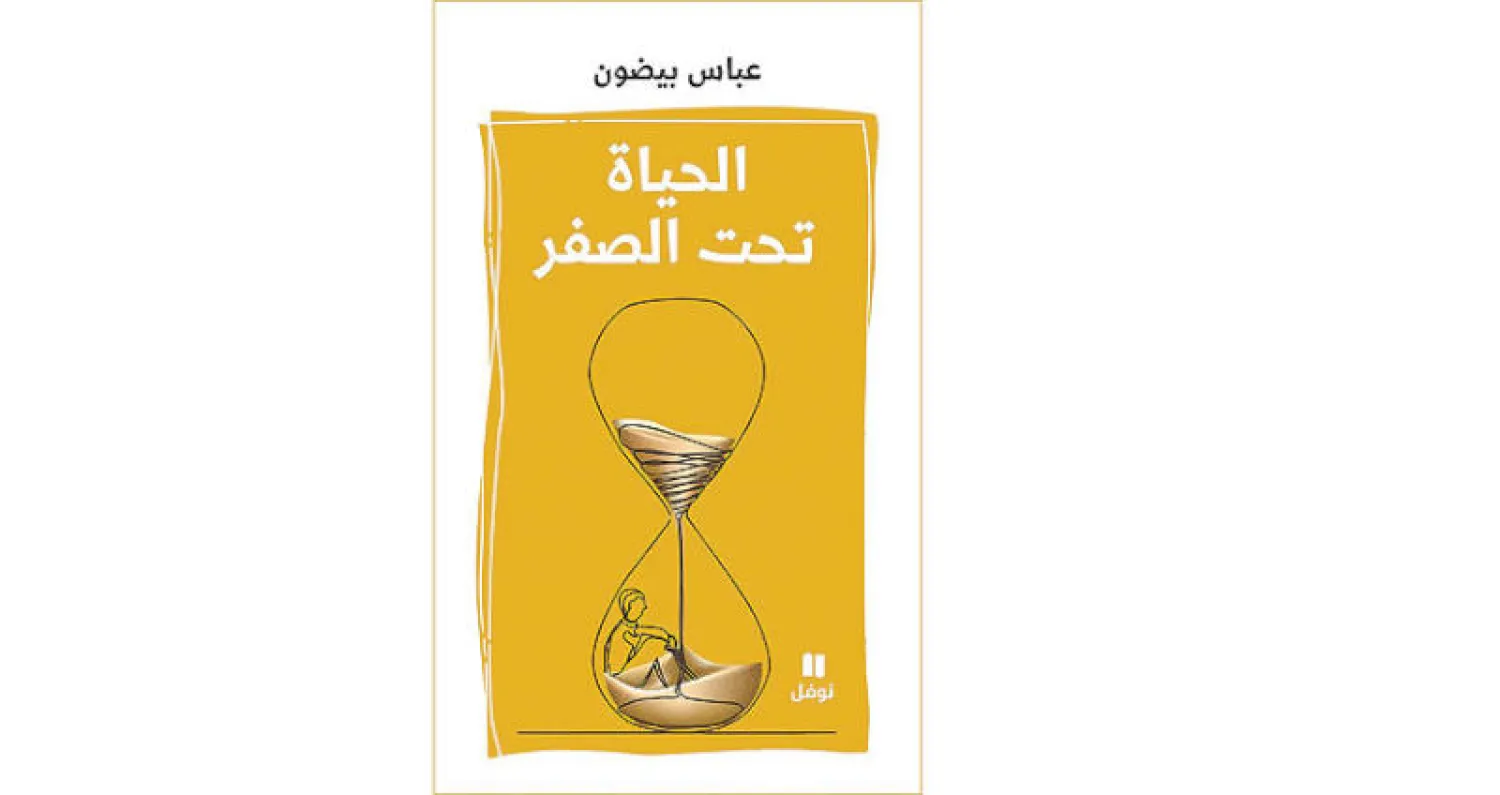

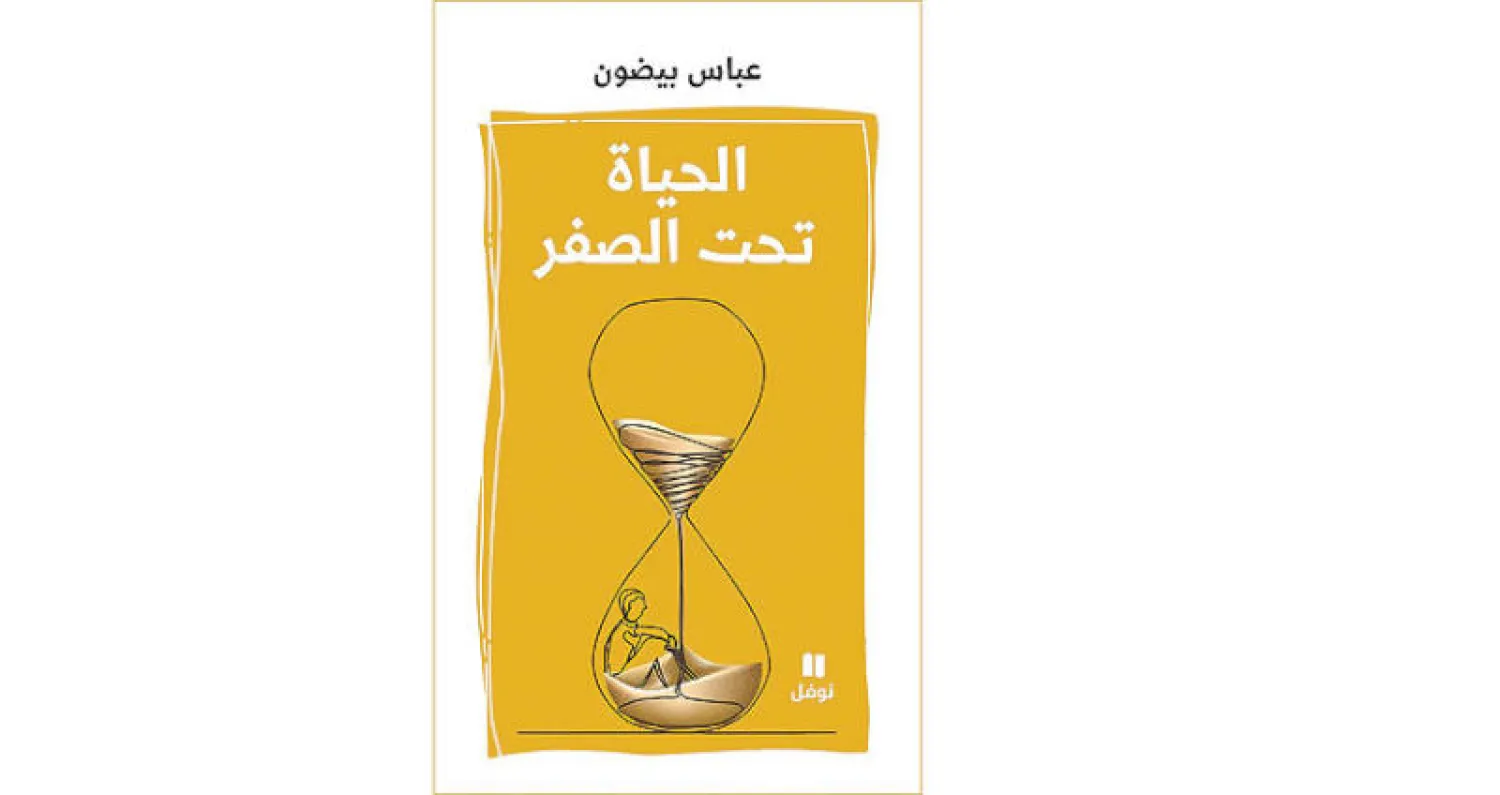
الكشف المأساوي عن النواة الفاسدة للأشياء
عباس بيضون في مجموعته الأخيرة «الحياة تحت الصفر»
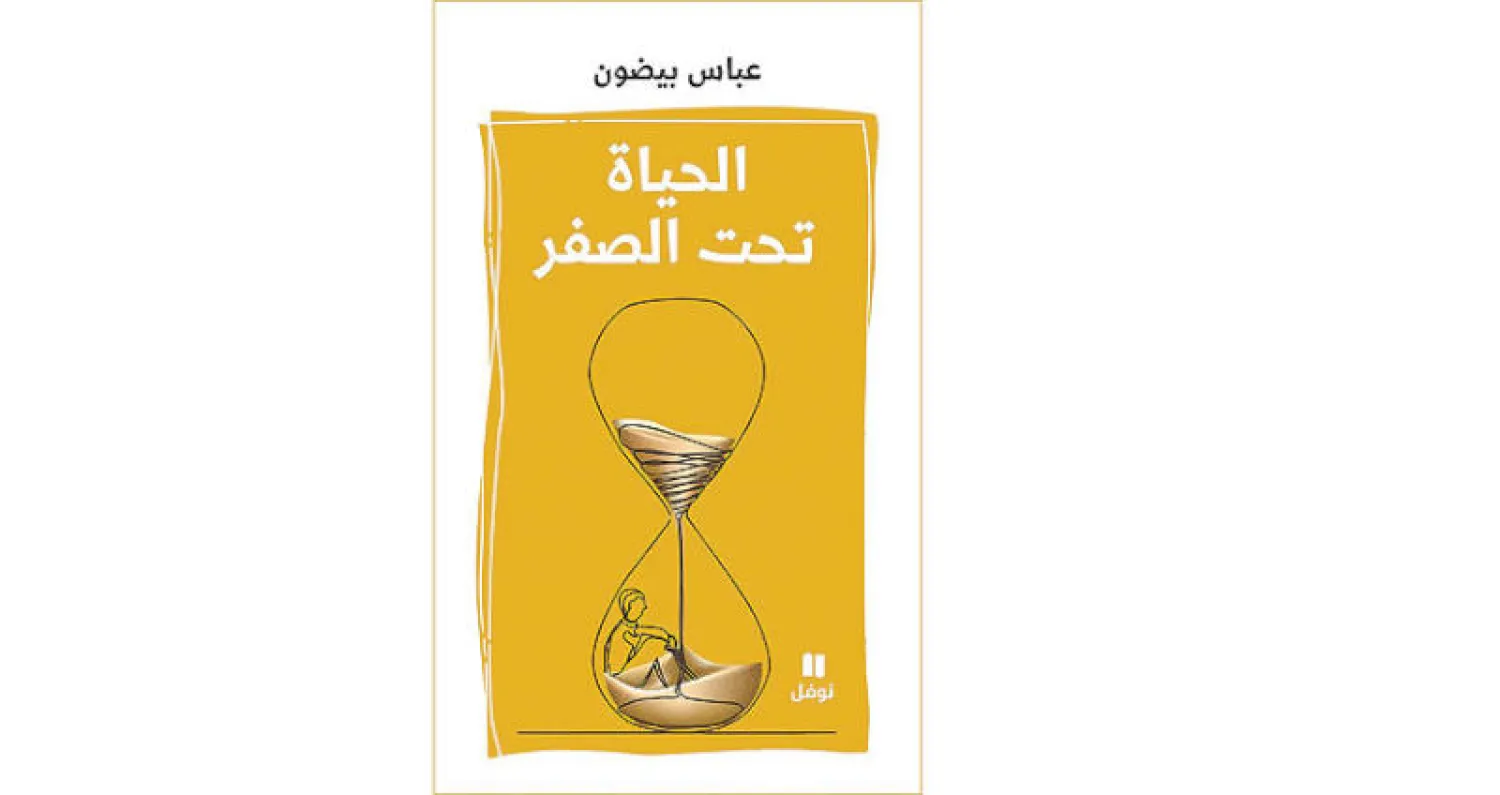

الكشف المأساوي عن النواة الفاسدة للأشياء
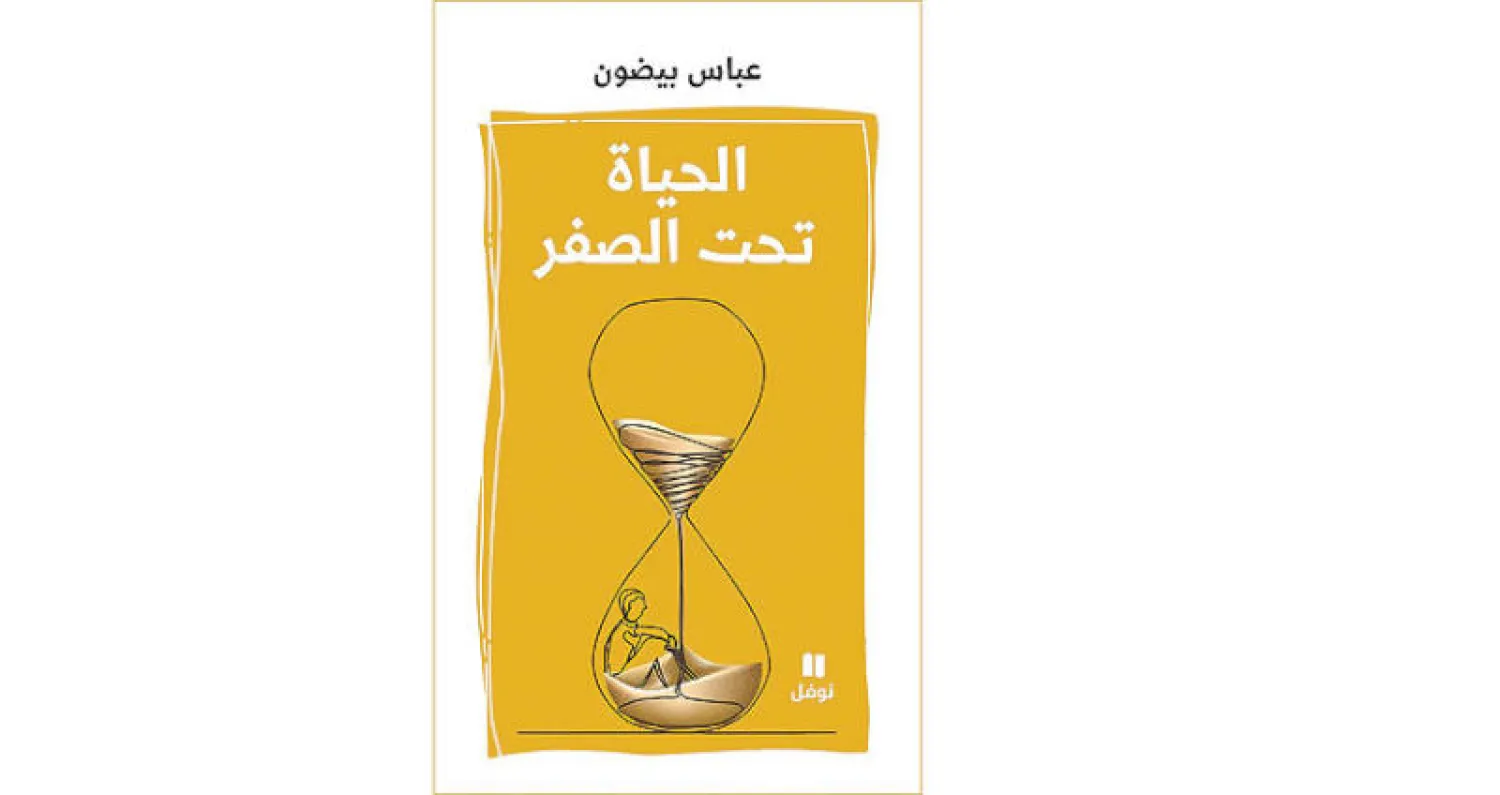
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة









