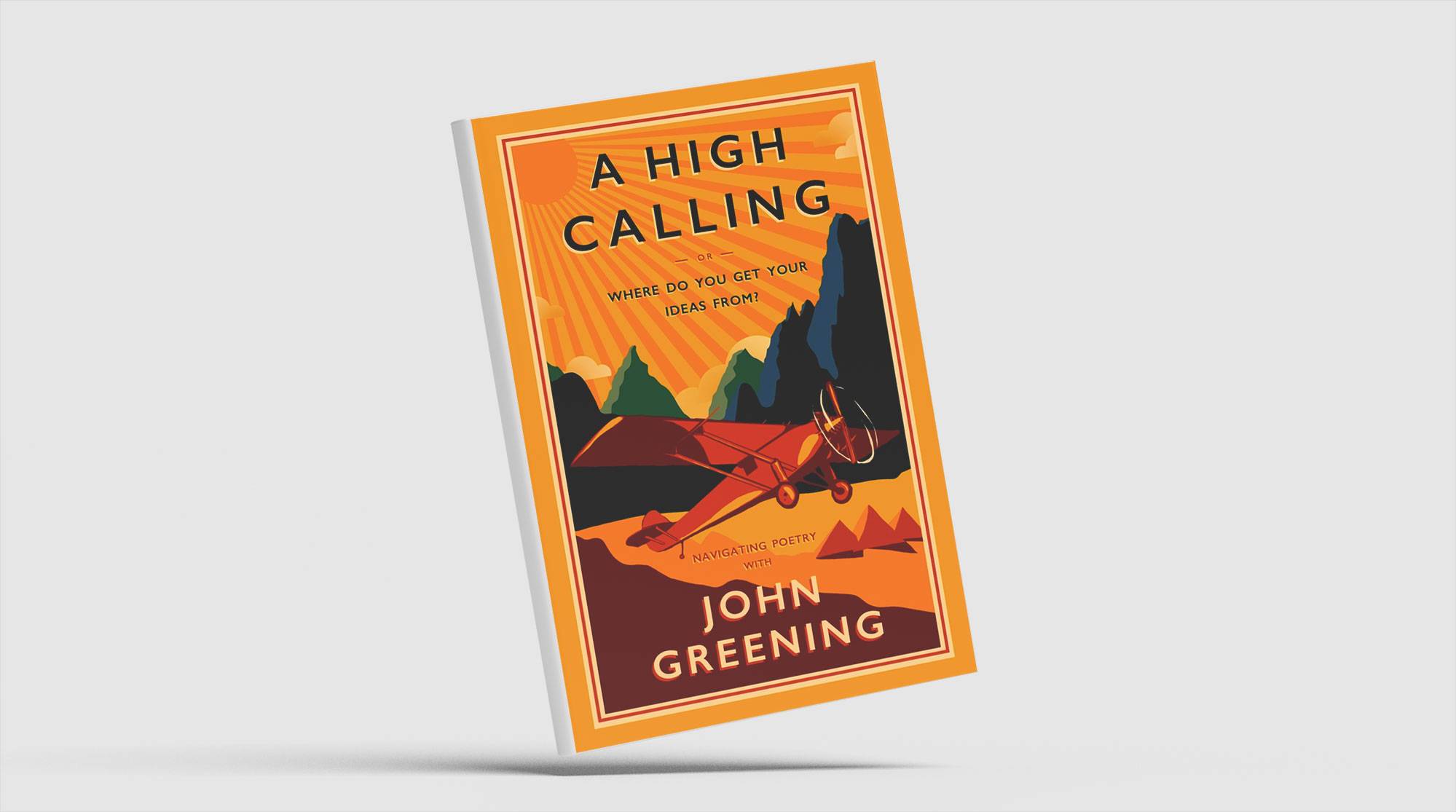كنت قد شرحت أكثر من مرة سبب تفوق أركون على جميع المثقفين العرب الذين تصدوا لدراسة التراث أو تجديد التراث أو نقد العقل العربي... إلخ. وقلت إن مشروعه هو وحده الذي بقي صامداً في الساحة في حين تبخرت كل المشاريع الأخرى إلى حد كبير أو اندثرت أو فقدت مصداقيتها. والسبب هو أنه يذهب إلى أعماق الأشياء ولا يتوقف في منتصف الطريق. والسبب هو أن فكره عبارة عن حفر أركيولوجي في الأعماق أو أعماق الأعماق حتى يصل إلى عقدة العقد التراثية المستعصية فيفكها ويضيئها بشكل غير مسبوق. وبتفكيكها وإضاءتها يحصل شيء خارق يشبه المعجزة: لقد تحررنا من إرهابنا اللاهوتي المزمن لأول مرة وتنفسنا الصعداء! هناك سبب آخر هو أنه يسيطر على المنهج والمصطلح بكل تمكن واقتدار. هذا في حين أن المحاولات الأخرى عبارة عن أدلجات أو مراهقات فكرية لا تشفي الغليل ولا تروي العليل. لهذا السبب لم يبقَ في الميدان إلا حديدان. كنت قد تحدثت عن كل ذلك بالتفصيل في الفصل المطول الذي كرسته له في كتابي الصادر مؤخراً عن «دار المدى» بعنوان: «العرب بين الأنوار والظلمات. محطات وإضاءات». عنوان الفصل بالضبط هو: «محمد أركون: أكبر مفكر في الإسلام المعاصر». للأسف لا أستطيع أن أكرر هنا ما قلته هناك. ولذا سأكتفي باستعراض سريع لبعض أطروحات هذا المفكر العملاق.
لقد أوضح أركون أكثر من مرة الفرق الأساسي بين إسلام العصر الذهبي وإسلام عصر الانحطاط. لقد بيّن الفرق بين الأخلاق الإسلامية - الفلسفية النبيلة التي بلورها كبار مفكري العصر الذهبي من معتزلة وفلاسفة، وبين الموجة الظلامية المنتشرة حالياً التي لا علاقة لها بالأخلاق ولا بالنزعة الإنسانية. ولهذا السبب يرى أركون أنه ينبغي تحرير الفكر العربي من السجن الدوغمائي المغلق الذي سجنتنا فيه عقلية القرون الوسطى. لقد دعا إلى الخروج من العقلية الدوغمائية والطائفية الضيقة. فالدوغمائية إذا زادت على حدها تتحول إلى تحجر، فتعصب، فإرهاب. لقد كان إسلام العصر الذهبي المجيد، منفتحاً على الفلسفة اليونانية وبخاصة فلسفة أفلاطون وأرسطو... إلخ. أما اليوم فلا يوجد أي انفتاح وإنما انغلاق وانغلاق الانغلاق. هل يوجد مفكر إسلامي واحد مطلع على مؤلفات كانط أكبر فيلسوف أخلاقي وتنويري في الغرب الحديث؟ أما جهابذة مفكري الإسلام القدماء فقد عرفوا كيف يوفقون بين التراث الإسلامي العريق من جهة، والفلسفة الإغريقية من جهة أخرى. بمعنى آخر فإنهم عرفوا كيف يوفقون بين العقل والنقل، أو بين الفلسفة والدين. وهذا ما ينقصنا بشكل موجع اليوم. لولا الانفتاح على الحضارات الأخرى لما كانت كنوز التراث العربي التي لا تزال تدهشنا وتبهرنا حتى اليوم. كان الإسلام آنذاك حضارياً مشرقاً منفتحاً على الآخرين ومتسامحاً معهم ومحترماً لكرامتهم الإنسانية. وما كان يشتمهم أو يكفرهم لأنهم ليسوا مسلمين! ولكن كل ذلك اختفى من ساحة الفكر العربي ولم يعد له من وجود بعد إغلاق باب الاجتهاد والدخول في عصر الانحطاط وهيمنة السلاجقة الأتراك. ثم يسألونك مستغربين: لماذا فشل الإخوان المسلمون أو وصلوا إلى الجدار المسدود؟ لأن مفهومهم للإسلام غير صالح لهذا العصر. إنه ضيقٌ عليه أو مضاد له. ولذلك نقول: المستقبل للإسلام الحضاري المستنير المتصالح مع عصره الذهبي ومع أفضل ما أعطته الحداثة العالمية. وهذا ما لم يتحقق حتى الآن. من هنا الفشل الذريع لما دعي خطأ بالربيع العربي!
في إحدى المرات توقف أركون مطولاً عند تحليل ذلك «الإعلان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان» الذي تلاه الأستاذ سالم عزام على الجمع الثقافي النخبوي المحتشد في قاعة ضخمة بمقر اليونيسكو في باريس وفي حفل مهيب بتاريخ 19/ 09/ 1981. وكان من بين الحاضرين أحمد بن بيلا وحسين آيت أحمد، بالإضافة إلى شخصيات أخرى عربية وفرنسية. ويعترف أركون بأنه إعلان مفيد وضروري، ولكنه للأسف بقي عبارة عن صياغات إنشائية عامة في نهاية المطاف. صحيح أنها مليئة بالنوايا الحسنة والوعود الجميلة، لكنها لا تقدم ولا تؤخر ولا تدخل في صلب الموضوع. فهذا النص لا يقول شيئاً عن المكانة القانونية للإنسان في النصوص الدينية التأسيسية. ومعلوم أن الإنسان الكامل الحقوق لديها هو المسلم إذا كان المجتمع مسلماً أو المسيحي إذا كان المجتمع مسيحياً... إلخ. ولكن الحداثة التنويرية قطعت مع كل ذلك ووسعت مفهوم الإنسان لكي ينطبق على أي إنسان سواء كان من ديننا أم لا، من طائفتنا أم لا، من مذهبنا أم لا. فالإنسان كشخص بشري له كرامته بغض النظر عن أصله وفصله أو دينه وطائفته ومعتقده. هنا تكمن قطيعة الحداثة الكبرى مع اللاهوت والفقه التكفيري القديم. ويبدو أن هذه الفكرة الأساسية مجهولة من قبل مدبجي الإعلان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان. إنهم يتجاهلون أو يجهلون أن الفلسفة العلمانية الإنسانية الحديثة لم تعد تميز بين المواطنين طبقاً لأصولهم العرقية أو الدينية أو المذهبية. لم يعد لديها مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية ومواطن درجة ثالثة... إلخ. الجميع أصبحوا مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. وذلك على عكس اللاهوت المذهبي أو الفقه الديني القديم. فإعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرته الثورة الفرنسية في 26 أغسطس (آب) من عام 1789 كان ينطبق على جميع المواطنين الفرنسيين، وليس فقط على المسيحيين أو على أبناء الأغلبية الكاثوليكية. فالبروتستانتي أصبح بفضله إنساناً كامل الحقوق لأول مرة في تاريخ فرنسا. لقد رفعوه، وهو الأقلوي المضطهد والمحتقر، إلى مرتبة الكاثوليكي الأكثري الغالب المتغطرس والمهيمن تاريخياً. بل وحتى اليهودي أصبح مواطناً بالكامل. من هنا الطابع التحريري والإنساني بل والكوني لهذا الإعلان التاريخي الشهير الذي أصدرته الثورة الفرنسية. هذه ثورات حقيقية تقذف بك إلى الأمام ولا تعود بك قروناً إلى الوراء! هذه ثورات تقضي على الطائفية ولا تنعشها إنعاشاً غير مسبوق. ومن أي شيء استمد هذا الإعلان الشهير مبادئه ومواده الأساسية؟ هل من الكتب التراثية الصفراء التي صدئت وعلاها الغبار؟ هل من كتب اللاهوت والكهنوت؟ أبداً لا. لقد استمد مواده الأساسية من جان جاك روسو وكتابه العظيم: العقد الاجتماعي. كما استمده من كتاب روح القوانين لمونتسكيو وبقية كتب فلاسفة الأنوار وعلى رأسهم فولتير. هل نسينا كتابه الرائع: رسالة في التسامح؟ ففيه قضى على التعصب الطائفي الذي كان يكتسح فرنسا آنذاك قضاء مبرماً.
لا أستطيع للأسف معالجة كل محاور فكر أركون في هذه العجالة وإلا لدبجت عشرات الصفحات. لكن لنتوقف عند بعض اعترافاته الشخصية حيث يقول ما فحواه: بصفتي مؤرخاً للفكر الإسلامي فإني كنت قد واجهت مشكلة المجابهة الجدلية الخصبة بين العقل الديني/ والعقل الفلسفي عندما تعمقت في دراسة المرحلة الكلاسيكية المبدعة من تاريخ الفكر العربي الإسلامي (750 - 1300). ولكن المشكلة إن لم نقل المصيبة هي أن هذه المجابهة التفاعلية الرائعة توقفت عندنا، في حين أنها استمرت في أوروبا صعوداً دون توقف منذ عصر النهضة في القرن السادس عشر وحتى اليوم. وهنا يكمن الجواب على التساؤل الشهير: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ لأن الأصولية الدينية تغلبت عندنا كلياً على العقلانية الفلسفية إلى درجة أنها حذفتها وطمستها بل واستأصلتها. «من تمنطق فقد تزندق»، أو «كان يتفلسف لعنه الله»... إلخ. والشيء الذي زاد الطين بلة هو أن الأصولية الدينية تحولت عندنا إلى عقلية ظلامية تكفيرية متعصبة، بل وطغيانية استبدادية لا تقبل النقاش. نستنتج من كلام أركون أنه ينبغي أن نعيد الاعتبار إلى العقل الفلسفي إذا أردنا أن نستعيد أمجادنا الغابرة وعصرنا الذهبي. فالحضارات تقوم على ركيزتين لا ركيزة واحدة: ركيزة الدين وركيزة الفلسفة. وعندما انهارت إحداهن انهارت حضارتنا العربية وعمّ الظلام العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه.
أخيراً سأقول ما يلي وبه أختتم: لقد انتصر فكر أركون وسوف ينتصر أكثر في المستقبل لأنه جاء في الوقت المناسب ولبى حاجة تاريخية. لقد استطاع أن يعري الأصولية من جذورها، من أساساتها، من أساسات أساساتها. وهو ما عجز عنه كل مثقفي العرب والإسلام قاطبة.
لماذا انتصر محمد أركون؟
المحاولات الأخرى عبارة عن أدلجات أو مراهقات فكرية

محمد أركون

لماذا انتصر محمد أركون؟

محمد أركون
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة