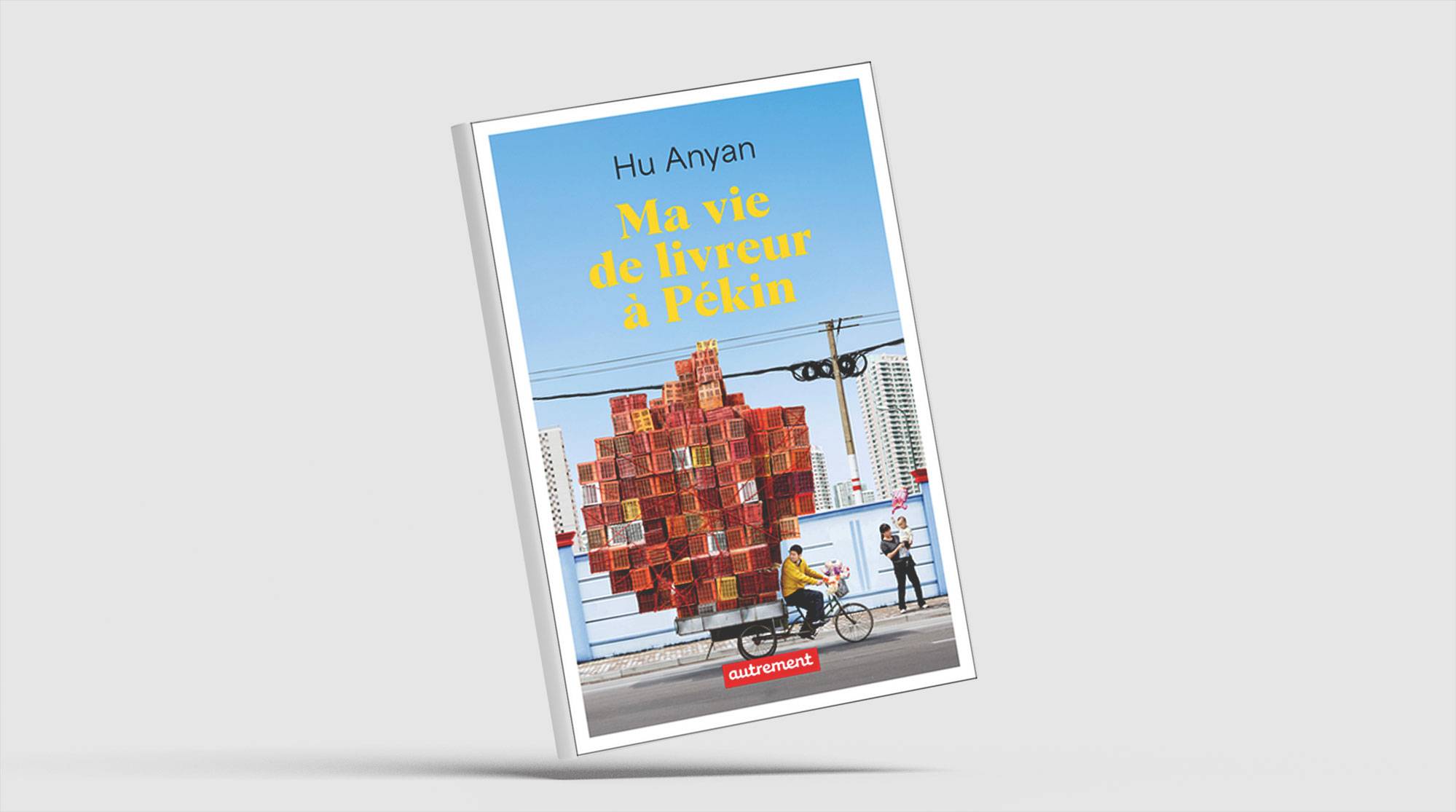وسط العزلة التي فرضها وباء «كورونا»، كتب الروائي البحريني عقيل الموسوي، روايته الثانية «دارا الزرادشتي»، التي استحضر فيها متحف الملل والنحل والثقافات والحضارات التي تكتنزها بلاد فارس، مستلهماً شخصية الزاهد المتصوف «دارا» الذي اتخذ من الترحال والسفر والتنقل عبر الأمكنة وسيلته للاستكشاف، قاطعاً المسافات من أجل التزود بالمعرفة والعلم والإيمان.
رأى الناقد البحريني د. فهد حسين، «أن رواية (دارا الزرادشتي) تؤكد ما يمتلكه الكاتب من موهبة حقيقية في الكتابة الإبداعية من جهة، ورؤيته لهذا الجنس الإبداعي وكيف يوظف الأبعاد المختلفة داخل فضاء العمل، فهو بهذا النص يملك ناصية اللغة، وسبكها وربط جملها بحرية سلسة، وبعفوية من دون تكلف، بل أعتقد أنه كتبها بحب وشغف ورغبة وتفاعل حقيقي من أجل إبراز بعضٍ من تاريخنا الإنساني».
في حين وصفها الناقد جعفر المدحوب، بأنها «رواية من طراز فريد، وصوت مغاير بين أصوات السرد البحريني».
عقيل الموسوي كاتب ومصور فوتوغرافي، ويعمل طبيب أسنان منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وقبل هذه الرواية أصدر روايته البكر «أريامهر نامه»، التي صدرت عن «دار الفارابي».
هنا حوار معه عبر وسائل التواصل، جراء التباعد الذي فرضته جائحة «كوفيد - 19».
> أصدرتَ مؤخراً روايتك الثانية «دارا الزرادشتي»، هي ثاني تجربة بعد روايتك الأولى «أريامهر نامه: سيرة نور الآريين»، كلا الروايتين تحملان عمقاً ثقافياً وفلسفياً ومشبعتان بالتاريخ... ماذا يجمع بين هاتين الروايتين؟
- ما يجمع بين الروايتين هو تفاعلي بعمق مع التاريخ. لا يستطيع أي روائي أن يكون مبدعاً دون أن يكون مستثاراً من موضوع روايته، دون أن ينغمس فيه، ويكون جزءاً منه. وأنا مرتبط بفكرة التاريخ في الرواية، ليس بوصفي أميل لأخلاق هذا الدين أو ذاك، وليس بوصفي متعاطفاً مع أمة ضد أخرى، بل بوصفي روائياً مهتماً لأعرف النفس البشرية، وأتلمس ما يحدث في دواخل الإنسان. ثمة رغبة جامحة عند البشر للحكم على شخصيات التاريخ، إما أخياراً أو أشراراً، وذلك ليس شأني، لا تقدم رواياتي أحكاماً جاهزة، بل تستعرض فهماً مختلفاً للتاريخ وشخصياته.
> أيضا كلا الروايتين تحملان مشاهد باذخة من الحضارة الفارسية. كيف تسنى لك توظيف كل هذه المحتوى والاستفادة منه، رغم تعقيداتها التاريخية والسياسية والقومية؟
- يجب ألا نغفل عن حقيقة أن كل أمة تسعى لتحتكر التاريخ، وكل دين يحتكر الحقيقة. وإذا كنت قد نجحت في تحميل أعمالي «مشاهد باذخة»، فذلك لأن الرواية في شكلها السردي تتبع حال الإنسان وتقلباته أكثر مما تتبع حال الدول، وذلك خلاف ما تفعله في العادة كتب التاريخ أو كتب الدين. ولقد لاحظ تلك الحقيقة الروائية الباحث علي الديري، ونشرها سابقاً: «أن السرد الروائي الذي جاء في رواية (دارا الزرادشتي) أتاح لنا برؤيته المتسعة أن نتحرر من فهم كُتب الملل والنحل».
هناك من قال «إنه زمن الرواية»، وذلك ببساطة لأن الرواية تقول ما يمكن للرواية وحدها أن تقوله. أما التعقيدات السياسية والقومية التي ذكرتها، فهي في الأخير مقص يحمله رقيب غليظ. ولتجنب ذلك المقص، لجأت إلى عدة حيل سردية مثل معظم الروائيين. الكاتب البحريني أحمد خلف رأى أنه يمكن اعتبار رواية «أريامهر نامه» جسراً أدبياً يصل بين الثقافتين العربية والفارسية. وفي رواية «دارا الزرادشتي»، تمكن بعض القراء من أن يلاحظوا إسقاطات الماضي على الحاضر العربي، وعبروا عن ذلك على قنوات التواصل الاجتماعي بجرأة تفوق ما ذهبت إليه الرواية.
> هناك من رأى أن رواية «دارا الزرادشتي» تحمل بعضاً من سيرتك الشخصية. وعلى رأي أمبرتو إيكو، فإن أجزاء من حياة المؤلف تنتقل إلى رواياته بوحي أو في غفلة منه... أين نجد ظل الكاتب في فضاء الرواية؟
- ما تقوله روايتي شيئاً مختلفاً عني، فلست أتحدث في الرواية باسمي، أو باسم أفكاري الخاصة، ولا باسم أحدٍ آخر. أتفق مع الفرنسي فلوبير حين قال إن الروائي هو الشخص الذي يختفي خلف عمله الإبداعي. مع ذلك، شيء لا بد تسرب مني في غفلة مني، ليس من الأنا اليومية لطبيب الأسنان فحسب، ولكن من الأنا العميقة غير الواعية كذلك. أختي الفوتوغرافية، عديلة الموسوي، رأت ظلي في الرواية وكتبت في صحيفة «الأيام» البحرينية أن شغف بطل الرواية «دارا» بالسفر والكتب، مستوحى من حياتي الخاصة، ولعل صيغة المتكلم (أنا)، وليست صيغة الراوي العليم (هو)، أحدثت تماهياً بين شخصيتي كروائي وشخصية البطل. أما الكاتب جعفر المدحوب فقد كتب في مجلة «أوان» الإلكترونية أن شيئاً من سيرة الغربة لوالدي المرحوم، قد تسربت من وعيي الباطن، وظهرت في حياة «دارا». أحب أن أضيف هنا أني اخترت أن يتحدث «دارا» بلسانه، بسبب الطبيعة السيكولوجية للرواية التي اضطرتني إلى تلك الصيغة لسبر أغوار نفس بطلي، واستعراض مونولوجات داخلية. لكن استخدام الصوت السردي (أنا) جعل القراء يتقاسمون الرؤية مع البطل، فوجدوا أنفسهم متماهين مع الأنا التي يقرؤونها كما وكأنهم هم المتلفظون بها.
> كيف أثْرَتْ اللغة الصوفية هذه الرواية؟
- اللغة الصوفية يمكنها أن تمارس سحراً حقيقياً على المسلمين، وهي بالفعل أَثْرَتْ نصي، بعض القراء لاحظوا ذلك، كثير منهم راق لهم ذلك. ثمة قبول جميل للتصوف بين شباب المسلمين اليوم. وينبغي أن أوضح هنا أن تأثر «دارا» بالشعر الصوفي منطقي ومبرر، لأنه زرادشتي أصيل، أول حكمة عرفها كانت شعراً كتبه زرادشت.
لست مؤمناً بالإلهام
> قلت ذات مرة إنك ذهبت لصحراء الربع الخالي تفتش عن التيه والضياع، ولكنك أخفقت فاهتديت للطريق مجدداً... هل هذا ما حدث لـ«دارا الزرادشتي»، حيث الارتحال بين الأديان مثل ممارسة للتيه حتى يتحقق اليقين؟
- ينبغي أن أعترف هنا أني لم أكتب الرواية في نفس واحد، كتبت الجزء الأول الخاص بالزرادشتية، ثم غصت في بطون الكتب، أبحث لبطلي عن طريق مقنعة إلى رحاب الإسلام، ولم يكن في تصوري أن «دارا الزرادشتي» الذي قرأتموه هو الشكل النهائي. كنت أتأمله، وأعيد كتابته باستمرار. كان دارا يتغير، ومنطق الرواية يتضح أكثر، ثمة شخصيات تخرج من النص، وأخرى تدخل، وفهمي للمذاهب يتعمق في معمعة البحث/ الكتابة الدؤوب. لم يسبق دارا كل ذلك، بل ولد أثناء كل ذلك. ليس ثمة إلهام خارق تملكني، ولن أمل من تكرار أني لست مؤمناً بالإلهام في الكتابة. أثناء الكتابة، كنت مثل دارا، عقلي مفتوح على الأديان، أرتحل معه من مذهب إلى آخر، وقناعاته تتبدل، تتغير، لا ضرر في أن نتغير، من الطبيعي أن نتغير، قال دارا في نهاية حياته: «ثلاثة وثمانون عاماً مرت، عمرٌ كان ينبغي أن يغير من هيئة فارس، لكن فارس هي التي غيرتني». وليس ثمة يقين مطلق في نهاية الرواية، لكن هناك يقين نسبي، الكشف الأخير الذي يحرزه الإنسان في نهاية عمره، ويرتاح أن يموت به.
> إلى أي مدى كانت رحلة البحث عن المعنى في مسيرة «دارا» بين زوايا التاريخ والأديان والثقافات تمثل هموم الإنسان الحاضر وتطلعاته نحو الحقيقة؟
- عندما نقول رواية تاريخية فإننا نقصد أنها تتكئ على مادة التاريخ، تقدم للقارئ المعاصر هموم الماضين وتطلعاتهم نحو الحقيقة. كروائي كنت أفكر في آلام بطلي «دارا» الزرادشتي الذي عاش مهمشاً في فارس في القرن الثالث عشر، تقمصت ثقافة الأمة الفارسية برمتها لكي أجعله ينطق، تخيلت سلمان الفارسي يفكر في أمر الإسلام، تخيلت الفلكي البيروني يقرأ بذهول وصف القرآن الكريم للكون، تخيلت الفردوسي يعاني بين إسلامه واعتداده الفارسي، تخيلت عمر الخيام مهرطقاً هائماً في سكراته، تخيلت البسطامي وابن المقفع وابن سينا، جميع هؤلاء حضروا معي وأنا أسعى مع دارا من أجل الحقيقة. لست أدري من فيهم الذي ألهمني عندما قال دارا: «في فارس أتذوق نكهة زرادشت». إنها ليست أفكاري الخاصة، بل حكمة فارس، وفي نصي هي منطق الرواية.
الغريب أني حين رجعت لنصي بعد مدة، كدت لا أصدق أني كتبته، وشعرت أنه أذكي مني، وارتحتُ لأنه أذكى مني، فلا ينبغي أن يكون الروائي أكثر ذكاء من أعماله، حسبما يزعم ميلان كونديرا.
> هل كانت الرواية تشير إلى أن القمع الذي واجهته الجماعة الزرادشتية، كان مجرد مثال لصورة القمع السائد في المجتمعات الشرقية تجاه المختلف. يقول «دارا» حينما وصل إلى شيراز بعد خروجه من يزد وخراسان: «عشت بينهم غريباً، أخفي ديانتي كما لو كانت وباء، أسير في السوق حذراً مثل قط، وسرعان ما أفر إلى غرفة صغيرة استأجرتها في مسافر خانه، أقفلها على أسراري، في الداخل تغيب شيراز، وتشرق أريانا».
- تشير الرواية إلى القمع الديني الذي واجهته جماعات عديدة، لكني لست أكتب بصفتي مدافعاً عن جماعة بعينها، فمعظم الجماعات اضطهدوا الآخرين في عهودهم الذهبية، وأولهم الزرادشتيون. ولست أكتب لأقارن بين الأديان، فأنا لست باحثاً، بل أكتب بصفتي روائي - روائي يبحث فيما يمكن أن يؤول إليه الزرادشتي، فيما هو قادر على التفكير فيه، لهذا كان منطق الرواية هو منطق دارا، والذي يسميه ميلان كونديرا حكمة الرواية، فكان دارا موبذاً في صميم أعماقه، حتى آخر يوم في حياته.
> ألا تجد تبايناً في المعنى، فالنص واضح في التحريض على نقد الثقافة السائدة أسوة بما فعله الفلاسفة والشعراء والعلماء والمثقفون. لكنه يشير في موقع آخر للمصير المأساوي للفلاسفة التنويريين فالحلاج قتلته بغداد، والشيخ السهروردي قتلته حلب، وطردت شيراز الشيخ البلخي.
- الرواية تقدم حقيقة مختلفة عما هو متفق عليه في الثقافة السائدة، ولا شأن لها بالتحريض ضد أحد ولا بالانتصار لأحد، كما قلت سابقاً. ولكن هذا لا يعني أني أملك أن أمنع القراء عن تأويلاتهم الخاصة. وليس فقط الحلاج والسهروردي اللذان قتلتهما الدول الرسمية، رشيد الدين الهمذاني كذلك قتلته السلطنة الإيلخانية، بسبب أصوله اليهودية، وقتلت «دارا» بسبب سابقته في الزرادشتية.
> كيف تناولت الرواية من خلال رحلة «دارا» حياة المهمشين والصراع الأزلي للإنسان نحو العدالة والكرامة؟
- لم يكن مقدراً لبطلي دارا أن يعيش مهمشاً، كان موبذاً، وتأهل ليكون رئيس أو دستور الجماعة الزرادشتية، لكن طلاب الحقيقة مثل دارا لا يختارون إلا حياة المهمشين، فكانت حياته سيرة طويلة من الغربة والخوف والجوع. في يزد، وتناولتها بالألقاب، لدي اهتمام خاص بالألقاب، حمل دارا كثير منها: أوشتادارا، العتال، الغندورا، الدرويش المجذوب، المريد، العطار، السائس، الجاسوس، الأسير. كان العذاب ينتظره في كل مدينة، ولكنه لا يبالي، يلاحق النور والأولياء مستصغراً المخاطر.