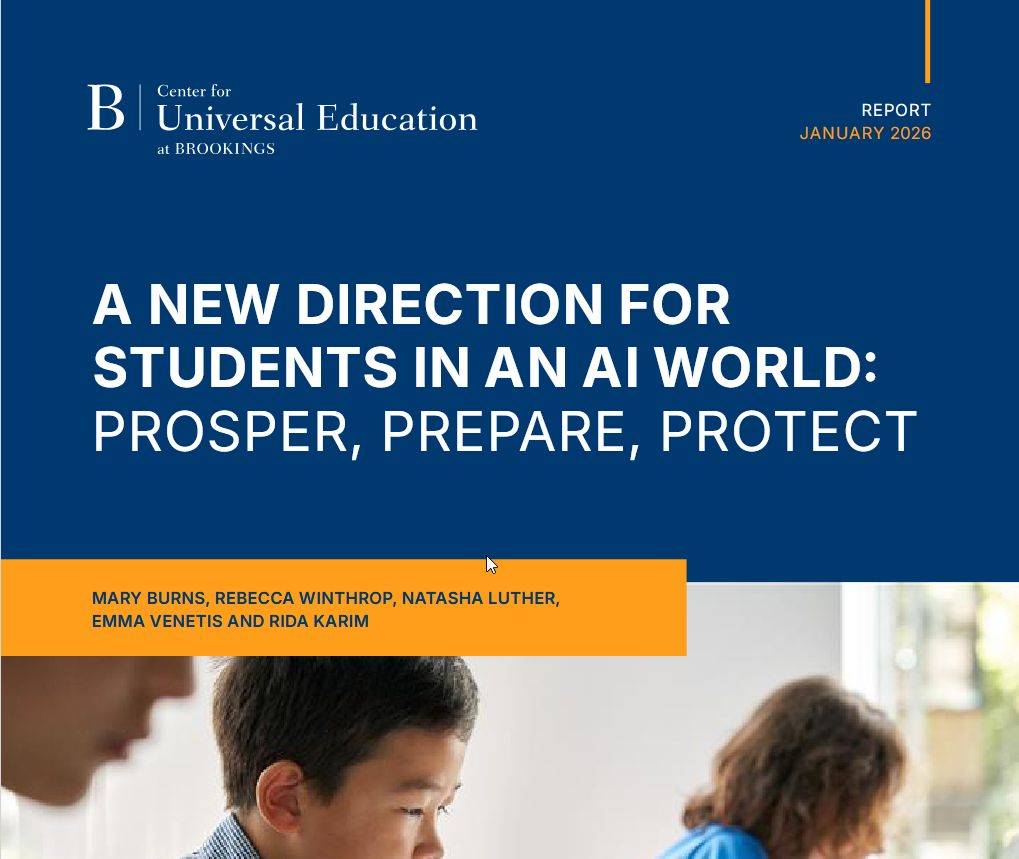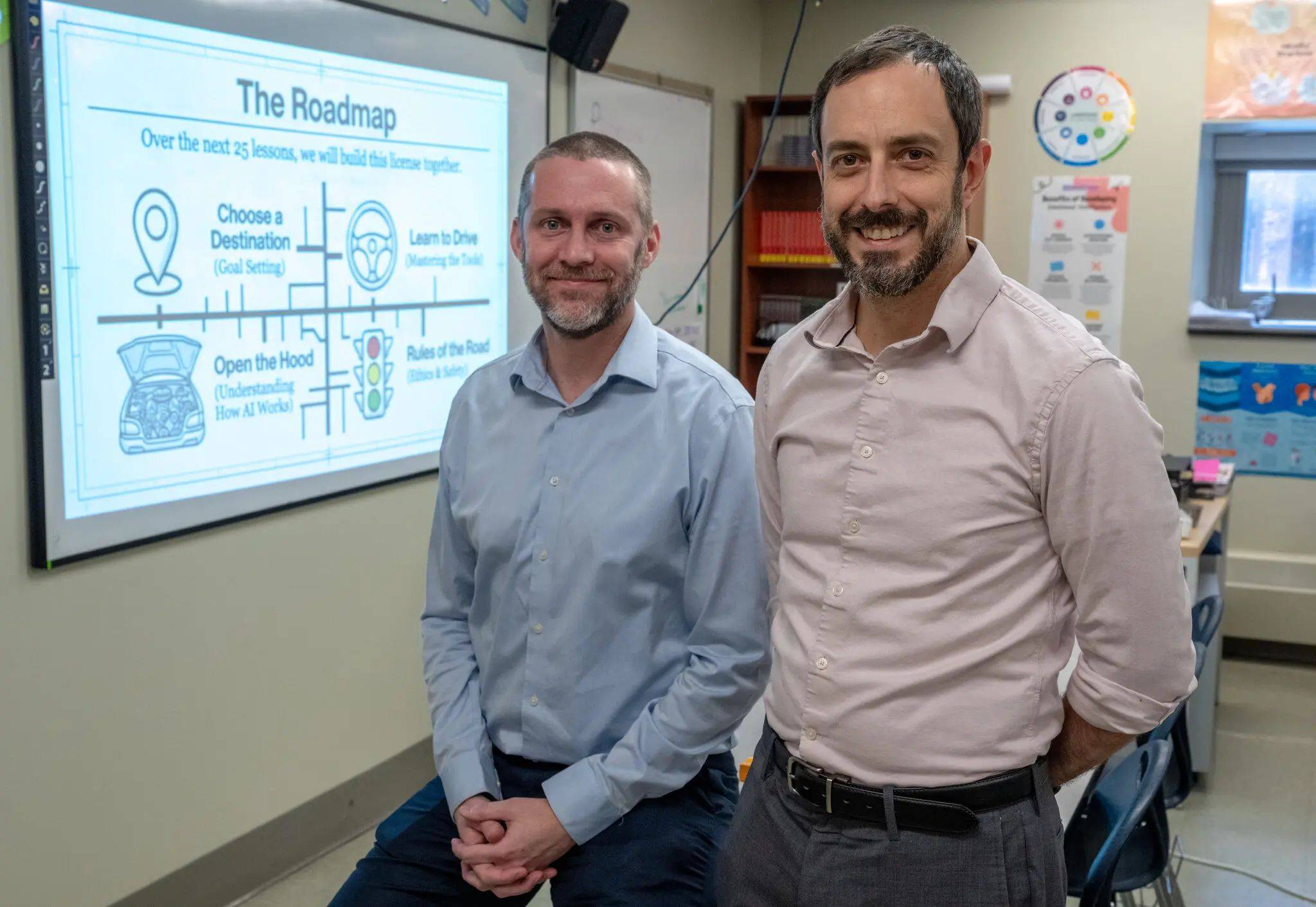عندما استنسخت النعجة دوللي من خلية ثديية لنعجة من فصيلة دورست الفنلندية عام 1996، سيطرت على أذهان الرأي العام صور استنساخ نسخ طبق الأصل من جميع أنواع الحيوانات. وقد أغرتنا هذه العملية، التي حملت اسم «الاستنساخ الجسدي»، بالتفكير في أنه إذا نجحنا في الحصول على نواة واحدة فقط عاملة من أية خلية، سيصبح بإمكاننا إعادة إنتاج حيوان بأكمله.
وسرعان ما قفزت أذهان العلماء باتجاه حيوانات الماموث ذات الجلد الصوفي، التي انقرضت منذ قرابة 4 آلاف عام. وتظهر من حين لآخر جثث متجمدة للماموث من طبقات متجمدة تحت أرض قطبية بدأت في الذوبان، توجد فيها مجموعة من الأنسجة اللينة والشعر المحفوظة بصورة جيدة. من جانب آخر، حققت جامعة بنسلفانيا تقدما كبيرا على صعيد إعادة تركيب جينوم الماموث، فيما أعلنت مجموعتان من العلماء عن خطط لاستنساخ الماموث. وتسعى المجموعتان لتحقيق الاستنساخ بهدف توسيع نطاق التفهم العلمي للحيوانات، على أمل إعادة الماموث إلى قيد الحياة ووضعه في بيئات قطبية شمالية بعينها بحيث يتمكن من خلالها في مساعدة تلك الأنظمة البيئية على العمل بصورة أفضل بعد فترة غياب الحيوان القصيرة نسبيًا.
* «إحياء» الماموث
وعلى ما يبدو، يوفر الماموث المجمد جميع المواد الخام اللازمة لإعادة بناء حيوان حي. في بعض الحالات، إذ توجد أعضاء كاملة سليمة. كما تم العثور على دماء وأعين وأجزاء خاصة بالجهاز الهضمي. بيد أن كل ذلك لا يكافئ العثور على أنسجة محفوظة بصورة جيدة على مستوى الخلايا والجزيئات.
وتأمل بعض مجموعات العلماء، منها مجموعة بقيادة أكيرا إريتاني من جامعة كيوتو وأخرى تنتمي لمركز سوام البحثي بمجال التقنيات الحيوية في كوريا الجنوبية (بالتعاون مع الجامعة الفيدرالية الشمالية الشرقية في روسيا)، في استخراج خلايا عاملة من ماموث متجمد واستخدام المواد الجينية الموجودة بهذه الخلايا في بدء عملية الاستنساخ.
يذكر أنه من دون احتواء الكائن الحي على نمط ما من مضادات التجمد، فإن عملية التجميد تسفر عن تدمير الخلايا. وقد تبدو قطعة من اللحم داخل جهاز التبريد ممتازة بالنسبة لك من حيث العضلات والدهون، لكن إذا أمعنت النظر إليها تحت ميكروسكوب، ستلاحظ أنه مع تجمد الماء داخل الأنسجة، يحدث مدد وتمزق لجدران الخلايا والهياكل الدقيقة الأخرى. وعليه، أخفقت محاولات الاستنساخ الجسدي للخلايا الثديية المجمدة منذ سنوات، مع استثناء واحد ممكن. إذ أعلن باحثون بمركز ريكين لعلم الأحياء الإنمائي في اليابان، عام 2008، عن أنهم استنسخوا فأرًا من خلايا مخ حيوانات مجمدة منذ 16 عامًا. إلا أن تيروهيكو واكاياما، الذي اضطلع بغالبية العمل، أشار إلى أنه لم يتوصل أي مختبر علمي آخر لنتائج مشابهة. يذكر أنه عندما يتعذر تكرار الوصول لادعاء علمي استثنائي، فإن هذا قد يكون مؤشر تنبيه إلى أن البحث قد يكون معيبا.
إلا أن هناك فارقا كبيرا بين 16 عاما وعصر البليستوسين، فالمعروف أن تجميد الجسد لا يوقف عملية التغيير أو التداعي التي تصيبه. يذكر أنه عادة ما تبدأ الإنزيمات الموجودة داخل أجسام الحيوانات في تكسير الخلايا في أعقاب الهلاك بفترة قصيرة. ولا يترك هذا النشاط من قبل الإنزيمات تأثيرا رقيقا على هياكل الخلايا، لكنها ما تجعل اللحم البقري المتقدم في السن أكثر ليونة.
* جدل علمي
أما عملية التجميد فتؤدي لتباطؤ عمل هذه الإنزيمات بصورة كبيرة، لكنها لا توقفها تماما. وربما قد لا تنتبه لاكتساب قطعة من اللحم لقوام أكثر ليونة بعد عام داخل جهاز التبريد. إلا أنه إذا تركتها بضعة آلاف من السنوات، فإن قوامها قد يتحسن. كما أن التأثير المتراكم للإشعاع الطبيعي يدمر تدريجيا الحمض النووي داخل الأنسجة المجمدة.
من جهته، لا يصدق جورج تشرتش أنه يمكن العثور على الخلايا أو النواة السليمة التي يسعى خلفها فريقا البحث الياباني وكوري الجنوبي يمكن العثور عليها داخل أي ماموث مجمد. ويعتقد تشرتش، بروفسور علم الوراثة في مدرسة هارفارد للطب وأحد مناصري إعادة الحيوانات المنقرضة إلى الحياة، أن الطريق لإعادة الماموث ينبغي العمل على إيجاده بمكان آخر.
وعلق على الأمر بقوله: «عشرات آلاف الأعوام من الإشعاع. داخل كائن من دون عملية أيض (تمثيل غذائي) سارية، فإنه يتراكم ويحطم. مثل هذا الحمض النووي لن يعمل ثانية قط. وبينما هدفهم هو إيجاد ماموث، فإن هدفنا هو اختبار الجينات».
وقد تقوم الشكوك حيال مشروعات الاستنساخ على أسس منطقية. وعلى سبيل المثال، يتولى فريق البحث داخل مركز سوام البحثي بمجال التقنيات الحيوية، هوانغ وسوك، وهو عالم حظي بادئ الأمر بالإشادة لإنجازاته بمجال الاستنساخ الجسدي، بما في ذلك أول كلب مستنسخ بالعالم - وهي خدمة يروج لها المركز عبر موقعه الإلكتروني. بيد أنه عام 2009، أدين بالاحتيال لتزويره بحثا حول استنساخ خلايا جذعية بشرية. كما تورط يوشيكي ساساي، نائب مدير مركز ريكين، في قضية احتيال مشابهة، بجانب إدانته بالفشل في مراقبة باحثين بالمركز زيفوا أبحاثا تتعلق بالخلايا الجذعية. وقد انتحر في أغسطس (آب) الماضي.
* أبحاث جينية
في المقابل، تبدو جهود تشرتش في هارفارد أكثر تواضعا عن المشروعين الكوري الجنوبي والياباني. ويأمل تشرتش في العثور على جينات ماموث ذات قدرة على التكيف مع الطقس البارد ودمجها داخل نواة خلايا فيل. في الواقع، يؤكد تشرتش أن هذا الأمر تم بالفعل.
وأوضح خلال رسالة عبر البريد الإلكتروني أنه: «لدينا خلايا فيل عاملة، داخلها حمض نووي لماموث في الوقت الراهن. لم تحدث أي إخفاقات حتى الآن حسب علمي.. نطبق حاليا أسلوب التعامل مع الجينات المعروف اختصارا باسم «سي آر آي إس بي آر» على خلايا فيل، وحققنا 14 تغييرا في الجينوم بسهولة نسبية حتى الآن. ونركز في البداية على الأجزاء المقاومة للبرد (مثل الدم والشعر الصوفي ودهون تحت الجلد)».
ومع ذلك، لم ينشر تشرتش أبحاثه في دورية علمية. ومن غير المعتاد أن يطلق عالم مثل هذا الادعاء الفريد من نوعه من دون تقديم دليل يمكن تقييم مدى دقته من قبل أقرانه.
الملاحظ أن آخرين اتبعوا سبيلا مختلفا. عبر إعادة بناء جينوم الماموث من خلال مجموعة متنوعة من العينات، قد يتمكن العلماء من هندسة نواة خلية، ثم استخدام أسلوب الاستنساخ الجسدي الذي أثمر النعجة دوللي.
يذكر أن ما تمكن العلماء من الخروج به من الماموث المتجمد، حمض نووي جزئي. ولم تنجح خلية واحدة من تقديم جينوم كامل بنفسها، لكن عبر تحليل عينات مختلفة من حيوانات ماموث متنوعة، يبدو أن العلماء المعنيين بمشروع جينوم الماموث بجامعة ولاية بنسلفانيا اقتربوا من نشر جينوم كامل لماموث صوفي الجلد. وفي جهد منفصل، استخدم كيفين كامبل، من جامعة مانيتوبا شظية من الحامض النووي لتقديم نسخة من هيموغلوبين حاملة للأوكسجين الذي اعتادت حيوانات الماموث إنتاجه.
أما المصدر الأمثل للحامض النووي الماموث فلم يكن بقايا الأنسجة اللينة، وإنما الشعر، حيث تحتوي كل خلية شعر على جينوم كامل كامن داخل غلاف لحمايته.
ومثل البشر، كان الماموث مليئا بالبكتريا والفيروسات. وتعج البقايا المرتبطة بالجهاز الهضمي للماموث التي تم اكتشافها بمواد جينية تتعلق بالنباتات التي كان يأكلها. وقد تكون حبوب لقاح معاصرة وحديثة قد اختلطت بالنبات. والواضح أن الماموث المتجمد يحوي الكثير من أنواع الحمض النووي بخلاف الحمض النووي الخاص به.
ومن بين التحديات التي انطوى عليها إعادة تركيب جينوم الماموث التخلص من هذا التلوث. يذكر أن العلماء بمقدورهم غسل وتنظيف شعر الماموث، وتعد مسألة التخلص من الحمض النووي المسبب للتلوث من الشعر أسهل نسبيا مقارنة بأنماط الخلايا الأخرى.
المؤكد أن دمج جينوم مركب بطريقة صناعية في نواة حيوان ماموث وجعلها تعمل من جديد أمر لم يحدث قط، وحال تحققه فإنه سيكون فتحا علميا جديرا بجائزة نوبل. وحال توافر وقت ومال كافيين، فإنه قد يصبح من الممكن استغلال تفاعل البوليميراز المتسلسل (أسلوب في نسخ أجزاء صغيرة من الحامض النووي) لإنتاج ملايين النسخ من الجينوم المتوافر لدى جامعة بنسلفانيا ووضعها داخل خلية حية من فيل حديث. بعد ذلك، بمقدور العلماء تحفيز عملية انقسام الخلية والبدء في إنتاج خط من خلال الماموث. وإذا نجح العلماء في الوصول لهذه النقطة، فإنه من غير المستبعد أن يتمكنوا من دمج نواة من هذه الخلايا داخل بويضات فيل وتحفيزها عبر تيار كهربي كي تشرع في إنتاج كيسة أريمية (وهي أجنة في مرحلة مبكرة للغاية)، على نحو شديد الشبه بما حدث مع النعجة دوللي وكثير من الثدييات المستنسخة الأخرى.
ومع ذلك، دعونا لا نبالغ في الشعور بالإثارة حيال هذا الأمر، لأنه بدءا من هذه النقطة لن يقتصر تعاملنا على المختبرات وخطوط الخلايا، وإنما سيتعين إشراك أفيال حية في الأمر.
* الماموث والفيل
يذكر أن الأفيال الآسيوية والأفريقية لديها 56 كرومسزوم مقارنة بـ58 لدى الماموث. إلا أن ما يفوق 98 في المائة من الحامض النووي الخاص بهما متطابق. ومن المعتقد أن حجم ووزن الماموث لدى ولادته يبلغ نفس حجم ووزن الفيل الآسيوي تقريبا، ما يعادل قرابة 200 رطل. ويعد الفيل الآسيوي أكثر قربا من الماموث عن الفيل الأفريقي، ومن المعتقد نظريا أن بإمكانه توفير أم بديلة مناسبة لصغير ماموث مستنسخ.
إلا أن «مناسب» لا تعني أنه «فاعل طيلة الوقت»، وهنا تحديدا تكمن العقبة الكبرى أمام استنساخ ماموث حديث. وقد يحتاج العلماء لكثير من الأفيال للحصول على فيل قادر على حمل صغير ماموث.
من ناحية أخرى، فإن العمل مع الأفيال يختلف عن العمل مع فئران المختبرات، حيث بإمكان الباحثين الحصول على الملايين من بويضات الفئران من دون صعوبة. كما أن باستطاعتهم محاولة تلقيح مئات الفئران وتقبل فشل معظم المحاولات. إلا أن هذا الوضع لا ينبئ بالنجاح بالنسبة للأفيال.
من جهته، كان جون إنغلهاردت، رئيس قسم التشريح وأحياء الخلايا بكارفر كوليدج للطب بجامعة أيوا، واحدا ممن شاركوا في وضع دراسة عام 2007 تتناول بالتفصيل النجاح الذي حققه فريقه في إنتاج أول حيوان ابن مقرض عبر الاستنساخ الجسدي. نشرت الدراسة في دورية «ديفلبمنتال بيولوجي»، وتصف نقل الأجنة إلى 30 حيوانا ابن مقرض بديل. وجاءت هذه التجربة بناء على محاولة سابقة تضمنت 19 حيوانا بديلا، مما يعني أن الأمر تطلب 49 بديلا لتخليق أول زوج من ابن مقرض المستنسخ.
وتبعا لدينيس شميت، بروفسور العلوم البيطرية بجامعة جنوب غرب ولاية ميزوري والمتخصص في الصحة الإنجابية للأفيال، فإنه ربما لا تتوافر أعداد كافية أسيرة من الأفيال الآسيوية تنتمي لسن التكاثر لتوفير أعداد مناسبة من الأمهات البدائل. وبافتراض استغلال 20 فيلا فقط في برنامج لاستنساخ الماموث، فإن هذا سيقوض جهود الحفاظ على الأفيال الآسيوية.
يذكر أن نتائج جهود توليد الأفيال قيد الأسر جاءت مخيبة للآمال، حيث اتسم الكثير منها بدورات غير منتظمة أو لا تدخل للدورة النزوية إطلاقا، إضافة لأن التلقيح الصناعي عادة ما يفشل. من بين 27 حالة نجح فيها هذا الأسلوب في تحقيق حمل داخل حدائق الحيوان الأميركية، انتهت 8 حالات بالإجهاض أو ولادة أجنة ميتة. وتوفي 6 صغار آخرون بعد الولادة بفترة قصيرة. عالميا، ولد 45 فيلا آسيويا فقط في الأسر عام 2013 عبر طرق طبيعية أو صناعية. والواضح أن العلماء لا يدركون بصورة كاملة بعد الدورات الإنجابية للفيل بقدر ما يفهمون الدورات الإنجابية للقوارض أو الماشية. ومع ذلك، فإن إجراء أبحاث حول الاستنساخ الجسدي للماموث بأعداد صغيرة من الأفيال الآسيوية قد يعزز جهود الحفاظ على الأفيال.
وعن ذلك، قال شميت: «من الخطأ القول بأن الاستنساخ الجسدي لن يقوم بأي دور، فهناك سبل يمكننا من خلالها مراقبة وتوليد الأفيال لظروف معينة، لكننا لا ندري تحديدا حجم التكاثر بين الأفيال الآسيوية التي تعيش بالبراري، فهذا الأمر لم يخضع لدراسة دقيقة. وقد يكتسب الاستنساخ الجسدي المرتبط بالحمض النووي أهمية في المستقبل».
كما أشار إنغلهاردت لعائق آخر أمام استنساخ الماموث، إن حقل البيولوجيا التركيبية لم يتمكن بعد من بناء كائن حي قادر على إعادة تقديم نسخة من ذاته أكثر تعقيدا عن الخلية الواحدة.
ومع توافر عدد قليل من إناث الأفيال القادرة على الإنجاب، فإن برنامج استنساخ الماموث يحتاج أولا تحقيق إنجاز ملموس في أعداد وتوليد الأفيال قيد الأسر.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}