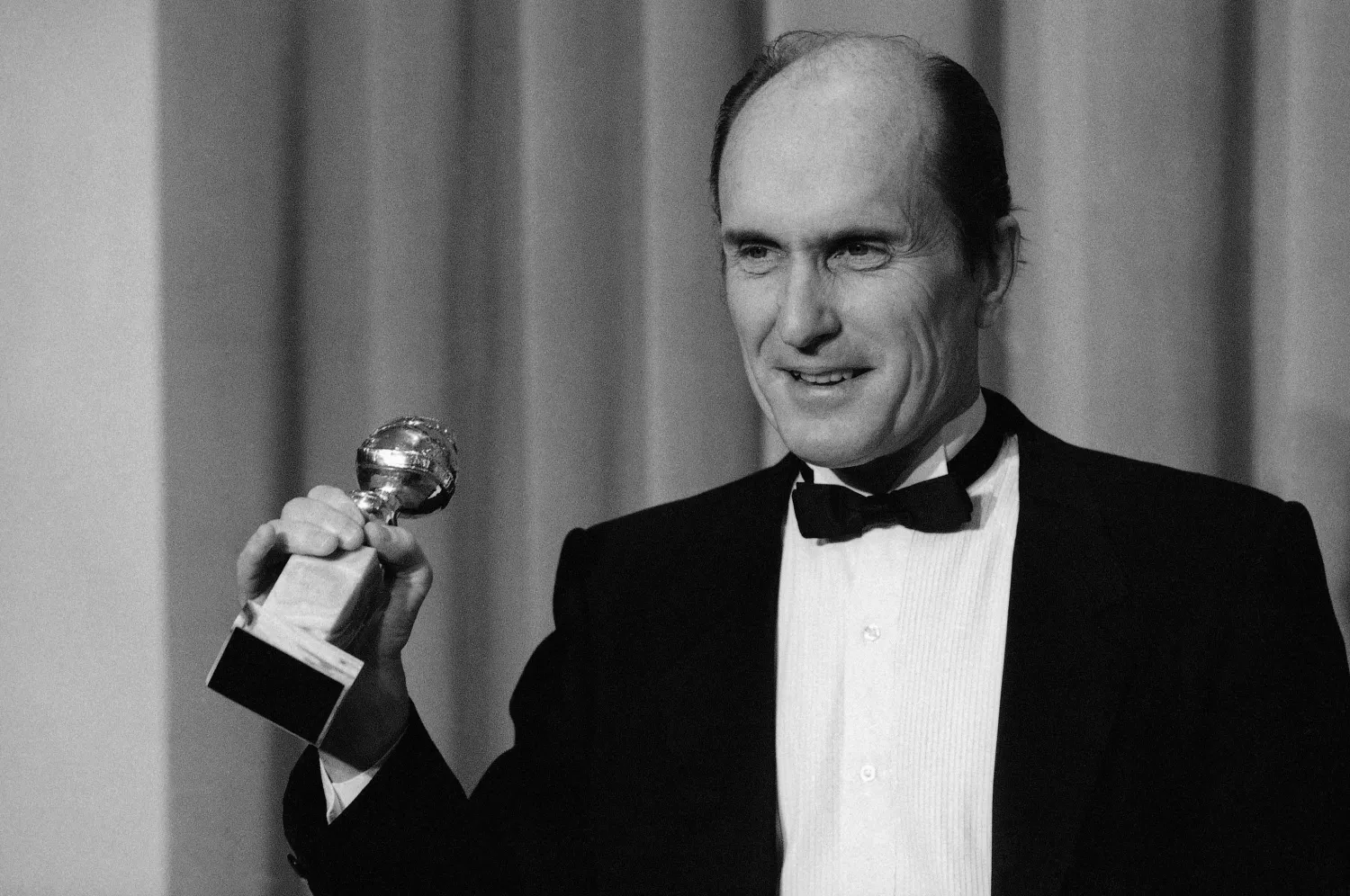أفضل ما في مهرجانات السينما عموماً ربما حقيقة أن المعروض على شاشاتها (إلا إذا كان المهرجان متخصصاً في نوع محدد) يبحر في الزمن كما يُريد. من أفلام تقع في أي فترة من رحاب التاريخ، إلى أخرى تعكس حاضرنا اليوم وثالثة تتحدّث عن مستقبل آتٍ تقوم بزيارته.
لا يختلف هذا الوضع في عروض مهرجان برلين هذه السنة التي تستمر لخمسة أيام فقط بسبب وباء كورونا. لكنها خمسة أفلام حاشدة تستطيع أن تشاهد فيها الأفلام لأربع وعشرين ساعة والكثير من الشاي والقهوة.
أحد الأفلام التي تدق على باب المستقبل هو الفيلم الألماني «أنا رجلك» (I Am Your Man) لماريا شرادر الذي عُرض داخل المسابقة كواحد من حفنة من الأفلام الألمانية المشتركة فيها. هو، حتى كتابة هذه الكلمات، أفضلها لكن جودته محط تساؤل حين مقارنتها ببعض الأفلام الأخرى التي شاهدنا أو سنشاهدها من خارج الطاقم الألماني.
يلتقي الفيلم الذي تقع بطولته على كاهل مارن إيغرت ودان ستيفنز، مع القصّة القصيرة التي كتبها البريطاني الراحل برايان ألديس في 1969 تحت عنوان «سوبر تويز تدوم طوال الصيف» (Super Toys Last All Summer Long) الذي رغب ستانلي كوبريك في تحويلها إلى فيلم بتوقيعه لكنه تخلّى عن المشروع وحوّله إلى عناية ستيفن سبيلبرغ الذي صنع من الرواية فيلمه «ذكاء اصطناعي» سنة 2001. تلتقي من حيث إن الصبي في قصّة ألديس مصنوع كروبوت مبرمج على الحياة مع الآدميين كما لو كان منهم. هذا ما يقع هنا بالنسبة للروبوت بفارق أنه ليس ولداً صغيراً، بل شاب مكتمل الرجولة.
هنا، تعيش ألما وحيدة. بلغت الأربعين ولا تكترث للزواج. تشرف على مشروع كبير في مؤسسة أبحاث تريد من خلاله تحديد النصوص الشعرية التاريخية البعيدة. تحت المجهر هنا نصٌ اعتبرته الأقدم في التاريخ. ولدعمه بالتمويل اللازم لاستكماله توافق على قيام مؤسسة علمية بإعارتها رجل - لعبة (روبوت) اسمه توم يتمتع بكل مواصفات الرجولة وبالمعرفة غير المحدودة. بطل «أنا رجلك» متقدّم بمداركه عن البشر وبعض هذه المدارك تكشف لألما بأنها على الطريق الخطأ بالنسبة لذلك النص القديم، إذ هو، حسب حسابات الروبوت السريعة، لا يعود إلى 4 آلاف سنة، وبالتالي ليس بالقيمة التاريخية التي تصوّرته.
هذا الاكتشاف يطيح بدراستها جميعاً ويتيح لبطلي الفيلم، ألما وتوم، استكمال علاقة مضطربة بدأت عندما رضيت باستضافته لثلاثة أسابيع لأجل مساعدتها في ذلك المشروع. هذه العلاقة العقلانية تتحوّل إلى عاطفية وجنسية في الوقت الذي تتحاشى فيه المخرجة نقد طرفيها. ما تعمل عليه ماريا شرادر هو طرح السؤال حول ما إذا كان بالإمكان التعايش بين امرأة من لحم ودم وروبوت وتستخدم في ذلك مقاييس بارعة في طرح السؤال وما يتفرّع عنه قبل أن تضطر، في نصف الساعة الأخيرة، لاستكمال الحكاية صوب الخاتمة المنشودة وبأقل عتاد فكري ممكن.
في النهاية، وبعد خلاف حول مستقبل ألما وتوم، يلتقيان مجدداً وينتهي الفيلم بهما طارحاً احتمال أن يبقيا معاً كثنائي أو ربما ينتهيان كزوجين.
- حكاية مدرّسة ووطن
بعض المطروح في «أنا رجلك» هو وضع الإنسان في المستقبل القريب إذا ما تم صنع مثيل له. لكن «حظ سيء في الحب» للمخرج الروماني رادو يود يتحلّق حول الحاضر ويمضي منه صوب التاريخ من قبل عودته إلى الحاضر في ثلاث قصص.
يختار المخرج البدء بمشهد إباحي واضح. كثير من الأفلام الغربية بدأت هكذا في السابق لكن المعروض هنا يحاكي فيديو «بورنو». لعل إحداث الصدمة هو إحدى غايتين هنا. الثانية هي اكتشاف الممثلة التي كانت تمارس الحب مع زوجها أمام كاميرا منزلية أن الفيلم انتهى إلى الإنترنت وشاع بين المشاهدين بوفرة. كونها مدرّسة تاريخ لتلاميذ صغار سيجعلها هدفاً لجمهور من الآباء والمدرّسين في محاكمة تقع في الفصل الثالث من الفيلم.
قبل ذلك وطوال الفصل الأول، تمضي المدرّسة (كاتيا بشاريو)، الوقت وهي تسير في شوارع بوخارست. تدخل وتخرج من بعض المحلات لكنها تسير طويلاً وتدخّن كثيراً. يتابعها المخرج وكاميرته وهي تجتاز الشوارع ويتركها تمضي أحياناً ليلتقط مشاهد لآخرين لا علم لهم بوجود الكاميرا وهم يمشون في الشوارع المكتظة والتي تصطف على جوانبها مبانٍ قديمة. تقوم الكاميرا (تصوير ماريوش باندورو) أكثر من مرّة بحركة أفقية لليمين (عادة) ترتفع عند نقطة معيّنة لتصوير أعلى المباني (بعضها من الأثريات).
المستوحى في كل ذلك بشاعة المدينة ووحدة بطلته التي تجهّز نفسها للعواقب. الفصل الثاني تاريخي الصفة. يتابع المخرج هنا كل ما يمكن له عرضه من تاريخ البلاد فإذا بذلك التاريخ لا يقل بشاعة عن تلك الشوارع والمباني إن لم يكن يتجاوزها. يمر على مراحل متعددة من التاريخ: الشيوعية والفاشية والعنصرية والهولوكوست والتحالفات مع وضد النازية وكل ما يمكن مروره في خانة سوء المعاملة حيال المرأة والطفل والمجتمع عموماً.
في الفصل الثالث يعود إلى حكاية إلما فإذا بها تجلس في محاكمة تقع ليلاً في حديقة. إلما تجلس وراء طاولة وجمهور من المعلّمين والمعنيين بما حدث يجلس على كراسي موزّعة في تلك الحديقة. تدافع إلما عن نفسها وترش مبيدات كتبها لها المخرج ضد فساد المنتقدين لها. هنا يستخدم المخرج بعض التوازن: هي على حق في انتقادها لممارسات مزدوجة تشي بفساد الآخرين لكنه يمنح بعضهم زاداً في انتقاده. امرأة تنتقد دروس إلما حول تاريخ الهولوكوست وتتساءل «ماذا عن الهولوكوست الممارس ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة». رجل بزي عسكري يقف ويقول: «لو تحدثت عن الهولوكوست لتم تغريمي، لكن لا أحد يسأل عمن وراء انتشار الوباء».
الوباء موجود في فصلي الفيلم الأول والثالث. حين بدأ التصوير قبيل منتصف العام الماضي قرر المخرج تصوير الناس بكمّاماتها ما يمنح الفيلم حضوراً في الحاضر رغم أن سهامه النقدية وطريقة عمله لا تصيبان الهدف المرجو دائماً.
- صدف قاتلة
فيلم آخر مؤلّف من فصول هو «عجلة الحظ والفانتازيا» للمخرج الياباني رايوسوك هاماغوشي لكن كل قصّة هنا لا ترتبط، درامياً، بالأخرى. الأولى (بعنوان «سحر لشيء أقل تأكيداً») عن صديقتين تحبّان شاباً واحداً. الثانية («الباب مفتوح كلياً») عن امرأة تتسبب في طرد أستاذ جامعي من منصبه بالتواطؤ مع طالب يريد الانتقام منه. الثالثة («مرّة أخرى») عن امرأتين تتعرّفان على بعضهما البعض كل منهما تعتقد أن الأخرى هي امرأة أخرى.
الفيلم نوع من تلك الأفلام التي تُكتب كأفكار وحوارات أكثر منها كأحداث ويتم لاحقاً إلباسها أماكن تصوير وعناصر عمل أخرى. خلال فعل الكتابة يشيّد السيناريست (المخرج ذاته هنا) عالماً من السجال الحواري الواقع في أماكن محدودة: داخل سيارة تاكسي، داخل منزل، داخل مكتب... إلخ) ومن دون الرغبة في تقديم أحداث تقع خارج الأماكن الداخلية إلا في القليل من المناسبات. بذلك تتكوّن أمام المُشاهد نتيجة مسرحية ولولا حسن دراية المخرج بتفاصيل أسلوبه وبحسن إدارته للممثلين لما تجاوز الفيلم مبدأ الحوار كفعل ثرثري مصوّر بالكاميرا.
في هذه الحكايات الثلاث ثلاث صدف اثنان منها قاتلان: مرور الشاب المتنازع عليه، في القصّة الأولى، بالصدفة أمام المقهى الذي تجلس فيه الفتاتان تتحدثان عنه، ولقاء المرأة بصديقها القديم بعد خمس سنوات صدفة في الحافلة ذاتها في القصة الثانية، ثم هو لقاء صدفة بين المرأتين في القصّة الثالثة). هنا فقط يمكن قبول الصدفة لأن اللقاء يقع في مطلع القصّة. عدا ما سبق، هناك أحكام لأسلوب تشكيل الصورة المؤسسة كلاسيكياً (تصوير جيد من يوكيكو ليوكو). أما الحوار ذاته فيتراجع في النهاية لدوره التقليدي في سبر غور الذوات الشخصية بدلاً من تفعيل الصمت والسلوكيات لهذه الغاية.