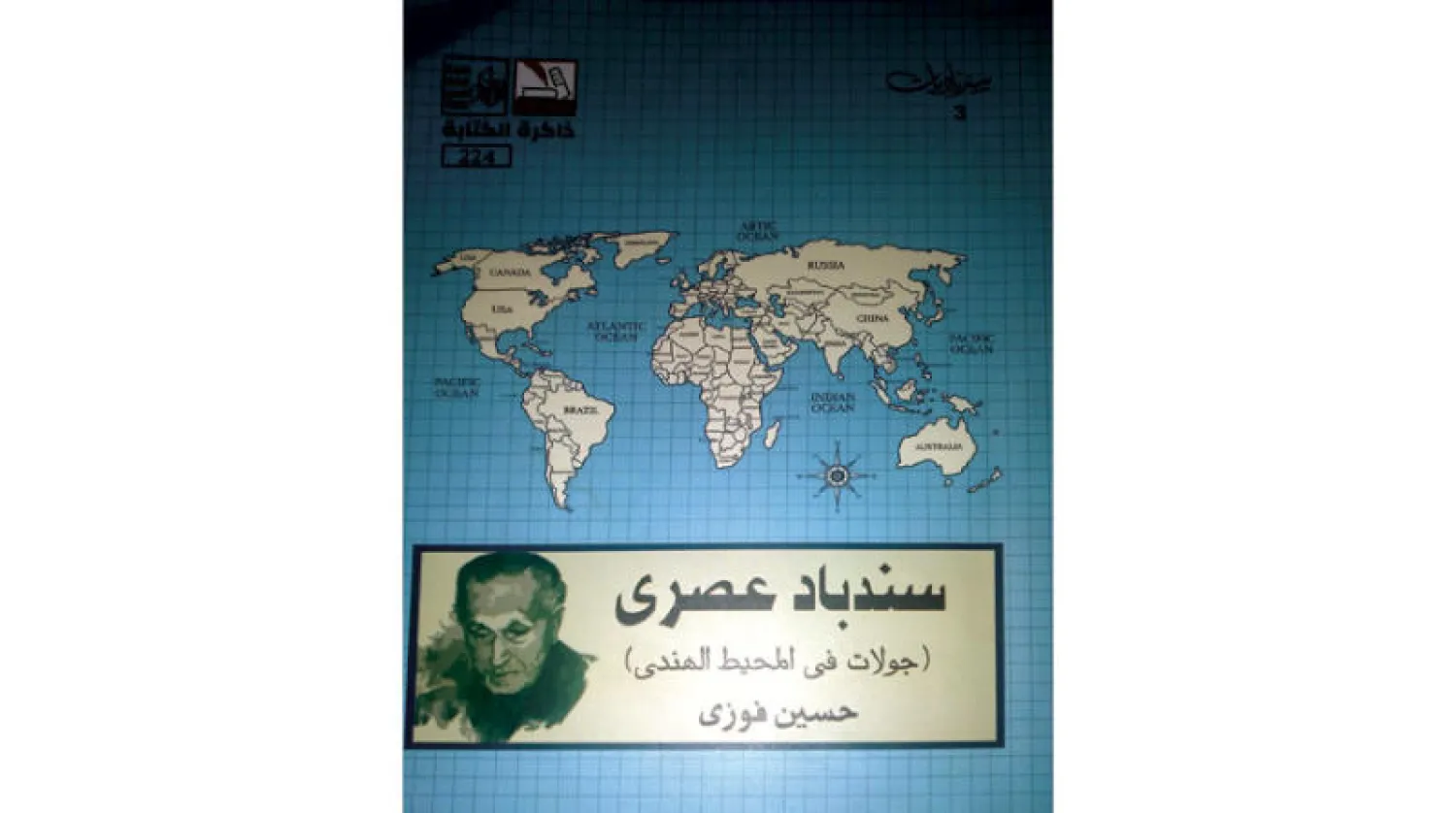لم تقتصر إسهامات الدكتور حسين فوزي (1900 – 1988) على بحوثه ودراساته الرائدة في علوم البيولوجي والبحار والطب، فضلاً عن الموسيقى والتاريخ، إنما امتدت كذلك إلى أدب الرحلات عبر كتابه الأشهر «سندباد عصري» الذي صدرت طبعته الأولى عام 1938 ليضع النواة الأولى لهذا الأدب في السردية العربية الحديثة، ويستحق عن جدارة لقبه الأثير «سندباد العلوم والفنون».
الكتاب صدرت منه أخيراً طبعة جديدة في القاهرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن سلسلة «ذاكرة الكتابة»، ويضم مغامراته كأديب وطبيب شاب في المحيط الهندي، عبر رحلة بحثية على سفينة صغيرة مع مجموعة من الشباب أعضاء بعثات أجنبية استعاروا سفينة مصرية بضباطها وبحارتها واشتركوا مع بعض الاختصاصيين المصريين في دراسة مستفيضة لمياه البحر الأحمر والمحيط الهندي، وما تكنه من أسرار حية وجامدة. وكان من نصيب الدكتور حسين أن يركب هذه السفينة طوال رحلتها الهندية، وأن يشترك في بحوثها العلمية ويشرف على صحة ركابها. وهو يصف كتابه بأنه مستوحى من تلك الرحلة دون أن يكون له علاقة بالقصة الرسمية، وإنما هو صفحات ضمنها صوراً وخواطر أوحت بها جولاته في أنحاء المحيط الهندي، وحياته على ظهر السفينة «دون ادعاء أو حذلقة فنية».
كما يصف العمل بأنه بسيط العبارة يسرد الأحداث، ويصف الوقائع ليس تبعاً لقيمتها، بل تبعاً لما أثارته في نفسه من إحساس وفي ذهنه من تفكير.
مع التماسيح
من الوقائع والمشاهدات العجيبة التي يوردها الكتاب، ما حدث على نحو عشرة كيلومترات من مدينة كراتشي بالهند، حيث «مقام» لرجل مبروك حوله ينابيع ماء بارد وساخن وبركة يعيش في مياهها أكثر من مائة تمساح، وقد أحيطت بسور يطل منه الزائر على تلك الزواحف المفزعة وهي ممددة على شاطئ البركة كأنها جذوع أشجار لا تتحرك إلا حين تلقى إليها النذور من الأغنام المذبوحة. ويؤكد الدكتور حسين، أن من حسن حظه أنه لم ير يوم زيارته نذراً ولا ناذراً. لكن ما هي حكاية هذا الرجل المبروك؟ يقال إن اسمه «مانجويير»، وكان فقيراً هندوسياً، ويقال إن أصل التماسيح عائلة رجل شرير استولى على أموال اليتامى والأيامى إلى آخر ما هنالك من ضروب الشرور التي يظهر أنها كانت تلقى في العصور الخالية عقوبات أشد صرامة مما نعرف في عصورنا المادية، وجاء الشيخ مانجويير فدعا على المعتدي وأسرته أن يتحولوا إلى تماسيح وقد كان له ما أراد!
جزيرة عجيبة
يبرز أسلوب حسين فوزي الذي يتسم بأناقة مخيلة ورشاقة أسلوبية وروح مرحة، فيروي أنه هبط إلى مجموعة من الجزر المهجورة على مقربة من شاطئ حضرموت، المسكون منها واحدة فقط تسمى جزيرة «الحلانية»، لافتاً إلى أن مجموع سكانها نساء ورجالاً لا يتعدى أبطال حكاية «علي بابا والأربعون حرامي»، ويعيشون في بضع عشرة كوخاً من حجارة رص بعضها فوق بعض بغير خرسانة، وغُطيت سطوحها بأعشاب البحر المجففة لا زرع فيها ولا ضرع، وثمة عين ماء آسن لا ثانية لها تروي ظمأ عرب الحلانية، وبضعة حجارة تحيط بمصلاهم وأخرى تدل على موتاهم. لا هم في طريق قوافل أو بواخر، ولا هم يستطيعون التجوال خارج الحدود المحمية، حيث يصيدون السمك بالحراب، بينهم وبين العمار سفر أيام وليال تقل وتكثر تبعاً للريح حين تملأ شراع المراكب. الغرباء يمرون بهؤلاء السكان فيقايضونهم على أسماكهم الجافة بخبز وأرز.
بحس فكاهي يحكي مغامرته في تلك الجزيرة قائلاً «دخلنا ذات عصر بين جزر خوريا موريا وألقينا مرسانا أمام الحلانية، وكنت أراقب الشاطئ بمنظاري فرأيت راية حمراء وقف بجوارها رجل، نزلنا بأرض الجزيرة ولم تكن الراية سوى شال عمامة شيخ الحلانية نشره فوق عكازه واجتمع حوله بضعة أفراد حفاة نصف عراة واسعي المحاجر هابطي الوجنات تبرق عيونهم جوعاً. كانوا رجال حكومة الحلانية، فهذا الكبير الرأس المقطوع الأذن هو وزير الحربية، ولا ريب فهو قلق يكشر عن أنيابه بلا سبب واضح، أما هذا الربعة الحديد يحمل حربة الصيد فلعله وزير الاقتصاد، ويظهر أن الشيخ يجمع إلى رئاسة الحكومة وزرات الأديان والصحة والمعارف والخارجية. وقد اجتمعت حكومة الحلانية في أصيل هذا اليوم على شاطئ ثغرها المنيف لمفاوضات مهمة مع قبطان سفينتنا موضوعها رغيف عيش نتعشى به، وقمت أنا بمهمة الترجمة بين شيخ العرب وبين القومندان الاسكتنلندي. ولعل الذكاء المصري كان عوني على أعمال الترجمة أكثر من لغتي العربية؛ فهذا الشيخ أو هذا الرئيس للحكومة يتكلم العربية بلغة قحطانية أو حميرية أو حضرمية ولما كنت ضعيفاً نوعاً في فهم اللهجات فقد اعتمدت على نظري أكثر من سمعي في فهم ما يقوله الشيخ، ويقيناً كان يطلب منا رغيف عيش يتعشى به. وقد فهمت أنه مضى على آخر سفينة وقفت بجزيرتهم خمسون يوماً، وقد فرغ خبزهم وأرزهم فهم لا يأكلون منذ أسبوعين سوى السمك المشوي ويخشون أن تنبض بئرهم الوحيدة فيموتون عطشاً.
ويقارن بين تلك الجزيرة وبين ما أحس به حين كان في زيارة لجزيرة «سان» أمام ساحل فرنسا الشمالي الغربي؛ فقد رأى هناك جزيرة منخفضة يعيش بضعة آلاف من أهلها تحت رحمة موجة عنيفة من أمواج المد تجرفهم وتترك جزيرتهم لا أثر فيها ولا حياة، مشيراً إلى أن ثمة إحساساً ضيقاً يعتريه أمام هذا الفزع الخيالي ناشئاً عن عدم توصله إلى فهم الدافع لهذه البشرية أن تصر على العيش تحت سيف الخطر على مقربة من فوهات براكين غادرة مثل «سترومبلي» و«كاراكاتوا» التي تصب حممها المدمرة بين الحين والآخر!
فتاة بومباي
حين يصف الدكتور حسين فوزي بعض المدن يكتب ما يعتقده بصراحة ودون تجميل أو دبلوماسية. يقول على سبيل المثال «بومباي حاضرة كبرى اجتمع لها من ضروب السوء المعماري مما يكفي أن يطمس على جمال فلورنسا وروما وباريس وفيينا، ولو أن طيراً أبابيل تكلفت بعملية توزيع بعض مباني بومباي فحملتها وألقتها على هذه المدن فإنه يمكنك أن تقول يا رحمن يا رحيم على فن العمارة في حواضر الجمال! والسبب في ذلك يعود برأيه إلى أن العهد الفيكتوري في عمارتها امتزج أقبح امتزاج بالفن الإسلامي الهندي فكانت النتيجة تلك القباب والأعمدة التي تقذي العين بصلفها وغطرستها ولا منطقيتها.
ويمتدح الذوق والرقي لدى المرأة الهندية، معلقاً على فتاة رآها في بهو الفندق تنتمي إلى طائفة خرجت من إيران بعد الفتح الإسلامي واستقرت في مدينة سكانها أهل جاهٍ وثراء، فهم يمتلكون المصانع والمصارف والمتاجر في بومباي، وتتكون منهم أرستقراطية مالية في بلد المال، بيض الوجوه رقيقو الحاشية، تمتاز نساؤهم بحسن الذوق بملبسهن فلا يتخيرن تلك الألوان التي تتكالب عليها بعض النساء هناك هي والعطور والبخور لتوقعك في شبه إغماء مزمن من طول إقامتك في الهند.
أحفاد بن بطوطة
يتوقف دكتور فوزي بشكل خاص عند جزيرة المهل في مالي، والتي سبق وكتب عنها رحالة المغرب بن بطوطة قبله بستمائة عام قائلاً «ولقد زرت الجزر بعدك بستمائة عام فوجدت النساء محجبات يتوارين خلف الأبواب؛ إذ ما مر بها الغريب ويرمقنه بعيونهن الحوراء الحارة من فوق أسوار حديقتهن».
ويسهب في وصفه لتلك المغامرة قائلاً «لمست أقدامي الجزيرة وأنا أتحرق شوقاً لمشاهدة الجزر التي سبق وكتب عنها رحالة طنجة الفذ ابن بطوطة وأمنّي نفسي بلحظات هي ملك للفن الخالص حين أمتع سائر روحي برؤية الجمال الرائح والغادي في غير احتشام زائف وخجل متصنع. بدت لنا الجزيرة كالأحلام ونحن نراها على امتداد البصر زمردة في عقد الجزر المرجانية التي تحيط باللاجون. ميناء طبيعي تحيط به مجموعة من الجزر تتخللها منحدرات خطيرة لا سبيل إلى اجتيازها أو تتحطم السفن فيها تحطيماً ما عدا المعبر الوحيد الذي لا يسلكه إلا كل ملاح قدير».
ويخلص الدكتور حسين فوزي في كتابه الشيق المبكر إلى أنه ركب البحر كثيراً قبل أن يعيش تسعة أشهر بطولها على ظهر هذه السفينة العلمية فلم يعرف إلا القليل عن حياة البحر، ذلك أن المسافر بالبواخر الكبيرة يعيش داخلها أكثر مما يعيش على سطحها وهو في اللحظات التي يتمشى ويلقي نظرة عابرة على البحر مرة مقابل عشر نظرات فضولية للركاب من حوله. وهكذا لا يعرف البحر إلا من يكابده على ظهر سفينة صغيرة طولها لا يتعدى الأربعين متراً، وحمولتها ثلاثمائة طن.