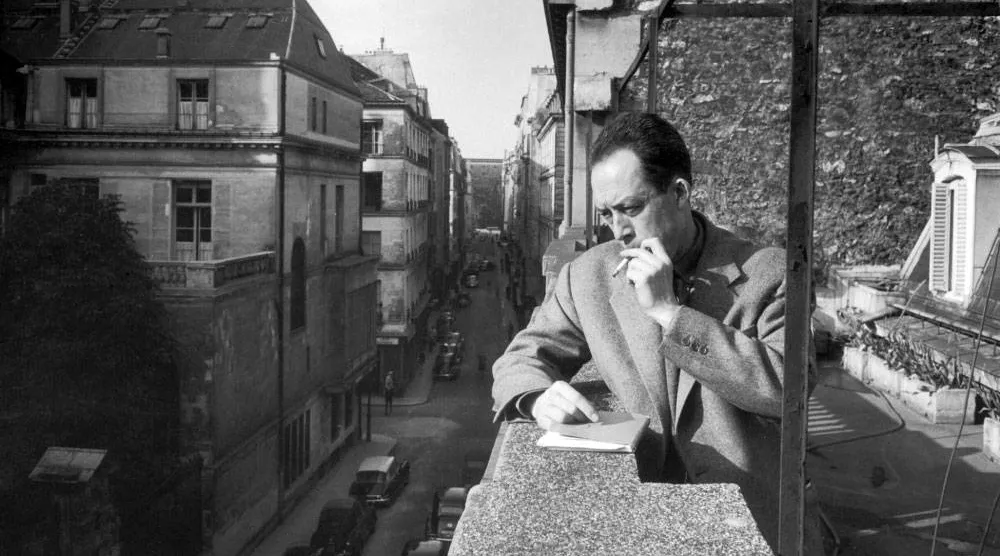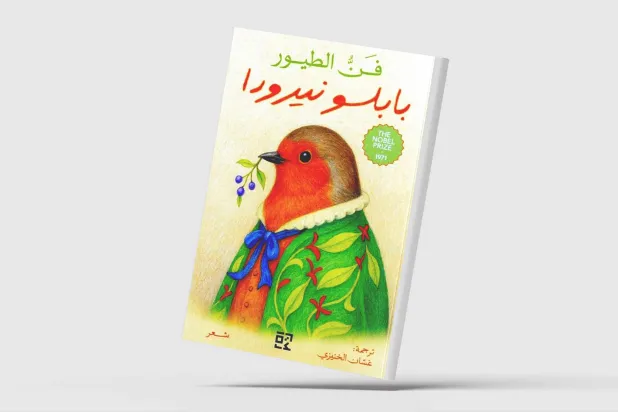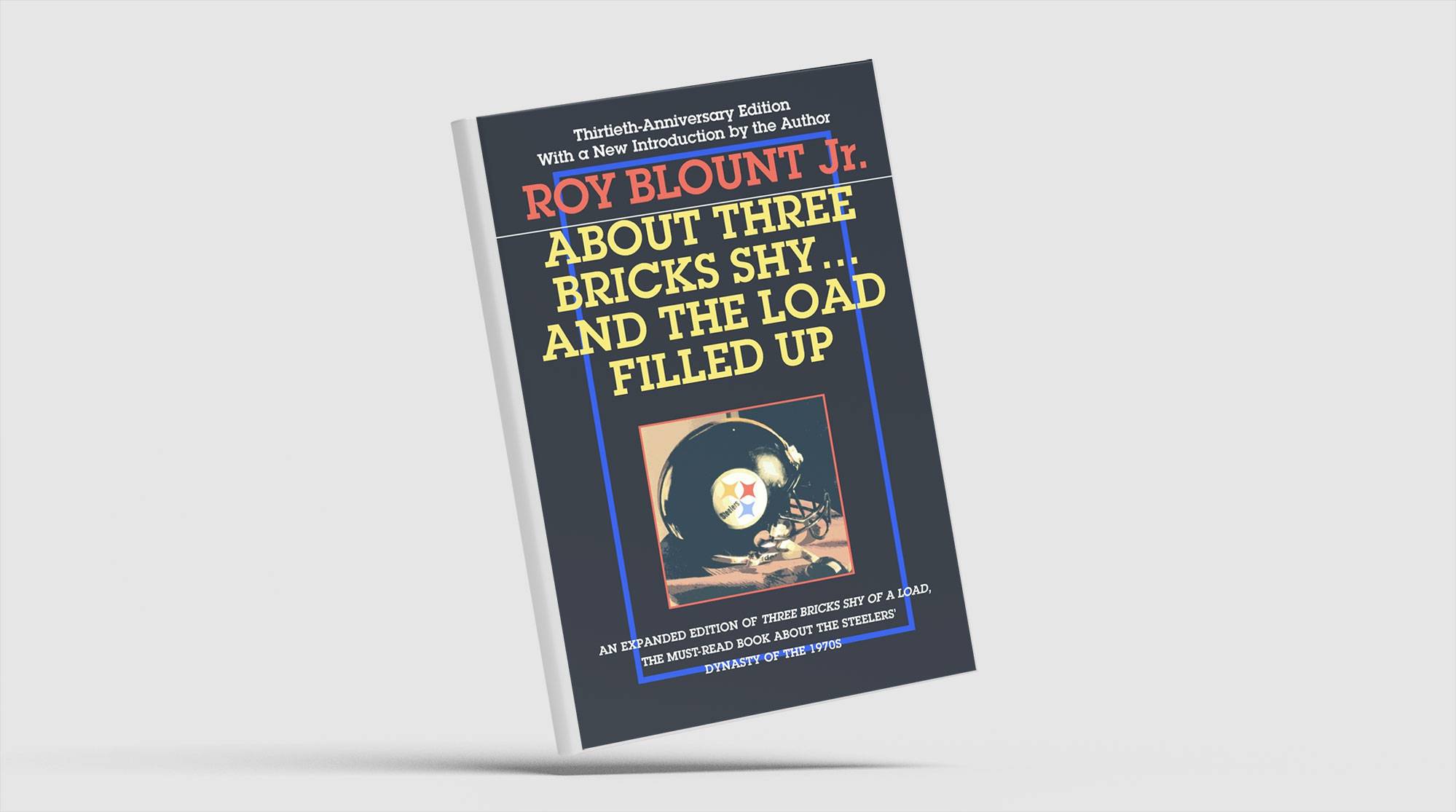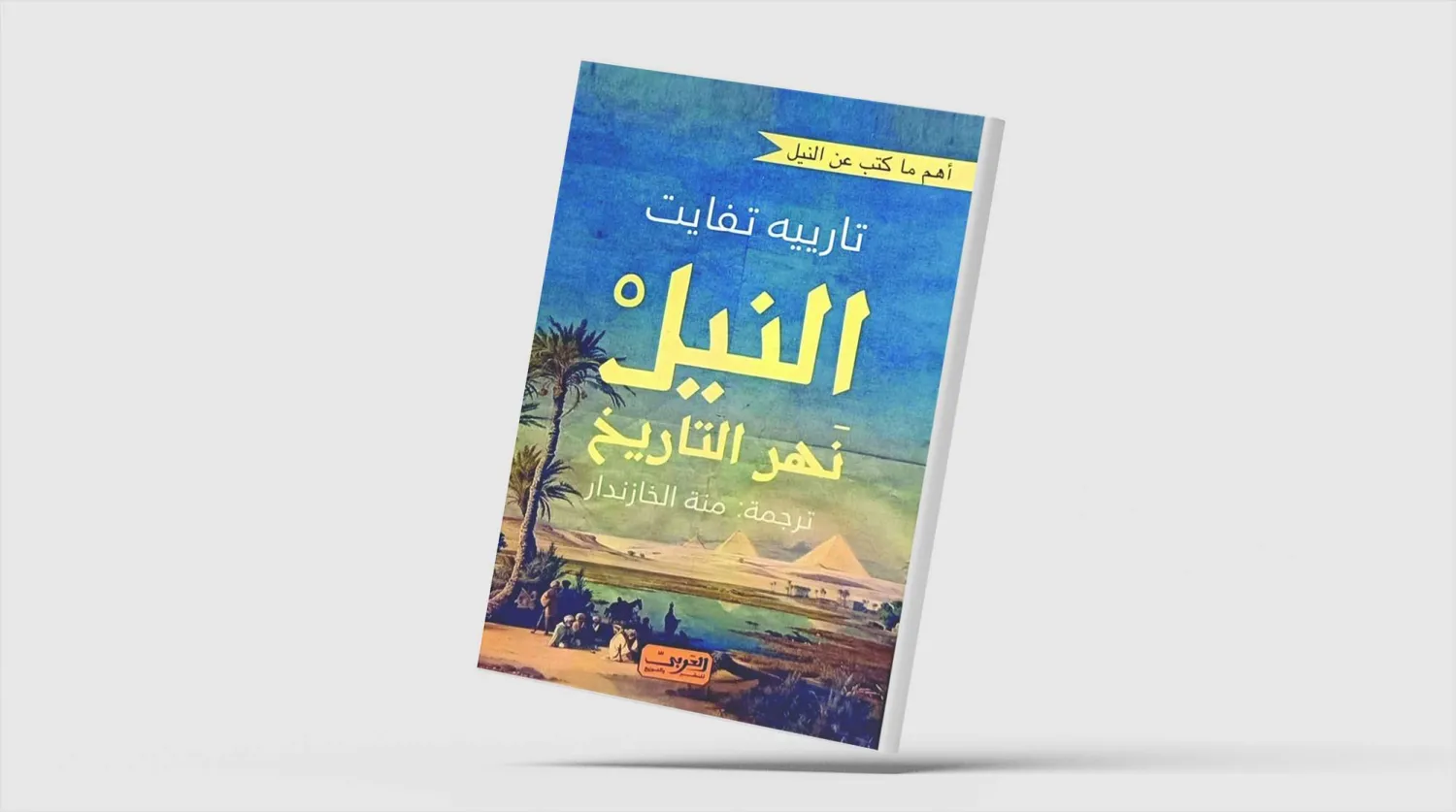بعد ربع قرن من رحيله في 22 يوليو (تموز) 1996 عن 81 عاماً، تخرج مذكرات المخرج صلاح أبو سيف المُلقب برائد الواقعية في السينما المصرية إلى النور، التي سجلها على مدار لقاءات عدة معه الكاتب الصحافي عادل حمودة.
تقع المذكرات في 260 صفحة، وصدرت عن دار «ريشة» للنشر بالقاهرة، وتلقي الضوء على جوانب مستترة مهمة في حياة مخرج عبقري قدم عشرات الأفلام، أصبح بعضها علامة في تاريخ السينما في مصر، منها «الزوجة الثانية»، و«شباب امرأة»، و«أنا حرة»، و«القاهرة 30»، و«بداية ونهاية»، و«بين السماء والأرض»، ونقل الصورة السينمائية من حياة القصور المترفة إلى بساطة الحارة الشعبية.
المذكرات تأخر نشرها ما يقرب من ربع قرن بسبب فقدان عادل حمودة لمسودتها الأصلية، حتى عثر عليها لاحقاً، لافتاً في مقدمتها إلى أن أغلب المشاهير في عالمنا العربي يخشون كشف أسرارهم ومحاسبتهم بأثر رجعي، كما يخشون السفر دخل نفوسهم، ويكتفون بالسفر داخل نفوسنا، مؤكداً أن «من يملك الجرأة على مخالفة ذلك يتصور أننا سنسقطه من عيوننا، وهو خطأ شائع». وحول تقييمه لمدى صراحة صلاح أبو سيف في تلك المذكرات، يوضح عادل حمودة أنه للإنصاف كان «صريحاً بسيطاً، كما لو كان يتحدث إلى نفسه بصوت مرتفع، وكان ما قاله أقرب إلى المونولوج لا إلى الحوار، أقرب إلى الاعتراف لا إلى المناقشة».
فقر وحرمان
ترصد المذكرات العديد من الملامح حول طفولة صاحبها، فقد عاش يعاني من جحود الأب الذي كان ثرياً ومزواجاً يملك العديد من الأفدنة الزراعية، ومع ذلك تنكر لابنه، ولم يره مرة واحدة، أو ينفق عليه قرشاً، لأن والدته تلك المرأة الشابة الجميلة صممت أن تعيش في حي بولاق الشعبي بالقاهرة، ولا تنتقل إلى محافظة بني سويف بصعيد مصر، لتكون مجرد رقم جديد في «امبراطورية الحريم» التي بناها الأب الذي كان يغير زوجاته، كما يغير ملابسه، فعاقبها الزوج بالطلاق والإهمال، وحين حصلت على حكم قضائي يلزمه بالإنفاق عليها، استطاع بنفوذه كعمدة قرية وإقطاعي صغير أن يتهرب من تنفيذ الحكم، وهكذا عاش المخرج طفولة عنوانها الفقر والحرمان. ويتوقف صاحب المذكرات عند خاله ناظر المدرسة الشاب الذي تولى الإشراف على تربيته وتعليمه، وكان مثقفاً يهوى القراءة والفن، ويشتغل بالسياسة وكانت ميوله ثورية، يعقد الاجتماعات ويوزع المنشورات المنددة بالاحتلال الإنجليزي للبلاد، وينظم خلايا سرية. ويحكي أنه ذات يوم اقتحم البوليس السياسي منزل العائلة، وقام بتفتيشه بحثاً عن المنشورات، ولكن قبل دخولهم الشقة نجحت خالته في إخفاء المنشورات في سلة الخبز، فلم يعثروا عليها، ولو أنهم نظروا في وجه الطفل الصغير «صلاح» لعرفوا مكانها فقد كانت عيناه ترتكز على السلة. ومع أنهم لم يجدوا منشورات، فإنهم لم يتركوا خاله وأخذوه معهم بعد أن وضعوا الحديد في يديه.
ويحكي أيضاً عن الحارة الشعبية التي نشأ بها، ومن معالمها «الحانوتي» الذي كان لا بد أن يكون خفيف الظل حتى لا ينفر منه الناس، وكان ابن الحانوتي زميلاً له، وابن البقال أيضاً، ويتذكر أن البقال كانوا يسمونه «خضرة»، ويعاملونه كطفلة خوفاً من الحسد، لأن كل إخوته الذكور سبق وأن ماتوا صغاراً.
الحارة الشعبية
يقول أبو سيف إن الحارة بكل تفاصيله كانت عالمه الخاص الذي فرض نفسه على أفلامه عندما أصبح مخرجاً، فلا يوجد فيلم من أفلامه لا يحتوي على تفاصيل هذا العالم الشعبي العجيب الغريب.
ويشرح أبو سيف كيف تحولت طفولته إلى مخزن خبرات وذكريات أفادته في صناعة الأفلام قائلاً: «قدمت على الشاشة الدنيا التي عرفتها لم أكذب، ولم أفتعل ما لا أعرفه، وربما كان ذلك سر انفعال وحماس الجمهور لأفلامي». ويضيف أن أمه كانت «هي المسؤولة عن كل شيء وصاحبة القرار الأول والأخير، فهي الأب والأم معاً، ومن ثم لا تجاوز ولا تدليل، والعقاب لا بد منه مهما كان حجم الذنب صغيراً». ولا جدال أن السبب هي رغبة الأم الدفينة أن تثبت للأب أنها كانت على حق، أو أن اختيارها كان صائباً.
يحكي أبو سيف أيضاً عن بيته الذي نشأ فيه، مشيراً إلى أنه كان على الطراز المملوكي، مدخله من الرخام، ونوافذه مغطاة بمشربيات على شكل نصف دائرة محفورة بالزخرفة الإسلامية أو الأرابيسك، ولعل ذلك ما جعل الكثير من شخصيات أفلامه تخرج من وسط تسيطر عليه الروحانيات والمعتقدات الإسلامية. ويرى حمودة أنها ملاحظة فاتت الكثير من النقاد الذين اهتموا أكثر بالصراع الاجتماعي في أفلامه وفاتهم البعد الروحاني.
سحر السينما
يروي أبو سيف عن طفولته مع السينما، قائلاً إنه ذات يوم وهو يتسكع في شوارع القاهرة وقف أمام شباك التذاكر لدار سينما عليها زحام بحي عابدين، يسأل عن سعر التذكرة، وعرف أنه قرش صاغ، أي مصروف يومين، فقد كان مصروفه اليومي نصف قرش، ومن ثم كان القرش ثروة كبيرة، ولكن لم يتردد في التضحية به. دخل السينما وفي هذا العرض شاهد فيلمين، أحدهما لشارلي شابلن، وكان اسمه «شارلي في البنك»، والآخر كان لممثل إيطالي قديم كان من نجوم السينما الصامتة هو إيلامو لنكولن، وكان أول من قدم دور طرزان على الشاشة.
خرج أبو سيف من السينما مفلساً، ليعود لبيته سيراً على الأقدام، ولكنه لم يشعر بطول المسافة فقد كان منتشياً مسحوراً لا يكاد يصدق ما رآه، ومن شدة انفعاله لم يستطع الكذب، فأخبر أمه وخاله بسر السينما، وتلقى عقاباً قاسياً، فقد ارتكب جريمتين معاً؛ التهرب من المدرسة ودخول السينما، وما كان منه إلا أن تحمل الضرب، ولكن بدون بكاء!
من باريس إلى أم كلثوم
عاش أبو سيف ميلاد استديو مصر، أول محاولة مصرية جادة لتوفير أدوات إنتاج محلية تساهم في نهضة السينما، وهو فكرة طلعت حرب أبو الاقتصاد المصري الحديث، كما شارك كمساعد مخرج في صناعة فيلم «العزيمة» من إخراج كمال سليم، الذي يعد بداية الواقعية في السينما المصرية. وكانت المرة الأولى في الفيلم التي تصور حارة مصرية نرى فيها على الشاشة الحلاق والحانوتي والجزار وبنت البلد والحياة الخلفية الخفية للقاهرة! وتكشف المذكرات عن سر مهم، حيث يروي أبو سيف أنه البطل الحقيقي لفيلم «شباب امرأة» الشهير الذي قامت ببطولته تحية كاريوكا وشكري سرحان، وفيه تقوم سيدة ناضجة تعاني الحرمان باستغلال شاب ساذج يبحث عن مكان للإيواء! يقول: «الفيلم تجربة حية عشتها في باريس، حين سافرت إليها شاباً في مقتبل العمر لأدرس المونتاج والإخراج. الطرف الآخر سيدة تمتلك فندقاً صغيراً، تجاوزت سن الشباب في حاجة إلى علاقة تعيد مصالحتها مع الحياة ومستعدة لأن تفعل أي شيء في سبيل ذلك».
ويشير صاحب المذكرات إلى موقف طريف جمعه بكوكب الشرق أم كلثوم، فقد كانت مطربة شهيرة عندما بدأت السينما تجري وراءها، أو بتعبير أدق وراء صوتها. كان أبو سيف مسؤولاً عن مونتاج فيلم تصوره في استديو مصر، وكانت حريصة على متابعة المونتاج كل يوم بعد الانتهاء من التصوير. ولم يكن يتصور مخرجنا أن هذه المتابعة جزء من وساوس ومخاوف أم كلثوم عند القيام بأي عمل فني، وتصور أن هذا الاهتمام موجه له شخصياً. ضاعف هذا الإحساس أنها كانت دائمة السؤال عنه، وسألت زملاء له عن أخلاقه ومرتبه، وكانت تحرص على إحضار الطعام له من بيتها، وكان من الطبيعي أن يقنعه غرور الشباب بأنها تحبه، بل تسعى للزواج منه!
لكن أبو سيف لم يبتعد عما في نيتها كثيراً، فهي كانت تريده أن يتزوج، ولكن ليس منها، بل من فتاة قريبة لها. وفيما بعد عرفت كوكب الشرق أنه مهتم بفتاة في قسم المونتاج، فاختفى الطعام، على حد تعبيره، وتراجع اهتمامها به حتى نهاية الفيلم!