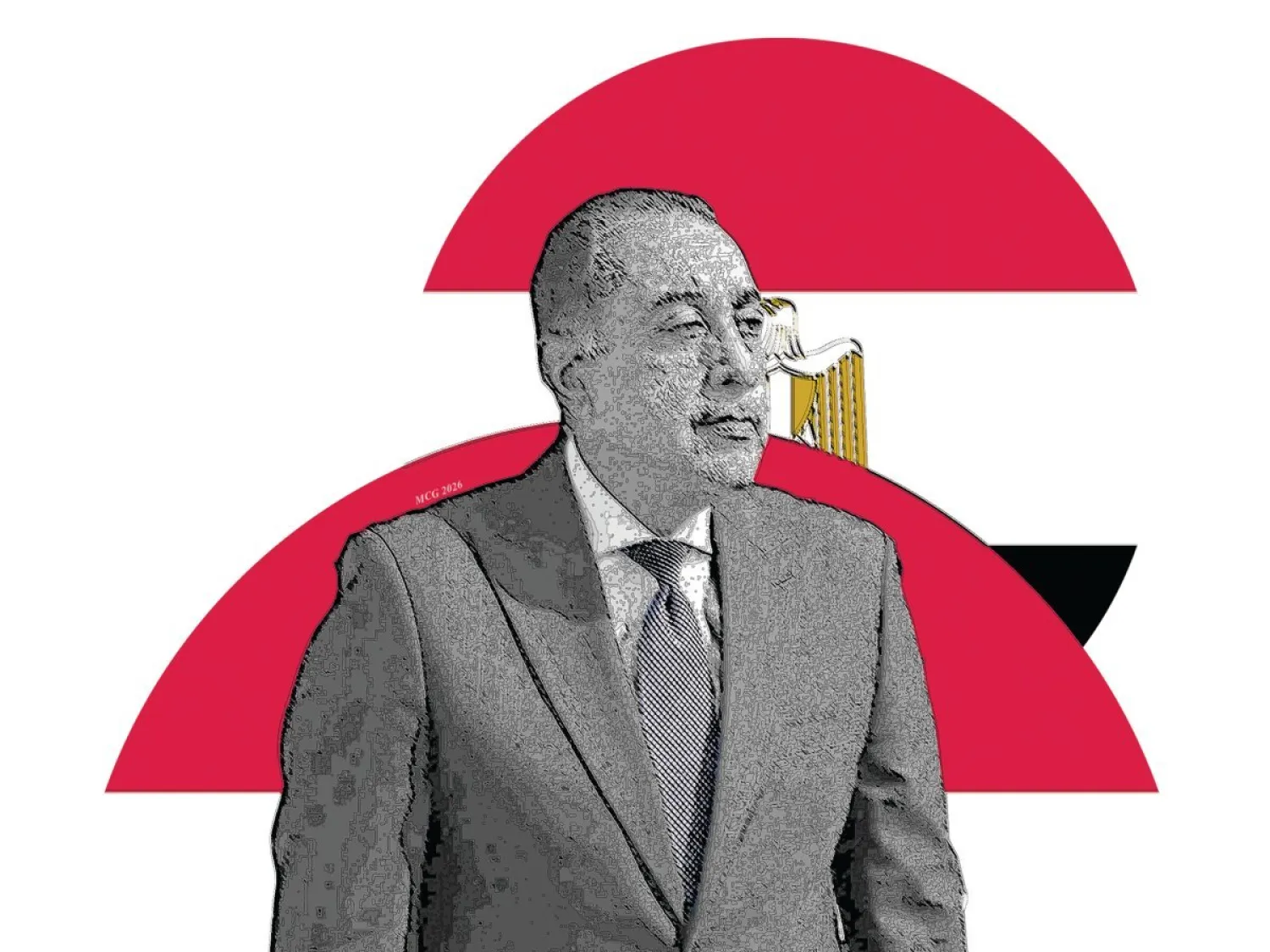يقف لبنان اليوم على مفترق طرق، حيث من المفترض أن يحدد خياره مصيره ككل بعدما وصل إلى «نقطة اللا عودة» على المستويات كافة، سواءً على: الصعيد السياسي بعدما فقد قسم كبير من اللبنانيين الثقة بالطبقة الحاكمة منذ 30 سنة، وخرجوا في انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. أو الصعيد الاقتصادي - المالي، بعدما انهارت عملته الوطنية، وتراجعت الموجودات بالعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي إلى حدودها الدنيا، ما بات يهدد الانهيار المالي بوقف دعم القمح والوقود والدواء. أو على الصعيد الأمني بعد انفجار مرفأ بيروت من دون تحديد أسبابه المباشرة حتى الساعة، وربط الملف بعجز واضح من الدولة على ضبط مرافقها الشرعية وغير الشرعية على حد سواء.
نجح لبنان، بل على الأصح الدولة اللبنانية، في تخطي «مطب» حكم المحكمة الدولية الخاصة المولجة بالنظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورفاقه. وبعدما كانت المخاوف كبيرة من ردّات فعل سلبية في الشارع في أعقاب إدانة أحد عناصر «حزب الله» بارتكاب الجريمة، مرّ هذا التحدّي المفصلي «على خير». وحصل هذا الأمر في ظل ترقّب قسم كبير من اللبنانيين ما إذا كانت السلطات المحلية ستتحرك فتحاول إلقاء القبض على سليم عيّاش، الشخص الذي أدانته المحكمة، خصوصاً، أن «حزب الله» يصرّ على رفض التعليق على الحكم واعتبار أنه - أي الحزب - غير معني بالمحكمة ككل.
جدير بالذكر أن عيّاش، أدانته المحكمة وحيداً، في حين برّأت 3 عناصر آخرين تابعين للحزب لنقص الأدلة الكافية للإدانة. وفي حين تؤكد مصادر مطلعة على أجواء «حزب الله» أن تسليم عيّاش لا يمكن أن يحصل، بل ولا مجال للنقاش به، تتساءل المصادر ذاتها في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، حيال كيف يمكن تسليم عيّاش بينما الحزب أصلاً لم يعترف ولا يعترف بالمحكمة ولا بأحكامها؟
فجوتان في حكم المحكمة الدولية
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، يتحدث الدكتور شفيق المصري، الاختصاصي في القانون الدولي والمرجع القانوني والدستوري اللبناني، عن «فجوتين أساسيتين في قرار المحكمة الدولية، أولهما عدم تحديد مسؤوليات القيادي في (حزب الله) مصطفى بدر الدين في الجريمة، حتى ولو كان قد أعلن عن اغتياله في وقت سابق. أما الفجوة الثانية فهي تبرئة المتهمين الثلاثة أسد صبرا وحسين عنيسي وحسن مرعي، مع العلم أن نص الحكم كان قد أشار إلى أدوار لهم في موضوع الاتصالات. وبالتالي، فمجرد الاشتراك في جزء من العملية، حتى وإن كانوا لا يعلمون بالهدف النهائي، يحمّلهم مسؤولية، ولو لم تكن على مستوى مسؤولية الطرف أو الشخص الذي نفّذها».
ويشّدد الدكتور المصري على «وجوب قراءة الحكم بكامل حيثياته وليس حصراً بالفقرات الحُكمية، لأنه بذلك يرد بوضوح أن هدف الجريمة كان سياسياً، ويخصّ سوريا، خاصة أنه ورد في متن الحكم أن قرار اغتيال الحريري اتخذ بعد حدثين: الحدث الأول (مؤتمر البريستول الثالث) الذي شارك فيه رفيق الحريري وتقرر خلاله وجوب إخراج سوريا من لبنان. أما الحدث الثاني فلقاء الحريري بوزير الخارجية السوري وليد المعلّم وما تخلله من شكاوى على الوضع السوري في لبنان». ويضيف المصري: «يتحدث البعض عن مآخذ على المحكمة كونها لم تذكر بوضوح مَن قرر تنفيذ عملية الاغتيال، إلا أن المحاكم الدولية لا تستطيع إصدار أحكام بحق مؤسسة أو دولة باعتبارها تختص بمقاضاة الأفراد»، معتبراً أن الإشارة الواضحة إلى سوريا في الحكم بمثابة إدانة لها.
من ناحية ثانية، وفيما يترقب لبنان العقوبة التي ستعلنها المحكمة بحق المتهم الوحيد سليم عيّاش في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، يبدو أن إلقاء القبض عليه غير متاح، باعتبار أنه ومنذ صدور القرار الاتهامي لم يكن هناك محاولات جدية من قبل السلطات المحلية لتوقيفه. وفي هذا الإطار يقول المصري إن الأمر منوط حالياً بالحكومة التي سيصار إلى تشكيلها، وما إذا كانت حقاً تريد أن تُظهر للرأي العام المحلي والدولي أنها تقوم بمساعٍ جدية في هذا المجال. ويتابع: «كما أن المحكمة قد تحيل الموضوع بعد الإعلان على العقوبة إلى الإنتربول (البوليس الدولي) ليقوم بتعقبه واعتقاله. وهناك سوابق في هذا المجال بحيث تم إلقاء القبض على مدان من قبل إحدى المحاكم الدولية من خلال الإنتربول».
المرفأ: تخوف من إسقاط المسؤوليات السياسية
على صعيد آخر، لئن كان لبنان قد تخطى إلى حد بعيد تداعيات حكم المحكمة الدولية، بعد مخاوف من فتنة سنية - شيعية، فهو لا شك لن يتخطى قريباً آثار وتداعيات انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الحالي الذي ذهب ضحيته عشرات القتلى وآلاف الجرحى.
إذ تتواصل التحقيقات، التي لا تزال تكاد تكون محصورة بالمسؤولين الأمنيين في المرفأ وبإدارته المدنية. وهذا، في ظل إعلان أكثر من طرف سياسي أساسي في لبنان انعدام ثقته في أي تحقيق محلي، والمطالبة بتحقيق دولي لا تبدو طريقه معبّدة في ظل إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون، وحليفه أمين عام «حزب الله»، السيد حسن نصر الله، عدم موافقتهما عليه.
ما يُذكر، أنه حتى الساعة أصدر فادي صوّان، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، عدداً من مذكرات التوقيف الوجاهية، أبرزها بحق مدير عام الجمارك بدري ضاهر، ومدير استثمار المرفأ حسن قريطم. ولا يزال صوّان يركّز في تحقيقاته على جانب التقصير والإهمال الذي أدى إلى بقاء مادة «نيترات الأمونيوم» موضوعة طيلة 7 سنوات داخل العنبر رقم 12 إلى حين انفجارها. أما النظر في أسباب الانفجار، فيؤجله صوّان إلى حين تسلمه تقارير خبراء المتفجرات، خصوصاً الخبراء الفرنسيين وفريق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) اللذين يساعدان لجنة التحقيق اللبنانية.
في أي حال، يخشى كثيرون من حصر المسؤوليات بملف انفجار المرفأ بالمسؤولين الأمنيين، وألا تطال القضاة الذين كانوا على علم بالموضوع، وكذلك الوزراء المعنيين. وهنا يوضح العميد المتقاعد الدكتور محمد رمّال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «أكثر من جهاز أمني يتولى أمن المرفأ، إضافة لسلطة مدنية تقوم بإدارته، إلا أنه تبين أن هناك مراسلات بين الأمنيين والإدارة المدنية، كما السلطات القضائية، ما يستدعي التحقيق مع عدد من القضاة، وبخاصة قضاة الأمور المستعجلة، لأنه في نهاية المطاف فلا سلطة للأمنيين للتصرف بالموجودات في المرفأ. وهم لا يقومون بأي شيء في هذا المجال إلا بإشراف وبقرار من القضاء المختص». ومن ثم، يشير الدكتور رمّال إلى «الخشية من حصر المسؤوليات بإدارة المرفأ والأمنيين تجنباً لتوسيعها... فتطال السلطة السياسية والوزراء المعنيين، وهنا نتحدث عن وزراء الأشغال والنقل ووزراء المال. وعلى سبيل المثال، مع قرار توقيف مدير عام الجمارك يجب أن يكون هناك تحقيق فوري مع وزراء المال باعتبار المديرية العامة للجمارك تتبع في نهاية المطاف وزارة المال».
ولكن يبدو أن السلطة السياسية لن تتمكن من التهرب من مسؤولياتها في كارثة المرفأ، نتيجة الضغط الشعبي الكبير؛ إذ يُتوقع أن يدلي عدد من الوزراء بإفاداتهم على سبيل المعلومات أمام المحقق العدلي، على أن يُصار، في حال توافرت خلال التحقيق أدلة على ارتكاب أي منهم جرماً متلازماً للقضية، إلى تحويل الوزير المستجوَب إلى مُدَّعى عليه. أما إذا كان الجرم غير متلازم، فيحيل الأوراق إذ ذاك إلى النيابة العامة التمييزية للنظر بأمر الادعاء وإحالته إلى المرجع المختص.
الحكومة المقبلة مؤجلة حتى الانتخابات الأميركية؟
في هذه الأثناء، تجري التحقيقات في ملف مرفأ بيروت بغياب حكومة فاعلة قادرة على الضغط باتجاه تسريع الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها.
إذ إن الكارثة التي أطاحت بحكومة الدكتور حسان دياب وحوّلتها إلى «حكومة تصريف أعمال» لا يبدو أنها ستشكل حافزاً كافياً للقوى السياسية لترحيل خلافاتها والترفع عن مطالبها، وبالتالي، السير بخطى سريعة في عملية تشكيل حكومة تضغط القوى الدولية لتكون حيادية وتلتزم بالإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وراهناً ترفض «قوى الثامن من آذار»، بقيادة «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») وحليفها رئيس الجمهورية، السير بحكومة من المستقلين، وتصرّ في المقابل على «حكومة وحدة وطنية» من السياسيين. وهذا هو ما ترفضه قوى المعارضة، خصوصاً رئيس تيار «المستقبل» بزعامة الرئيس سعد الحريري، الذي يُعدّ المرشح الأوفر حظاً لتولي الدفة الحكومية. وهذا الوضع، يعني فعلياً أن عملية التشكيل لن تكون ميسّرة رغم كل ما جرى ويجري تداوله عن «طبخ» تسوية إقليمية - دولية ستمكّن من إنجاز التشكيلة الحكومية قبل الزيارة الثانية المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
الدكتور سامي نادر، مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» في بيروت، يبدو متشائماً بخصوص ولادة حكومية قريبة. إذ رجّح نادر خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «تواصل حكومة دياب (تصريف الأعمال)، أقله حتى موعد الانتخابات الأميركية المقبلة في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل». ويعتبر نادر أن قرار تشكيل الحكومة «بات في ملعب إيران والولايات المتحدة الأميركية، فواشنطن تنتظر من طهران أن تأتي إلى طاولة المفاوضات للبت في كل الملفات العالقة ومن بينها الملف اللبناني، إلا أن الأخيرة لن تأتي إليها قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، لا سيما في ضوء استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجع حظوظ الرئيس دونالد ترمب بعد تفشي جائحة (كوفيد - 19)».
ويلفت الدكتور نادر في تصريحه إلى أن ما يُحكى عن مبادرة فرنسية وعن تسوية إيرانية - فرنسية ستؤدي لولادة قريبة للحكومة أمر غير دقيق؛ إذ إن الطرف الأميركي هو الممسك بالملف اللبناني، في حين أن الدور الفرنسي مجرّد مُسهِّل ودور واسطة حصراً. ويشدد الخبير الاستراتيجي اللبناني على القول إنه لا إمكانية لنهوض لبنان إلا من خلال حكومة مستقلة عن الطبقة السياسية، تواكب الكارثة الإنسانية التي نتجت بعد انفجار المرفأ وعملية إعادة إعمار بيروت، وتنكبّ جديّاً على وقف الانهيار الاقتصادي وهو ما لا يمكن أن يحصل من دون مساعدة دولية، ونجاح المفاوضات مع «صندوق النقد الدولي». ويختتم ملاحظاته بالقول: «أما حكومات الوحدة وطنية أو حكومة الخديعة، أي حكومات التكنوقراط التي تمسك بها المنظومة السياسية من الخلف، فلن يُكتب لها النجاح، وأصلاً يرفضها المجتمع الدولي».
الانهيار المالي يهدد فرص حصول اللبنانيين على القمح والدواء
> في خضم المجابهة الإيرانية - الأميركية وانصراف القوى السياسية الداخلية في لبنان إلى محاولة تحسين شروطها، يتواصل الانهيار المالي في البلاد... ولقد بلغ فعلاً مستويات غير مسبوقة مقابل ارتفاع جنوني في معدلات الفقر والبطالة.
الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان بشير في لقاء مع «الشرق الأوسط» إلى أن «أي فراغ في إحدى المؤسسات الدستورية، سيؤدي بطبيعة الحال إلى تدهور الأوضاع، فكيف الحال إذا كانت المؤسسة التنفيذية هي التي تشهد الشلل وهي المسؤولة عن إدارة المفاوضات مع (صندوق النقد الدولي)؟!».
ويتابع أبو سليمان قائلاً: «لبنان اليوم بأمسّ الحاجة لنجاح هذه المفاوضات، وبأسرع وقت، من أجل وضع البلد على سكة الإصلاحات والنهوض وإعادة هيكلة الدين». ويلفت إلى أن «نجاح هذه المفاوضات لا يعني حصراً الحصول على دعم الصندوق البالغ نحو 8 مليارات دولار أميركي، وإنما يعني أيضاً فتح الأبواب أمام مؤسسات دولية أخرى قد تقدم الدعم أو القروض للدولة اللبنانية. وهذا، من دون أن ننسى أن الصندوق طرف ذو صدقية للسير في المفاوضات مع الدائنين بعدما تخلف لبنان عن سداد دينه الخارجي. وبناءً عليه، فإن تحوّل الحكومة إلى مجرد (حكومة تصريف أعمال) سيضع الدولة في حالة شلل تام، وكلما امتدت في الزمن، تكبدنا خسائر أكثر».
الخبير أبو سليمان يعتبر أنه رغم أهمية الإجراءات والقرارات التقنية «فإنها لم تعد ذات جدوى، إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم سياسي جذري من شأنه أن يساعد على الإنقاذ، من خلال تأليف حكومة قادرة على ترميم الثقة مع الداخل ومع الخارج. للعلم هذا الخارج بات معنياً بالملف اللبناني بكل تفاصيله، ولا سيما في ظل ما يحكى عن عقوبات قد تطال بعض الشخصيات اللبنانية». ثم يستطرد: «لا يمكن للحكومة الجديدة أن تكون امتداداً للسياسات السابقة، خصوصاً إذا كان هناك من نية جدية لمخاطبة الخارج. وبالتالي فإن الحل السياسي هو انطلاقة الألف ميل».
وأخيراً، رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كان لبنان على موعد مع مزيد من الانهيار في سعر صرف الليرة، جزم أبو سليمان بذلك «ما دامت الإصلاحات لم تُقرّ، وما دام دخول الدولار إلى السوق اللبنانية مقنّناً، حيث صارت الاستثمارات الخارجية وكذلك تحويلات المغتربين شبه معدومة، في حين يعاني التصدير من إشكالات بنيوية، منها تعطيل المرفأ وامتناع الصناعيين عن إدخال دولاراتهم إلى السوق اللبنانية بسبب انعدام الثقة». ثم أردف قائلاً إنه «إذا لم تحصل إعادة نظر لميزان المدفوعات، فمن الطبيعي أن يتدهور سعر صرف الليرة. وهذا ما نلاحظه عبر بعض التلميحات والتسريبات التي تفيد بأن (مصرف لبنان) لن يستطيع الإبقاء على دعم المواد الأساسية، أي النفط والأدوية والقمح لأكثر من ثلاثة أشهر إضافية. وبالتالي ما لم يُتخذ أي قرار بشأن الأسر الأكثر فقراً في لبنان، فالخشية الحقيقية أن تزداد حالة الفقر بنسب ملحوظة قد تصل إلى أكثر من 70 في المائة... وكذلك سيرتفع التضخم بنسبة 50 في المائة كل شهر، وبالأخص أن هناك كثيرين من اللبنانيين الذين يستفيدون من الدعم الذي يؤمنه (مصرف لبنان)، ولا ننسى أن الاحتياطي بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان ينخفض بوتيرة سريعة جداً ومخيفة».