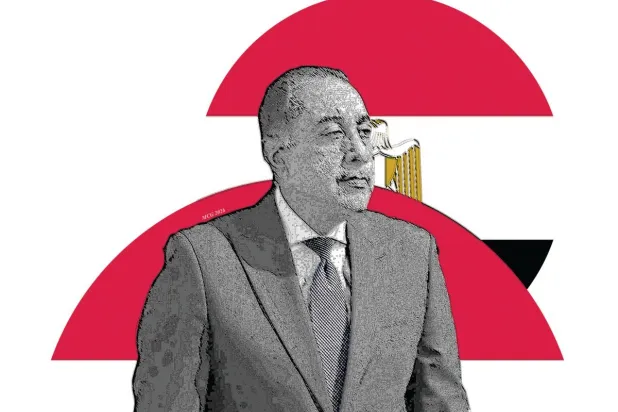على مدى الأعوام السبعة عشر الماضية، كان الحديث عن هيبة الدولة المفقودة في العراق والعمل على حفظ سيادتها لا يتعدّى «حديث خرافة يا أمّ عمرو» وفق القول الشائع.
هذا كان ولا يزال الحال، بدءاً من الأزمة مع الأميركيين سواءً كانوا «محرّرين» أو «محتلين» منذ لحظة إسقاط تمثال الرئيس السابق صدام حسين عصر 9 أبريل (نيسان) 2003، مروراً بالتدخلات المسلحة على الحدود العراقية من قبل إيران وتركيا، وانتهاءً بالموقف ممن تصف نفسها بـ«محوَر المقاومة» بينما تصنفها كل الحكومات العراقية بوصفها فصائل تملك سلاحاً خارج سيطرة الدولة.
لعل السؤال الذي بقي مطروحاً على مدى سنوات «زحف» سلطة الفصائل المسلحة الموالية لإيران على الدولة ومؤسساتها، الذي أسّس ما يسمى «الدولة العميقة» في العراق هو: من يعلق جرس المواجهة معها؟
كل رؤساء الوزارات العراقية قبل مصطفى الكاظمي، الذي جاء إلى السلطة من خارج الخط الأول من الزعامات الشيعية ومن خارج منظومة الأحزاب الإسلامية (ما عدا رئيس الوزراء الانتقالي إياد علاوي الذي كان مدنياً) تجنبوا خوض مواجهة مفتوحة مع ما يعدّونه «خارجاً عن القانون»، باستثناء ما عُرفت بـ«صولة الفرسان» التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عام 2009 ضد جماعة «التيار الصدري في محافظتي البصرة والعمارة. ويومذاك، حققت «الصولة» نجاحاً لفترة من الزمن قبل أن تستفحل عناصر أخرى وتحت أغطية أخرى.
غير أن الكاظمي، الذي جاء إلى السلطة بمعادلة جديدة، لم يغير ما وضعه من التزامات، أبرزها إنجاز أهم استحقاق ينتظره العراقيون، ألا وهو الانتخابات المبكرة والنزيهة ومعها استعادة هيبة الدولة المفقودة.
المعادلة المقلوبة
لعل أقل ما كان يمكن توقعه من قبل خصوم الكاظمي، وفي مقدمتهم الفصائل المسلحة، فضلاً عن أطراف كثيرة في كتلة «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري، هي أن الكاظمي «سيتغاضى» عن استهداف «جماعات الكاتيوشا» (أي الميليشيات) المصالح الأميركية في العراق، سواءً في «المنطقة الخضراء» - حيث السفارة الأميركية - أو مطار بغداد الدولي أو معسكر التاجي، حيث يتمركز أميركيون مع القوات العراقية لأغراض التدريب والتجهيز والتسليح والدعم اللوجيستي.
لكن الكاظمي سارع إلى إجراء حوار وصف بأنه «استراتيجي» مع الأميركيين يفترض أن يستكمل خلال يوليو (تموز) الحالي أو أغسطس (آب) المقبل، رابطاً المسار على جبهة الحوار - بما في ذلك جدوَلة انسحاب القوات الأميركية من البلاد - بوضع حد للسلاح المنفلت.
المفارقة اللافتة هنا، أن الحوار الذي جرى عبر دائرة تلفزيونية مغلقة رافقه إطلاق مكثف ويومي لصواريخ «الكاتيوشا». وبينما كان المطلوب من الكاظمي الاستمرار بهذه المعادلة كي يبقى نصف مرضيّ عنه من قبل هذه الأطراف، فإنه قلب المعادلة حين قرّر البدء بفرض هيبة الدولة عبر ما عُرف بـ«واقعة الدورة» جنوبي بغداد. ومع اختلاف الروايات بشأن الواقعة والمتهمين بها، وما إذا كانوا 1 أم 13، فإن النتيجة بدت متباينة بين قوى الدولة و«اللا دولة». وبينما احتفل المُفرَج عنهم الـ13 لنقص الأدلة، أعلنت الحكومة أن المطلوب كان واحداً لا يزال معتقلاً، وهو الذي اعترف بحيازة أسلحة ومنصّات صواريخ.
غير أن اللافت كان طريقة الاحتفال، بالإمعان في إهانة الدولة. إذ داس المُفرَج عنهم على صور مسؤولين، مع إنهم وفق الوصف الرسمي ينتمون إلى هيئة «الحشد الشعبي» التي تتبع رسمياً رئاسة الوزراء .
الكاظمي يعتقد، على الأرجح، أن ردّات فعل كهذه متوقعة، لا سيما إنه دون غيره من رؤساء الوزارات السابقين يخوض معركة «كسر عظم» تتطلب المزيد من الخسائر بما فيها الشخصية. ولذا عدّل الكاظمي خطة المواجهة التي يبقى الكثير من خيوطها بيده عبر الشخص الذي لايزال معتقلاً، وهو ما يمكن عده صيداً ثميناً في سياق التوجه مستقبلاً إلى أحد أهم مصادر تمويل الجماعات المسلحة، وهي المنافذ الحدودية، بدلاً من غزو المعسكرات التي يتحصن فيها هؤلاء ومعظمها معسكرات مشتركة بينهم وبين «الحشد الشعبي».
الليلة الكبيرة
صباح الخميس 26 يونيو (حزيران) الماضي كان مفعماً بالنشاطات بالنسبة للكاظمي. فبالإضافة إلى لقاء طويل عقده مع مجموعة من الإعلاميين والمحللين السياسيين حضرته «الشرق الأوسط»، أجرى رئيس الحكومة لقاءات عدة مع الفنّانين والأدباء وقبلهم أصحاب المهن الطبية. وكان القاسم المشترك في كل هذه اللقاءات أمران: الأول، التأكيد أن ملء الحقائب الـ22 مضى عليه أسبوعان فقط. والآخر هو ما ينوي عمله خلال الفترة المقبل، بما يوحي أنه سيبدأ مواجهة شاملة تبدأ من الأحزاب وتنتهي بالجماعات المسلحة، وبالعكس. ومما قاله الكاظمي «سنتّخذ في القريب العاجل مجموعة إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية في الدولة، وسنسمع بعدها حملة تشويه للحكومة؛ لأن هناك مَن سيتضرّر جرّاء هذه التغييرات. ونقول بكلّ صراحة إنه ليس لدينا شيء نخسره، ورهاننا على الإعلاميين والصحافيين وعلى الناس. وإن لم يتركونا نعمل فسنخرج وأيدينا نظيفة... الفساد أخطر من الإرهاب لأنه يساعد الإرهابيين، وستكون لدينا حملة لمتابعة أسباب الفساد وملاحقة الفاسدين».
وحقاً، في منتصف ليل الخميس وفجر الجمعة بدأت مواجهة غير مسبوقة، مع اقتحام قوة من جهاز مكافحة الإرهاب مقراً لـ«كتائب حزب الله» واعتقال مجموعة من عناصرها. بذا استعجل الكاظمي المواجهة رغم عمر حكومته القصير، وهو ما قد يمثل له ورطة بسبب نقص عناصر المواجهة. وهنا يقول محمد الكربولي، القيادي السنّي وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المواجهة مع الفصائل المسلحة والميليشيات الخارجة عن القانون أمر حتمي، لكنه يحتاج إلى وسائل وآليات كي لا تفقد الدولة هيبتها مرتين». وتابع أن «الكاظمي يعتمد حالياً على جهاز واحد قدّم تضحيات جسيمة في مواجهة (داعش) هو جهاز مكافحة الإرهاب».
حسب الكربولي «ليس من الحكمة الآن الزجّ بهذا الجهاز وحده في مواجهة مع الفصائل؛ لأنه لا هو ولا الكاظمي مؤهلان لهذا الدور الآن... وإلا ستفقد الدولة هيبتها مرتين: مرة في مواجهة خاسرة، ومرة في العجز عن تحقيق النصر، وبدلاً من ذلك إحداث شرخ داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية». ثم يستطرد «ينبغي بناء القوات المسلحة بشكل جيد ومتماسك، وتأجيل المواجهة الآن إلى أن تنضج ظروف المواجهة بحيث يكون ولاء القوات الأمنية للدولة تاماً».
وفي الإطار نفسه، يفسر الخبير الاستراتيجي الدكتور هشام الهاشمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ما حصل بأنه «بموجب مدرك رئيس الحكومة، فإنه يحاول إنهاء الأزمات الأمنية التي أربكت حلوله الاقتصادية من خلال تمرد خلايا الكاتيوشا وسيطرة الهيئات الاقتصادية على المشاريع والمنافذ الحدودية». ويضيف الهاشمي، أن «الكاظمي، من هذه الزاوية، كان لا بد أن يصل إلى تسوية من خلال القوة الناعمة، لكنها يبدو أنها فشلت، فلجأ إلى فرض القانون عبر تنفيذ مذكرات القبض القضائي».
وفي سياق تبادل الرؤى والأفكار لما حصل وما يُتوقع حصوله، يقول الأكاديمي العراقي الدكتور إحسان الشمّري، رئيس «مركز التفكير السياسي، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، إنه «على الرغم مما جرى نتيجة محفّز أمني لأمور واستهدافات كثيرة حصلت في المنطقة الدولية (الخضراء) أو مطار بغداد أو العمليات المشتركة، وكذلك طبيعة مواقف هذه الفصائل من مخرجات الحوار بين بغداد وواشنطن، فإن المواجهة تحمل من جانب آخر بعداً سياسياً يتمثل في أن الكاظمي بدا أكثر ثباتاً في تطبيق منهاجه الوزاري، ولا سيما، على صعيد حصر السلاح بيد الدولة». وأردف الشمّري، أن «الكاظمي كسر قاعدة الحكومات العراقية السابقة لجهة المواجهات مع الفصائل المسلحة أو الجهات الخارجة عن القانون. وبالتالي، فهو يتحرك بعيداً عن الضغوط والإملاءات السياسية».
الشمّري يرى أيضاً، أن ما حصل «سيكون له تداعيات سياسية كبيرة»؛ لأن الكاظمي لا يمتلك كتلة سياسية، «وستكون نسيج عمل سياسي بين هذه المجاميع لتعويق عمل الكاظمي ومساءلته واستقدامه إلى البرلمان وتعطيل خطواته، إلا أن الأهم هو أن هذه الخطوة من الناحية السياسية ستثبّت القناعة عند هذه الفصائل بأن لدى الكاظمي القدرة على الانقلاب على كل التوافقات السابقة بمعنى غض الطرف عن نشاط هذه الفصائل المسلحة». وأشار إلى أن الفصائل «ستعمل على إنهاء خلافاتها وإعادة تموضعها لمواجهة هذا التحدي الجديد، وعليه فإن قدرة الكاظمي على المواجهة تعتمد على أكثر من مسار، كقدرته أولاً على المطاولة، وثانياً دعم القوى السياسية لهذه الخطوات، وثالثاً مسألة التأييد الشعبي له».
عرس بلا «شهر عسل»
كل الحكومات العراقية السابقة بعد 2003، التي تشكلت أو مرّرت داخل قبة البرلمان، كانت حكومة توافقات، فضلاً عن المحاصصة الحزبية والطائفية. ومع أنها كلها باستثناء حكومة عادل عبد المهدي أنهت دوراتها المقرّرة (أربع سنوات)، فإن حكومة مصطفى الكاظمي تبدو «حكومة إجماع اضطراري»، لكن بمهمة واحدة هي إجراء انتخابات مبكرة نزيهة... وفي غضون سنة.
بناءً عليه، قبِل الكاظمي بمهمة «انتحارية». وبالفعل، وصف نفسه بـ«الشهيد الحي». ولئن كانت حكومته الوحيدة بلا «شهر عسل» بعكس كل الحكومات السابقة، فإن تعجّله المواجهة سيجعله في حالة حرب معلنة مع خصومه الذين يُصنَّفون وفقاً لقاموسه كـ«قوى اللادولة»، بينما يتباهون بأنهم «المقاومون» الممنوع التحرش بهم طالما يوجد «احتلال أميركي»، كما يسوّقون في خطابهم المعلن.
هادي العامري، زعيم تحالف «الفتح: هادي العامري»، بدا عقب «واقعة الدورة» غاضباً من الكاظمي. وفي سياق هذا الغضب برّر حضوره حفل تكليف الكاظمي بأنه لغرض تحقيق الإجماع. وأقرّ العامري، الذي يتكلم عادة بصراحة لا يملكها سواه، بأن القبول بالكاظمي كان «اضطرارياً» مع وجود بدائل رُفضت قبله كان يمكن أن تكون مقدمة لشق البيت الشيعي ومفاقمة خلافاته.
ومن جهته، يدرك رئيس الوزراء العراقي أن «حفلة زفافه» القصيرة في «قصر السلام» انتهت عند بوابة القصر ليواجه وحده مصيراً بدا مجهولاً منذ البداية. إذ ثمة أزمة مالية حادة توقفت معها رواتب المتقاعدين قبل الموظفين، وأزمة صحية بدأت تتفاعل بطريقة أكثر سواء مما كانت عليه أيام حكومة تصريف الأعمال الطويلة (نحو ستة أشهر). وفي سياق صيغ المجابهة مع الكاظمي، فإن قوى «الفتح» بدأت تركّز على المهمة الوحيدة التي يتوجب على الكاظمي القيام بها، ألا وهي الانتخابات المبكرة.
وفي سياق ما أقدم عليه الكاظمي من عمل جريء، لعله الأكثر جرأة مما فعلته الحكومات السابقة، وما قد يقدم عليه في المستقبل، يقول فرهاد علاء الدين، رئيس «المجلس الاستشاري العراقي» لـ«الشرق الأوسط» معلّقاً «ما قدمه الكاظمي حتى الآن غير محكوم عليه من قبل المراقبين». وتابع وهناك خلافات في وجهات النظر، حيث هناك مَن يرى بأن يكمل على الأقل 100 يوم في المنصب ونرى ما سيكون عليه الأداء خلال هذه الفترة... وهناك فريق آخر يريد أن يحكم بما رأى حتى الآن، ويعتبر الأداء غير ما كان متوقعاً منه».
ووفق علاء الدين «الإجراءات الإدارية والأمنية والمالية، حتى الآن، تبدو غير منضبطة، وربما مُبهمة، وبقدر ما تنطوي على علامات تفاؤل فإنها تنطوي كذلك على علامات تشاؤم».