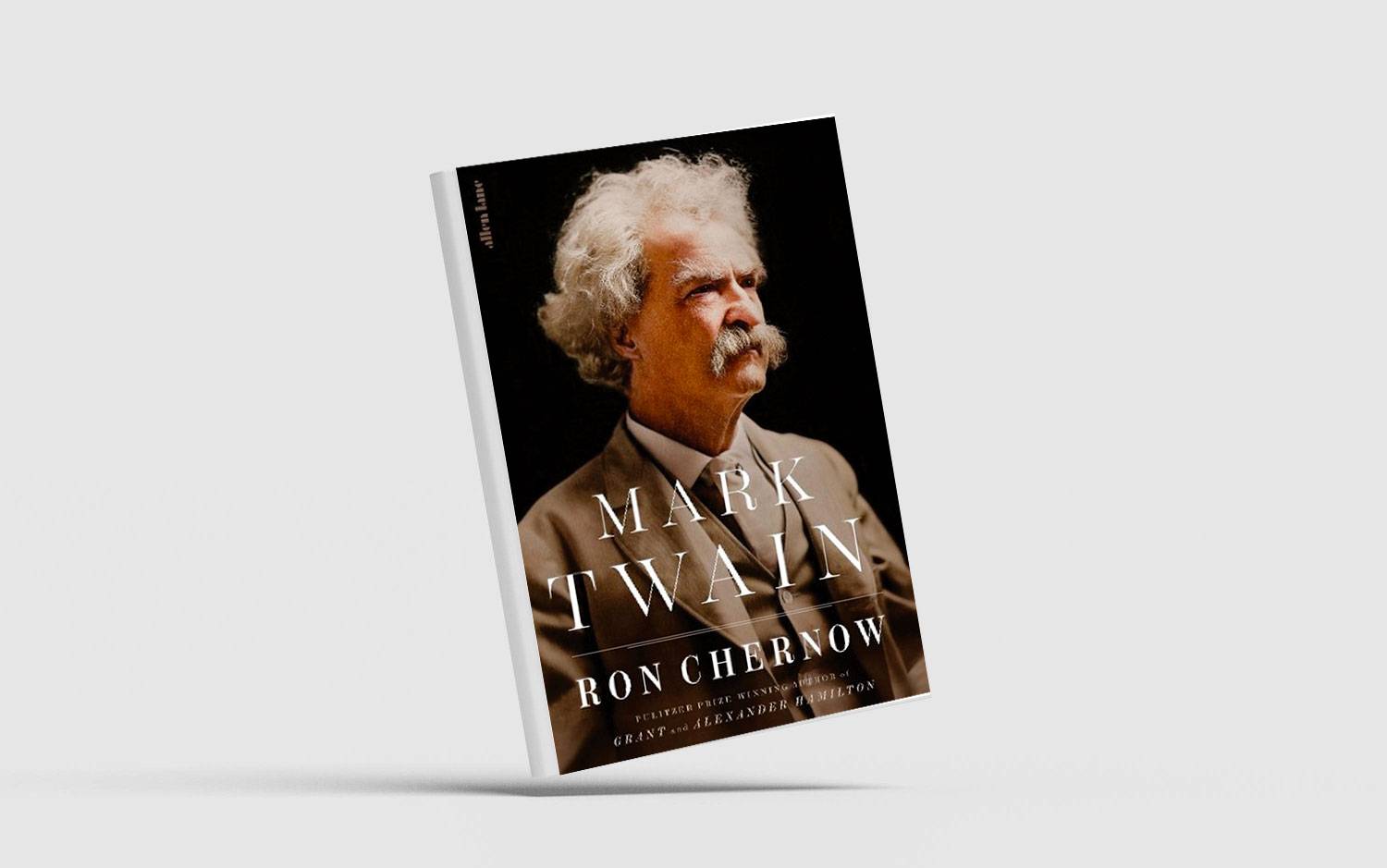لطالما شكّل الغياب والفقدان الموضوعين الأكثر قدرة على رفد قرائح الشعراء بما يلزمها من عناصر التخييل والتوهج الوجداني، والمادتين اللتين لم تكفّا عبر العصور المختلفة عن إضرام النار تحت قش اللغة وحطبها اليابس. ففي ظل الانزلاق السريع لعجلة الزمن، يتضح لنا أن الأشياء التي ننجح في الاحتفاظ بها لا تكاد تُذكر بالقياس إلى ما خسرناه.
ولعل مقولة هيراقليطس الشهيرة عن استحالة السباحة في مياه النهر مرتين، هي التعبير الأمثل عن واقع الحال المتغير، سواء تعلق الأمر بالكائنات الحية أم بالجمادات. فليس الجسد الإنساني وحده هو الذي يتعرض عبر موت الخلايا للتلف التدريجي، بل كذلك هو الأمر مع الأماكن التي تتآكل، والبيوت التي تبلى، والأشجار التي تتعرض لليباس أو الاحتراق، والحضارات التي تصبح أثراً بعد عين. يكفي أن نتطلع بإمعان إلى الخلف، لكي نكتشف أن الحياة التي نعيشها لم تكن منذ بدء الخليقة سوى وقوفٍ مستمر على أنقاض ما تهدم أو طواه النسيان.
فمنذ هبط آدم وحواء من الجنة، ونحن لا نفعل شيئاً سوى الوقوف على طلل الفردوس الذي خسرناه، أو «البحث عن الزمن المفقود»، على حد تعبير مارسيل بروست. وإذا كانت الجنة هي النموذج الأصلي لأحلام البشر الجمعية، فإن لكلّ شخص على حدة جنته الخاصة التي ضيعها في غفلة من الزمن، والتي تتوزع بين الطفولة الغاربة والحب الأول والأماكن الضائعة، وغيرها من المفقودات.
لم يكن الوقوف على الأطلال بهذا المعنى سوى محصلة طبيعية لخروج الحياة عن سياقها الأول، من خلال تذرر اللحظات، أو تشتت الأماكن، أو انقلاب المسارات والمصائر. وحتى لو بقي المكان ثابتاً لا يتغير فإن الزمان لن يفعل الشيء نفسه، بل ستتحول كل لحظة نعيشها إلى طلل زمني بالقياس إلى اللحظة التي تليها.
ولن يكون بمستطاع أحد تبعاً لذلك أن يوقف حركة الزمن التي لا تأبه من جهتها بمآلات أجسادنا التي تهرم وبيوتنا التي تؤول إلى زوال. وهو ما يعكسه بوضوح بيت أبي العتاهية الشهير:
لدوا للموت وابنوا للخرابِ
فكلّكمُ يسير إلى يبابِ
وحده الفن بفروعه المختلفة يمكن أن يتكفل بتقييد حركة الزمن وتثبته في صورة أو لوحة أو منحوتة أو قصيدة أو عمل موسيقي أو قصيدة شعرية.
وأي نظرة عميقة ومتفحصة إلى راهن الأدب والفن، كما إلى مسارهما التاريخي، لا بد أن تظهر للقارئ المتابع الكيفية التي استطاع بواسطتها الكتاب والفنانون أن يستردوا باللغة والحنين كل ما خسروه في الواقع، وأن يجعلوا من الماضي صفة من صفات الحاضر، وذخيرة للمستقبل غير قابلة للنفاد.
لم يفعل الشعراء العرب القدامى تبعاً لذلك غير ما كان ينبغي لهم أن يفعلوه. وإذا كانت الآداب التي سبقتهم، رغم انتمائها إلى حضارات مدينية مزدهرة على مستويات الفكر والفلسفة والعمران، قد حفلت في مراحل سقوطها برثاء الماضي وانهيار الأحلام، فالأوْلى بأولئك المترحلين في متاهات المكان الصحراوي، والقاطنين خياماً هشة لا يكفون عن حملها من مكان إلى آخر بحثاً عن الماء والكلأ ولحظات الأمان، أن يلتفتوا بالقلب والشعر إلى بقايا المضارب التي خلّفوا حول أثافيها وأوتادها فلذات لا تنطفئ من جمر قلوبهم وحرقة أكبادهم المثلومة.
وليس الزمان الصحراوي وحده هو الذي يتسم بالانزلاق والتحول، بل إن للمكان أيضاً السمات نفسها حيث تتكفل الريح والمطر وعوامل الطبيعة المختلفة بتغيير معالم الأماكن والتضاريس، وبطمس الحياة التي سبق لها أن خفقت بقوة بين جنباتها. ومن البديهي في هذه الحالة أن تتولى الذاكرة، من خلال الشعر، ترميم نثار العيش وبقايا الأماكن المهجورة.
وإذا كان امرؤ القيس يستهل معلقته الشهيرة بفعل الأمر أو الطلب «قفا»، فلأنه يريد ولو لبرهة محدودة أن يوقف جريان الزمن، ويثبّته على مشهد التذكر الاستعادي.
وفي ذلك الفضاء المفتوح على القيظ والجوع والخوف وانعدام الأمان، لا بد أن تكتسب المرأة حضوراً طيفياً وشبه أسطوري، وأن يستحضر الشعراء أطيافها في مطالع قصائدهم، بما هي رمز للحدب أو الحب، للمتعة أو الأمان للطهر الأمومي أو للأنوثة المغوية.
بناء على ما تقدّم يحق للمرء أن يتساءل عن مدى صوابية الموقف الحاد والهازئ الذي اتخذه أبو نواس من موضوعة الوقوف على الأطلال، وهل كان موقف الشاعر يستند إلى معايير إبداعية بحتة تتصل بدعوة الشاعر إلى تحديث الكتابة عبر التفاعل الخلاق مع قيم العصر وتبدلاته، أم أن موقفه الحاد كان مرتبطاً بموقفه السياسي السلبي من العرب، في ظل الصراع المستشري بين العرب والأعاجم المنضوين تحت لواء الدولة العباسية، والذي اصطلح المؤرخون على تسميته بالشعوبية؟
ولن نُعدم في هذا السياق الشواهد الدالة على نفور أبي نواس من العرب الممسكين بمقاليد السلطة، فيما هم لا يستندون، من وجهة نظره، إلى أي إرث حضاري عريق وراسخ المعالم، بالقياس إلى الفرس والروم والشعوب الأخرى. وقد وجد الشاعر في مسألة البكاء على الأطلال الذريعة التي تتيح له تسديد أكثر من هدف في مرمى الإسهام الثقافي العربي في الحضارة العباسية.
فهو لا يكتفي بالنقد اللاذع والمشوب بالازدراء لأولئك الذين يقفون على أطلال الماضي
قل لمن يبكي على رسمٍ درسْ
واقفاً، ما ضرّ لو كان جلسْ
بل يصر على تسمية العرب بالأعراب، وينهى محدّثه عن التمثّل بهم في أي صفة أو مقام
ولا تأخذ عن الأعراب لهواً
ولا عيشاً، فعيشهمُ جديبُ
غير أن كل ذلك كان يمكن أن يوضع في خانة الصراع بين القديم والجديد داخل النسيج الثقافي لذلك العصر، لكن المسألة تعدت ذلك، لتتحول إلى موقف إثني عدائي من كل ما يمت إلى العرب بصلة. وهو ما يبدو جلياً في أبياتٍ من مثل:
عاج الشقي على رسمٍ يسائلهُ
وعجتُ أسأل عن خمارة البلدِ
يبكي على طلل الماضين من أسدٍ
لا درّ درّك قل لي مَن بنو أسد
ومَن تميمٌ ومن قيسٌ ولفّهما
ليس الأعاريب عند الله من أحدِ
يحق لأبي نواس بالطبع أن يدحض فكرة انفصال الشعراء عن واقعهم المعيش، وتحويل الشعر إلى نموذج نمطي يأخذه اللاحقون عن السابقين، كما لو أنه طوطم ينبغي تقديسه أو مثالٌ أوحد يستوجب النسج على منواله. ويحق له أن يحتج على الكثير من الشعراء المفصومين الذين عاشوا في كنف الانفجار العمراني والثقافي والاجتماعي الذي شهدته بغداد وغيرها من الحواضر المماثلة، فيما كان شعرهم يستعيد تجارب وموضوعات متصلة بعالم الصحراء والبداوة والترحل، ولا تمت لحياتهم الفعلية بأي صلة تذكر.
ولعل القيمة الأهم التي جسدها الشاعر بامتياز لا تتمثل في اختيار الخمرة كموضوع أثير للكتابة، حيث الموضوعات متروكة على الطرقات كما يشير الجاحظ، بل في تعبيره الجريء عن قيم العصر والروح المدينية، وفي صدور الشعر عن أعمق ما في الذات البشرية من نوازع وهواجس وتمزقات. إضافة بالطبع إلى لغته الطازجة وصوره المبتكرة وفتوحاته التخييلية الصادمة.
ولكن ما لا يحق للشاعر هو الدحض الكامل لموضوعة الوقوف على الأطلال، باعتبار أن الشعر في صميمه هو محاولة مضنية لاسترداد ما يتعذر استرداده على أرض الواقع. فالحنين إلى الماضي الذي تصرم عهده، هو الينبوع الذي لم يكف عن رفد الشعراء والفنانين من مختلف العصور والأمصار بأفضل ما قدموه من أعمال. وهو يتجاوز في عمقه مسألتي التجديد والتقليد، أو الحداثة والقِدم، ليغدو تصنيف الأعمال والنصوص، وبصرف النظر عن الموضوع المتناول، مرتبطاً باللغة والرؤية والمقاربة الأسلوبية.
إن النقاد العرب، على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم النقدية، لم يُخرجوا أبا تمام من خانة التجديد بسبب حنينه إلى البيوت التي سكنها في يفاعته، وهو القائل:
كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى
وحنينه أبداً لأول منزلِ
كما أن المتنبي الذي وصل بالشعرية العربية إلى ذروتها الأخيرة، لم تنتقص من دوره التجديدي أبيات من مثل:
لك يا منازل في القلوب منازلُ
أقفرتِ أنتِ وهنّ بعدُ أواهلُ
أو مثل:
بليتُ بِلى الأطلال إن لم أقف بها
وقوف شحيحٍ ضاع في التّرْب خاتمهْ
ولا يضير البحتري بشيء وقوفه المشوب بالأسى أمام ما تبقى من إيوان كسرى ومعالمه الهندسية الباذخة. لا بل إن الشاعر في سينيته، يقدم من خلال ما تعقبه من تفاصيل الزخارف والمنمنمات والنقوش، أحد أكثر النماذج الشعرية القديمة اقتراباً من تعريفات الحداثة ومفاهيمها. وهو إذ يكاد يجهش بالدموع إزاء ذلك الجمال المتداعي، فليس لأن ما يراه هو حطام منزله العائلي أو مسرح صباه القديم، بل لأنه يجسد المآل المأساوي للحضارة الإنسانية برمتها.
والأهم من كل ذلك أن البحتري يتجاوز إزاء البعد المأساوي للمشهد، كل اعتبار إثني وشعوبي، فيصف تلك الطلول بالقول:
عمَرَتْ للسرور دهراً فصارت
للتعزي رباعهمْ والتأسي
ذاك عندي، وليست الدار داري
باقترابٍ منها، ولا الجنسُ جنسي
ثمّ أو لم يقف أبو نواس نفسه، بعد أن أدركته الكهولة، على أطلال حياته الماجنة وقوف أبي العتاهية أمام خراب المصائر؟ أوَلسنا، نحن المعاصرين، وقد فتك بناء وباء «كورونا» على حين غرة، ودفعنا ذاهلين إلى زوايا بيوتنا، نقف على أطلال حضارتنا المادية الخاوية، الوقفة ذاتها التي وقفها امرؤ القيس أمام أطلال ماضيه، والبحتري إزاء الإيوان المهدم، وإرميا إزاء أنقاض أورشليم، وابن الرومي إزاء خراب البصرة؟
دفاع متأخر عن شعرية الوقوف على الأطلال
هل خلط أبو نواس لأسباب سياسية بين التقليد النمطي ومكابدات الفقدان؟

تمثال أبي نواس في بغداد

دفاع متأخر عن شعرية الوقوف على الأطلال

تمثال أبي نواس في بغداد
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة