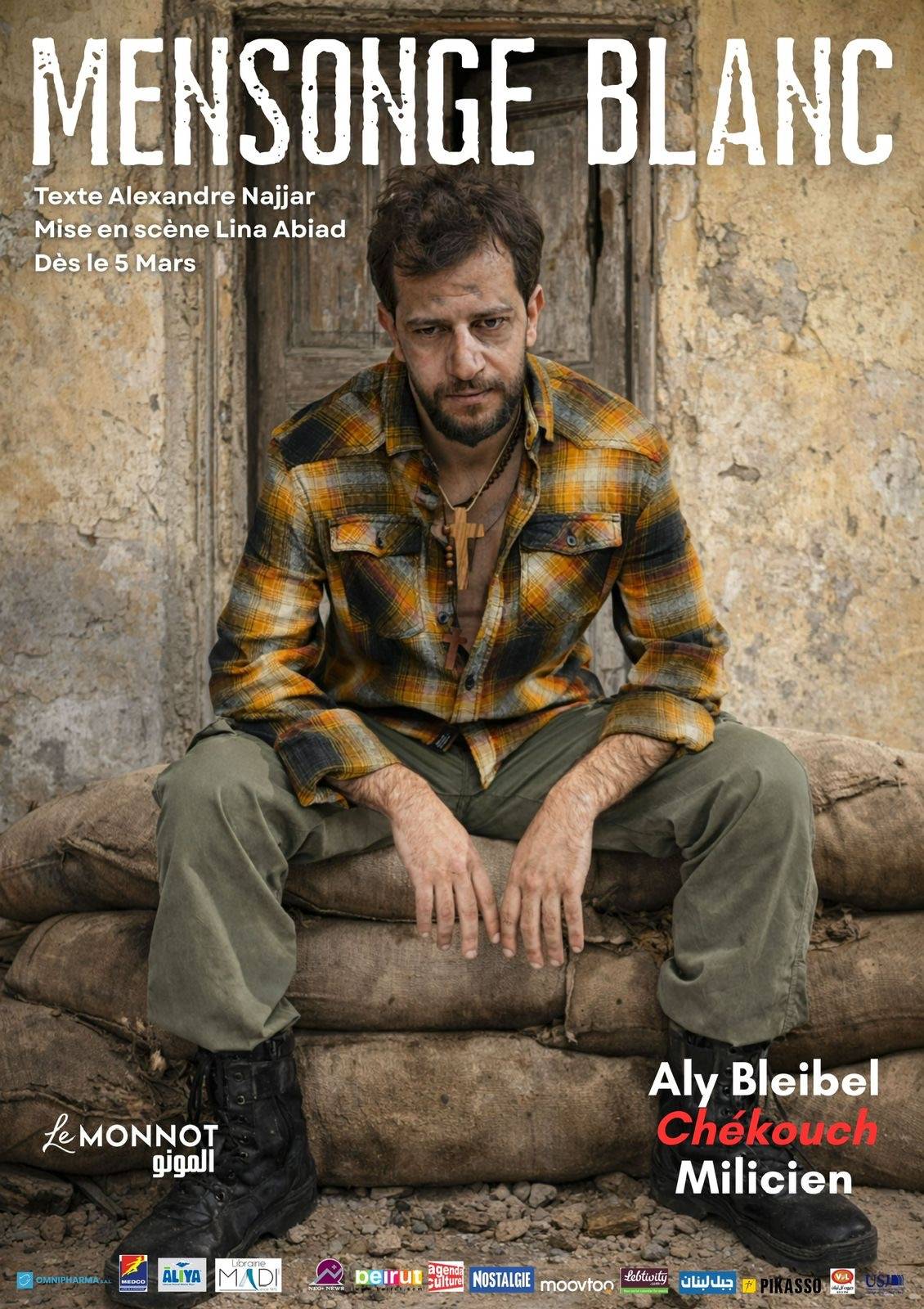بمجرد أن صُنف ڤيروس كورونا بمستوى الجائحة، بدأ القراء حول العالم يستعيدون الأفلام والروايات الديستوبية والأبوكلبتية التي تستشرف نهاية العالم من خلال الحروب النووية وأوبئة الدمار الشامل، كما صاروا يبحثون عما يُعرف بأدب الأوبئة، فيستعيدون عناوين «الطاعون» لألبير كامو، و«العمى» لخوزيه ساراماغو، و«رَنِمِزِيسْ» رَبَّة الانتقام، لفيليب روث، وغيرها من الروايات والقصائد التي تحمل عناوين الوباء حتى وإن كانت مضامينها خالية منه. أما لجوؤهم إلى تلك المنتجات الأدبية فلم تكن بطبيعة الحال بحثاً عن علاج. إذ لا تحتوي أي رواية عن لقاح أو مصل ضد أي نوع من أنواع المرض، ولكن رغبة في الاستئناس بأناس تلك الروايات والتعرّف على أقدارهم. وتصريف فائض الخوف والانفعال الذي يسكنهم، بمعنى إعادة تشييد المشهد الحياتي عبر «بينصية» مُلحة تفسر واقع الخوف الآني من خلال فحوى النص الأدبي والعكس، أي فهم النص الأدبي على إيقاع رعب الواقع الموبوء.
هكذا أعاد كورونا إلى الواجهة قراءة فن كتابة الخيال العلمي بالقوة ذاتها التي دفع بها للارتداد إلى مطالعة كلاسيكيات أدب الأوبئة، فرواية «الرجل الأخير» للروائية ماري شيللي، المكتوبة عام 1826 تتحدث عن وباء يجتاح العالم اليوم، وعن بشر يقاومونه بكل الطرق من أجل البقاء، وذلك من خلال بطل يصارع لإبقاء عائلته خارج الخطر، إلى أن يفنى الجميع ولا يبقى إلا هو بصفته الناجي الوحيد. وهذا خيال روائي استشرافي يقف أمامه إنسان اللحظة الكورونية باندهاش، حيث يجد له مكاناً شعورياً في سياق الرواية، تماماً كما يستعيد غابريل غارثيا ماركيز قيمة ومعنى الحُبّ، من خلال الحيلة التي يدبرها فلورينتينو أريثا بطل رواية «الحب في زمن الكوليرا» بإيهام السلطات بأن السفينة التي تعبر النهر موبوءة بالكوليرا، ليتخلص من المسافرين ويختلي بحبيبته السبعينية فيرمينا، وذلك لخلق فضاء حجر صحي عاطفي يتمثل في رفع العلم الأصفر، إشارة إلى وباء الكوليرا، وبذلك يضمن للسفينة حرية الحركة. وهذه لقطة أدبية مؤانسة في هذا المفصل الحياتي المعتم.
الڤيروس المتخيل في رواية «عيون الظلام» الصادرة مطلع الثمانينات من القرن الماضي للروائي الأميركي دين كونتز، صار ڤيروساً واقعياً مطلع العام الحالي، خصوصاً أن مدينة ووهان الصينية التي تفشى فيها الوباء تتطابق مع المدينة المتخيلة في الطبعات الجديدة من الرواية «ووهان 400». وهو المخيال ذاته الذي اعتمده ستيفن كينغ في روايته «نهاية العالم» الصادرة نهاية السبعينات. حتى ما شُوهد في صالات السينما كفيلم «عدوى» (Contagion) صار يشاهد على الشاشات كأمر واقع، بكل ما فيه من مخاطر التماس الجسدي بين البشر، وإجراءات العزل الصحي، وإغلاق المطارات، وتعطيل دور العبادة، ورعب مواجهة وحشية الڤيروس الخفي بشكل فردي أوجماعي، كأن الفيلم يسجل واقعة كورونا بشكل تفصيلي، الأمر الذي يعزز لدى القراء نظرية المؤامرة، المستمدة هذه المرة من فكرة الحرب البيولوجية، وذلك بسبب تطابق سيرورة الوباء مع الخيال الأدبي، كما يلمّح إلى أن أدب ما بعد كورونا قد كُتب قبل الحدث، في الوقت الذي يدفعهم فيه إلى الارتداد مرة أخرى لوساعات ومخيال الأدب المحض.
هذه هي الصورة المحدثة أدبياً للموت الأسود (الطاعون) الذي تكلم عنه جيوفاني بوكاتشيو في «الديكاميرون». وهو ذاته الموت الأحمر، الذي تحدث عنه إدغار آلن بو في «قناع الموت الأحمر». فالموت الوبائي مهما كان لونه المجازي هو موت واقعي. ولأن كورونا ليس حدثاً أدبياً بقدر ما هو لقطة قيامية متشظية، سرعان ما يرتد الإنسان المعولم قارئاً ومشاهداً، إلى شاشات الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي ليكون شاهداً على قضية كبرى من القضايا المعولمة، وما يترتب عليها من اهتزاز للتاريخ، من دون أن يغفل عن أدبية البعد الرمزي لهذه الجائحة، فهذه ليست جريمة معلومة الملامح كظاهرة الإرهاب مثلاً، بل هي مواجهة مع عدو شبحي يندس في كل أرجاء العالم، وله من طاقة الدمار ما يصعب الإلمام به، أو التنبؤ بمدياته.
هذا الدمار الذي يكاد يشل مفاصل العالم يتجاوز رمزية سقوط البرجين في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، ولذلك يبدو الخراب الشامل الذي أحدثه كورونا في الاقتصاد والسياسة ومفهوم حقوق الإنسان يصعب تصوره مروياً في عمل أدبي، سواء كان واقعياً أو متخيلاً، لأن فيه من الرعب ما لا يمكن لأدب الخيال العلمي والديستوبيا أن يستوعبه. وعليه فإن العودة إلى مطالعة أدب الأوبئة بأشكاله الواقعية والغرائبية، إنما يعني البحث عن صورة مقربة لجائحة مزلزلة تحدث في لحظة زمنية معقدة ومتشابكة، مع غياب أي أفق للسيطرة على ڤيروس كورونا الميت والمُميت في آن، الذي يعي تماماً نقاط ضعف الإنسان وهشاشة نظام القرية الكونية، كأنه هو مؤلف رواية الرعب هذه، والممسك بحبكتها، فهو كمؤلف كالإله الخفي الذي قال به لوسيان غولدمان، حيث يتحكم في كل مفاصل الرواية وأقدار أبطالها من دون أن يراه أحد.
ولأن اللحظة اليوم هي لحظة الصورة، يتغذى حدث كورونا كواقعة على البصري أكثر مما يتغذى على السرد الروائي، إلى جانب استحواذه كمروية على السرد ذاته ومتعلقاته من الوصف والخيال، لدرجة أن سيولة الصور تموضعه في موقع الخيال. فصورة الحرم المكي خالياً من المصلين تشكل جزءاً مرعباً من مروية الڤيروس. وهي صورة لن تغادر الذاكرة البشرية، وستبقى راسخة بعمق في الأذهان، مثلها مثل صور ميدان سكوير تايم وغيره من ميادين العواصم العالمية الفارغة، وصور توابيت ضحايا كورونا، وصور شاشات أسواق المال المطلية بالأحمر، وصور المطارات الخالية من المسافرين، وصور البشر الملثمين بأقنعة الوقاية في كل مكان، وصور الملاعب الرياضية ومدرجاتها الخاوية. وهي صور تعيد إلى الذاكرة البشرية مشاهد انفجار مفاعل تشرنوبل، وانهيار برجي التجارة في نيويوك، وتسونامي المحيط الهندي.
تخزين الصور في وجدان البشرية بقدر ما يعطيها سمات السرد والخيال، بقدر ما يبتذلها. وكلما تكاثرت الصور امتصت الحدث، وإن أعادت التذكير بأن ما عُرض سينمائياً أو روائياً، ليس سوى افتراضات مقابل مرجعية هذه النازلة. وبذلك تتضاءل قيمة كل سيناريوهات الخيال العلمي المؤفلمة قبالة هذا الوباء الذي يبدو حدثاً استعراضياً، حيث يتوازى عنفه الواقعي مع عنفه الرمزي. فهو ليس حدثاً موضعياً كبكتيريا «أنثراكس» المعروفة باسم الجمرة الخبيثة، التي اتهمت فيها القاعدة بمحاولة النيل من المؤسسة الأمريكية. وعلى الرغم من الهلع الذي أصاب العالم بعد أن صمم وأطلق قرصان إنترنت فلبيني ڤيروس إلكتروني باسم «I love you»، فإن ذلك الإرهاب الإلكتروني لم يحدث هذه الهزة العميقة في وعي ونفسية وأخلاقيات البشر. وربما هذا هو ما يفسر الكيفية التي تحولت بها السرديات الإعلامية إلى جزء من حفلة الرعب الكوروني، لتمكين الخيال بشقيه العلمي والأدبي من استيعاب واقعية هذه القيامة التي تتشظى بوحشية وبطء.
- كاتب سعودي
«كورونا»... سيناريوهات الخيال العلمي والأدبي
حدث يتغذى على البصري أكثر مما يتغذى على السرد الروائي

مشهد من فيلم «عدوى» للمخرج ستيفن سودربرغ

«كورونا»... سيناريوهات الخيال العلمي والأدبي

مشهد من فيلم «عدوى» للمخرج ستيفن سودربرغ
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة