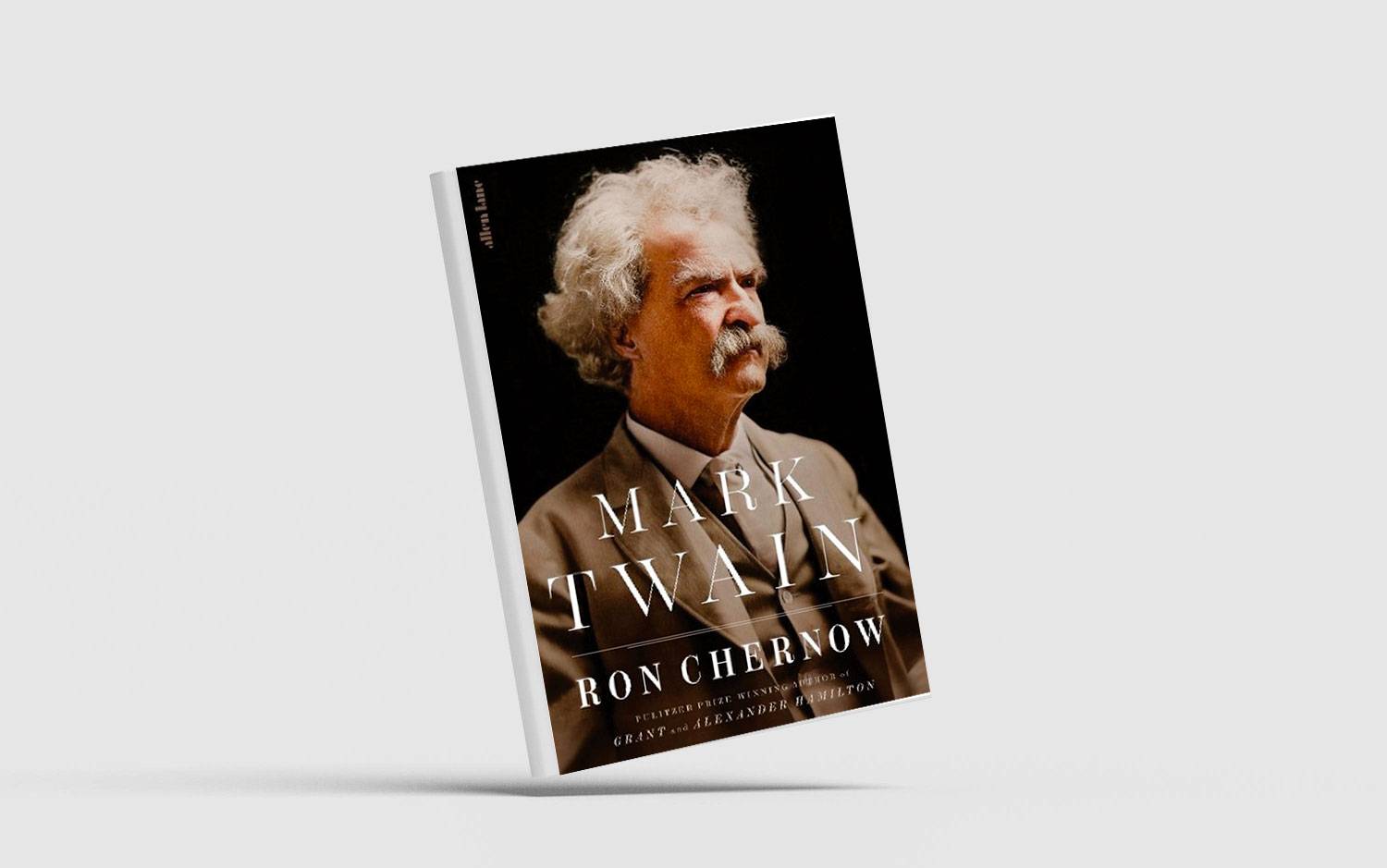ليس هنالك نقص اليوم في أعداد النسويات الناشطات اللواتي يقدن نضالاً على جبهات متعددة عبر العالم لتحسين أوضاع النساء. وتُطرح مسائل المساواة الجندرية كإحدى القضايا الأساسية للنقاش العام - أقله في الثقافة الغربية - سواء فيما يتعلق بالحقوق السياسية والاجتماعية أو الأجور، أو نسب التمثيل في المؤسسات العامة وشركات الأعمال. وقد حققت كثير من المجتمعات بالفعل تراكمات من الإنجازات في هذا الاتجاه تستحق التنويه، وأصبحت ثيمات العدالة الجندرية جزءاً لا يتجزأ من عدة العمل والدعاية التي يوظفها السياسيون ومصالح الأعمال الكبرى لكسب رضا جمهورهم - النسوي، كما فئات من الذكور ذوي الحساسية الثقافية تجاه قضايا النساء. ومع ذلك كله، فإن ثمة نوعاً من إحساس جماعي غالب لدى النساء بأن العالم لم يتغير مع ذلك كثيراً، وأنه برغم كل ما تحقق من مكاسب مشهودة، فإن شعور اغتراب النساء تجاه تجربة العيش في المجتمع المعاصر ما زال سيد الموقف وديدن الأيام، مما يدفع للتشكك أحياناً بأن النضالات النسوية كانت مضيعة للوقت، وانحرافاً عن لب المواجهة في البحث عن غد البشرية الأفضل، وحروباً (دونكيشوتية) شنت على طواحين هواء!
كارولاين كريادو - بيريز (35 عاماً)، النسوية البريطانية الشابة تجرأت وحيدة على إلقاء حجر في بركة الركود هذه، بعدما نشرت عام 2019 كتابها (القنبلة) عن «النساء غير مرئيات: الكشف عن انحياز المعلومات في عالم مصمم للرجال»، الذي تسبب بصدمة إيجابية في العالم الأنجلوفوني، دفعت حكومات كثيرة وشركات كبرى للتواصل مع المؤلفة واستشارتها بشأن تعديل منهجياتها في جمع المعلومات لضمان تجارب عيش أفضل للنساء، سواء في إطار التشريع وتنفيذ السياسات الحكومية أو تصميم الحلول الاستهلاكية للمجموعة التي تشكل أكثر قليلاً من نصف مجموع البشر. وليس سراً الآن أن نيكولا ستورجين، الوزيرة الأولى في إقليم اسكوتلندا البريطاني، شكلت فور اطلاعها على مضمون الكتاب مجموعة عمل رسمية للنظر في طرائق لإزالة الانحياز الجندري من المعلومات التي تستند إليها حكومة أدنبره لدى اتخاذ القرارات.
جمعت كريادو - بيريز في كتابها الذي حاز على عدة جوائز مرموقة مجموعة حقائق وإحصائيات مثيرة للدهشة مُستقاة من مئات الدراسات العلمية لتثبت نظريتها في كون العالم المادي الذي أنتجته الحضارة الغربية وتعيش معظم البشرية على ضفافه اليوم مُصمماً في تفاصيله العملية حول الرجل (الأبيض الغربي حصراً)، فكأن النساء مخلوقات خفية وغير مرئية، وليست من النوع الإنساني: سواء تحدثنا عن الصيغة المعتمدة لتصميم إجراءات السلامة في السيارات، أو سياسات التعامل مع النوبات القلبية، أو حجم أجهزة الهاتف الذكية المحمولة باليد، إلى هندسة الطرق وبيئة المباني (كدرجة الحرارة وعدد دورات المياه في الأماكن العامة) ومئات التفاصيل غيرها، فكل المواصفات والمقاييس والتصاميم تبدو مبنية بشكل شبه كلي على معلومات جمعت عن الذكور (الغربيين غالباً)، وتشيح النظر عن حقيقة اختلاف حاجات النساء المادية، والسيكولوجية، والفيزيائية، عن رفاقهن الرجال، مما يجعلهن عرضة للأخطار وللتجارب اليومية المزعجة، والحاجة لبذل جهد إضافي في إنجاز المهمات المختلفة شخصية كانت أو تتعلق بممارسة المهن على تنوعها. ومع أن المؤلفة تورد في سياق أمثلتها بعض المسائل المسلم بها كحقائق، مثل وجود فجوة في الدخول بين النساء والرجال مقابل أداء العمل ذاته، أو أنهن يعملن لسبع ساعات إضافية بالأسبوع في الأعمال المنزلية مقارنة بالرجال، وأن ثلثي النساء يتملكهن الرعب في مواقف السيارات متعددة الطوابق، أو أنهن الغالبية العظمى من ضحايا العنف المنزلي، أو أن واحدة من كل ثلاث نساء في العالم لا يتمتعن بحق الوصول إلى دورات مياه آمنة تتوفر فيها الخصوصية (فإنها تورد عشرات المسائل التفصيلية الأخرى غير المألوفة أيضاً) مثلاً درجة حرارة المباني العامة وأماكن العمل وفق التصاميم الحديثة أقل بخمس درجات، مما تحتاج إليه النساء للشعور بالراحة، أو أن مواصفات الأبواب الزجاجية تناسب قوة أيدي الرجال لا أيديهن، أو أن مواقع مخارج الكهرباء على الجدران عادة ما توضع منخفضة متناسبة مع الرجال بينما تشكل حرجاً لهن، أو أن معدل كمية الإضاءة في الشوارع ومواقف السيارات أقل من المستوى المطلوب لإشعارهن بالأمان النسبي، أو أن صفوف انتظارهن لاستعمال المرافق الصحية العامة أطول بما لا يقاس بصفوف انتظار الرجال إن وجدت. ومن مجموع هذي التفاصيل كلها سواء مألوفة أو غير مألوفة تبدو مرافعة كريادو - بيريز صورة مكتملة الأركان، ولا يمكن المجادلة بشأنها. فنحن بالفعل نعيش في عالم وكأنه مشغول حول الرجل (الأبيض)، بينما تضمحل من الصورة النساء (والأعراق الملونة والفقراء وذوو الحاجات الخاصة).
ومع أن الصيغة التي قدمت فيها المؤلفة مرافعتها في «النساء غير مرئيات» تبدو من الخارج معنية أساساً بعيوب انحياز إحصائية، فإنها في الحقيقة تمنحنا أدوات ثمينة للبحث في الجذور الثقافية والتاريخية للانحياز الجندري في المجتمعات الغربية (المهيمنة بالطبع على ثقافة العالم المعاصر)، لا سيما أن معظم النساء يشتركن دون وعي منهن في قبول معطيات تلك الانحيازات، وربما إعادة إنتاجها. فمن الواضح بأن كسر اغتراب النساء خلال تجربة عيشهن اليومي لن يتحقق بمجرد تعديل تلك الأخطاء في استحضار المعلومات وفرض «الكوتات» النسوية وغيرها من الإجراءات الشكلية، بل يتطلب قبل ذلك تغييراً منهجياً لناحية طريقة التفكير والنظرة إلى الإنسان والسلوك تجاه رفاه البشر، وهي قضية قد تحتاج إلى دعم فوقي من السلطات، وتنوير للذكور بخطورة أبعادها على رفيقاتهن (لماذا يصوت نائب بريطاني شاب مثلاً ضد مشروع قرار مخصص لتوفير أجواء عمل أكثر راحة للنساء)، لكنها ذات الوقت تتطلب من النساء أنفسهن أن يقدن في مواقعهن معارك التغيير. بما خص تصميم المباني والتخطيط الحضري، هنالك مثلاً عدد هائل من المعماريات والمهندسات اللواتي يمارسن المهنة لكنهن في النهاية يلتزمن بالمقاييس والمواصفات المصممة للذكور، وفي مواقع القرار داخل الحكومات والشركات أعداد متزايدة من القائدات النساء اللواتي يحققن نتائج ممتازة لمؤسساتهن، لكنها نتائج غير متوازنة بحق النساء.
النشاط النسوي الفاعل للشابة كريادو - بيريز لم يبدأ من هذا الكتاب تحديداً. فهي اشتهرت في الفضاء البريطاني العام بعدما خاضت مواجهة كادت تصل للقضاء مع بنك إنجلترا المركزي، إثر حملة كسبت تضامناً شعبياً واسعاً، للمطالبة بوضع رسم لشخصية نسوية عامة على ورقة العشر جنيهات إسترلينية، ولاحقاً قادت الحملة لإضافة تمثال لواحدة من المناضلات لأجل منح حق التصويت للنساء كأول شخصية أنثى تنضم إلى تلك السلسلة الطويلة من تماثيل الشخصيات البريطانية المهمة التي تزين جدار باحة مقر البرلمان البريطاني في ويسمنستر، وهي اليوم تُعدّ من أهم الوجوه النسوية البريطانية التي يُستعان بها لإلقاء المحاضرات، وتقديم الاستشارات بشأن الانحيازات الجندرية، فيما أعد ناشرها طبعة شعبية من كتابها احتفاء بعيد المرأة العالمي، 8 مارس (آذار) الحالي.
ربما كريادو - بيريز ليست نسوية ثورية بما يكفي بالنسبة للمثقفين واليساريين وأنصار التحولات الجذرية، وربما هي لا تقدم إجابات جاهزة ووصفات عمل محددة لكسر اغتراب النساء عن عالمهن المعاصر. لكن هذه الشابة الشجاعة نجحت وخلال سنوات جد قليلة في تحقيق خطوات إيجابية عملية لتعديل كفة الميزان لمصلحة النساء في مساحات عجزت أطنان من الكتب والمقالات والثرثرات عن تحقيقها عبر العقود، وهي بالتأكيد أشعلت بذرة وعي مستجد في أذهان كثيرين حول قصر نظر معتق حكم نظرة البشر لعالمهم. لقد صححت كريادو - بيريز من طريقة الرؤية كي تكون مسيرة البشر في تغيير عالمهم إلى الأفضل أكثر رفقاً بنصفهم، حتى لو كان ذلك مجرد تعديل تفاصيل صغيرة مزعجة ستتراكم كماً لتخلق في وقت ما تغييراً نوعياً.
نساء غير مرئيات في عالم صمم من أجل الرجال
كارولاين كريادو تلقي حجراً في بركة الركود

مظاهرة نسائية في لندن 2019

نساء غير مرئيات في عالم صمم من أجل الرجال

مظاهرة نسائية في لندن 2019
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة