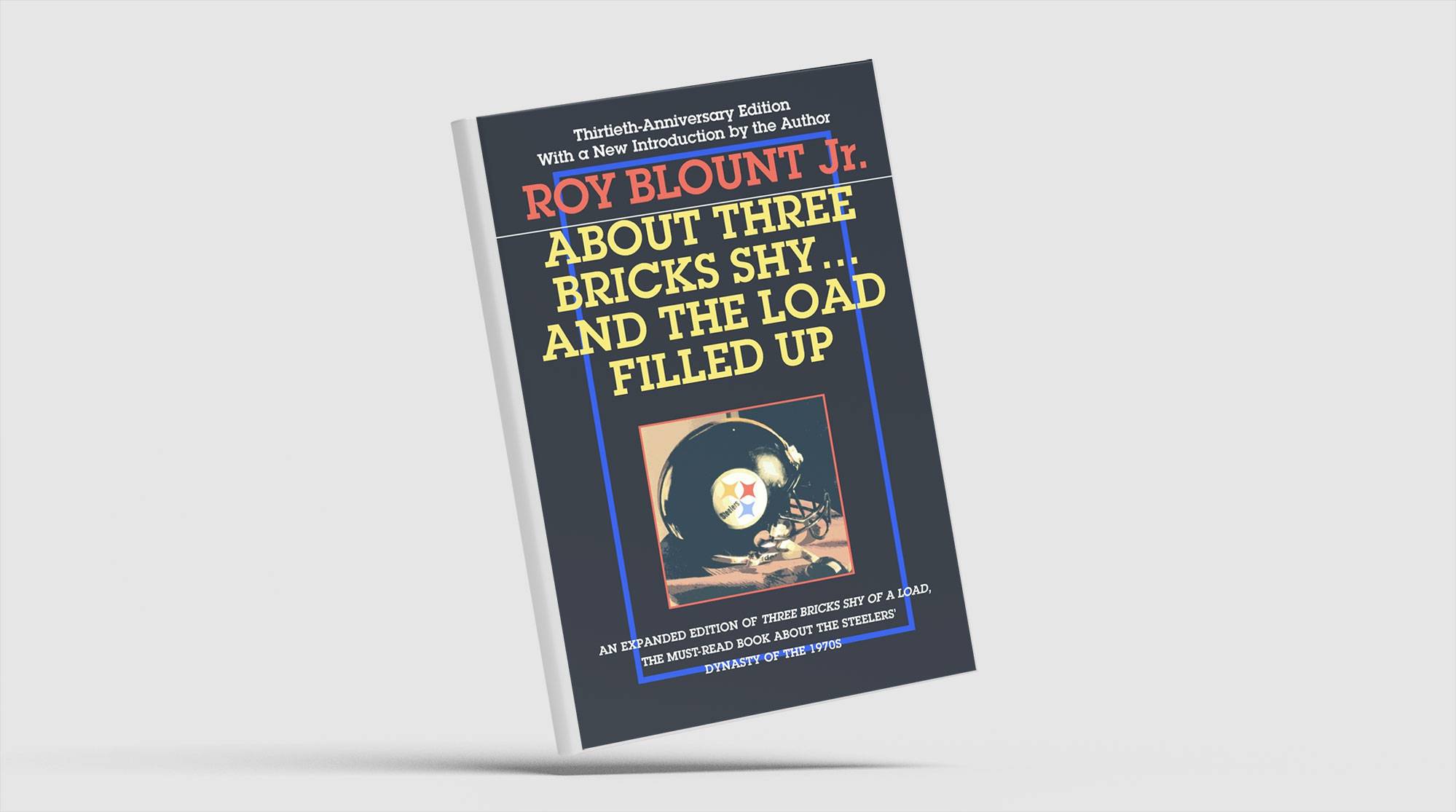في 398 صفحة من الحجم الكبير، يروي الصحافي الجزائري فريد عليلات «القصة السرية» للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. والكتاب الصادر عن منشورات دار «روشيه» ليس الأول، ولن يكون الأخير، الذي يُكرّس للرئيس الجزائري المتنحي عن السلطة، العام الماضي، بعد أن حاول التربع على عرش الجزائر لولاية خامسة. إلا أن ما يتميز به الكتاب أنه لا يكتفي بالتحليل والاعتبارات السياسية والاستراتيجية، بل يأتي بقصص صغيرة ولكنها مهمة، وأغلبها يُسرَد للمرة الأولى. ومنها على سبيل المثال قصة هجرة والد عبد العزيز بوتفليقة من قريته الفقيرة غرب الجزائر إلى مدينة وجدة المغربية القريبة من الحدود المشتركة، وولادة الأخير فيها من زوجة والدته الثانية، يوم 2 مارس (آذار)، عام 1937. إضافة إلى ذلك، يسرد الكتاب معاناة الصبي من قصر قامته وضعف تكوينه، وصيت والده الذي أطلق عليه أبناء وجدة والجزائريون اللاجئون إليها لقب «المخبر». لكن عبد العزيز عوض عن ذلك كله بالتفوق في الدراسة وإتقان العربية والفرنسية، وتمكّنه من الكتابة. وهذه الميزات دفعته إلى أن يقدم طلباً، وهو في الـ19 من عمره، للانضمام إلى الشرطة البلدية، في مدينة وجدة. لكن طلبه رُفِض بسبب «قصر قامته»، إذ كانت تنقصه ثلاثة سنتيمترات ليقبل في صفوفها، وذلك رغم «الوساطات» التي قام بها والده. لكن هذه السنتيمترات لم تمنع عبد العزيز من أن يصبح رئيساً للجزائر، وأن يقول يوماً: «لن أترك الرئاسة إلا للانتقال من القصر إلى القبر».
عندما اندلعت الثورة الجزائرية في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1954، لم يكن بوتفليقة من أوائل الملتحقين بها. فوالده الذي كان على صلة قوية بالسلطة المغربية وبفرنسا عارض ذلك بشدة. إلا أن الشاب الطموح قرر بعد سبعة أشهر أن يخطو هذه الخطوة، وأن يتقدم بطلب انتساب إلى مكتب التجنيد في وجدة، برفقة صديقه وأخيه بالرضاعة مصطفى بري.
وفي مكتب التطويع، سأله المسؤول: «هل أنت هنا من أجل غسل شرف والدك؟»، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة لوالده بالتجسس على الجزائريين في وجدة. والنتيجة أنّ طلب الشاب عبد العزيز بالانتساب إلى «جيش التحرير الوطني» رُفِض. كذلك طلب صديقه. ولم يتغير وضع بوتفليقة إلا بعد تدخُّل شخصية مغربية نافذة لصالحه. وفي بداية عام 1957، ها هو عضو في «الجيش» في «الولاية الخامسة»، حيث اختار «عبد القادر» اسماً حركياً له. وفي هذه المرحلة، تعرف الشاب «عبد القادر» على هواري بومدين الذي سيكون له بالغ الأثر في حياته وصعوده السياسي وسقوطه بعد موت الرئيس الأسبق، ورحيله إلى سويسرا. ففي سن الـ21، أصبح بوتفليقة، الذي رُقّي إلى رتبة ضابط، السكرتير الشخصي لبومدين، إلا أن هذه المرحلة من عمره لطختها مهمة أُسندت إليه للتحري عن عملية اغتصاب قام بها أحد القادة الميدانيين. وجاء تقرير بوتفليقة مكبلاً لذلك القائد الذي أُعدم داخل الجزائر برصاصة في الرأس، بعد «محاكمة ثورية» رأسها الكولونيل بومدين شخصياً.
يصعب استعادة جميع القصص التي يتضمنها الكتاب؛ فهي كثيرة. لكن أهميتها أنها تلقي الضوء على بعض ما عرفه بوتفليقة، الذي عاش حياة ممتلئة، مناضلاً ووزيراً أو رئيساً. ومن مناطق الظل في سيرته وفاة والده في الستين من عمره، في رحلة بالحافلة إلى داخل المغرب. يؤكد المؤلف أن بوتفليقة لم يتناول أبداً هذه الواقعة التي بقيت ظروفها سراً دفيناً.
طيلة سنوات الثورة، لم يفارق «عبد القادر» العقيد هواري بومدين. وبعد نجاحها، في عام 1963، عُيّن الأخير وزيراً للدفاع، في ظل رئاسة أحمد بن بيلا وبوتفليقة وزيراً للخارجية. إلا أن الصراع على السلطة دفع بومدين لتنظيم انقلاب أطاح ببن بيلا. وفي تلك الليلة، كان بوتفليقة إلى جانب «الرجل القوي» الذي أرسل أول رئيس للجمهورية الجزائرية إلى السجن مدى الحياة.
ويؤكد المؤلف أن بن بيلا كان في البداية مدافعاً عن وزير الخارجية الشاب الذي كانت تنصبّ عليه الانتقادات لصغر سنه ولأدائه ولـ«غيابه» المتكرر لأيام وأسابيع عن وظيفته. إلا أن نظرته إليه تغيرت، وبعد عام واحد على شغله وزارة الخارجية، سعى الرئيس إلى إبعاده. ونقل عن بن بيلا أنه قال يوماً إن بوتفليقة «لا يفعل إلا ما يدور في رأسه». وفي زيارة رسمية إلى موسكو، مايو (أيار) 1964، جادل بوتفليقة طويلاً لدى كتابة البيان الختامي، ما دفع المفاوض الروسي إلى الاتصال بـنيكيتا خروتشيف ليخبره بالعقبات التي يواجهها. فما كان من الأخير إلا أن أيقظ بن بيلا في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، حتى يضغط على وزير خارجيته، ليرى البيان النور.
ويروي الكتاب أن بن بيلا منع بومدين من الدخول إلى اجتماع في القاهرة، على هامش القمة العربية، نظمه الرئيس عبد الناصر، للتقريب بين المغرب والجزائر، وبحضور الحسن الثاني وأنور السادات. وقال بن بيلا لبومدين: «هذه شقتي وليس لك أن تدخل إليها»، الأمر الذي يدل على الصراع على الصلاحيات وعلى العلاقات المتوترة بين قائدين رئيسيين للثورة الجزائرية.
في حياة بوتفليقة الدبلوماسية، يلوح ضوآن: الأول، رئاسته للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث انتخب بإجماع أعضائها، وحيث برزت مهارته الدبلوماسية، ومنها دعوة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية إلى إلقاء خطاب أمامها، فيما ظهر على جنبه الأيسر طرف جعبة مسدسه. والثاني، مهارته في التفاوض مع الإرهابي العالمي كارلوس، للإفراج عن وزراء نفط «أوبك»، الذين اختطفهم الأرجنتيني من فيينا، نهاية عام 1975، وتنقل بهم من فيينا إلى الجزائر إلى طرابلس ثم مجدداً إلى الجزائر، حيث أطلق سراحهم مقابل اللجوء السياسي والحماية.
ويروي الكاتب، الذي يؤكد أن العملية تمت بطلب من العقيد القذافي، تفاصيل المحادثات في بين بوتفليقة وكارلوس في مطار الجزائر، والعلاقة التي قامت بين الرجلين، ورفض الثاني عروضاً مالية مغرية للإفراج عن عدد من الوزراء، بينهم وزيرا النفط الإيراني والسعودي. وبحسب الكتاب، فإن بوتفليقة أبلغ كارلوس أنه سيُحرم هو ورفاقه من اللجوء السياسي في حال أقدم على اغتيال أي من الوزراء. وبعد الإفراج عن الرهائن، أعطي كارلوس «فيلا» وأُمّنت له الحراسة. واستمرت علاقته ببوتفليقة الذي كان يزوره هناك، وحصل أنه تناول يوماً الغداء معه.
رغم ما يدين به بوتفليقة لبومدين، فإنه وصل إلى حد كرهه، وفق ما نقله الكاتب عن محادثة بين بوتفليقة وشريف مساعدية، أحد أركان النظام. فقد قال بوتفليقة: «بومدين هو الذي أكنّ له الكره الأكبر في العالم»، وجاء جواب الثاني: «من غير بومدين، ما كنتَ لتصبح معاون مدير ناحية».
وينقل الكاتب كلاماً عن بومدين قاله في موسكو وهو على سرير المرض: «بوتفليقة كان شاباً صغيراً وعديم الخبرة وبحاجة إلى رعاية، وكنتُ له بمثابة الأب». ويؤكد الكاتب أن أحد الأسباب لفقد الود بين الرجلين أن بومدين رفض تسميته خلفاً له، لأنه لم يقبل إدخال تعديل على الدستور ينص على انتخاب نائب رئيس للجمهورية، بحيث يعود المنصب المستحدث لبوتفليقة. ومن جانبه، فإن الأول حقد على بوتفليقة لما اعتبره مشاركة في المؤامرة الهادفة إلى منعه من الزواج من «أنيسة»، والتآمر بعدها لدفعه إلى الطلاق منها.
ويروي الكاتب أن بوتفليقة تآمر على بومدين عندما عاد الأول من موسكو بعد إقامة في المستشفى، إذ طلب وزير الخارجية من كابتن الطائرة تغيير مسارها حتى تمر فوق جزيرة كورسيكا، ما أعطاه الحجة للإبراق للرئيس جيسكار ديستان يتحدث فيها عن «الصفحة الجديدة» التي سيكتبها البلدان.
ورغم مشكلاته الصحية، قال بومدين يوماً لوزير خارجيته بعد أن تكاثرت زياراته إلى باريس: «هل أنت وزير خارجيتي أم وزير خارجية جيسكار»؟
في 27 ديسمبر (كانون الأول) 1978، أسلم بومدين الروح، ومعه فُتِحت معركة خلافته التي كان يطمح إليها بوتفليقة. وللوصول إليها، يسرد الكتاب كيف أن بوتفليقة ادعى وجود «وصية» من بومدين يعينه فيها خليفة له، وأنه جال على عدد من قادة الدولة، وبينهم خالد نزار، قائد المنطقة العسكرية الثالثة، وقال له: «بومدين عينني خليفة له، وهناك وصية مكتوبة رأيتها. أين هي؟ أريد أن أراها».
وبسبب إصرار بوتفليقة، أمر قصدي مرباح، مسؤول أحد أجهزة المخابرات بتفتيش منزل بومدين الشخصي، حيث فُتّش كل شيء من الأرائك إلى الطاولات والأسرّة والمكاتب والخزائن والمكتبات. لكن لا أثر لـ«الوصية». لكن بوتفليقة ليس وحده الساعي. وخصمه اللدود كان محمد صلاح يحياوي، الذي له أنصاره من المدنيين والعسكر. والنتيجة أن التنافس بينهما أقلق مجلس قيادة الثورة، ومنهم مجموعة من ثلاثة ضباط رئيسيين وجدوا ضالتهم في شخص وزير الدفاع، الشاذلي بن جديد، الذي رشحه المؤتمر العام لـ«جبهة التحرير الوطنية» وكان حقيقة مرشح العسكر. وبقي بن جديد رئيساً لثلاث ولايات، أي لـ12 سنة و11 شهراً ويومين. وبانتخابه، تبخر حلم بوتفليقة.
مع موت بومدين، انتهى عهد بوتفليقة الذي خسر وزارة الخارجية، ومعها كل الامتيازات التي اعتاد عليها طيلة 15 عاماً، لا، بل فُتح تحقيق بشأن حسابين شخصيين في مصرف سويسري كانت تُنقَل إليهما، بأمر من الوزير، كل الأموال التي لم تُصرَف سنوياً في السفارات عبر العالم. ولإهانته بشكل مباشر، يروي الكاتب أن بوتفليقة طلب مقابلة الرئيس الجديد. وفي مكتبه، همّ بوتفليقة بالجلوس، فنهره بن جديد بقوله: «مَن سمح لك بالجلوس؟»، ولأنه عُين مستشاراً في الرئاسة، فقد أُعطي مكتباً من غير نوافذ ومن غير مهمات، وبالتالي، يروي الكتاب أنه كان يمضي وقته في شرب الشاي والحديث بالهاتف. وبداية 1980، سُحِب منه هذا المنصب، وشعر بوتفليقة بأنه مستهدف بتحقيقات مالية، وأن أعداءه في الحزب راغبون بالتخلص منه. وقبل أن تتحول هواجسه إلى واقع، قرر بوتفليقة مغادرة الجزائر والعزلة الطوعية التي بدأها في باريس، ومتنقلاً بينها وبين جنيف، ومتحيناً الفرص للقاء مَن يقبل الالتقاء به بعد سقوطه المدوّي.
بوتفليقة أبعد من المكتب السياسي للحزب الحاكم من الحزب، وتمّت ملاحقته بتهم مالية، رغم أنه أعاد للخزانة 3 ملايين دولار. لكن الدولة بقيت تطالبه بـ14 مليون دولار. وقد صدر بحقه حكم في مايو (أيار) 1983 يرغمه على دفع مبلغ 728 ألف فرنك سويسري. وإبان المحاكمة، طلب أصدقاؤه من بوتفليقة العودة إلى الجزائر والدفاع عن نفسه، إلا أنه رفض خوفاً من اعتقاله، ولعدم ثقته بالقضاء.
ويروي الكاتب أن بوتفليقة حاول توسيط ياسر عرفات لدي بن جديد، فرفض التدخل شخصياً. وعن بن جديد، ينقل الكتاب نفيه السعي لملاحقة بوتفليقة، داعياً إلى عودته من غير خوف.
ولأن شمس باريس أو جنيف لا تُدفِئ، فقد قرر بوتفليقة الذهاب إلى دمشق عام 1983 حيث إن له صداقات مع نظام الرئيس الأسد. ولكن مَن سيجد في العاصمة السورية؟ كارلوس الذي استقر في عاصمة الأمويين بعد ترحال بين لبنان واليمن. وفي دمشق، أسكن بوتفليقة في الطابق الأرضي من فيلا مشددة الحراسة من ثلاثة طوابق تقع في حي المزة. ففي الطابق الأول، يقيم ابنا رئيس باكستان ذو الفقار علي بوتو. وفي الثالث، السكرتير الشخصي للرئيس صدام حسين... ويُفهَم من الكتاب أن كارلوس كان يقيم في الطابق الثاني. ويؤكد الكاتب أن بوتفليقة كان يتناول العشاء معه، كل مساء، وأن كارلوس أهداه مسدسه الشخصي. إلا أن إقامته في دمشق، بغض النظر عن لقائه بكارلوس والصداقة التي جمعتهما، لم تُرضِ بوتفليقة تماماً؛ إذ كان يريد المزيد. ولذا، فقد غادرها في العام نفسه عائداً إلى باريس، حيث التقى صديق صباه المغربي مصطفى بري الذي أقام عنده، وحيث كان يلتقي زائرين كباراً، مثل وسيلة، زوجة الحبيب بورقيبة، أو شخصيات من النظام الجزائري. وأمام وسيلة، شكا بوتفليقة من معاملة بن جديد له؛ أوقف راتبه التقاعدي، وجعله في وضع بائس... لكن تحقيقاً أمر به بن جديد أثبت العكس. والحقيقة، وفق الكاتب، أن بوتفليقة كان يستفيد من صداقاته الخاصة ومن علاقاته كما في سوريا، أو مع الشيخ زايد بن سلطان. وبحسب المؤلف، فإن بوتفليقة استفاد من كرم الإمارات، حيث كان يقيم في شقة فاخرة في فندق «إنتركونتينتال - أبوظبي» محجوزة له سنوياً. وعمل بوتفليقة مستشاراً للإمارات في نزاعها مع إيران حول ثلاث جزر في الخليج مقابل راتب شهري من 10 آلاف دولار، وتغطية جميع المصاريف، ولاحقاً وهبه الشيخ زايد مزرعة شاسعة.
والمدهش أن تقارير وصلت إلى رئيس الإمارات تفيد بأن بوتفليقة يغالي في الاستفادة من كرمه في الفندق، حيث يشتري الحلي والساعات والخواتم له ولأصدقائه ويرسل الفواتير إلى الديوان الأميري، ما دفعه إلى تناول الموضع مع بن جديد.
بعد ست سنوات من المنفى، نهاية عام 1987. عاد بوتفليقة إلى الجزائر بمناسبة مؤتمر علمي في العاصمة، وبعض تطمينات أُعطيت له. لكن الجزائر كانت في تلك الفترة تغلي: مظاهرات وقمع وسقوط عشرات القتلى وقرار بن جديد بإحداث إصلاحات.
وفي عام 1989، أُعيد بوتفليقة إلى اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير لتنتهي بذلك فترة إبعاده وعزلته. لكن ما كان ينتظره بوتفليقة ظهرت بوادره في 1992، عند استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، إذ سارع للقاء وزير الدفاع، الجنرال خالد نزار الذي يعيش حالياً منفياً في إسبانيا، ليطلب منه دعمه لتولي منصب سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة.
كذلك طلب منه رخصة حمل سلاح لشعوره بأنه مهدد. فسارع الأخير لتقديم مسدسه له. بالمقابل، فإن طلب السفارة رفض قطعاً من قبل خصومه. لكن الجزائر التي كانت تعاني من حرب داخلية، كانت تبحث عن شخصية تقود المرحلة الانتقالية من ثلاث سنوات وتخرجها من مأزقها. وأعتقد بوتفليقة أن ساعته قد حان أوانها بعد اتصالات أولية من فريق العسكر عبر وسطاء. وبعد الوسطاء، حان وقت لقاء كبار القادة العسكريين: خالد نزار، محمد لعماري (رئيس الأركان)، ومحمد مدين (المعروف بـتوفيق، رئيس المخابرات العسكرية)، الذين التقوه في مطعم فخم لتقديم عرضهم له.
يروي المؤلف في 17 صفحة تفاصيل المفاوضات والضغوط المتبادلة بين بوتفليقة والعسكر، الأول يريد رئاسة تمارس السلطة والعسكر يريدون تأطيرها. ولأن شروط الأول لم تُلبَّ، ولأنه ماطل وناور وتكبر، ولأن مفاوضيه من أصحاب البدلات العسكرية لم يتجاوبوا مع أوامره، فقد انتهت الأمور إلى تكليف اليامين زروال لرئاسة المرحلة الانتقالية، وإلى عودة بوتفليقة إلى جنيف بانتظار أيام أفضل.
«القصة السرية» للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
فريد عليلات يروي عنه تفاصيل مهمة أغلبها يُسرد للمرة الأولى


«القصة السرية» للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة