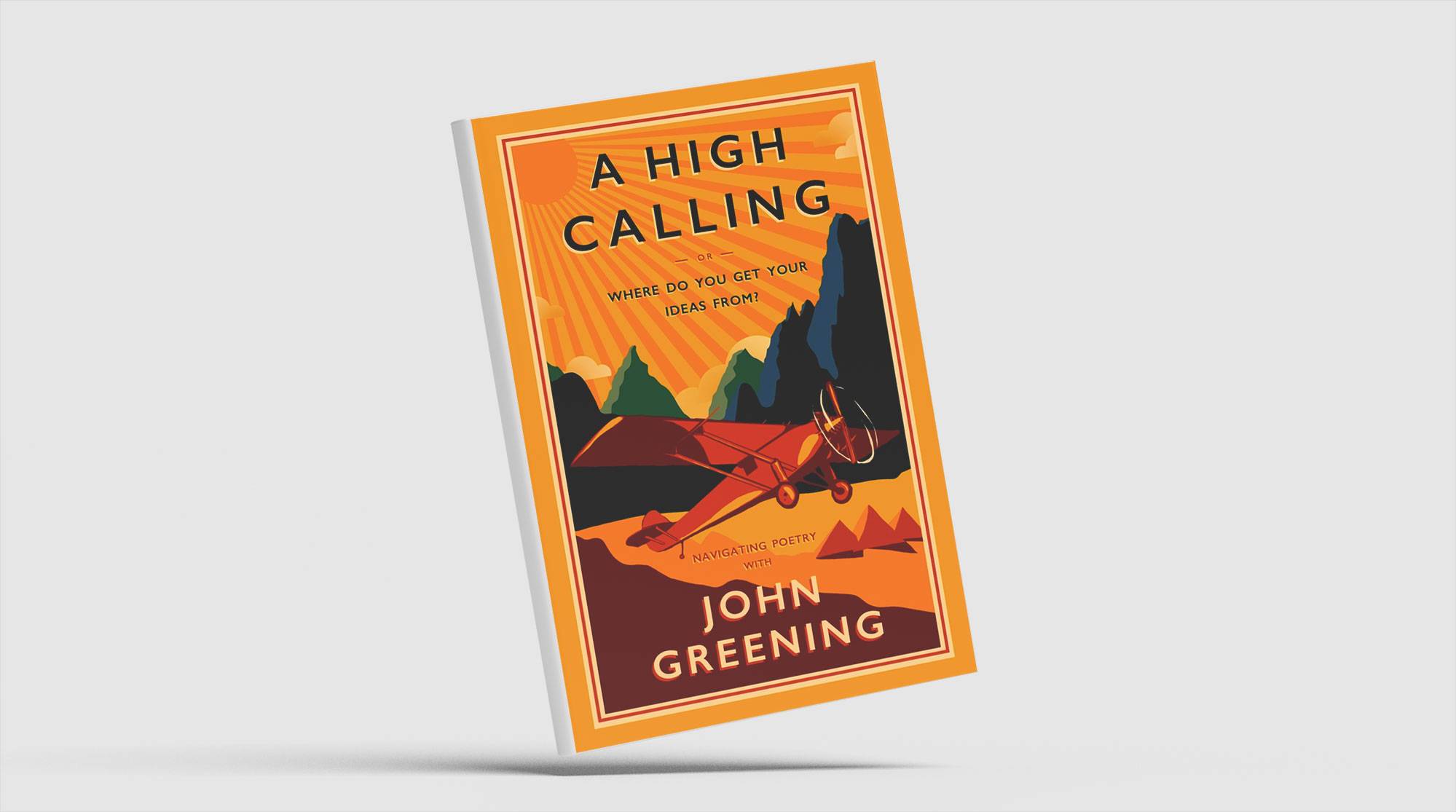تلقى بعض الكتب الأدبية السريعة عموماً والروائية تحديداً رواجاً ملحوظاً في مبيعات الكتب وتحتل موقعاً متفرداً في قوائم «البيست سيلر» (best seller) في أوروبا وأميركا. وفي الأغلب تنافس هذه الكتب سريعة الرواج تسويقياً الكتب الجادة الرصينة.
ولقد عرف القرن العشرون هذه الظاهرة فكان روائيو التكسب - كما يسميهم كولن ولسن - ينافسون الروائيين الجادين مثل ديفو ورتشاردسون وسكوت وديكنز. وقد سميت روايات المتكسبين بـ«الروايات البنسية» كمصطلح يدلل على دور التكسب في جعل رواية ما هي الأكثر مبيعاً في سوق الكتب. وقد ذهب ولسن إلى أن هذه المنافسة سرعان ما تفقد بريقها مع مرور الزمن، فلا تبقى روايات المتكسبين بينما تصمد الروايات الجادة. وكثير من أسماء الكتب الأكثر رواجاً في أوائل القرن العشرين أصبحت نسياً منسياً في غضون 50 سنة. وفي أدبنا العربي أمثلة على ذلك، فقد سادت في خمسينات وستينات القرن الماضي روايات رومانسية ميلودرامية سريعة ليوسف السباعي وإحسان عبد القدوس وعبد الحليم عبد الله ونافست الروايات الجادة لتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ.
وليس غريباً ألا ينطبق هذا التصور على جميع الكتب التي توسم بأنها الأكثر رواجاً أو «البيست سيلر»، لأنها ليست دائماً مبتذلة بلا هدف فني ولا تطلع مستقبلي، إذ قد تكون لها من السمات والتوجهات ما يجعلها فاعلة ومؤثرة في الساحة الأدبية كما حصل مع روايتي «سيد الخواتيم» و«رحلة إلى أركتورس» اللتين بسببهما احتلت الفانتازيا موقعاً مهماً في الستينات والسبعينات، حتى نافست روايات الأفكار المستندة إلى تجارب فكرية.
واللاغرابة فيما تقدم يعود إلى أن الرواية نفسها فن تعددي؛ وهي ملحمة الحياة وسجلها الذي يضم أشكالها الكثيرة، حتى أن كاتبها قد يرى نفسه أكبر من مجرد كاتب أو أديب، كما حصل مع بلزاك الذي رأى نفسه شخصاً يشبه نابليون أو آينشتاين، وهو القائل: «لقد عاش أربعة أشخاص حياة غنية: نابليون وكوفيه وأوكونيل، وأستطيع أن أكون رابعهم؛ فقد عاش الأول حياة أوروبا وازدرد الجيوش، وتزوج الثاني من الكرة الأرضية، وتجسد الثالث في شعب، أما أنا فباستطاعتي أن أحمل مجتمعاً بأكمله في ذهني»، من كتابه «رسائل إلى الخارج».
ومن ثم لا يكون هناك معيار على جدة الكاتب مثل معيار إخلاصه للحياة ومحاولته ترجمتها في شكل عمل يسميه «البيريس» (رواية كلية) التي هي برأيه أكبر أحلام العصر التي قد توازي حلم العلم الكلي والتقدم الجبري ووحدة الفكر. ولا فرق في ذلك بين أن يكون أسلوب الكاتب ريبورتاجاً صحافياً أو يكون متقنعاً ورمزياً ما دام الهدف هو تمثيل الحياة واستقصاء شموليتها. والنوع الروائي الذي يحظى بالإقبال القرائي وينال أعلى المبيعات هو القادر على تجسيد الحياة في سمتها الكلية. وهكذا كانت الرواية التاريخية والرواية الواقعية والرواية النفسية ورواية الخيال العلمي والرواية الرمزية والرواية التسجيلية والرواية الوثائقية ورواية اليوميات والمذكرات والرحلات والأسفار والسيرذاتية والترجمية وغيرها.
وفي العقدين الأخيرين من القرن الحالي، أخذت رواية المذكرات واليوميات والرحلات والأسفار تنافس الأنواع الروائية الأخرى في سوق الأدب، حتى أن كلود ليفي شتراوس الاثنوغرافي، الذي كره الأسفار والمستكشفين وشكك في جدوى كتابة اليوميات، وجد نفسه ملزماً بكتابة رحلاته فيما بين 1935 و1941 في كتابه «مداريات حزينة» الذي ترجم إلى اللغة العربية والصادر في دمشق 2003. وفيها أشار شتراوس إلى حيرته أمام هذا النوع من الحكايات متسائلاً: «أينبغي علي أن أقصَّ بكل دقة تلك التفاصيل التافهة والحوادث التي لا معنى لها... بالإضافة إلى ما لا يحصى من المشقات التي تجعل الحياة الخطرة في قلب الغابة البكر أشبه بالخدمة العسكرية... لكن هل تستحق حثالة الذاكرة... أن أرفع القلم لتدوينها؟». ص17 - 18.
والسر وراء هذا الذي يتصوره شتراوس يكمن في رغبة الإنسان الأوروبي العميقة في العودة إلى الطبيعة بروائحها وطعومها وصورها الصادقة البعيدة عن الخداع التي تقدم ثقافة متغايرة ومعرفة أكيدة توقظ في الإنسان أكواناً غير مرئية من الطيبة والحرية. وهكذا يندفع القراء نحو روايات اجتاحت المكتبات والأسواق موضوعها الأمازون والتبت ومجاهل أفريقيا.
وإذ برع الروائيون الأميركيون في كتابة هذا النوع من الروايات، فلأن النقد الأميركي المتأثر بفلسفة كروتشه ونزعات الرمزيين الفرنسيين كان قد عرف مدرسة النزعة الإنسانية جنباً إلى جنب المدرستين التصويرية والنقد الجديد، موظفاً شكلاً من أشكال الواقعية هو «الواقعية الموضوعية»، وفيها الراوي لا يتدخل في استبطان الشخصية بل هو كالمخرج السينمائي الذي لا يعبر عن نفسه في اختيار المشاهد ولا يعيرها صوته لتغدو الرواية مجموعة متتالية من الأحداث الموضوعية التي تنقل بحيادية مسجلة الحياة. ومن رواد هذه الواقعية كالدوبل وهمنغواي وباسوس وفوكنر وشتنايبك وداشيل هامت.
وقد شاع هذا اللون من الأعمال الروائية في الربع الثالث من القرن العشرين وغزا القارات بروايات تتناول هنود بوليفيا أو حياة السهوب الفنزويلية والغابات الاستوائية أو حياة صيادي سردينيا والسهول الهنغارية والحمامات المعدنية، كما في رواية «بلاد الثلج» للياباني ليناسوري كواباتا. وأصبحت رواية المغامرات مثل رواية «ثلوج كليمنغارو» لهمنغواي الممثل الحقيقي لهذه الواقعية، وفيها تظهر ردود فعل الشخصية الخارجية فقط في حركاتها أو سلوكها.
ومن تلك الروايات ما كتبته ديليا مع زوجها مارك أونس من أعمال جسدا فيها رحلتهما التي دامت 23 عاماً في أفريقيا. وأول رواية لهما «صرخة كالاهاري» عن دار «هوغتن ملفن» 1984 وتسرد بضمير المتكلم وتدور أحداثها في براري كالاهاري في ناميبيا.
تلتها رواية «عين الفيل» عن دار «هوغتن ملفن» 1992 وهي عبارة عن مغامرة ملحمية تدور حول القتال في سبيل منع صيد الأفيال في براري بوتسوانا وزامبيا. ومما قالته ديليا في التقديم لها: «كنت بحاجة دوماً إلى تذكر الأخاديد المطوية في جلد الفيل وعينه اللامعة الرطبة التي تعكس شروق الشمس، وبالتأكيد هذا لن يحدث لي مرة أخرى، الذاكرة تستمر مدى الحياة ولن أنسى الطريقة التي بها شعرت لأول وهلة أني أستطيع أن أرى كل شيء بوضوح... في وادي الخداع والجفاف ونهر متحجر جاف في صحراء كالاهاري في بوتسوانا. أريد أن أهمس بشيء ما، ولكن ماذا أقول؟ عين الفيل هي عين العاصفة».
والرواية الثالثة هي «أسرار السافانا» 2006 وهي رواية درامية تسرد مذكرات الكاتبين في العيش في براري أفريقيا ووادي لونغوا شمال زامبيا منذ أواسط سبعينات القرن الماضي، وفيها يجد القارئ أسرار القتال من أجل إنقاذ الفيلة من الصيد.
ونأمل أن تتاح ترجمة هذه الروايات الثلاث إلى العربية، ومؤخراً كتبت ديليا أونس روايتها «حين تغني السلطعونات» (where the crawdads sing) لوحدها وصدرت بطبعتها الإنجليزية عام 2018. والمبهر أنها احتلت الرقم واحد في قائمة «البيست سيلر» متجاوزة 4 ملايين نسخة ورقية، وهو ما لم تنله الروايات الثلاث المشتركة في كتابتها مع زوجها.
ويبدو أن تجارب الكتابة المشتركة قد تعمل على إنضاج أسلوب الكاتب وربما العكس؛ أي أن الكتابة المشتركة قد لا تسمح له بإظهار مواهبه الفردية. وهكذا بدت قدرات ديليا في الكتابة بمفردها واضحة كما ظهر تأثرها بأسلوب الروائية آن رادكليف التي كانت لها طاقة خيال هائلة في توظيف المناظر الطبيعية الخلابة، بشخصيات وحوارات وأحداث، مصعِّدة الحبكة تصعيداً دراماتيكياً. وكذلك وضح تأثر ديليا بالكاتبة الدنماركية كارين بلكسين 1885 - 1962 التي كانت تكتب باسم مستعار، هو إسحق دينسين. وتتميز قصصها بالإتقان في دمج الواقع بالحلم مع الميل إلى السرد التقليدي الخيالي. وقد أثنى همنغواي وآرثر ملير وغيرهما على أسلوبها القصصي.
ولها مجموعة قصصية عنوانها «سبع حكايات قوطية» 1932، ثم تلتها روايتها الأولى «خارج أفريقيا» 1937 التي تُرجمت إلى العربية بعنوان «راحلة من أفريقيا» ونشرها المركز القومي للترجمة بمصر عام 2012، وفيها تخوض بلكسين تجربة مشابهة لتجربة ديليا؛ فقد سافرت إلى أفريقيا مع زوجها برور فينيك عام 1914، وهناك امتلكا مزرعة في كينيا، وحين عادت إلى الدنمارك سجلت سنواتها التي عاشتها في أفريقيا وحبها الغامض لها ولشعبها وذكرياتها وأسلوب حياة الأفريقي البسيط.
وإلى جانب تأثر ديليا بهاتين الكاتبتين، فإنها أتقنت توظيف الواقعية الموضوعية في روايتها هذه، باستعمال تقانة «الإضمار النفسي» التي مكنتها من تجسيد النزعة السلوكية في تصوير العواطف والانفعالات وتفسيرها تفسيراً آلياً، مصورة العلاقة الأمومية بين الإنسان الحاضر الذي تمثله الطفلة كيا kya والطبيعة الغائبة التي تمثلها الأم الراحلة، وقد انفصمت عرى هذه العلاقة وتغرب الإنسان عن إنسانيته وانغمس في حياة العولمة مديراً ظهره للحياة الفطرية معزولاً في بيته وهو ينظر إلى الخارج من خلال تلسكوب.
وإذا كانت بلكسين قد تغنت بأفريقيا وسعتها وكثرة حيواناتها وتنوع نباتاتها وجمال مرتفعاتها ووديانها وتفاصيل الروائح والطعوم والمطر والمناظر الطبيعية مع معلومات جغرافية كثيرة تتعلق بأحوال الطقس والتبدل في الفصول وطبيعة الأرض، فإن ديليا أونس جسدت الطبيعة الأميركية من خلال كيا التي وجدت في الطبيعة أماً رؤوماً تعوضها الوحدة والحرمان وتنقذها من شرور الواقع المعيش وآلامه، في إشارة إلى أن الحياة المعاصرة بانوراما تراجيدية فيها الإنسان المهزوم هو البطل الجديد الذي ليس من سبيل أمامه سوى العودة إلى أحضان الطبيعة.
والرواية تسرد بضمير الشخص الثالث برؤية أحادية تبدأ بعام 1952 وكيا طفلة في الكوخ تواجه الحياة لوحدها حتى جودي الأخ الأكبر غادر هو الآخر من دون وداعها، وتتساءل: لمَ الجميع يغادرون وهي وحدها لا يمكنها أن تفعل شيئاً؟ فتهمس لها الأمواج أنها عقلة المنزل التي ستكسر الصمت. وتسمع أصوات الضفادع فتسليها وتتذكر كيف أن أمها كانت تغني لها أغنيتها فلكلورية «هذه ضفدعتي الصغيرة تذهب إلى السوق».
وتشكل أصوات الأشجار والأنهار والحيوانات فاعلاً سردياً يحاور ذهن كيا همساً، ومع مرور الوقت يصبح الهمس سلوتها التي تمكنها من تخطي أزماتها النفسية وانكساراتها الاجتماعية، بسرد موضوعي بضمير الشخص الثالث مع توظيف للحوارات التي فيها استعملت الكاتبة اللهجة الأميركية المحكية باختصاراتها وإضافاتها.
إن رواية «حين تغني السلطعونات» ليست فقط رواية «البيست سيلر» التي حققت شهرة تسويقية؛ بل الرواية التي أكدت أنّ الواقعية الموضوعية أسلوب ما زال قوياً، فيه لا فرق في تصعيد درامية السرد بين الفواعل السردية العاقلة وغير العاقلة. وهكذا كان المستنقع والضفدع والبحر والمطر والشاطئ بمثابة الملجأ الحامي من تبعات الحرب الأهلية والحربين العالميتين مما عرفته السنوات التي تلت 1952. فكان المستنقع حراً مقدساً يحفظ الأسرار ويوثقها عميقاً في الجينات كأسطورة جميلة تنتقل مع الأجيال.
ماذا وراء ظاهرة الروايات الأكثر مبيعاً؟
«حين تغني السلطعونات» لديليا أونس نموذجاً

نجيب محفوظ

ماذا وراء ظاهرة الروايات الأكثر مبيعاً؟

نجيب محفوظ
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة