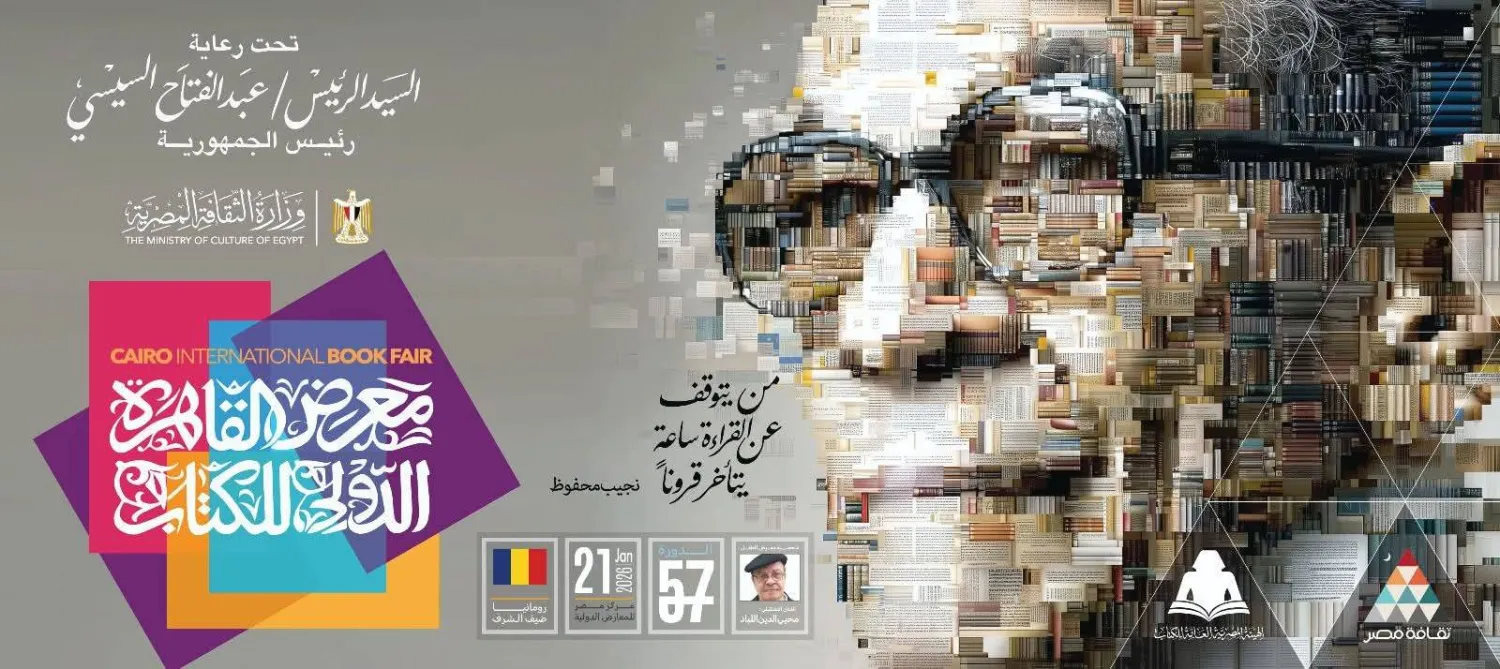أحزاب سياسية انتهت بعد أن أصبحت عاجزة عن إيجاد حلول لمشاكل الناس، بيروقراطية متسلطة بلا فرامل أو رقابة، حلّت مكان القرار السياسي، وشعب يزداد فقراً. هذا الكلام ليس عن دولة من العالم الثالث، بل هو باختصار رأي الأنثروبولوجي والمؤرخ الفرنسي المثير للجدل إيمانويل تود، حول ما تعيشه بلاده في الوقت الراهن. وفي كتابه الجديد «الصراع الطبقي في فرنسا في القرن الحادي والعشرين»، يشن حملة على النظام القائم خاصة على «الماكرونية»، متعاطفاً مع أصحاب السترات الصفراء، ومعتبراً أنهم من خلال انتفاضتهم التي بدأت تستجرّ موجات من الاحتجاجات النقابية، أعادوا له إحساسه بـ«الفخر» كمواطن فرنسي.
معجب هذا الباحث الأكاديمي، الذي تلقى تعليمه في كامبريدج، بالنموذج البريطاني الذي يراه ناجحاً، ويملك مقومات التطوير الذاتي. عاش لفترة من الزمن هناك ولا يزال له أولاد وعائلة، وهو لا يتوقف عن المقارنة بين التوجه الأنجلو ساكسوني، وما تنتهجه أوروبا عموماً، واجداً في هذه الأخيرة رغم طموحها الوحدوي عوائق يصعب تجاوزها. لهذا يعتقد أن «بريكست» رغم كل المعارضات له، يشكل بداية لتحلل أوروبا، وعودة السيادة التي يتمناها إلى دولها.
إيمانويل تود يميل إلى القول إن هذا الانفتاح الكبير الذي يشهده العالم لا يؤدي إلى نتائج إيجابية، بل على العكس، يزيد الأزمات، ويصعّب من الحلول. ويلقي الكاتب باللائمة على «اليورو» باعتباره سبباً رئيسياً في خفض مستوى الحياة في فرنسا، وزيادة الفقر، لأن اعتماد العملة المشتركة حرم فرنسا تدريجياً من سلطتها على اقتصادها، فيما قوانين الاتحاد الأوروبي حدّت من إمكانية اتخاذ قرارات مستقلة، بما فيها التعامل مع المهاجرين. المشكلة ليست في استقبال هؤلاء بأعداد معقولة، وإنما بافتقار المجتمع الفرنسي إلى الديناميكية التي تسمح له باستيعاب المهاجرين.
ويخالف تود عدداً من زملائه الباحثين الذين يرون أن المجتمع الفرنسي غير متجانس، وأن هذا جزء من معضلته. فهو يصرّ على أن الاختلافات المناطقية التي يتحدث عنها بعض الكتاب تلاشت إلى حدودها الدنيا، وكذلك الاختلافات الدينية، وحتى المهاجرين من الجيل الثالث باتوا مندمجين، وهذا ما يفسر بروز المشكلات نفسها، والشكوى ذاتها في مختلف المناطق في وقت واحد.
الأزمة في عمقها كما يراها الكتاب هي أن عدد الموسرين الذين يقبضون على الثروات لم يعد تتعدى نسبتهم 1 في المائة، فيما تعتقد البرجوازيات الصغيرة أنها تنعم بحياة هانئة، كالبحاثة والأكاديميين الذين ينتمي إليهم تود، لكنها في حقيقة الأمر ذاهبة إلى فقرها. وهو ما يعني أنها قد تنضم سريعاً إلى المحتجين، وحينها يمكن الحديث عن ثورة حقيقية في فرنسا. فلا ثورة دون انخراط الطبقة الوسطى فيها، وهو ما يعتقد أنه آت وخلال سنوات معدودات. مراهناً بذلك على أننا نعيش في زمن كل ما فيه أسرع من ذي قبل.
يخيل لمن يقرأ الكتاب، أن تود يتحدث عن لبنان، أو واحدة من دول منطقتنا الباحثة عن خلاصها، لكنه مؤمن بأن الأزمة كبيرة. وهو كأنثروبولوجي متخصص في الأصل في دراسة بنى العائلة وتشعباتها، وما يترتب عليها من أنظمة في المجتمعات وتحولاتها، له في قراءته لظواهر مجتمعه ومنهجه الخاص.
لذلك هو يتحدث عن نتائج سيئة تتعدى الاقتصاد إلى مناحٍ مختلفة منها الصحة والتعليم وحتى عن تدمير لليبرالية والبرجوازية الصناعية، فيما تحول العمال والموظفون الصغار إلى محتجين ومنتفضين. وتقع المسؤولية على عاتق السياسيين والأحزاب التي وصلت إلى حافة الانفجار، وفقدت القدرة على المبادرة. وبسبب هذا الشلل السياسي بات بمقدور الإدارات العليا أن تفرض سطوتها على المجتمع.
يشكو الكاتب أيضاً من تردي المستوى التعليمي، وتراجع الدراسات. وإلا كيف يمكن أن يفسر عجز وتيه خريجي المدارس العليا، فخر النظام التعليمي الفرنسي، حين يتولون المناصب السياسية، عن مواجهة العمال وبسيطي التعليم من السترات الصفراء الذين يظهرون ذكاء، وفاعلية، وقدرة على الحركة والمواجهة والاستمرار في الاحتجاج. وتقف الطبقة التي يفترض أنها النخبة الأكثر تأهيلاً عاجزة أمامهم.
لا يكف تود عن إثارة الجدل، وهو يعتبر كتابه هذا نوعاً من المكاشفة والمصارحة الفجة التي لا بد منها. لكن الكاتب كان قد أثار غباراً كثيفاً، حين أصدر عام 2015 كتابه «من هو شارلي؟» بعد أشهر من التظاهرات الضخمة التي شهدتها فرنسا، بعد وقوع الهجمات التي استهدفت يومها مجلة «شارلي ايبدو» ومتجراً يهوداً.
قيل يومها إنها أكبر تظاهرات تشهدها فرنسا، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بسبب تكاتف الشعب الفرنسي ضد العنف والإرهاب، والتفافه حول مبادئ العدالة والحرية وقيم الجمهورية. لكن تود كان له في هذه المظاهرات رأي آخر، إذ اعتبر أن الذين تظاهروا هم طبقة بعينها أنهم الأغنياء والمثقفون وغيرهم من المحظيين الذين قال إن الهستيريا أصابتهم، بينما لم يشعر الفقراء وسكان الضواحي والعمال البسطاء بأن القضية تعنيهم بالقدر نفسه. واعتبر تود أن هذه القوة التي عكستها المظاهرات من خلال فئة بعينها، كانت في مواجهة فئة أخرى أضعف هم المسلمون.
على أي حال، تود الذي يقرأ تحولات المجتمع الفرنسي، ليس متفائلاً، وهو يرى إيمانويل ماكرون يعمل على قضم تقاعد العاملين الفرنسيين، مما يرفع منسوب القلق ويبشر بمزيد من الفقر، لذلك فتوقعاته أن الأمر إذا ما بقي على ما هو عليه فإن فرنسا ذاهبة إلى عنف وصدامات وصعود للتطرف في السلطة لمواجهة جحافل المعترضين، لكنه في الوقت نفسه يرى الأمل في «السترات الصفراء» وحيوية المجتمع في مواجهة الإفقار.
تمكن هذا الكاتب المحبوب تلفزيونياً، بفضل خلطاته المثيرة في دراساته أن يتحول إلى «بيست سيلر». ففي كتابه الأخير هذا يجمع كل المكونات التي تجعل منه مشتهى القراء، منها: مواقف حادة من الرئيس إيمانويل ماكرون، وإشادة بالسترات الصفراء، ودور اليورو، وتقسيمه الخاص للطبقات الاجتماعية الفرنسية في أربع خانات تذهب إلى خلخلة، والمهاجرون، والتعليم، والمرأة، والديموغرافيا... كل هذا في قالب تحليلي يعتمد على الأرقام والديموغرافيا، ويقدم قراءة مستقبلية مع طروحات غالباً ما تأتي استفزازية.
البعض يصف تود بأنه يجانب الموضوعية، بينما قراء كثر لا يزالون يتنظرون مؤلفاته، ويرون في تحليلاته ذكاء يستحق الثناء.
8:47 دقيقه
إيمانويل تود يعيد فرنسا إلى «الصراع الطبقي» في القرن الـ 21
https://aawsat.com/home/article/2128881/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%8A%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%80-21



إيمانويل تود يعيد فرنسا إلى «الصراع الطبقي» في القرن الـ 21
الأنثروبولوجي المعروف باستفزازيته المثيرة للجدل

إيمانويل تود
- بيروت: سوسن الأبطح
- بيروت: سوسن الأبطح

إيمانويل تود يعيد فرنسا إلى «الصراع الطبقي» في القرن الـ 21

إيمانويل تود
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة