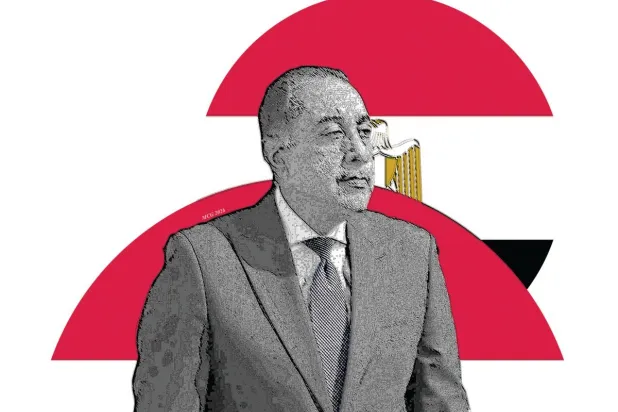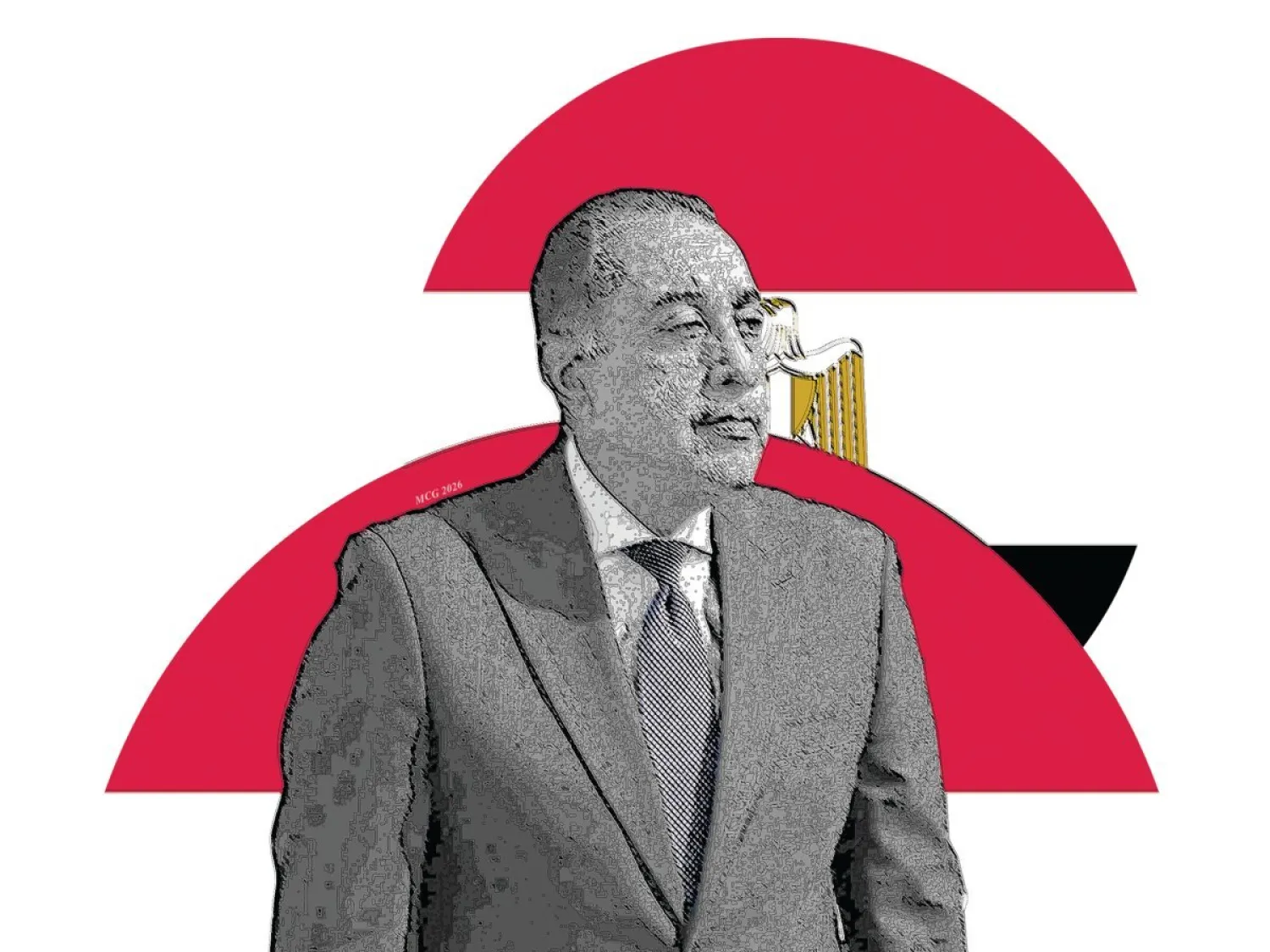إذا كان مستقبل الوجود الأميركي في شمال شرقي سوريا مطروحاً في نهاية 2018، فإن نهاية العام الجاري حسمت الجدل حوله. لكن الأنظار اتجهت إلى إدلب، حيث يعيش ثلاثة ملايين مدني حالة القلق، اقتلعت حملة القصف والمعارك أكثر من 300 ألف منهم، وأخذتهم إلى المجهول... بانتظار جولة جديدة، أو صفقة أخرى.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرر ثلاث مرات الانسحاب من سوريا خلال 12 شهراً. وغيَّر رأيه ثلاث مرات. المرة الأخيرة كانت في بداية أكتوبر (تشرين الأول)، بعد اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان الذي دشن العمليات العسكرية شرق الفرات في 7 أكتوبر ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية، المكون الرئيسي في «قوات سوريا الديمقراطية»، حلفاء واشنطن في الحرب ضد «داعش».
غير أن ضغوطاً من «الكونغرس» ودول أوروبية دفعت ترمب إلى التراجع، ووافق على الاحتفاظ بنحو 600 جندي في القسم الشرق من شرق الفرات. ولأول مرة بات ترمب مقتنعاً بالوجود العسكري شرق الفرات في سوريا: حماية النفط وامتلاك النفط والدفاع عن النفط. لأول مرة منذ 2016، دخل الموضوع إلى عقل الرئيس ترمب الباحث عن الانكفاء من الشرق الأوسط والتدخل العسكري خارجياً. صحيح أنه عقّد مهمة أعضاء التحالف الدولي خلال اجتماعهم في واشنطن منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، لأن «الدفاع عن النفط» ليس سبباً شرعياً للبقاء العسكري في سوريا، لكنهم باتوا أقل قلقاً من تغريدات ترمب المفاجئة حول ديمومة هذا الوجود.
عام 2019، بدأ بضغط أيضاً من حلفاء واشنطن المحليين والإقليميين والدوليين لإقناع ترمب بأن ما قاله بعد الاتصال بنظيره التركي في ديسمبر (كانون الأول) 2018، ليس صحيحاً: «داعش» لم يُهزَم 100 في المائة، لا جغرافياً ولا عقائدياً.
عليه، صعَّد التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة واشنطن بالتعاون مع «قوات سوريا الديمقراطية» عملياته ضد التنظيم في ريف دير الزور، إلى أن تمت السيطرة الكاملة على الباغوز، آخر جيوب «داعش»، في 23 مارس (آذار) 2019. وقتذاك، صار بإمكان التحالف الإعلان عن القضاء الكامل على «داعش»...جغرافياً.
المفارقة أنه بعد أيام على إعلان ترمب، وهو الثالث، الانسحاب من سوريا في أكتوبر، شن الجيش الأميركي عملية معقدة، وأعلن ترمب نفسه في 27 أكتوبر القضاء على زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي... أين؟ ليس غرب العراق ولا شرق الفرات أو البادية السورية، بل في باريشا في ريف إدلب. صار بإمكان ترمب أن يعلن ما فعل غريمه وسلفه باراك أوباما؛ بقتل أسامة بن لادن، بتبني القضاء على البغدادي ثم أحد المرشحين لخلافته.
القضاء على «داعش» جغرافياً وزعيمه، لم ينهِ التهديدات التي يشكلها التنظيم أو «القاعدة» خصوصاً مع تولي شخص «شرس» قاتل الأميركيين في العراق، خلافة البغدادي. وسنرى لاحقاً تكرار غارات أميركا ضد متطرفين في مناطق نفوذ روسية غرب نهر الفرات، خصوصاً شمال غربي سوريا. قد يكون هذا معلماً من معالم 2020.
تقسيم المقسم
المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، بدعم التحالف، تشكل ثلث مساحة سوريا البالغة 185 ألف كلم مربع، وتضم معظم ثروات البلاد النفطية والغازية والمائية والزراعية. هذا الصورة تغيرت في أكتوبر، حيث قُسّم المقسم. إذ إن قرار ترمب سحب قواته من حدود تركيا فتح الطريق للجيش التركي وفصائل سورية موالية للتوغل في شرق الفرات ضمن عملية «نبع السلام». خلال أيام، سيطروا على منطقة بين تل أبيض ورأس العين بعمق 30 كلم. وفي 17 أكتوبر، تم التوصل إلى اتفاق أميركي - تركي تضمن وقفاً للنار وانسحاب «وحدات حماية الشعب» الكردية مع سلاحها الثقيل بعمق 30 كلم.
وفي 23 أكتوبر، تم التوصل إلى اتفاق بين إردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في سوتشي. تضمن الإقرار بوجود تركيا وفصائل موالية بين تل أبيض ورأس العين، مقابل عودة حرس الحدود السوري إلى حدود تركيا في باقي المناطق شرق الفرات، وتسيير دوريات روسية - تركية بعمق 10 كيلومترات أو 30 كيلومتراً.
قرار ترمب وشعور «قوات سوريا الديمقراطية» بـ«خيانة» أميركية دفعا قيادة هذه القوات للذهاب إلى دمشق، والتوصل إلى اتفاق معها لنشر قوات الحكومة في مناطق محددة شرق الفرات، وعلى الحدود مع تركيا.
وإذ أحكمت أميركا، بعد التراجع، سيطرتها على الشريط النفطي قرب حدود العراق بنشر معدات متطورة رغم تراجع عدد عناصرها، فإن الدوريات الروسية - التركية، ذات دلالة رمزية أكثر منها تعبيراً عن قوة السيطرة، ذلك أن أدوات الأمن والحكم المحلي بقيت في أيدي «قوات سوريا الديمقراطية»، ما يشكل قلقاً لتركيا، وقد يحرضها على التدخل مرة أخرى، إثر تعزيز الهياكل الأمنية والإدارية في مناطق «نبع السلام» بين تل أبيض ورأس العين.
ربما تحتاج تركيا لإنجاز ذلك من 4 إلى 6 شهور، إضافة إلى ارتباط التوسع بمصير إدلب والعلاقة التركية - الأميركية.
«فيتنام إيرانية»
المنطقة التي كانت حكراً على حلفاء واشنطن، وتريدها إدارة ترمب أداة للضغط على روسيا لإضعاف إيران، باتت مسرحاً للقوات الروسية والتركية والسورية، إضافة إلى محاولات توغل إيراني وتجنيد سوريين في ريف دير الزور.
النقطة الجديدة في 2019، هي تركيز إيران جهودها على البوكمال وشرق الفرات بعدما انسحبت في بداية 2018 من جنوب سوريا بموجب تفاهمات روسية - أميركية - أردنية وبعلم إسرائيلي.
تكثيف الحضور الإيراني في البوكمال وشرق الفرات قوبل بغارات إسرائيلية عدة تزامنت مع قصف إسرائيلي على «مواقع إيرانية» في العراق، إذ شنت تل أبيب عشرات الغارات على ريف دمشق، قيل إنها استهدف الوجود الإيراني، ولعل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) شهد جولة من أشد وأوسع الغارات. وفي ديسمبر (كانون الأول)، شنّت طائرات «إف 35» إسرائيلية غارات مكثفة على «مصنع إيراني» في البوكمال، على بعد بضع مئات من الكيلومترات من نقاط انتشار القوات الروسية في القامشلي.
وفي 25 ديسمبر (كانون الأول)، قُتِل خمسة مقاتلين من الفصائل الموالية لإيران في غارات على البوكمال. قبل ذلك، في 8 ديسمبر (كانون الأول)، شنّت إسرائيل غارات مشابهة. سبق ذلك مقتل 28 مقاتلاً «إيرانياً» في سبتمبر (أيلول). وكان مسؤول أميركي في واشنطن أعلن أن المسؤولية عن القصف في أقصى الشرق السوري تقع على إسرائيل.
ولعل كلام وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت يفسر هذه الغارات التي بقيت غامضة تجنّبت أطراف إعلان المسؤولية عنها. إذ أعلن بينيت أن تل أبيب ستحول سوريا إلى «فيتنام إيرانية»، وأن قواته ستتحول من «العمل الوقائي إلى الهجومي».
اللافت أن الجولة الأخيرة من الغارات جاءت بعد اجتماعات بين رئيسي الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، والأميركي الجنرال مارك ميلي، في جنيف، من جهة، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات ونظيره الأميركي روبرت أوبراين في البيت الأبيض، من جهة ثانية، لتنسيق العمليات العسكرية و«منع الاحتكاك» في سوريا. يعني هذا أن 2020 سيكون امتداداً لطرح سؤال حول الوجود الإيراني، لعلاقة ذلك بملفات إقليمية والوضع داخل إيران.
مصير مجهول
إذا كان مصير إدلب وأهلها غامضاً في بداية العام، فإن نهايته جلبت مزيداً من عدم اليقين لنحو ثلاثة ملايين شخص يعيشون في ظلها وسط اضطرار نحو 320 ألفاً، للنزوح من القصف والمعارك إلى المجهول.
حاولت قوات الحكومة التوغل، الصيف الماضي، في شمال حماة وجنوب إدلب الخاضعة لتفاهم روسيا وتركيا منذ سبتمبر 2018، وتم قضم بعض المناطق، إلى أن توصل إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في نهاية أغسطس (آب) الماضي إلى هدنة واتفاق يفسر الاتفاق السابق، مع مهلة لأنقرة لتنفيذ بندين: الأول، فتح الطريقين الرئيسيين بين اللاذقية وحلب، وبين حماة وحلب. الثاني، إخلاء المنطقة الآمنة من الإرهابيين وسلاحهم الثقيل.
في 12 ديسمبر (كانون الأول) شنّت قوات الحكومة هجوماً جديداً، بانخراط روسي جوي، ذلك أن دمشق تريد السيطرة الكاملة على إدلب، وتساند موسكو دمشق في المنطقة، لكنها تدرك كذلك التداعيات الإنسانية الهائلة على تركيا المجاورة. كما أن التعامل مع تهديدات «هيئة تحرير الشام» يستلزم صياغة المقاربة العسكرية التي ترمي إلى تشجيع أو إجبار مكونات «الهيئة» على الانقسام والتفكك، بدلاً من المواجهة في منطقة قريبة من قاعدتي حميميم وطرطوس الروسيتين.
تحت غبار القصف، وبين رماد الخراب والرياح التي تلفّ النازحين، تدل المؤشرات على إعطاء دمشق بدعم موسكو الأولوية للسيطرة على الطريقين السريعين بين حلب واللاذقية، وبين حلب ودمشق، تفسير موسكو امتداد لتفاهم روسي وتركيّ على فتح طريق حلب - القامشلي شرق الفرات.
إنسانياً، أدّت الحملة إلى نزوح أكثر من 235 ألف شخص بين 12 و25 الشهر الحالي من جنوب إدلب، تزامناً مع تكثيف قوات النظام وحليفتها روسيا وتيرة غاراتها على المنطقة. كثير منهم فروا من منطقة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، التي باتت «شبه خالية» من السكان.
«خطوة متأخرة»
في بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، انعقدت اللجنة الدستورية السورية. كان ذلك أول اتفاق سياسي بين الحكومة والمعارضة، تضمن تشكيل اللجنة والاتفاق على القواعد الإجرائية. وعُقِدت جولة أولى بداية نوفمبر تواصل فيها الطرفان لتشكيل لجنة مصغرة و«مدونة السلوك». لكن الجولة الثانية، اصطدمت بالجدار. إصرار وفد الحكومة على موافقة وفد المعارضة على «مرتكزات وطنية» تضمن رفض العقوبات الغربية والإرهاب والتدخل التركي قبل بحث الإصلاح الدستوري.
صحيح أنه لم تسفر التطورات عن تغييرات كبيرة في الحسابات السياسية للأطراف المعنية، لكن الصحيح أيضا أن دمشق لا ترى إلى الآن مصلحة أو قيمة واضحة في الاستثمار باللجنة، نظراً للمخاطر السياسية العالية على ضعف سقف عمل اللجنة. كما أنها تريد تأجيل أي مسار سياسي على تواضعه إلى ما بعد الحسم العسكري واستعادة كامل البلاد.
في المقابل، تريد موسكو إحداث تقدم في صياغة الدستور والعملية السياسية لإقناع الاتحاد الأوروبي بزيادة المساعدات وتخفيض العقوبات على نحو تدريجي، كوسيلة من وسائل تحفيز المزيد من التقدم في تسوية الأزمة. لكن إقرار الرئيس ترمب «قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين» في 11 ديسمبر (كانون الأول)، أي بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى واشنطن، شكّل صدمة في موسكو، إذ إنه بات من أدوات الضغط الأميركية على موسكو، ورسالة إلى حلفاء دمشق بأن الوضع الراهن قد يزداد سوءاً مع مرور الوقت.
ويتيح القانون، رغم قسوته، تخفيف العقوبات أو إلغاءها، إذا وجد الرئيس الأميركي مصلحة. هذا يسمح بالتفاوض إذا اختارت دمشق وحلفاؤها المقايضة مع واشنطن. وبالنسبة إلى الجانبين الأميركي والأوروبي، هناك اعتقاد بوجود أدوات للضغط على روسيا: الأولى، المساهمة في إعادة إعمار سوريا. الثانية، التطبيع مع دمشق. الثالثة، العقوبات الاقتصادية. الرابعة، الوجود العسكري شرق الفرات. الخامسة، السيطرة على الموارد الاستراتيجية من نفط وغاز وثروات. لكن إلى الآن، ليست هناك محفزات واضحة لاتخاذ الإجراءات التي يمكن أن تستفيد منها دمشق، ما لم تعبر عن استعدادها للمشاركة والتفاعل والانخراط.
قبل أن تطوي سنة 2019، شهرها الأخير، حصلت أربعة تطورات: الأول، إعلان المبعوث الأممي غير بيدرسن أنه لن يدعو أعضاء اللجنة الدستورية لاجتماع قريب. الثاني، توقيع الرئيس ترمب «قانون قيصر» لفرض عقوبات على المساهمين في إعمار سوريا، ومحاسبة المسؤولين عن «جرائم حرب». الثالث، «فيتو» روسي - صيني ضد تمديد مشروع قرار دولي لتمديد إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لأول مرة منذ إقرار القرار في 2014. الرابع، بدء قوات دمشق معركة جنوب شرقي إدلب باتجاه معرة النعمان بغطاء جوي روسي، ودفع آلاف للنزوح إلى شمال إدلب وحدود تركيا. تبدأ 2020 بقمة بوتين - إردوغان في إسطنبول في 8 يناير (كانون الثاني) لبحث مصير إدلب وشرق الفرات والتسوية، واستقبال إردوغان للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، القلقة من موجة جديدة من اللاجئين السوريين للبناء على القمة الرباعية التي ضمتها وإردوغان مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في لندن، في 3 ديسمبر (كانون الأول) على هامش قمة «حلف شمال الأطلسي» (ناتو).
تنتهي السنة، وسوريا تضيق بأهلها وتقلق جيرانها. تزدحم باللاعبين الخارجيين. تزداد انقساماً. المعاناة بدرجات مختلفة: «توحد» السوريين في مناطق الحكومة والمعارضة. والترقب ينتظر مناطق الإدارة الذاتية شرق الفرات حول مستقبلها وسط زحمة اللاعبين الخارجيين براً وجواً.
يستقبل السوريون سنة 2020 بتغريبة جديدة من النزوح واللجوء، وتدني الوضع الاقتصادي والمعيشي والتشقق الاجتماعي... من دون نافذة أمل أو ضوء في نهاية النفق.