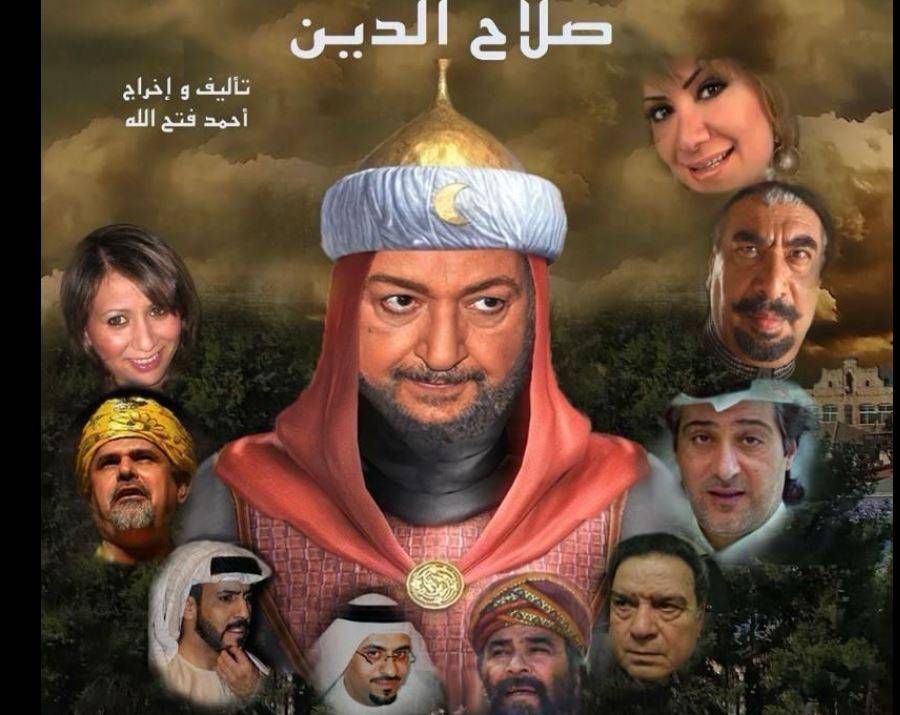الغربة والاغتراب، مفردتان متلازمتان في قاموس الشاعر والمفكر السعودي محمد العلي، كما في تجربته الخارجة عن النسق منذ حفر طريقه وسط الصخور وفوق كثبان الرمال وعلى صفحات الماء، يُفّتش عن مسارب ومعابر تسوقه نحو البحث عن المجهول، زاده العقل واجتراح السؤال.
في عام 1970 كتب قصيدته «آه... متى أتغزل؟»، يوائم بين روحه المتقدة بالحنين والاغتراب داخل الوطن، وروح الشاعر أبي الطيب المتنبي، الذي لاحقته الغربة من وطن إلى وطن، ومن بيداء إلى بيداء.. ليعقد الألفة بين الحالتين:
قف بي ملياً أبا الطيب
واقرأ عليّ الجراح التي قد تركت بها مصر
كان الجواد هو الليل
غادر دون صهيل...
وأغمدت جرحك بالشعر
لكن ما عندنا كيف يُغمَد
ما عندنا زرقة طفلة تجهل النطق
إني أقبِّل عينيك
لو جئت تمنحني بعض لؤلؤك الرطب
هذا الخليج المبرح غادر منه المحار.
وذات مرّة أعطى محمد العلي بُعداً فلسفياً للغربة والاغتراب، مستشهداً بقول أبي حيان التوحيدي: «إن الغريب هو مَن في غربته غريب»، ثم يضيف: «كل إنسان يُحسب أحياناً غريباً، فإذا لم يشعر بهذه الغربة فهذا يعني أنه أصبح فرداً من المجموع، في أحيان كثيرة يشعر بالغربة كلّ من يمتلك حسّاً مرهفاً».
ومحمد العلي المشتغل دوماً بنزع الأساطير («ما الذي سوف يبقى - إذا رحت أنزع عنك الأساطير - أرمي المحار الذي في الخيال إلى الوحل؟»)، لا يفتأ يحدث أثراً مدوياً كلما أطلّ على المشهد الثقافي، يحرك ساكنه، ويثير اضطراباً حميداً في أرجائه. لا يُثِير محمد العلي أكثر من الرضوخ للجمود، وتشّرب الأفكار دون تمحيصها، والكفّ عن اجتراح الأسئلة. وفي إطلالته الأخيرة في جمعية الثقافة والفنون، آثر أن يلقي هماً ثقيلاً عن كاهله، جاء إلى المحفل يتكئ على أعوامه التسعين يجرّ خطئ ثقيلة ومعه أنبوبة الأكسجين تساعده على التنفس دون عناء، لكي يحدّثهم عن «الاغتراب».
يمثل الشاعر محمد العلي رمزاً للحداثة السعودية، وخاصة في تجربتها الشعرية، غرس حضوره في المشهد الثقافي والفكري، رائداً للتجديد، والخروج عن السائد، ومنحازاً إلى بناء «العقل النقدي» والعقلانية، ومتبنياً للأشكال الشعرية الجديدة، كما أنه شاعر منفعل مع عصره، يتمتع بعمق ثقافي وفلسفي، ورغم قلة شعره، فإن كل قصيدة تضّج بالمعاني والوجدان والانفعال.
شاعر صنع الدهشة في كلّ نصّ كتبه، وفي كل مفردة حفرها في قصائده: «العيد والخليج»، «لا ماء في الماء»، و«الأساطير»، و«الوجع»، وكلها نصوص مثقلة بالمعنى كما هي مثقلة بالهمّ الإنساني الكبير الذي يحمله محمد العلي.
ينحدر العلي من واحة الأحساء الغنية بزراعة النخيل، والخصبة بمياهها، حيث في قرية العمران بالأحساء في عام 1932. وقد بدأ حياته العلمية والأدبية في النجف بالعراق، ثم اقترن بتجربة الأدب الحديث هناك، حيث عاصر تجربة بدر شاكر السياب، وحفظ عن ظهر قلب ديوانه «شناشيل بنت الشلبي».
فيما يلي نصّ ورقة محمد العلي «الاغتراب»، مفردة الاغتراب ذات معنى قديم في ثقافتنا، فمنذ العصر الجاهلي كان سلوك الفرد، حين يصبح معارضاً لسلوك قبيلته يفرد «إفراد البعير المعبد»، ومن هنا نشأت ظاهرة الصعاليك، وهم لفيف من أفراد خلعتهم قبائلهم؛ أي تبرّأت منهم، فأصبح مأواهم مأوى الرياح:
وسائلة أين الرحيل؟ وسائلٍ
وهل يسأل الصعلوك أين مذاهبه؟
إنه تائه، ألف الوحوش، وألفته، كما يدعي بعضهم. وقد قيلت في ذلك أشعار مشهورة كثيرة لا داعي لذكرها.
كان السبب لظاهرة الصعاليك واضحاً. إنه الفقر المجدب، والشعور الحارق بعدم المساواة، لذلك سلك لفيفهم طريق سلب الأغنياء، وتوزيع ذلك على المحتاجين. وقد حورب هذا السلوك، لأنه سلوك يقوم به أفراد من قبائل مختلفة. والمفارقة المضحكة أن العمل نفسه، لو قام به أفراد من قبيلة واحدة لعُدّ عملاً سائغاً وشجاعاً. وقد استمرت ظاهرة الصعلكة طيلة العصر الإسلامي والأموي، حتى إن الأحيمر السعدي الذي يُعتبر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية هو القائل:
عوى الذئب فاستأنست
بالذّئب إذْ عوى
وصوت إنسانٍ فكِدتُ أطيرُ
في العصر العباسي تغيّر معنى الاغتراب من العزلة اللاإرادية، كما هي في العصر الجاهلي، إلى عزلة إرادية عن الناس. وهنا لا بد أن نسأل عن السبب لهذا التغير؛ فقد كان الفقر هو السبب لظاهرة الصعلكة، أما هنا، فإن السبب هو الغنى الفاحش في يد مَن لا يستحقه. وقد عبر عن ذلك ابن الرومي بحرقة ضارية:
أتراني دون الأُلى بلغوا الآمال من شرطة ومن كتّابِ
وتجار مثلِ البهائم فازوا بالمنى في النفوس والأحبابِ
ويظلّون في المناعمِ واللذات بين الكواعب الأترابِ
لهف نفسي على مناكير للنكر غضاب ذوي سيوف عضابِ
تغسل الأرضَ بالدماء فتضحي ذات طهر ترابها كالملابِ
من كلاب نأى بها كلّ نأي عن وفاء الكلاب غدر الذئابِ
أصبحوا ذهلين عن شجن الناس وإن كان حبلهم في اضطراب
هذه الأبيات لابن الرومي، لا شكوى فيها من الفقر، بل من الفساد السياسي الذي أصبح أهله ذاهلين عن شجن الناس وآلامهم، في حين كان حبلهم قصيراً؛ لأن الدولة كانت تتمزق، وهم ذاهلون. هذا الشعور الحارق عبّر عنه شعراء ذلك العصر بصور مختلفة، لأنهم يتميزون عن غيرهم بمستواهم الثقافي الشاهق، ومع ذلك فهم يحتاجون، لضرورات الحياة، إلى مَن هم دونهم، بمراحل، من الحكام الفاسدين وأذنابهم، بفعل «الزمان المغفل»، وكان أبعد الشعراء غوراً في التعبير عن هذا الشعور الممض هو أبو تمام حين قال:
وأصرف وجهي عن بلاد أرى بها
لسانيَ معقولاً وقلبي مقفلا
وجدّ بها قومٌ سوايَ فصادفوا
بها الصنع أعشى والزمان مغفلا
أما المتنبي فكان يتمزق نفسيا، لأنه لا يرى في الدولة إلا أبواقاً وطبولاً
إذا كان بعضُ الناسِ سيفاً لدولةٍ
ففي الناس بوقاتٌ لها وطُبُولُ
وكان يقصد الخلفاء العباسيين في عصر انهيار الدولة. وإذن فقد كان اختلال الموازين السياسية والاجتماعية هو السبب لتلك العزلة وذاك التذمر. الناقد الكبير الدكتور عبد الله الغذامي أدان شعراء ذلك العصر، ومن قبلهم، ومن بعدهم، حتى أدونيس ونزار.. لأنهم شوَّهوا الذات العربية، بإحالتها إلى ذات مشعرنة، لتمجيدهم الطغيان، فحمل شعرهم نسقاً خفياً مدمراً للذات. هذا الرأي نراه صائباً من زاوية واحدة، هي الزاوية الأخلاقية المثالية المنفصلة عن الواقع، وعن فعل التاريخ، فقد أعاد المفكر الجابري تمجيد الطغيان إلى تأثير الثقافة الفارسية التي حملت إلى العربية مقولة «السمع والطاعة».
وقد جادل الناقد العراقي عبد الله إبراهيم هذا الرأي بصورة موضوعية عميقة لا مزيد عليها. (فصول ع 63) في العصر الحديث تعدد معنى الاغتراب تبعاً لتعدُّد أسبابه؛ فهناك اغتراب نفسي، وثقافي، واجتماعي، وسياسي، وإيجابي، وسلبي... وهذا التعدد ليس معناه عدم وجوده في العصور السابقة، بل لأن التعدد وأسبابه لم تُكتشف إلا في الأزمنة المتأخرة.
- الاغتراب النفسي
وهو على نوعين: اغترب إيجابي، وهو التحول المعرفي، ونضج الوعي، اللذان يرتفع بهما الإنسان على نفسه، من خلال تجاربه، وتقلبه في وجوه التفاعل الاجتماعي، ودرجات التعلم. واغتراب سلبي، وهو «الشعور بالوحدة حتى بين الأهل والأصدقاء. إنه انفصال الفرد عن التفاعل الاجتماعي، والانفعال بالمؤثرات، وبالتالي الشعور بلا جدوى الحياة»، أي تحوله إلى مرض. وهذا يعود إلى أسباب فرعية مختلفة.
- الاغتراب الثقافي
لكل مجتمع حضاري ثقافتان: ثقافة سائدة، تعززها السلطة الاجتماعية والسياسية، هدفها إبقاء الوضع الاجتماعي، كما هو، بلا تغيير، وثقافة مضادة هدفها التغيير الجذري الشامل لكل أوضاع المجتمع المتخلفة. ولنضرب مثلاً بالتعليم. فقد كتب كثيراً عن تخلُّف المناهج التعليمية، وأنها حشو للذاكرة، لا لتنمية الوعي وإيقاظ الفكر... وفي لفتة ماهرة للكاتب القدير علي الشدوي أضاف فيها إلى ما ذكر أن تلك المناهج تسبب اغتراب الطالب عن نفسه، لأنها لا علاقة لها بالحياة الاجتماعية التي يعيشها، ولا بأي هدف من أهدافه.
إن الصراع بين الثقافتين السائدة والمضادة، هو في جذره صراع اجتماعي، يهدف إلى التغيير، ويصل أحياناً إلى حد التناحر، لذا فإن جميع من حاولوا التغيير من الفلاسفة، والمفكرين والمصلحين، وحتى الشعراء والأدباء قد اكتووا بنار ذلك الصراع، وذاقوا مرارة الاغتراب، ولكن النتيجة تكون دائما إيجابية، لأنها تثمر التقدم والتطور.
- الاغتراب الفلسفي
لا أريد هنا الخوض في نظرية الاغتراب عند باخ أو ماركس أو غيرهما من الاجتماعيين والنفسيين، بل كل ما أريده هو إيضاح اغتراب ما ندعوه فلسفتنا عن ثقافتنا السائدة والمضادة معاً، على كثرة من نسميهم فلاسفتنا، فابتداء من الكندي حتى ابن رشد نقرأ شتاتاً من الآراء المنقولة بصورة غير دقيقة، فلم تترك أي تأثير في ثقافة المجتمع، كما ترك المعتزلة، على قصر فترة ظهورهم. وقد أعاد العلامة عبد الرحمن بدوي سبب ذلك إلى فصل الذات العربية عن استقلالها، ودمجها بالجماعة. وهو رأي صائب، حين ننظر من زاوية تاريخية. وقد يكون للحديث القائل: «يد الله مع الجماعة» دخل في هذا، ولكني رأيت في أحد المواقع الدينية أن معنى الجماعة المقصود هنا هم الصحابة. وعليه فإن الحديث خاص بزمن مضى وليس عامّاً.
- الاغتراب السياسي
وهو غياب المشاركة في الفعل السياسي، مع القدرة عليه، الأمر الذي يفضي إلى السلبية وعدم المبالاة، وهذا موقف يؤدي، في النهاية إلى ضعف الأمة وانهيارها.
- الاغتراب الديني
أصرح هنا، منذ البداية، بأني مجرد ناقل، لا لرأي «باخ» في الاغتراب الديني، بل لرأي كاتب إسلامي هو الدكتور توفيق السيف، المستند بدوره إلى مفكر إسلامي آخر هو الدكتور عبد الكريم سروش؛ فقد كتب في جريدة «الشرق الأوسط» تحت عنوان «العلمانية الطبيعية: استقلال العلوم» في (31/ 7/ 2019) ما يلي:
«الذي حدث بعد استقلال العلوم أن البشر حصلوا على أدوات تفسير لعالمهم من خارج إطار الدين، أو لعل علاقتهم بهذا العالم قد تطورت من حالة الانفعال، وانتظار الأمر والنهي، إلى التأمل والبحث عن تفسيرات لما يجري فيه، أي ازدادت مساحة التساؤل، وتقلصت مساحة اليقين، وتغير موقف الإنسان من الانصياع إلى الرغبة في الاستقلال.
يبدو أن هذا هو الموقف الطبيعي، أو ما نسميه منطق التاريخ. في البداية يوفر الدين مفاتيح لفهم العالم، لعل أبرزها الإيمان الميتافيزيقي أولاً، التجريبي تالياً، بأن الكون نظام دقيق (...) وبعد أن يتعرف الإنسان، تتقلص وظيفة الدين إلى أخص اهتماماته، أي الإجابة عن أسئلة الوجود الكبرى وربط الإنسان بخالقه»، ثم يختتم النص بقوله: «يعتقد سروش أن هذا المسار يؤدي إلى ما نسميه: (علمانية)»، ينطلق سروش من الاعتقاد بأن الدين ثابت، أما معرفة الدين فهي متغيرة كسائر المعارف البشرية التي إذا تغير فرع منها أثر في الفروع الأخرى. وهذا الاعتقاد قديم؛ يستند القائلون به إلى الحديث «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها». وعلى هذا قال جلال الدين السيوطي:
«لقد أتى في خبرٍ مشتهرِ
رواه كل حافظٍ معتبرِ
بأنه في رأس كل مائةِ
يبعث ربنا لهذي الأمةِ
منًّا عليها عالماً يجددُ
دينَ الهدى لأنه مجتهدُ
فكان عند المائةِ الأولى عُمَر
خليفة العدل بإجماع وقر
والشافعي كان عند الثانيةْ
لما له من العلوم السامية
والخامس الحَبْرُ هو الغزالي
وعده ما فيه من جدال».
في الختام، واختصاراً لما تقدم كله، ينبغي أن نسأل: ما السبب لهذا الصراع والتمرد في كل هذه العصور المترامية؟ والإجابة نجدها في قضيتين، هما: غياب العدالة الاجتماعية، وغياب الحرية. لقد تكسرت الأقلام (زرافات ووحداناً) وهي تكتب عن ضرورة العدالة الاجتماعية، من دون رؤيتها على أرض الواقع المعيش، إذ لو كانت هناك عدالة في توزيع الخيرات، لاتجهت تلك الصراعات إلى ميدان التنافس في البناء الاجتماعي، بعيداً عن التناحر. وقد عبّر الشاعر الكبير الجواهري عن التفاوت المقيت بين الناس، وغياب العدالة بقوله:
لكن بي جنفاً عن وعي فلسفةٍ
تقضي بأن البرايا رُتِّبَتْ رُتَبا
وأن من حكمة أن يجتني الرطبا
فرد بجهد ألوف تعلك الكربا
أما غياب الحرية، التي كأن بينها وبين الأرض العربية نفوراً أزلياً، فهو الآخر سبب الانكسارات التي نتخبط فيها. لقد رادف الفيلسوف سارتر بين الإنسان والحرية، لأن الإنسان لا يصير ذاتاً إلا بالحرية، ومن دونها يصبح مجرد موجود، كأي (شيء) من الأشياء، ومعنى هذا أنه لم يتحول بعدُ إلى إنسان. إننا في عالمنا نتكلم عن الحرية، وكأنها شبح من الأشباح، أو حلم من أحلام شهرزاد. لذا، لو نظر إلينا سارتر لقال: «هؤلاء (موتى بلا قبور)»، ولأضرب مثلاً: جاء في حقوق الإنسان أن حرية الرأي حق من حقوق الإنسان. فهل يا تُرى لو أنت بدلتَ مذهبك فهل أنظر إليك أنا، الذي أدعي التنوير، من دون أن تحمر عيناي من الغضب؟ بل هل تستطيع أنت الآن أن تكتب مثل المعري أو أبي حيان أو أبي نواس؟ كلا، إنك لا تستطيع؛ لأن حراس الموتى جاهزون لك بكل الأسلحة.
«الاغتراب».. طوق النجاة للخروج عن «النسق»
بين الشاعر محمد العلي ونجله رياض (1 من 2)

محمد العلي في ندوة عن الاغتراب

«الاغتراب».. طوق النجاة للخروج عن «النسق»

محمد العلي في ندوة عن الاغتراب
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة