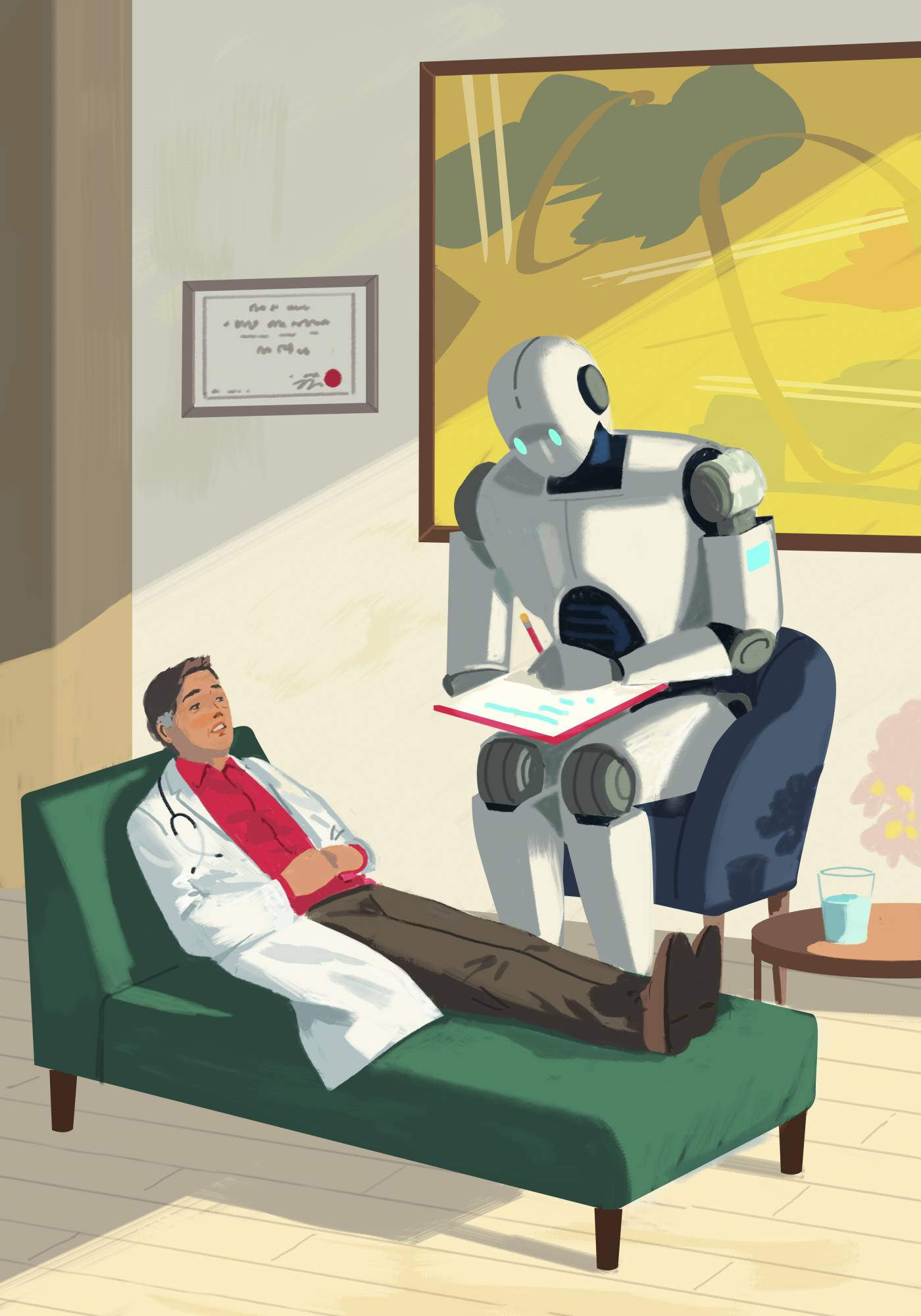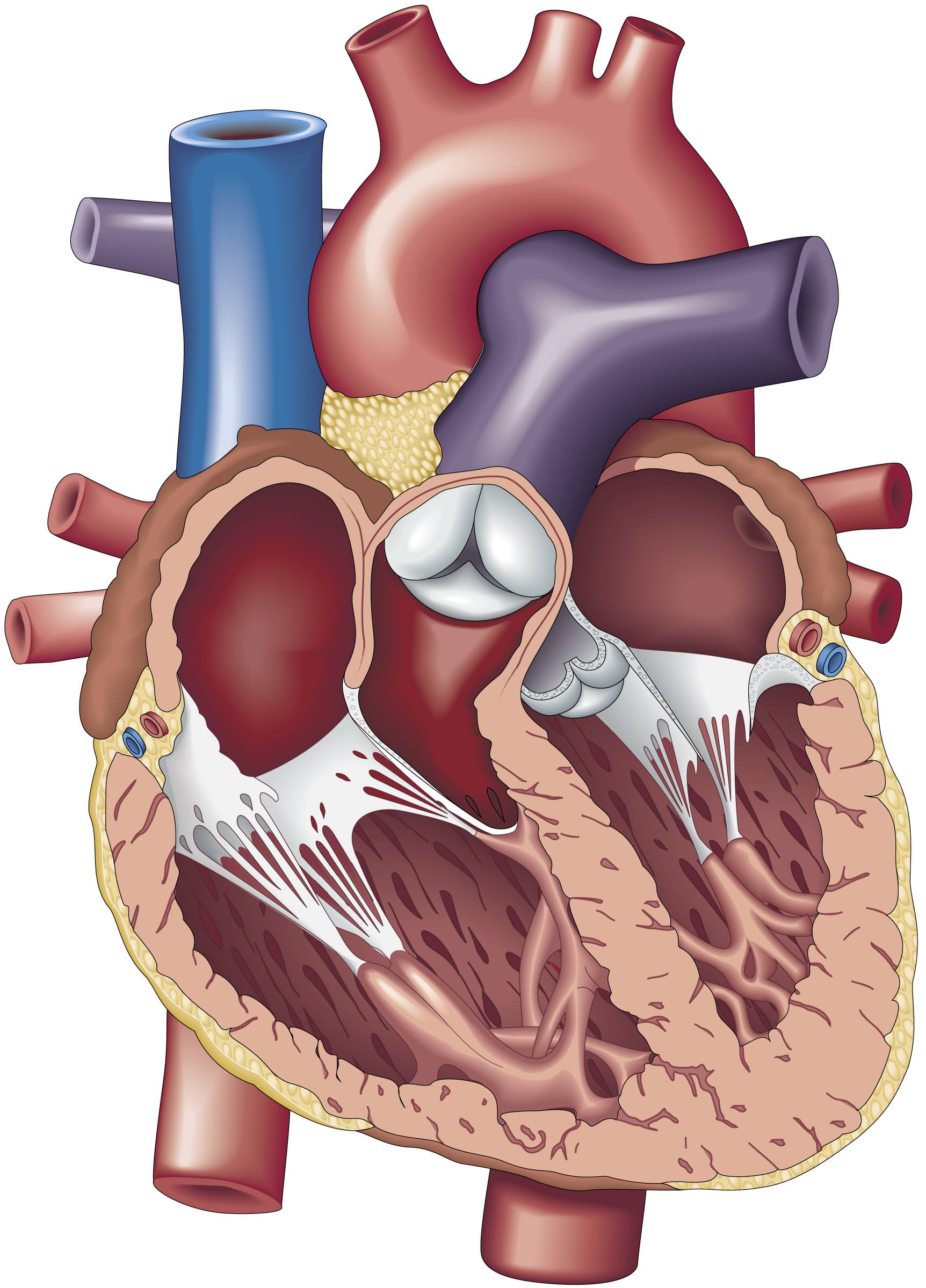في الدنمارك، يعد كل من يبلغ الـ18 من عمره مؤهلا للخدمة العسكرية. ولكن في الوقت الحاضر، لا يجري تجنيد إلا بضعة آلاف ويخضعون جميعهم للتقييم، الذي يشتمل على إجراء اختبارات الذكاء. وحتى وقت قريب، كان يستخدم الاختبار نفسه المستخدم منذ حقبة الخمسينات.
وجاءت النتائج مفاجئة؛ إذ خلال تلك الفترة كانت هناك زيادة كبيرة في متوسط ذكاء الشباب الدنماركي، لدرجة أن ما كان يعد متوسطا للذكاء في عقد الخمسينات يعد في الوقت الحالي معدلا منخفضا بما فيه الكفاية لعدم تأهيل وقبول الفرد في الخدمة العسكرية، على حد وصف الدكتور توماس تيسديل، وهو طبيب نفسي لدى جامعة كوبنهاغن.
جرى تسجيل الظاهرة ذاتها في العديد من الدول الأخرى. ولما لا يقل عن قرن من الزمان، كان كل جيل جديد أكثر ذكاء من سلفه على نحو ملموس. ولكن يبدو أن ذلك الفصل المبهج من التاريخ الاجتماعي قد قارب على الانتهاء.
في الدنمارك، سجل معظم الارتفاع السريع في معدل الذكاء، بنحو 3 في المائة لكل عقد، في الفترة من الخمسينات إلى الثمانيات. وبلغ المعدل ذروته في عام 1998، ثم انخفض بشكل كبير بنسبة 1.5 في المائة منذ ذلك الحين. ويبدو أن شيئا مماثلا يجري في عدد قليل من الدول المتقدمة، كذلك، بما فيها المملكة المتحدة وأستراليا.
لماذا كانت معدلات الذكاء تشهد ارتفاعا حول العالم؟ وبقدر أكبر من الأهمية، لماذا يبدو أن ذلك الارتفاع يقترب من نهايته؟ إن أكثر التفسيرات المثيرة للجدل هي أن معدلات الذكاء المرتفعة كانت تخفي وراءها انخفاضا في إمكاناتنا الجينية. ولكن هل يمكن لذلك أن يغدو صحيحا؟ هل نواجه حقا مستقبلا من الانخفاض التدريجي في قوة الذكاء؟
* ازدياد الذكاء
* لا جدال حول أن الذكاء – الذي يجري قياسه، على أقل تقدير، من خلال اختبارات معدل الذكاء «Intelligence quotient IQ» - قد شهد ارتفاعا كبيرا منذ صياغة الاختبارات لأول مرة قبل قرن من الزمان مضى. وفي الولايات المتحدة، ارتفع متوسط الذكاء بمعدل 3 نقاط لكل عقد فيما بين عامي 1932 و1978، كما هي الحال بشكل واضح في الدنمارك. وفي اليابان عقب الحرب، ارتفعت نسبة الذكاء بمعدل مذهل بلغ 7.7 نقطة لكل عقد، وبدأت في الارتفاع بعد ذلك بعقدين بمعدل مماثل في كوريا الجنوبية. وفي كل مكان بحث فيه أطباء النفس كانوا يجدون النتائج نفسها.
وصار ذلك الارتفاع الثابت في درجات اختبارات الذكاء يعرف باسم «تأثير فلين» Flynn effect على اسم جيمس فلين من جامعة أوتاغو في نيوزيلندا، الذي كان من أوائل العلماء الذين وثّقوا ذلك الاتجاه.
وألف العديد من المؤلفات حول ماهية وكنه ذلك الاتجاه ولماذا يحدث. قد يكون هناك عنصر ثقافي، مع ارتفاع موجة مشاهدة التلفاز، والكومبيوترات، والأجهزة المحمولة، التي صقلت بعض المهارات الخاصة لدينا. وأكبر زيادة في معدل الذكاء تشمل المهارات المرئية المكانية. ويلعب الإلمام المتزايد بصيغة الاختبار دورا كذلك.
النظرة العامة، مع ذلك، هي أن الصحة السيئة والبيئات الفقيرة دائما ما أعاقت تقدم البشرية، ولا تزال في العديد من البلدان. ومتى ما بدأت الظروف في التحسن، على الرغم من ذلك، يبدأ «تأثير فلين» في الارتفاع. ومع التغذية المحسنة، والتعليم الجيد، والتحفيز الموجهة إلى الأطفال، يصبح العديد من الناس حول العالم أكثر ذكاء بالفعل.
إذا كانت التغذية السليمة مع التعليم الجيد لهما أثر بارز في ارتفاع معدلات الذكاء، فإن المكاسب من وراء ذلك يفترض على وجه الخصوص أن يكون لها وقع كبير على الطرف الأدنى من النطاق، ويقصد بذلك الأطفال للآباء الذين يتمتعون بالقليل من المزايا في حياتهم. وإذا كانت التحسينات الاجتماعية تقف وراء «تأثير فلين»، وصارت عوامل أخرى مثل التعليم والتغذية المحسنة أمرا اعتياديا في دولة من الدول، فإن آثار زيادة الذكاء سوف تتدهور مع الوقت، في كل بلد. يقول فلين: «كنت أتوقع لفترة من الزمن أنه ينبغي علينا مشاهدة مؤشرات حول ذلك تبدو في الأفق». وتلك المؤشرات باتت جلية بالفعل. يبدو أننا على أعتاب نهاية تأثير فلين، خصوصا في الدول المتقدمة.
ولكن معدلات الذكاء ليست في طريقها إلى التوقف، ورغم ذلك فإنها تبدو في انخفاض مستمر. والدليل الأول على التدني الطفيف جرى تسجيله في النرويج في عام 2004. ومنذ ذلك الحين خلصت سلسلة من الدراسات إلى تسجيل انخفاضات مماثلة في بعض الدول المتقدمة للغاية بما فيها أستراليا، والدنمارك، والمملكة المتحدة، والسويد. والدليل الأخير، الذي جرى تسجيله العام الماضي، جاء من هولندا وفنلندا وفقا لتقرير نشرته مجلة «نيوساينتست» البريطانية.
* التدني الكامن
* حتى إذا لم يكن تدني مستويات الذكاء خاضعا للمصادفة، فإنه يمكن إسناد مستويات التدني الطفيفة إلى التغيرات البسيطة في الظروف الاجتماعية مثل هبوط مستويات الدخل أو التعليم السيئ. ولكن هناك احتمالات مزعجة، حيث يعتقد بعض الباحثين أن «تأثير فلين» قد أخفى التدني الكامن في الأساس الجيني للذكاء. وبعبارة أخرى، على الرغم من أن بعض الناس قد اقتربوا كثيرا من الإمكانات الكاملة للذكاء، فإن تلك الإمكانات كانت في طريقها للاضمحلال.
يتفق معظم علماء السكان على أنه خلال الـ150 عاما الماضية في الدول الغربية، فإن الأفراد ذوي التعليم الراقي كان يولد لهم القليل من الأطفال على غير الطبيعي بين السكان بوجه عام. والفكرة في أن الأفراد ذوي التعليم العادي يتفوقون في الإنجاب على غيرهم ليست أمرا جديدا، على شاكلة الاستدلال القائل بأننا نتطور لكي نكون أقل ذكاء.
أدت هذه الفكرة إلى برنامج تحسين النسل الموسع في الولايات المتحدة، مع حالات التعقيم القسري، التي بدورها ساعدت في إلهام سياسات «النقاء العنصري» في ألمانيا النازية. ذلك التاريخ غير السار، على الرغم من ذلك، لا يعني أنه لا توجد حالة من الاضمحلال الجيني، كما يزعم البعض.
وقد حاول ريتشارد لين، من جامعة ألستر في المملكة المتحدة، وهو طبيب نفسي غالبا ما أثارت أعماله الجدل، حساب معدل التدهور في الإمكانات الجينية لدينا باستخدام القيم المطبقة في قياس معدل الذكاء حول العالم في عام 1950 وعام 2000. وجاءت النتيجة: تسجيل الهبوط بأقل من نقطة معدل ذكاء واحدة، حول العالم، في الفترة بين عامي 1950 و2000. وإذا استمر الاتجاه في مساره، فسوف تكون هناك 1.3 نقطة هبوط أخرى بحلول عام 2050. وحتى مع افتراض صحة ما وصل إليه - وهو افتراض كبير - فإن ذلك لا يعد إلا تغييرا طفيفا للغاية عند مقارنته بـ«تأثير فلين».
هل تثير مستويات الهبوط الطفيفة تلك أي اهتمام يذكر؟ أجل، كما يدفع السيد مايكل وودلي، وهو طبيب نفسي لدى جامعة بروكسل الحرة في بلجيكا. ذلك النوع من التطور من شأنه أن يغير منحنى الجرس للذكاء، على حد زعمه، ويمكن لتحول طفيف أن يؤدي إلى هبوط حاد في عدد الدرجات المسجلة. فعلى سبيل المثال، إذا انخفض متوسط معدل الذكاء من 100 نقطة إلى 97 نقطة، فسوف يعني ذلك انخفاض عدد الأفراد الذين يحصلون على درجة 135 في اختبار معدل الذكاء إلى النصف.. «إنه تأثير فعال»، كما يقول وودلي.
ومع العديد من العوامل المربكة، ليس من الواضح ما إذا كان تأثير «التطور باتجاه الغباء» حقيقيا. والسبيل الوحيد الجازم لتسوية تلك المسألة يكون من خلال معرفة ما إذا كانت المتغيرات الجينية ذات الصلة بمعدلات الذكاء المرتفعة قد صارت أقل شيوعا. والمشكلة الكامنة وراء تلك الفكرة هي، وحتى يومنا هذا، وعلى الرغم من الجهود الضخمة، أننا فشلنا في العثور على أي متغير جيني محدد يرتبط بمعدلات الذكاء المرتفعة بصورة كبيرة في الأشخاص الأصحاء.
ومع ذلك، يعتقد وودلي أن فريقه قد عثر على دليل جلي حول التدني في الإمكانات الجينية لنا، وهو يزعم أن ذلك يحدث بوتيرة أسرع مما تقترحه حسابات لين. وبدلا من الاستناد إلى تقديرات الخصوبة، تحول وودلي إلى مقياس أبسط: وقت رد الفعل. فالأناس سريعو البديهة، على ما يبدو، يوصفون بأنهم: الناس الأذكياء الذين تولد لديهم ردود الفعل في وقت وجيز، ربما بسبب أن معالجة المعلومات لديهم تجري بصورة أسرع.
وتوصل فريق وودلي عند تحليله لدراسات سابقة حول الارتباط المعروف بين وقت رد الفعل والذكاء، إلى أن أوقات رد الفعل قد تباطأت بالفعل عبر قرن من الزمان، بمعدل يقترب من فقدان نقطة معدل ذكاء كاملة لكل 10 سنوات، أو أكثر من 13 نقطة منذ العصر الفيكتوري.
وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي رد وودلي على خصومه وأكد أن أدمغة اليوم تعمل بوتيرة أبطأ حتى مع وضع كل تلك التفسيرات الأخرى في الحسبان. ولكن حتى مع كونه محقا بشأن أوقات رد الفعل، فإن الرابطة بين معدل الذكاء ووقت رد الفعل ليست بالرابطة القوية الراسخة: حيث يفسر وقت رد الفعل نسبة 10 في المائة فقط من المتغيرات في معدل الذكاء.
ويقول كيفن ميتشل، وهو عالم في الجينات العصبية لدى جامعة ترينيتي في دبلن بآيرلندا: «على الأرجح، فإن كل جيل يشكو من قلة ذكاء الجيل الجديد عليه، وكل طبقة راقية تشكو من تفوق الطبقات الدنيا في المجتمع من حيث الإنجاب. والفرضية الأساسية تكمن في أن مستويات الذكاء في هبوط مستمر. ولا أرى أي دليل على ذلك، وهو السبب وراء أنني أرى الجدال حول ذلك أمرا يدعو للاستغراب».
وعلى المدى الطويل، قد يكون هناك تهديد أساسي على مستويات الذكاء لدينا. إن البشر يتغيرون سريعا، ولدى كل واحد منا ما بين 50 و100 طفرة جديدة لم تكن واضحة في آبائنا، ومنها طفرات قد تكون ضارة، على حد قول مايكل لينش، وهو عالم في الوراثة التطورية لدى جامعة إنديانا في بلومينغتون.
هل يتطور البشر باتجاه الغباء؟ يجادل عدد قليل من الباحثين حول حدوث ذلك الأمر عبر القرن الماضي أو نحوه، ولكن كان من الممكن أن يستمر الأمر لفترة أطول. هناك أمر واحد يقيني: ظلت أدمغتنا في تقلص مستمر عبر ما لا يقل عن 10 آلاف عام. والمرأة الأوروبية العادية اليوم، على سبيل المثال، لديها مخ أقل بنسبة 15 في المائة من نظيرتها عند نهاية العصر الجليدي.
كان يقال إنه مع ارتفاع الزراعة ونشوء المدن، وزيادة معدلات العمالة، يمكن للناس أن ينجوا ويستمروا حتى لو لم يكونوا أذكياء ويتمتعوا بالاكتفاء الذاتي مثل أجدادهم من الصيادين وجامعي الأغذية.