ليس هناك من يجادل في أن ستيفن هوكنغ، الفيزيائي الراحل، واحدٌ من ألمع علماء عصرنا. فقد حصل الرجل على معظم الجوائز التي تحصلها أعاظم الفيزيائيين قبله، وكانت جائزة نوبل قريبة منه لولا أن أعراف الجائزة تقضي بمنحها لمن يمكن التثبت من مقارباته الفيزيائية النظرية بالقياسات العملية المؤكدة، ولن ننسى كون الرجل وريث العبقري الإنجليزي «إسحق نيوتن»، عندما شغل مرتبة الأستاذية التي كان نيوتن يشغلها في جامعة كامبردج قبل نحو ثلاثة قرون ونصف القرن. هذه كلها حقائق معروفة مقطوع بصحتها؛ لكني أود في هذه المقالة تناول خصيصة محدّدة في شخصية هوكنغ، وهي كونه مؤلفاً للكتب واسماً ذائع الصيت شغل دور النشر والقرّاء في شتى أرجاء العالم.
لم يكن ستيفن هوكنغ اسماً معروفاً في الأوساط الشعبية على مستوى العالم قبل نشر كتابه ذائع الصيت «موجز تاريخ الزمان» عام 1987 (تولّت دار المأمون العراقية نشر الترجمة العربية الأولى للكتاب مطلع تسعينات القرن الماضي، ثمّ تتالت الترجمات العربية بعد ذلك)، ولم يكن ذلك الكتاب أوّل كتاب يؤلّفه هوكنغ، فقد كانت له مؤلفات أخرى ذات طابع أكاديمي متشدد ولغة رياضياتية صارمة. وأذكر هنا كتابه الأول الذي نشره عام 1973 بعنوان «بنية الزمكان على المقياس الكبير»، بالتعاون مع الفيزيائي «جورج إيليس»، وتولّت جامعة كامبردج طبعه وتوزيعه. إنّ ما يميّز كتاب «موجز تاريخ الزمان» كونه الكتاب الأوّل الذي كتبه هوكنغ لعامّة القرّاء، طبقاً لتوجيهات صارمة وخطوط إرشادية لدار النشر التي تولّت نشر الكتاب. وقد أفرد هوكنغ في كتاب منشور له عام 2013 بعنوان «موجز تاريخ حياتي» فصلاً كاملاً أراه من بين أوضح ما كُتِب بشأن التفاصيل الدقيقة التي تحكم علاقة الكاتب بالناشر، والتي غالباً ما تخفى على عامّة الناس. نقرأ في مقدّمة ذلك الفصل العبارات التالية:
راودتني للمرة الأولى فكرة كتابة كتاب علمي لعامة الناس حول الكون عام 1982. كانت نيّتي من وراء كتابة ذلك الكتاب - جزئياً - هي الحصول على ما يكفي من المال اللازم لتسديد نفقات دراسة ابنتي (الحقيقة أنّ الكتاب نُشِر بعد أن بلغت ابنتي سنتها الدراسية الأخيرة!!)؛ لكنّ الدافع الأكبر لكتابة كتابي ذاك هو رغبتي الجامحة في جعل الناس يدركون كم بلغنا في فهمنا للكون، وكم نحن قريبون من بلوغ نظرية قادرة على وصف الكون وكلّ شيء فيه.
كنت أفكّر آنذاك أنني إذا ما عزمت على بذل ما يكفي من الوقت والجهد في كتابة كتاب، فينبغي له أن يبلغ أكبر عد ممكن من القراء. جرت العادة أن تُنشر كتبي التقنية السابقة من قبل مطبعة جامعة كامبردج المرموقة، التي نشرتها بعد بذل جهود طيبة محمودة؛ غير أنّ شعوري السائد بشأن كتابي المتوقع هو أن جامعة كامبردج لا تملك مزاج النشر لكتابٍ من النوع الذي أسعى لوصوله إلى عامة الناس. لذا اتصلتُ بوكيل أدبي يدعى آل زوكرمان (Al Zuckerman)، كنت قد تعرّفتُ عليه سابقاً بوصفه صهر زميلٍ لي، وسلّمته مسوّدة الفصل الأول من كتابي، وأخبرته بأنني أريد للكتاب أن يكون من نمط الكُتُب التي كثيراً ما نشهدها تُباع في أكشاك بيع الكتب المنتشرة في المطارات. أخبرني زوكرمان لاحقاً بأنه ليس ثمة فرصة للكتاب في أن يحقق ما أصبو إليه، فهو قد يحقق مبيعات جيدة بين أوساط الأكاديميين والطلّاب، ولكنه لن يرقى بأي حال من الأحوال إلى تخوم مملكة «جيفري آرتشر».
ثم يتابع هوكنغ بعد هذا المقطع الافتتاحي تفاصيل رحلته في عالم النشر المخصّص لعامّة القرّاء، وهي تفاصيل رائعة أرى من المهمّ أن يطّلع عليها كلّ من يعتزم الكتابة في حقل ما أصبح يسمّى «الثقافة الثالثة» التي تسعى لتجاوز كلّ من الثقافتين الكلاسيكيتين الأدبية والعلمية نحو ثقافة جديدة تسائلُ أصول الأشياء: أصل الكون، والوعي، والحياة. لم يكن باستطاعة هوكنغ أن يغفل عن ملاحظة زوكرمان، فأعاد النظر في المسودة الأولى قصاً وتشذيباً وإعادة كتابة، وراحت المسودات تتنقل بين هوكنغ والمحرر لمرات كثيرة حتى استقر الكتاب على شكله النهائي الذي راقَ للناشر.
حقّق كتاب «موجز تاريخ الزمان» نجاحاً مدوياً مستحقاً لهوكنغ؛ والحقّ أنّ هذا الكتاب هو أحد أفضل الكتب التي تناولت تاريخ الكون ومستقبله، ولستُ في حاجة للقول إنّ هذا الكتاب جعل من هوكنغ مليونيراً، يكاد مرتبه الجامعي يبدو شيئاً تافهاً، بالمقارنة مع الملايين الكثيرة التي هبطت عليه من ريع كتابه هذا.
كتب هوكنغ بعد نشر كتابه «موجز تاريخ الزمان» عدداً آخر من الكتب، تفصل بينها فترات قصيرة نسبياً. وبالعودة إلى خاتمة الفصل الأخير من كتاب «موجز تاريخ حياتي» سابق الذكر، نقرأ العبارات التالية:
منذ نشر كتاب «موجز تاريخ الزمان»، نشرتُ عدداً من الكتب الأخرى بقصد توضيح بعض التفاصيل العلمية لأوسع عدد ممكن من الناس. ومن بين هذه الكتب: الثقوب السوداء والأكوان الوليدة، والكون في قشرة جوز، والتصميم العظيم. وأرى أنّ من الأمور عظيمة الأهمية أن يمتلك الناس فهماً أساسياً للعلم، لكي يحوزوا القدرة على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات جوهرية في عالمنا الذي بات معتمداً أكثر من ذي قبل على الإنجازات العلمية والتقنية، ولا ينبغي هنا نسيان الإشارة إلى أنني وبمعية ابنتي لوسي كتبنا سلسلة من الكتب تحت عنوان رئيسي يجمعها هو «جورج»؛ وهي كتب مؤسسة على حكايات صيغت في قالب مغامرات علمية الطابع موجّهة للأطفال الذين هم شباب الغد.
ثمة قناعة سائدة عند العلماء والمتخصّصين بالنشر أنّ كتاب «موجز تاريخ الزمان» كان العمل الأفخم الذي كتبه هوكنغ، وأنّ كتبه اللاحقة جاءت نسخاً مكتوبة على عجالة، وفيها كثير من الإسهاب وإعادة الأفكار والدوران حول صياغات محدّدة، وبما يوحي للقارئ الحصيف وكأنّ هوكنغ صار شخصية مطواعة لا تعمل لغير ترضية متطلبات الناشرين، وكسب المال منهم. وأنا هنا أشير لحقيقة حصلت، ولا أريد اعتبار الأمر مثلبة ارتكبها هوكنغ.
يخبرنا واقع الحال السائد أنّ كثيراً من الذين يحققون مبيعات ضخمة لأحد كتبهم (سواء أكانوا روائيين أو علماء أو كُتّاباً في شتى المناشط المعرفية) غالباً ما تنشأ بينهم وبين دور النشر علاقة عُرْفية غير مكتوبة، مفادُها: واصل الكتابة بأي شكل من الأشكال لكي تستثمر اسمك وتربح المال! وحتى لو افترضنا وجود شيء من الطهرانية التي تترفّع على إغراء تحصيل المال بعد أن انفتحت مغارة «افتح يا سمسم» أمام هؤلاء، فلربما سيصبحون مدفوعين بضغوط شديدة لا يستطيعون ردّها من قبل عوائلهم (الزوجة أو الزوج أو الأولاد) من أجل تحصيل القدر الأكبر من الأموال المتاحة. إنّ أمثولة هؤلاء في الحياة هي أن الدنيا شطارة، واغتنام الفرص المتاحة حق مكتسب، حتى لو جاء بغير جهد أو اجتهاد.
حَضَرَتْ كلّ تلك التساؤلات أمامي بعد أن أكملتُ قراءة الكتاب الأخير الذي نُشِر باسم هوكنغ عقب وفاته، وهو بعنوان «إجابات موجزة عن أسئلة كبيرة»، ورحتُ أتساءل: هل يضيف هذا الكتاب شيئاً مؤثراً للقارئ المتطلب الشغوف بالقراءات العلمية الجادة؟ لو استعرضنا الكتاب بقراءة مسحية سريعة، لرأينا أنه يتناول طائفة ما يسمّى «الأسئلة الكبرى»، أي الأسئلة التي تتناول أصول الأشياء، وقد أسهب هوكنغ في الحديث عنها في مقالات وحوارات سابقة له، فعلامَ إذن استعجل أبناؤه في تجميع هذه المقالات ونشرها في كتاب؟ هل أرادوا استغلال اسم أبيهم وحلب آخر قطرة من المال يمكن أن يجود بها؟ وهل ستنفع الأكسسوارات التي أضافها الناشر (كتابة مقدّمتين للكتاب: واحدة لفيزيائي ذائع الشهرة، والأخرى للممثل البريطاني الذي أدى دور هوكنغ في فلم «نظرية كل شيء») في إثراء المادة التي يحتويها؟
هذه بعض مظاهر سطوة المال في عالم كنّا نظنّ فيه أنّ أبناء هوكنغ (ومن خلفهم دور نشر بالطبع) ستكرّم ذكرى هوكنغ بطريقة أرفع من استغلال اسمه لحلب أموال إضافية لهم.
نحن نقدّر هوكنغ، ونرى فيه ممثلاً عظيماً للروح الإنسانية الخلاقة في أعظم تجلياتها؛ ولكنّ عالم المال له حساباته المتغوّلة التي تأبى أن تنكفئ حتى أمام ذكرى عبقري مقعد قضى معظم حياته وهو مُقيّد إلى كرسي بعجلتين!
- كاتبة وروائية ومترجمة
عراقية تقيم في الأردن
سطوة المال... وستيفن هوكِنغ
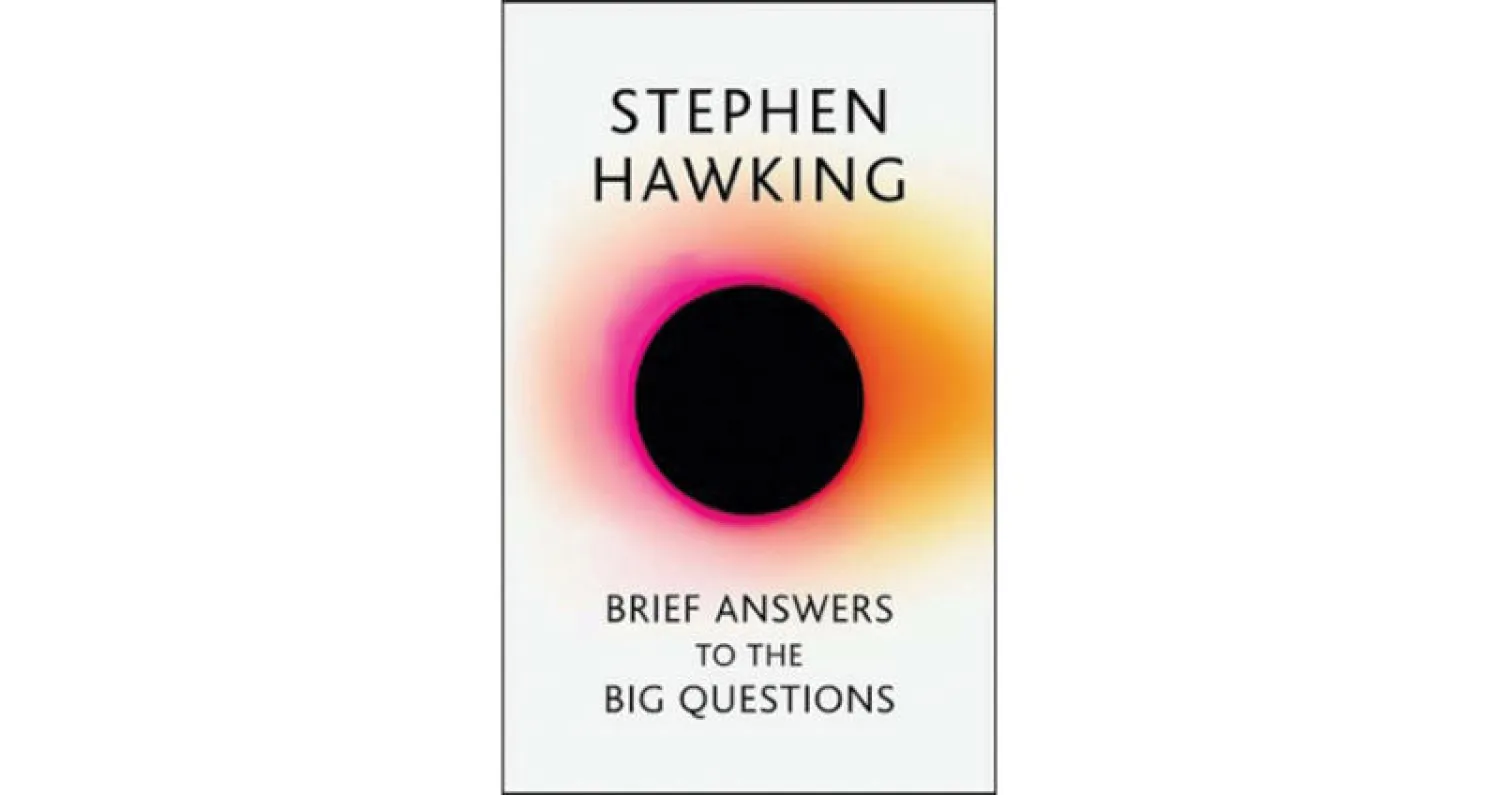

سطوة المال... وستيفن هوكِنغ
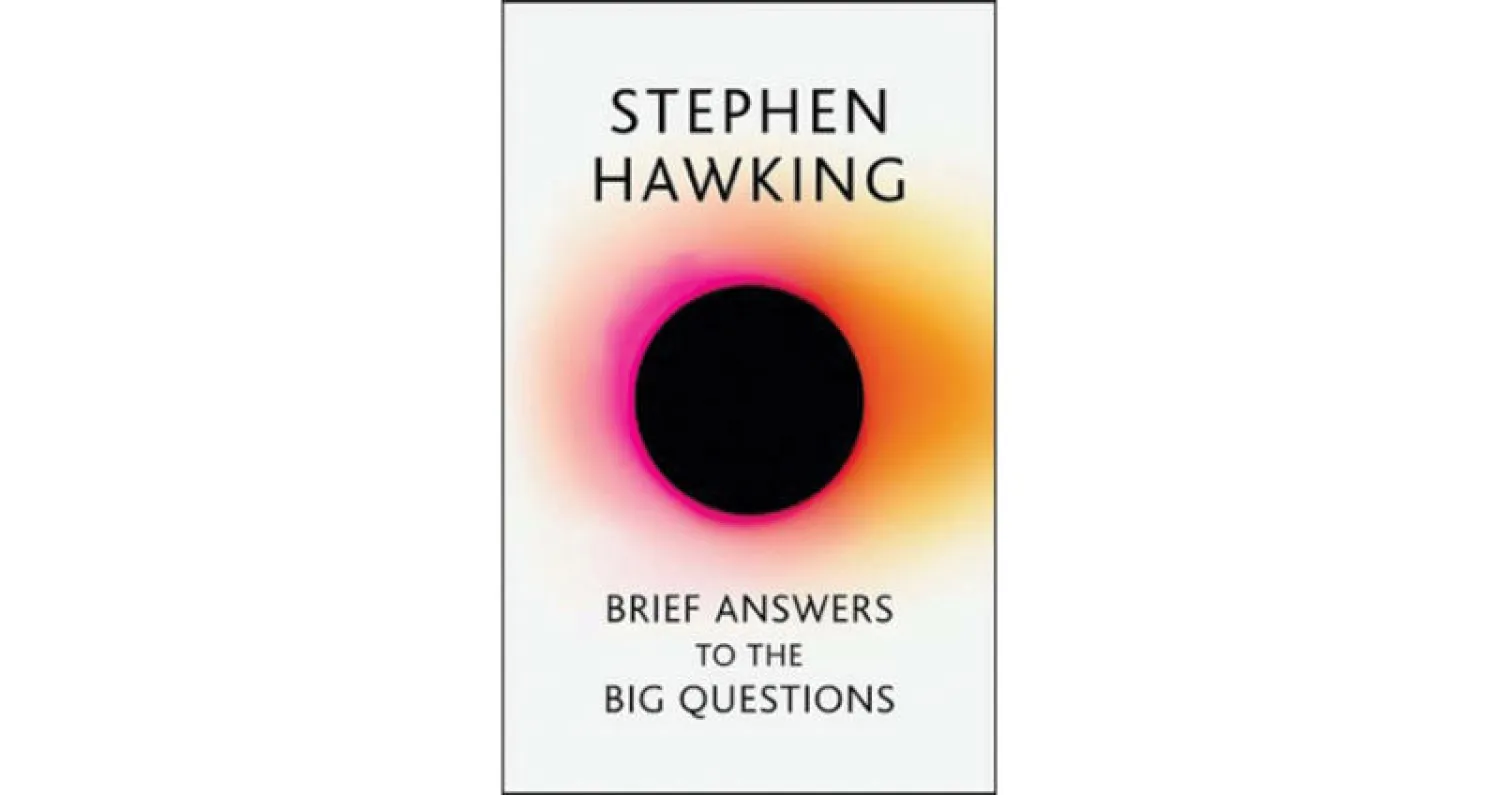
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة









