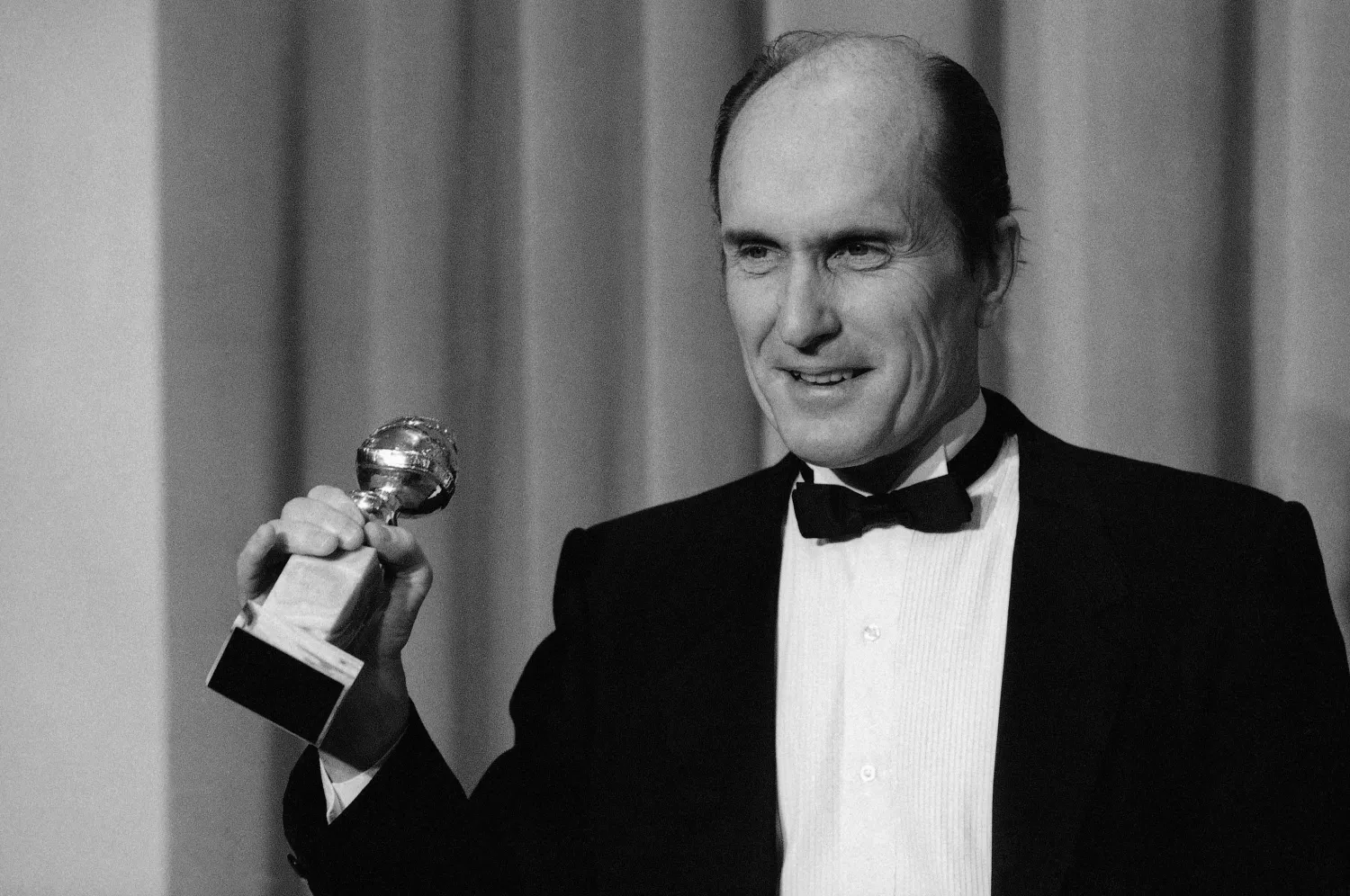The King Lion
* إخراج: جون فافريو
* تقييم:(وسط)
حكاية معهودة تصبح معهودة أكثر
بينما كان هذا الناقد يتساءل، منذ مطلع الفيلم، عن السبب الذي من أجله علينا أن نشاهد شخصيات من الحيوانات الناطقة، كان الجمهور الكاسح يقف خلف هذا الفيلم بكل حماس متسبباً في رسم الابتسامة العريضة على وجوه كل العاملين فيه والمتعاملين معه.
ديزني تعيد طبخ أفلامها هذه الأيام فتنجز على التوالي أعمالاً سبق وأن قدمتها في الستينات والسبعينات وما بعد مثل «كتاب الغابة» و«دامبو» و«علاء الدين». لكن «الملك الأسد» السابق (1994) كان فيلم أنيميشن كما كان حال «علاء الدين» الذي سبقه للعروض هذه السنة وتم تحويله إلى فيلم من بطولة بشر أحياء. المشكلة هي أن «ذا ليون كينغ» كونه من بطولة حيوانات لا يستطيع أن يتحول إلى فيلم حي. على الأرجح ستنقلب الحيوانات المستعان بها (أسود، فيلة، غزلان، ضباع، طيور) لأكل بعضها بعضاً.
الحل الوحيد هو الاستعانة بنظام الكومبيوتر غرافيكس لتنفيذ كل شيء نراه. من الحيوانات ذاتها إلى الصخور ومنها إلى الأشجار والأنهار وحتى نسمات الريح التي تتلاعب بشعر رأس الأسد الأب (صوت جيمس إيرل جونز الذي قام بالأداء الصوتي للدور نفسه في نسخة 1994 كذلك) وهو يوصي ابنه بما هو مطلوب منه لمواجهة تحديات المستقبل.
الأسد الصغير سيمبا (صوت دونالد غلوفر) عليه أن يشق ذلك الطريق وحده. أن يواجه المخاطر. يكفي المشهد الذي يلتقي فيه لأول مرّة بالضباع. عليه أن يفرق بين الصديق والعدو وعليه أن يتصرف بحكمة تتجاوز عمره الصغير فهو لا يزال شبلاً.
وبينما يهندس مصممو ومنفذو المؤثرات الغرافيكية معظم الشخصيات الحيوانية الأخرى بقدر كبير من المعرفة، تبقى حركات سيمبا أشبه بحركات الجرو منه إلى حركات الشبل. هنا نظرت حولي وأرهفت السمع لعل أحدهم لاحظ ذلك. هذا قبل أن يتحول هذا التنفيذ الساذج إلى مجرد قبول بالأمر الواقع. أو ربما عدم معرفة معظم المشاهدين بأن تصرف الكلاب، صغيرة أو كبيرة، تختلف - في التفاصيل كلها - عن تصرفات الأسود بمختلف أعمارها.
إحدى مهام تجاوز هذه العقدة حقيقة أن الكتابة ستضع على كاهل الشبل أكثر مما يحتمله. فإلى جانب تشرده في البراري الأفريقية وبين مؤثرات الكومبيوتر، يشعر بذنب دفين كونه يعتقد بأن تسبب في مقتل أبيه، بينما الفاعل ليس سوى عمّه الشرير (شيويتل إيفيجور). لكنها ما هي إلا ساعة واحدة قبل أن يكتشف الشبل الحقيقة ويعود لاستعادة مكانته.
هذه النهاية تستطيع أن تشاهدها إذا ما وقفت على واحدة من صخور الفيلم الشاهقة ونظرت إلى اتجاه الأحداث. أحياناً هي واضحة من حيث تجلس على كرسيك أمام الشاشة.
9:11 دقيقه
شاشة الناقد: The King Lion
https://aawsat.com/home/article/1829786/%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%AF-king-lion



شاشة الناقد: The King Lion

«ذا ليون كينغ».

شاشة الناقد: The King Lion

«ذا ليون كينغ».
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة