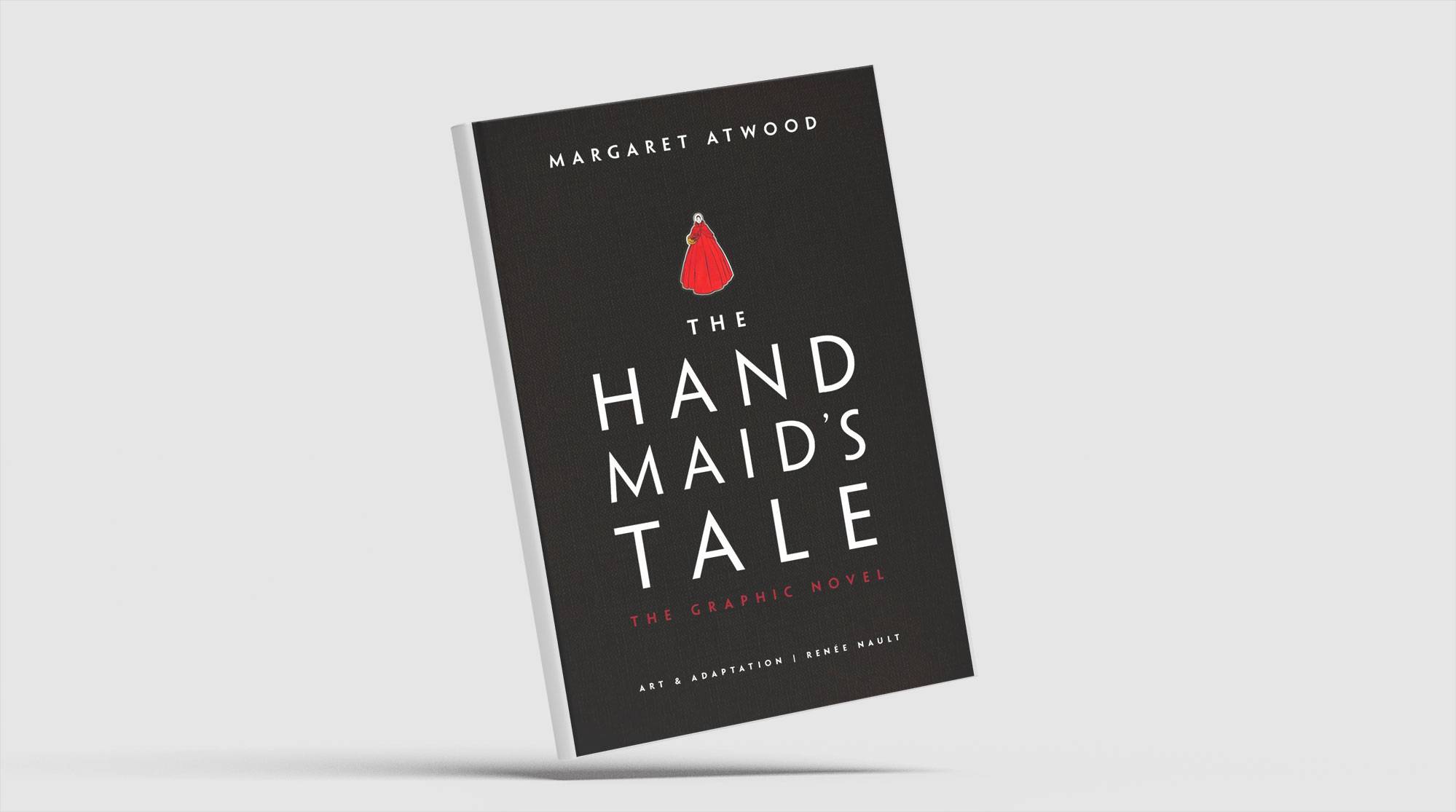مع التغيرات التي طالت مؤخرا نظرة العرب للقضية الفلسطينية، والتبدل الحاصل في الموقف الشعبي من فكرة المقاومة في شكلها «الحمساوي»، الإسلامي، خلال الأسابيع السبعة الأخيرة من العدوان على قطاع غزة، ربما باتت الفرصة مواتية لمراجعة تجسيد صورة الآخر الإسرائيلي في الثقافة العربية المعاصرة أيضا، وخاصة تناول الرواية لتلك الصورة، باعتبارها أكثر التجليات الثقافية رواجا، بعد الدراما التلفزيونية.
في روايته «جنين 2002» (2014، المؤسسة العربية للدراسات والنشر)، يتناول الروائي الفلسطيني أنور حامد، حادثة اجتياح الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين الواقع في الضفة الغربية في أبريل (نيسان) 2002، والعملية العسكرية الوحشية التي دارت في أعقابها على امتداد أكثر من عشرة أيام.
تدور أحداث الرواية حول شخصية «ديفيد أشكنازي»، المجند الشاب الذي يشارك في عملية اجتياح المخيم. وأثناء تفتيش أحد البيوت، يعثر ديفيد على مذكرات صبية تدعى «أريج الشايب»، دونتها خلال فترة حصار الجيش الإسرائيلي للمخيم. يعمل ديفيد، لاحقا، على ترجمة مذكرات أريج إلى العبرية، فتفجّر في داخله مجموعة من الأسئلة تطال مباشرة معتقداته ومفاهيمه للوطن والهوية، أي ما كان بالنسبة له من المسلمات، لتقوده في نهاية المطاف إلى العزلة ومن ثم الانتحار. يتشارك البطلان «الضدان»، سرد الأحداث، فنصف العمل يدور في رأس المجند الشاب، والنصف الآخر يحضر من خلال دفتر مذكرات الفتاة الفلسطينية التي تقرر أن توثق يوميات الحصار.
من حيث المبدأ، نحن أمام عمل أدبي دسم. فالموضوع يشكل نقطة مهمة من تاريخ الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، والبنيان السردي واعد: فلا راو عليم يفسد على القارئ متعة البحث والتحليل والاستكشاف، ولا بطل أوحد يستأثر بمهمة الحكي. على العكس، ومن الجانب النظري، فالبنية المتوازنة للعمل، من ناحية توزيع الأدوار بالتساوي بين ديفيد وأريج، تعد بنوع من التكافؤ في الأصوات الروائية، الأمر الذي يصعب تحقيقه في النصوص الأدبية التي تعالج الصراعات الكبرى والقضايا الإشكالية.
إلا أن القارئ، وبعد تجاوز الصفحات الأولى، يصاب بنوع من الدوار، ذلك أن ميزان حامد السردي سرعان ما يباشر التأرجح. فمن المستغرب حقا أن يُقدم كاتب فلسطيني الآن، وبعد مضي أكثر من ستة عقود على احتلال فلسطين، على تصوير الآخر الإسرائيلي بهذه العجالة، لا بل حتى السطحية. إذ إن تجسيد الكاتب لشخصية ديفيد جاء مطابقا لصورة الإسرائيلي النمطية الراسخة، للأسف، في المخيال العربي الشعبي: شخص محدود التفكير يعيش داخل فقاعة آيديولوجية كفيلة بأن تعزله كليا عن واقع فلسطيني لا تفصله عنه سوى بضعة أمتار.
ففي اليوم الأول لاقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين، وأثناء تفتيشه أحد المنازل، يندهش ديفيد حين يعثر داخل إحدى الغرف، على بعض الثياب الملونة، «توحي بأن نشاطا ما كان يدور هنا، نشاط غير عسكري. غريب!» (ص 54). ولدى إدراكه بأن بروفات مسرحية كانت تجرى في المنزل، يقول ديفيد بسذاجة: «لم يكن يخطر ببالي أن سكان المخيم يمارسون نشاطات كهذه». (ص 54).
في الواقع لا أدري ما الذي حدا بحامد لأن يرسم مثل هذا المشهد. وهل يعقل أن ديفيد، أو أي مجند إسرائيلي آخر، بهذا المستوى من العزلة، لا بل الغباء، لدرجة عدم معرفته فيما إذا كان أبناء المخيم يمارسون غير الأنشطة العسكرية؟ أيعقل لشاب في زمن الفضائيات والإنترنت، في أوائل الألفية الثالثة، أن يجهل طبيعة وعادات البشر القاطنين في المدينة المجاورة، حتى وإن كانوا أعداءه الفلسطينيين؟
لا تبدو التحولات التي تطرأ على شخصية ديفيد، بعد كل ما شاهده في المنزل مقنعة بدورها. فما شاهده داخل الغرفة، يقول ديفيد، كان كفيلا بأن «استعدت شيئا من وعيي الإنساني» (ص 55)، الأمر الذي جعله ينظر إلى «المكان (المخيم) بشكل مختلف». (ص 55). سذاجة ديفيد لا تنتهي هنا، فعند رؤيته صورا فوتوغرافية تعود لأصحاب المنزل، يعبر عن دهشته، إذ هي المرة الأولى التي يدرك فيها أن البيت الفلسطيني «فيه أيضا حياة عادية، تشبه حياتنا. فيه ناس يتناولون وجباتهم ويتبادلون الأحاديث، يزورون الجيران ويحتسون القهوة عندهم». (ص. 55) وكأنه اكتشف للتو، قبيلة بدائية على ضفاف الأمازون!
ولو اكتفى حامد بتصوير التمزق الداخلي للشخصية الإسرائيلية، ما بين ولائها للأجهزة الأمنية وماكينتها الدعائية التي تروج لفكرة أن «منفذي الكثير من العمليات الإرهابية الأخيرة (في إسرائيل) من جنين» (ص 51) وبين رفضها المشاركة في «هدم بيوت على رؤوس أصحابها»، أي لو جاء التركيز على معضلة البطل الأخلاقية لحظيت الشخصية بقبول أكبر، خصوصا أن الرؤية لدى الأفراد، تتداخل أثناء الصراعات، ويصعب التمييز بين الحدود الفاصلة، هذا إن وجدت، بين البياض والسواد. ولكن للأسف، يقع حامد في شراك الصورة النمطية للإسرائيلي الأمر الذي يؤدي إلى قيام الشخصية بتصرفات ساذجة.
طبعا نقطة التحول التي تنقل ديفيد من العتمة إلى النور، وتجعله يعيد النظر بموقفه من القضية الفلسطينية، تأتي مباشرة بعد عثوره على مذكرات أريج التي تشكل ذروة الحدث الدرامي التي تتحكم بخيوط العمل، وتسحبه بالاتجاه الذي يريده الكاتب. يقول ديفيد: «لاحظت أنها تقبض بيدها على شيء. كانت تمسك بكراسة مدرسية، عليها بقع دماء. كانت كأنها تحتضنها. هل كانت تعد واجباتها المدرسية؟ حاولت انتزاعها برفق. تمكنت من ذلك بصعوبة. تصفحت الكراسة. ما هذا؟ ليس هذا دفتر واجبات مدرسية. نص عربي، حاولت القراءة. أستطيع قراءة الخط العربي المطبوع، لا خط اليد، مع ذلك واصلت المحاولة. بدأت أتبين بعض الكلمات. غير معقول!! يا إلهي! هذه الفتاة كانت تكتب يومياتها! في أثناء القصف. أنا الآن في مواجهة أنا فرانك أخرى. أنا فرانك الفلسطينية» (ص 57).
من الأمور التي تؤخذ على العمل، الإيقاع السريع للأحداث. فحامد لا يعطي المشهد حقه من المسافة الزمنية، بما في ذلك المشاهد المفصلية. فهل يعقل أن يُمنح مثل هذا المشهد 78 كلمة فقط من أصل صفحات الكتاب التي تتجاوز الـ200؟ حتى إن سرعة البطل بالمقارنة بين أريج و«أنا فرانك» تحتاج إلى فطنة وسرعة بديهة تتناقض مع حجم السذاجة التي أظهرها طيلة العمل.
ليست هذه كل ما واجه ديفيد من أحداث في «أوديسته» عبر المخيم. في أحد البيوت، يعثر ديفيد على صحن فيه بعض من مربى المشمش، الطبق الذي يغير نظرته تجاه ساكني البيت الذين تفترض ثقافته أنهم إرهابيون، بينما هم أناس عاديون. يقول ديفيد: «أحسست بالجوع. داهمتني رغبة بتذوق مربى المشمش. غمست إصبعي بالطبق ولحسته. كان لذيذا. لا بد أن تلك المرأة المسجاة في الغرفة الأخرى كانت طاهية ماهرة. غمست إصبعي مرة أخرى، أحسست بشعور غريب» (ص57).
فصورة الإسرائيلي في هذا المشهد المفصلي هي استجرار لـ«كليشيه» مسطح يفتقد إلى أي عمق. وتجسيد ديفيد هو أقرب إلى التمثيل الطفولي للشخصيات. ديفيد، الذي فيما بعد تتكشف الجوانب الإنسانية من شخصيته، يبدو هنا ككائن متوحش يقتحم البيوت ويقتل أصحابها ومن ثم يتناول طعامهم. فالقارئ أمام مشهد كاريكاتيري مبسط، مرسوم بالأبيض والأسود، قد يصلح لوحة ضمن قصة لليافعين لا أكثر.
بالعودة إلى موضوع الطعام، تستحوذ المأكولات على حيز واسع من الكتاب تترك انطباعا لدى القارئ بأن ما بين يديه هو كتاب عن فنون الطبخ. ذلك أنه، وبخلاف كل التوقعات، يجد نفسه أمام عمل يسلط الضوء على تفاصيل جانبية غير منطقية في ظروف القتل والدمار. فعلى سبيل المثال، نقرأ في مذكرات أريج، أن الفتاة بعد أن وجدت نفسها وحيدة في بيت جدتها التي قتلت جراء القصف، شغلت نفسها بأمور الطبخ. مباشرة بعد مقتل جدتها أمام عينيها تصدمنا أريج بالتفكير فيما ستأكل أثناء الحصار، فتستعرض في ذهنها محتويات مطبخ جدتها «العامر» بـ«المشمش والعنب والسفرجل.. وكبيس الخيار.. والمقدوس من الباذنجان والفلفل» حيث «تحشي الأول بالجوز والثوم والثاني بالبندورة والبقدونس» (ص 89).
بعد مرور أيام على الحصار، وعلى الرغم من اضطرار أريج إلى التقنين بمحتويات المطبخ، تشعر الفتاة برغبة في تناول «الجبنة النابلسية»، وتتساءل بكل برود، بينما تتكوم جثة جدتها في الغرفة المجاورة: «ترى لماذا يسمونها جبنة نابلسية؟».
قد يقول البعض إن حامد استطاع أن يعرض للأحداث اليومية للمخيم التي غالبا ما تُعرِض عنها نشرات الأخبار. لا بل قد يجادل البعض الآخر بأن الروائي قد نجح في تقديم شخصية فلسطينية متحررة من الصورة النمطية للإنسان الفلسطيني، اليساري أو الإسلامي، ذلك أن أريج، الفتاة المراهقة التي تحب ابن الجيران عارف، والمولعة بالحياة والرقص مع الأصدقاء في حفلات عيد الميلاد تمثل محاولة جادة من قبل حامد لتقديم الإنسان الفلسطيني العادي المحب للحياة، المُعرِض عن جميع أنواع العنف والصراع. لكن تبقى أريج شخصية غير مقنعة، وتساؤلاتها الساذجة حول الطبخ، خصوصا إذا ما قيست بحجم المأساة التي حلت بالمخيم، مهينة لعقل القارئ وذائقته أيضا.
رواية «جنين 2002» تضعنا أمام تساؤلات جدية حيال القصور الظاهر في تجسيد صورة الآخر الإسرائيلي في الرواية العربية المعاصرة. من ناحية أخرى، فإن تجدد المواجهة مع قوات الاحتلال تحتم علينا كقراء أن نمارس دورنا عبر المساءلة المستمرة وإعادة التقييم للأعمال الأدبية التي تعالج الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، سعيا للارتقاء بأدوات التصوير السردي للآخر الإسرائيلي وتجاوز القوالب الجاهزة التي وضعت أساسا لإرضاء غرورنا بعد أكثر من نصف قرن من الهزائم.
صورة الآخر الإسرائيلي
قراءة في رواية «جنين 2002» لأنور حامد


صورة الآخر الإسرائيلي

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة