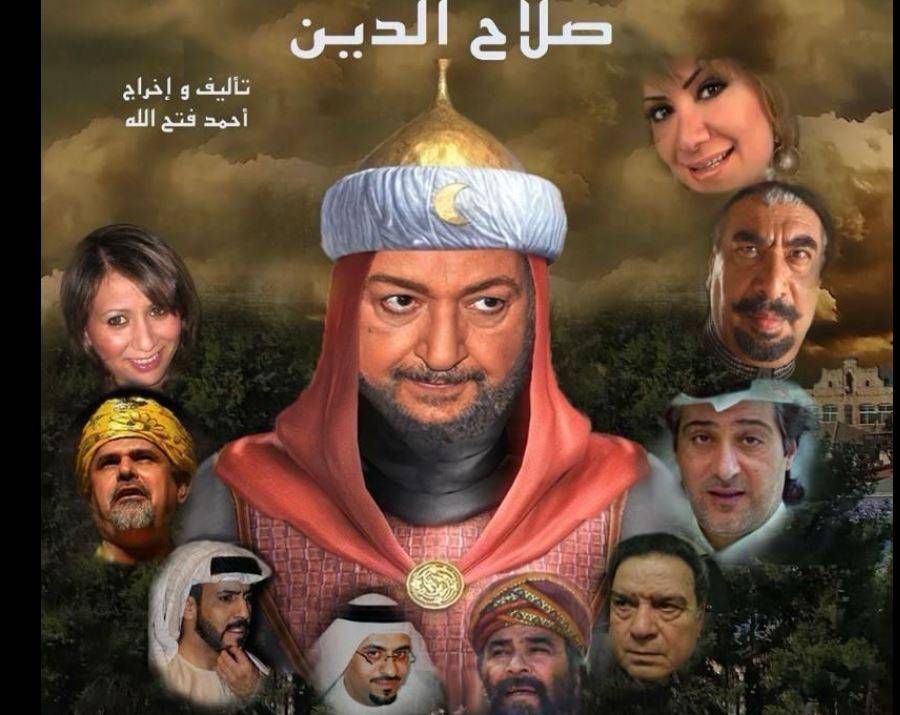كثيراً ما يُطرح سؤال «لمن نكتب؟» مقروناً بـ«كيف؟» و«لماذا؟»، من دون أن تستقر الإجابة على حال، وذلك تبعاً لقناعات المبدعين والتحولات المرتبطة بالكتابة في علاقةٍ بالرؤية إلى العالم، وما يَسْتَضْمِرُه السؤال منْ إشكالات الكِتابة: الجَدوى، الحُرية، الالتزام وثُنائيَّة الشَّكل والمضمون.
في علاقة بسؤال «لمن نكتب؟»، وما قد تتناسل عنه من أسئلة، نقرأ للكاتب والشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي، في كتابه «شاعر يمر» الذي استعاد فيه جانباً من سيرته الذاتية: «لم تتوقف المعارك التي انخرطت فيها لحد الآن، إلا أنني أجد نفسي سائراً في منعطف وفي الوقت نفسه متورطاً فيه. اعتباراً من ذلك فإن سؤال لمن نكتب ولماذا وكيف؟ سوف يُطرح على نحو مختلف. نكتب من أجل الحفاظ على ذاكرة المغامرة الإنسانية، وربما لكي نشهد، مَن يدري خلال كم من الوقت، آخر اختلاجاتها، هل تكون تلك هي المهمة الأخيرة للأدب؟ هل يشاركني كتاب آخرون الإحساس نفسه أمام هذه الخلخلة، أم أنني وحدي في ركني مَن يشعر بالذعر ويغرق في الهذيان؟».
من جهته، اختار عبد الفتاح كيليطو، في كتابه «حصان نيتشه»، أن يطرح قضية الكتابة في علاقتها بفعل القراءة. يقول: «إحدى مهام الكاتب هي أن يتبنى نبرة، ويحتفظ بها، ويجعل القارئ يتقبلها. حينما أقرأ محكياً، يحدث أن أقول لنفسي أمام مقطع: قد عشت هذا المشهد، وأحسست بهذه العاطفة، ويتكون عندي انطباع بأن ما أقرأه قد كُتب لي خصوصاً، بل يحدث أن أقول لنفسي بكل سذاجة: «كان بمقدوري أن أكتب هذا الفصل، وهذا الكتاب. وفي حال قصوى، أكاد أحقد على المؤلف لأنه قد اختلس شذرة من ذاتي، وسلبني إياها! سيسعدني أن يصادف القارئ نفسه في هذا النثر السردي، أن يتوجه إليه بإحساس أنه كان بإمكانه أن يكتبه، ويقرأه كما لو كان هو نفسه قد كتبه».
ماذا يقول كتابنا الذين ينتمون إلى جيل لاحق؟
- محمود عبد الغني: أكتب لشخص يشبهني
جواباً عن سؤال «لمن أكتب؟»، يقول الشاعر والروائي محمود عبد الغني: «أكتب لشخص يشبهني، يضجر في كل سطر، يعرف كل شيء ويجهل كل شيء في آن واحد. عدوّ ذكي للكاتب، يقف عند كل فكرة يقدمها له ويتأملها، ويعيد قراءة كل حكاية ليختبر صلابة تخييلها، وعند كل حبكة ليرى تماسكها وحسن تنظيمها. هكذا أتخيّل قارئي. لا أقصد المثقف بل صاحب خبرة في القراءة، والتأمل، والضجر السريع. كل شيء في هذا القارئ جميل ومثير ورائع. قارئ رقيق يقرأ بالنهار، فيكون قارئاً مستمعاً لنبض النصوص، وبالليل فيكون رقيقاً مثل الليل، الكلمات بالنسبة إليه أنشودة والشخصيات أغوار».
ويستحضر عبد الغني، الجاحظ، الذي قال عن هذا الشبيه إنه «يعرف كل شيء، وربما أكثر من الكاتب نفسه. بل وحتى إن كان يحبك ويقتني كتبك، فليس لأنه مستسلم لها أو لك، بل لأنه يريد عجنها من جديد، وإخراجها في شكل جديد»، و«لذلك -يستدرك محمود عبد الغني- وجب الحذر منه، ورؤية ظلاله المنتشرة في كل مكان. كل شيء فيه يفضحه، إنه كاتب متنكّر في هيئة قارئ. مؤوّل لا يملّ، شكلاني لا حدود لشكلانيته. وأنا أكتب إليه وأحييه. أنا سكرتيره الخاص. وذلك قدري الجميل».
- طارق بكاري: أكتبُ استشفاءً
من جهته، يقول الروائي طارق بكاري، جواباً عن السؤال نفسه: «شخصياً عندما أكتب لا ألقي بالاً لمسألة التلقي. أؤمنُ بأن الكاتب حينَ يخلصُ للكتابة ويبدعُ بصدقٍ فإن ما يكتبهُ يصلُ بصدقٍ إلى قلوب القراء بغضّ النظر عن اختلافاتهم الشكلية، لأنّ الأدب الحقيقي يخاطبُ الإنسان في القارئ، وهو واحد، بغضّ النظر عن الجغرافيا، أو اللغة أو الدين... ثمّ إنني أكتبُ لنفسي كذلك، أكتبُ استشفاءً. لطالما آمنتُ بإمكانية التداوي بالأدب كتابةً وقراءةً، ولأنني أجدُ في الكتابة عزاءً من نوع ما فلا بد من أن يجد القراء في الأدب هذا العزاء».
يستدرك بكاري فيقول إنه يكتبُ أيضاً «لمن يؤمنون بأن بمقدور الأدب أن يرتق الجراح الكثيرة التي تخلفها الحياة في أرواحهم، لمن يرون مثلي أن باستطاعة الأدب أن يصالحهم مع ذواتهم، أن ينقدهم، والأهم أن يُطلعهم على الحجم الحقيقي لأحزانهم، أكتبُ للذين يؤمنون بجدوى هذا التطهير. وأكتب أيضاً للمستقبل، أريدُ لنصوصي أن تعيشَ طويلاً بعدي، أشتهي هذا الخلود الرمزي الذي يمنحنا إياه الأدب، وأراهن على هذا الأمر في كل ما أكتب. كما أنني أكتبُ للحاضر، لقرائي وهم كثيرون من المحيط إلى الخليج، للقراء المخلصين جداً مغاربةً وعرباً».
- عبد اللطيف السخيري: لِمَن... ولماذا؟
ويرى الشاعر عبد اللطيف السخيري، أن سؤال «لِمَنْ يَكْتُبُ المُبدِعُون المغاربة اليَوم؟» هو «سُؤالٌ مُتعدِّدُ الأَبعاد، وإِنْ كانَ التبئيرُ فيه على المُرسَل إليه أَسَاساً».
يشدد السخيري على أن تعدُّدية السُّؤال تتبدى «فيما يَسْتَضْمِرُه منْ إشكالات الكِتابة، كأسئلة: الجَدوى، والحُرية، والالتزام، وثُنائيَّة الشَّكل والمضمون... إلخ»؛ ليرى أن مُسْتَنَد هذا الزَّعْم «تلازُمُ سُؤالِ: لِماذا نَكتُب؟ وسؤال: لِمَنْ نكتُب؟ حيثُ تَتَعَدَّى الكتابة الذَّاتَ نَحو المُتلقي أو القارئ تَحديداً»، مشيراً إلى أنَّ «دَوافعَ الكِتابة وغَاياتِها تَختلِفُ من مُبدِعٍ إلى آخر، تَبَعاً لسياقه الثقافي والاجتماعي والتاريخي، ولاستعداداته النفسية، وأسئلته الإبداعية»، وأن «العوامل ذَاتها تحدِّدُ العَلاقة التي يَبْنِيها، أو يَفْتَرِضُها تجاهَ القَارئ في أثناء فعل الكِتابة، سواءٌ أَكَان قَارئاً مُفترضاً، أَم مُتخيَّلاً، ضِمْنياً، أم خبيراً... إلخ».
يستدرك السخيري، فيشير إلى أن «العلاقة المُشارَ إليها هُنا، لَيست بالبَساطة التي قد نَظُنُّها. فقدَ فَتحت نَظريات التلقي والقِراءة وَعْيَنا على الدور الكبير الذي يُؤَدِّيه القَارئُ في بِناء مَعْنَى النَّص بما يَجْعَلُ القِراءة كِتَابَة عَلى كِتَابة، أي كتابة مُضاعَفَة. وعَلى الرُّغم من أَنَّ نَفْي أَي دَوْرٍ للقارئ في أَثناء إِنتاج العَمَل الإبداعي يَبْقَى ضَرْباً منَ العِناد غَيْرِ المُجدي؛ فَإنَّ الزَعم بأنَّنا نَتوجَّهُ إلى قَارئ مُعَيَّن، وأننا نَعْمَلُ على التأثير فيه، وتَغْييرِ قَناعاته، هُوَ قَوْلٌ لا يَقِلُّ ادِّعاءً عن سَابِقِه. وبَيَانُ ذلكَ أنَّنا في الكِتابة –وبخَاصَّة الكِتابة الشِّعرية- نَكتُبُ ونحنُ على وَعْي بِانتِمَاء فِعْلِنَا لِسِيَاقٍ درَاميّ، تَتَوَجَّهُ فيهِ الذَّاتُ نحوَ ذَاتِها، وتَظَلُّ -في تصوُّرِنا- مُتَأَرْجِحَة بينَ اليَأس من تفَاعُل الآخَر مَعها، وبَين الأَمَل في ذلكَ التفاعُل الذي يَتَغَيَّا تَغْيير الوَاقع».
يربط السخيري إجابته عن السؤال بالسياق الثقافي المغربي الراهن، الذي قال عنه إنه «يُحفِّزُ على مُشاطرة موريس بلانْشُو رَبْطَهُ الكتابة بالمَوت، على اعتبار أن (اكْتِمال) العَمل الأدبي هو إِعلانٌ عن مَوْتِ مُؤلِّفِه، وبِداية حَياة العَمَل في لَحْظَة الاِنْفِصَال هاتِه، التي هِي في الآن نَفْسِه لحظة اتِّصال آخر بِواسطة القِراءة. وبهذا الفَهْمِ يَسْتحيلُ التواصُل بين المُؤلِّف والقَارئ، لأنَّ التواصُل –إِن تَمَّ- يَكُون بينَ القارئِ والعَمل الأدبي (المُؤلَّف) بِوَصْفِه إِنْتَاجاً لُغَويّاً بالأسَاس. وهُنا تَحْضُرنِي قَصيدة مُكَثَّفَة لِتْشَارْلز سِيمِيك بعنوان (إلَى القَارئ): أَلا تَسْمَعُنِي-أَخْبِطُ حَائِطَكَ- برَأْسِي؟- بِالتأْكِيدِ تَسْمَعُنِي، - فَلِماذا إِذاً- لا تَرُدُّ عَلَيَّ؟- اِخْبِطِ الْحَائِطَ مِنْ جِهَتِك- وَلْنَبْقَ خِلّاناً».
يختم السخيري، بالقول: «نَكْتُب إلى هَذا القارئ، ونَكُونُه عند تَلقِّينا لِكِتابة الآخرين، فَتَحْضُر المُفارقة بين التواصُل واستحالته. لَمْ تَعُدِ الحَاجَة –في ضَوْءِ أُفُول الآيديولوجيا في سياقِنا الثَّقافي- إلى التزام الكَاتب بالمَعْنَى السَّارتريّ؛ وإنَّما نَحْنُ في حَاجة إلى التزَام الْكِتَابة بِمُقَوِّمَاتها الشَّكلية والمَضْمُونية، وهي تَبْحَثُ عن حَداثَتها الخاصّة».
لمن يكتب المبدعون المغاربة... اليوم؟
بين أسئلة الجدوى والحرية والالتزام وتخيل قارئ محدد

طارق بكاري - محمد عبد الغني - عبد اللطيف السخيري

لمن يكتب المبدعون المغاربة... اليوم؟

طارق بكاري - محمد عبد الغني - عبد اللطيف السخيري
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة